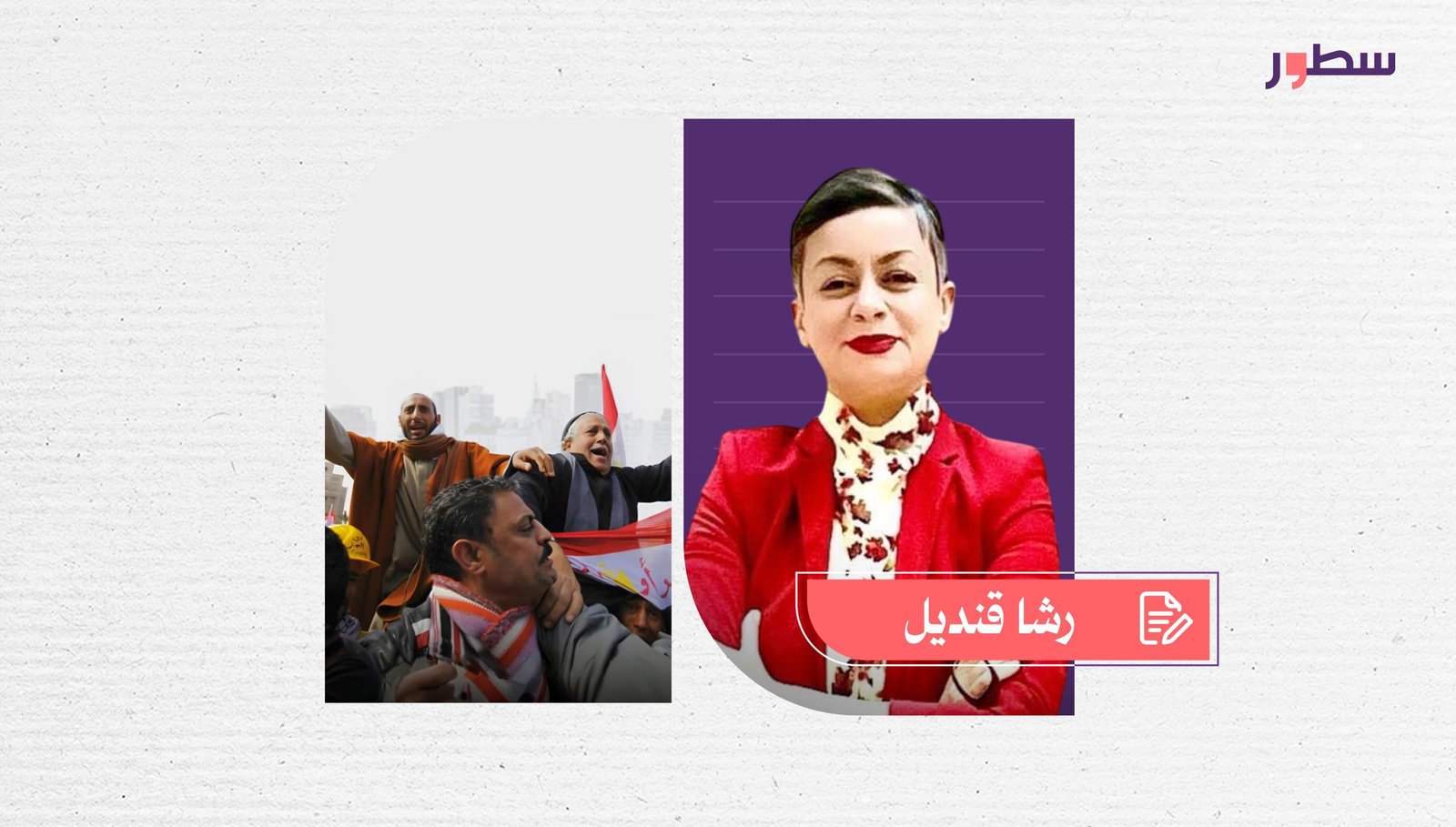آراء
عزيزي غسان.. هاهم يدقون جدران الخزان
عزيزي غسان.. هاهم يدقون جدران الخزان
على المعبر، هلك الثلاثة، أبو قيس، وأسعد، ومروان، وهم يحاولون الفرار من مصيرهم المحتوم، أو هروبهم من مقاومته، نحو مصير آخر كتب عليهم هو الآخر عنوة، محبوسين في صهريج خانق، تأكله حرارة الشمس في عز القيظ، وهم يتصببون عرقا كأنه من حمم جهنم، وتنقطع أنفاسهم دون أن يلتقطوا ذرة هواء واحدة تمنحهم أملا في الحياة، ماتوا وهم يخشون أن يحدثوا أي ضجيج، أن يثقبوا أي ثغر، أن يحدثوا أي جلبة، حتى لا يموتوا بينما هم في طريقهم للموت، وهم في الأساس خاضوا طريق الموت وهم يبحثون عن بقايا حياة.
كان سؤال غسان كنفاني الأخير لهم، في صوت القراء والقصة والمشهد الختامي والنهاية المحبوكة ببراعة لروايته الخالدة “رجال في الشمس”: “لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟” كان غسان يستنكر ذلك، ومنذ ذلك الحين، منذ خمسة عقود وما زال الجميع يسألهم آلاف المرات كل يوم، وقد تحللوا في أوراقهم وشبعوا موتا: لماذا لم تدقوا جدران الخزان؟ لعل ذلك كان يؤجل الموت دقيقة، أو لعله كان ينجيكم جميعا، أو لعله أماتكم في اللحظة نفسها لسبب، لشيء غير الخوف الكسير في مؤخرة العربة، أن تموتوا وأنتم تحاولون الخروج من القمقم، ورفع رؤوسكم التي لطالما أرادوها محنية.
وأنا قلبي معهم، لا ألومهم، ولا أقسو عليهم، لأن لكل منا خزانا يخشى طرقه، ويخاف إن دقّه أن يخرج منه الوحش الذي يرتعد منه، لكنني أفهم غسانا كذلك، أعرف ما يفكر فيه وهو ابن تلك الأرض، وهو المقاوم، ولسان المقاومة، وهو المفاوض، وهو المتحدث بلسان الخاطفين الذين يتحدون كبريات الدول وحثالة الكيانات الإجرامية، وهو الرجل الذي رأي دولا تسرق، وأراضي تباد، وقرى تهجّر، ورأي الموت متجسدا في الخوف أكثر من الجرأة، وفي السلامة أكثر من الجسارة، وفي الدعة أكثر من الحركة، فيعزّ عليه “الموت المجاني”، وهو الذي نبّه الجميع من بعده أن يحذروا الموت العادي، وجسّد هو مقولته بنفسه، بآخر لحظات حياته، ومن صميم أشلائه المتناثرة، فكان موته بسبب ولهدف، وثمنا لموقف، وقد كان سيموت سيموت، لكنه حينها اختار الموت بطريقته المفضلة، مغتالا في سيارة مفخخة.
وفي سياق هذا الموت غير العادي، خرج رجلٌ من أقصى المدينة يسعى، واصلا نحو المعبر، لا ليعبر أفقيا إلى الأرض، وإنما رأسيا إلى السماء، وفي يديه أرواح ثلاثة من العدوّ، هم كل ما ملك من هذه الدنيا، وأحقر ما ملك من هذه الدنيا، وآخر ما ملك من هذه الدنيا، لكن المشهد كله هو أعز ما ملك من هذه الدنيا، ممسكًا بهم كأنهم طوق نجاته في عهد الطوفان، وكأنهم محركات أجنحته التي يصعد بها إلى الأعلى، يقول يا رب، وعدني عبدك ونبيك ألا يدخل مجرمٌ كهؤلاء وقاتله في النار، وأنا يا رب قتلتهم ثلاثا، فنجّني ثلاثا، وارفعني ثلاثا، وآتني الفردوس الأعلى، ولظّهم هم في الدرك الأسفل من السعير.
كان عمي ماهر الجازي الحويطي سيمضي ذات يوم إلى مثواه، قد يموت على المعبر بضربة شمس، أو بضربة حادث، أو بضربة جندي يهينه أمام الجميع وهو يحاول العبور بين الضفتين -إلا أن الجندي الواقف بينهما لا ينتمي لأي منهما، ويود لو ألقى بهما بمن فيهما في النهر، ويعيش هو فاتحًا قدميه يحجز سرقته بين هنا وهناك- كان الحاج ماهر سيمضي إلى حشرجته، سيلفظ أنفاسه الأخيرة، في الميعاد ذاته، دون زيادة أو نقصان، لكنه اختار الموت بطريقته المفضلة، ودّع شاحنته رفيقة الحياة والرحلة والطريق، وقرر أن يدقّ جدران الخزان، بدلا من الانكفاء على عجلة القيادة في صمت خانع، وفك قيده بنفسه، حين قرر رفعها إلى الله، التقطَ مسدسه، ثم سدد نحو أهدافه الثلاثة، وقد أدى إلى الله ما عليه.
وبعدها يلهم ماهر رجلًا آخر، بشاحنة أخرى، كتلك التي ذكرها غسان في روايته، ولم يكتفِ أن يكون رجلا في الشمس، وإنما كان شمسا في رجل، وكوكبا في إنسان، وقمرا في الأرض، فدقّ جدران الخزان، ولم يستسلم للطريق التي رصفها من تحته عدوه ليسير فيها بين خطين محددين دون حيود، لكنه اختار الاعوجاج الذي هو ذروة الاستقامة، والعجلة التي هي قمة التأني، والثبات الذي هو قمة الاندفاع، وصنع الحدث بالحادثة، واختار أن يقوم بعمليته المعظمة، وهو يحاول تصحيح الأرض، وإماطة الأذى، وتسوية السبيل، شاحنًا بشاحنته تلك المخلوقات الدنيئة إلى الجحيم، بينما يضع هو كلتا قدميه في الجنة، ولو كانت روحه ما زالت في الدنيا، وكان إنسانا يقود منذ خمسين عاما، ثم فجأة رأى الجنة، أتراه يدوس على المكابح؟!
هاهم أبطال جدد، ورجال كالشموس ولو عاشوا وماتوا في الظل، لا يكتفون بسحب الصهاريج من خلفهم يا غسان، وإنما يدقون جدران الخزانات، يطرقونها، يثقبونها، يحرقونها، يفجرونها تفجيرا، يحدثون الضجيج الذي يفضلون الموت في كنَفه، بعيدا عن الموت في سكوت مطبق، واستسلام ذليل. هاهم يموتون، يا غسان، مثلك، بطريقتهم المفضلة.