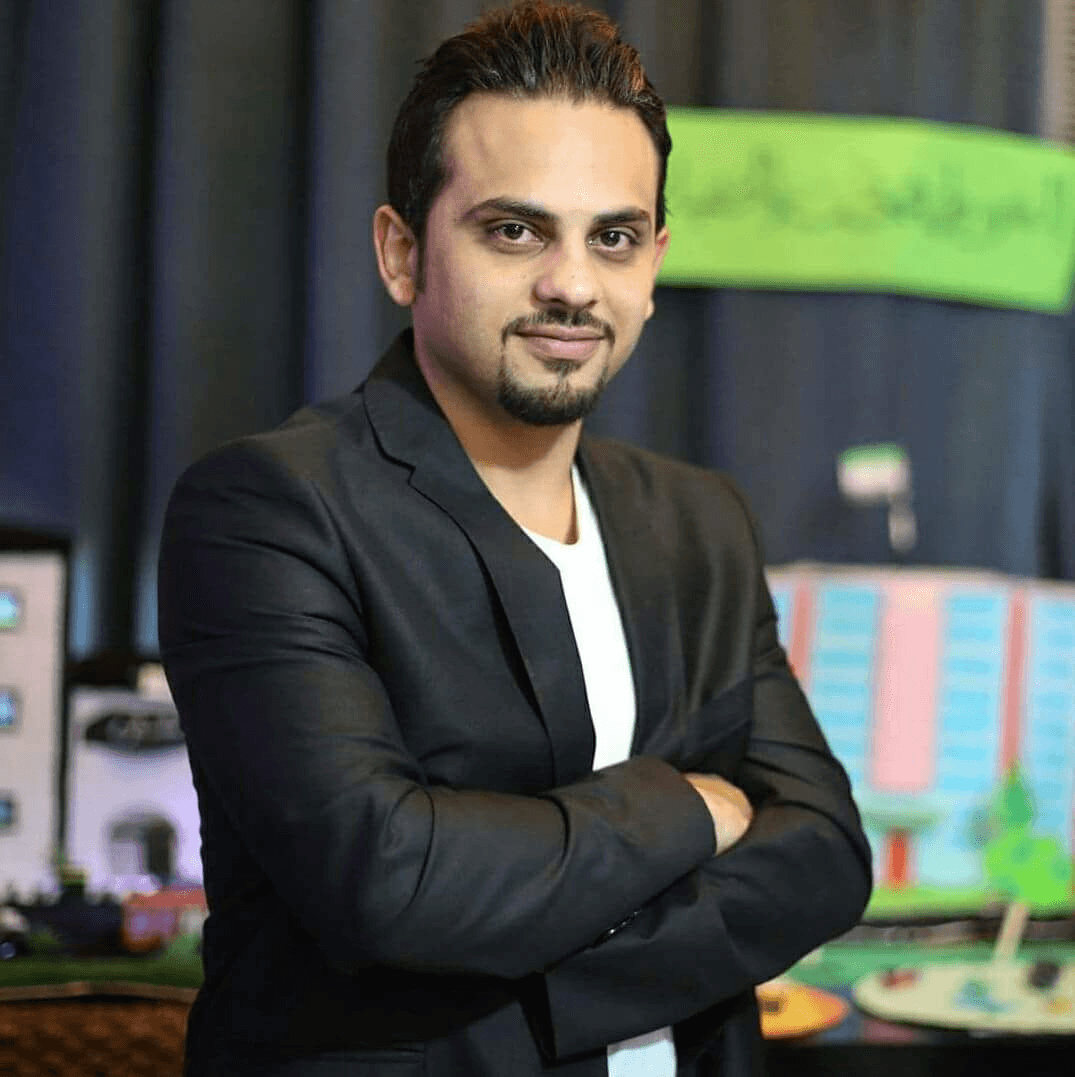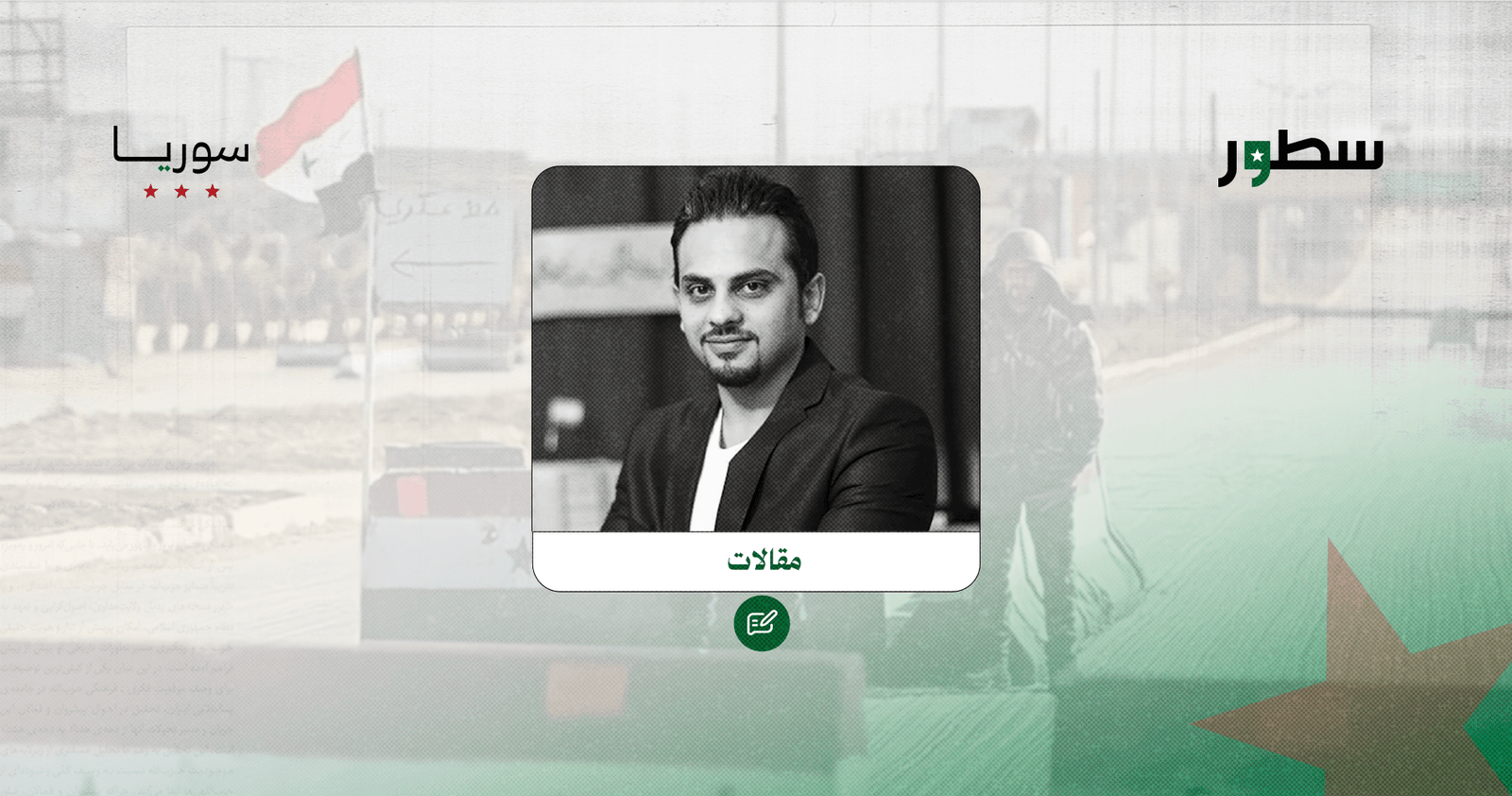أدب
كوابيس تحرس الذاكرة
كوابيس تحرس الذاكرة
كان صباحاً بارداً من كانون الثاني 2012 حين وجدتُ نفسي متوقّفاً أمام حاجز طيّار قرب مقبرة الدحداح، في اللحظة التي كنت أغادر فيها دمشق عائداً إلى الغوطة الشرقية. لم يكن ذلك الحاجز جزءاً من الطريق المعتاد، وكان ظهوره المفاجئ كفيلاً بإرباك الصباح الذي بدأ هادئاً قبل دقائق فقط. كنت قد أمضيت أسابيع متنقّلاً بين بيوت أصدقاءٍ وأقارب في الزاهرة والميدان، أحاول تنظيم حياتي الجامعية بعد انتقالي من كلية الاقتصاد في جامعة تشرين إلى جامعة دمشق، ولم يخطر لي أنّ هذا اليوم سيصبح نهاية علاقتي بالمدينة كلها، لأنّني لم أعد إليها بعد تلك اللحظة.
وقف العسكري يقلّب بطاقتي ببطء قصده غير واضح، ونظرته الطويلة إلى اسمي جعلتني أشعر أنّ الإنسان قد يجد نفسه معلّقاً بين قرارين لا يستطيع التحكم بهما. لم تكن تلك الثواني مجرّد إجراء أمني، إذ تحوّلت لاحقاً إلى لحظةٍ مرجعية يعود إليها ذهني كلما حاول تفسير ما يظهر ليلاً على شكل كوابيس متقطّعة تبدأ من تلك النقطة تحديداً.
منذ ذلك الصباح صرت أرى دمشق مساحةً تتجاوز حدودها المادية. لم تعد مدينةً تنتظم في شوارع وأسواق، وإنّما أصبحت طبقة داخلية تتقاطع فيها الذاكرة مع الخوف ومع سؤالٍ أكبر عن معنى أن يتوقف المرء عن العودة إلى مكان عاش فيه جزءاً من حياته. كنت أستعيد شوارع الزاهرة والميدان والبرامكة لا لأبحث عن حنينٍ ضائع، وإنّما لأفهم لماذا انقطع ذلك الخيط فجأة، وكيف تحوّلت مدينة كاملة إلى لحظةٍ توقّف عند حاجز لم يدم أكثر من دقائق.
أمّا الحاجز الطيّار الذي ظهر بلا مقدمات، فقد ظلّ نقطة مفتاحية في تفسير كثير من مشاهد الخوف التي تشكّلت بعدها. الجملة التي قالها العسكري وهو يقلّب بطاقتي لم تكن استفساراً عن الهوية فقط، وإنّما كانت إعلاناً بأنّ هشاشة الإنسان لا تظهر في الساحات الكبيرة، بل في لحظةٍ يضع فيها الآخر مصيره تحت مجهول لا يملك له اسماً. ارتباكي وقتها لم يكن خوفاً من الجندي نفسه، بل صدمة من إدراك أنّ وجودي يمكن أن يتوقف عند نظرة واحدة.
ومن هناك بدأت الكوابيس. لم تظهر كامتدادٍ ميكانيكي للخوف، بدت أشبه بمحاولة يعيد فيها العقل ترتيب التجربة التي لم يجد لها إطاراً مناسباً وقت حدوثها. كانت الصور تتداخل: الحاجز، الباص المحاط بالأسلاك، صوت الطائرة، الصمت الذي يسبق سقوط القذيفة، الارتجاج الذي كنّا نقيس به احتمال النجاة.. كلّ ذلك لم يعد مجرد أثر نفسي، إذ صار جزءاً من آلية تُبقي التجربة حيّة وحاضرة لكل تفاصيلها الحسيّة.
حدث أن التقيت صديقاً خرج من الاعتقال بعد 8 أشهر قضاها متنقلاً بين أفرع أمن مختلفة، كان يحاول أن يعيش حياته كما لو أنّ الزمن يمكن أن يستقيم بسهولة، لكنّه كان يتوقف فجأة وسط جملة عادية، كأنّه سمع صوتاً لا نسمعه. قال لي مرّة إنّه لم يستطع التخلص من مشهد واحد: لحظة استيقاظه ليلاً حين ظنّ أنّ الباب يُفتح مجدداً، مع أنّه كان في بيته. لم يكن الكابوس يزور نومه فقط، بل كان يزوره في النهار أيضاً. كان يعيش ما يشبه الازدواج بين حاضرٍ يحاول تثبيته، وماضٍ يتسلل إليه من فجوات صغيرة لا يستطيع إغلاقها.
مع مرور الوقت فهمت أنّ الكوابيس ليست استدعاءً عبثياً للماضي، وإنّما محاولة لحماية التفاصيل التي يمكن أن تتلاشى لو اعتمدت على الذاكرة وحدها. فهي لا تعيد الماضي إلى الواجهة بدافع النحيب، وإنّما بدافع مقاومة النسيان، لأنّ النسيان في سياقٍ كهذا يمكن أن يتحوّل إلى مساحةٍ يعيد فيها الآخرون تشكيل الحقيقة. كانت تعمل كنوعٍ من الأرشفة الداخلية، تحفظ الحقيقة من الانزلاق نحو التخفيف، وتعيد تثبيت الحدث في مكانه الصحيح.
حين رأيت الأمهات بعد سقوط النظام يقفن أمام أبواب صيدنايا، يحملن صور أبنائهن ويسألن عن أثر مهما كان صغيراً. فهمت أن المشهد كان أقرب إلى إعادة تثبيت الحقيقة، لأن الألم الذي ظهر في وجوههن لم يكن مجرد حزن على الغياب، وإنما إعلان أن التجربة لا يجوز أن تتحول إلى مادة قابلة لإعادة الصياغة. يومها رأيت أنّ الكوابيس التي نحاول التخفف منها هي، في لحظات كهذه، أداة لحماية الرواية الأصلية من التمييع.
وهكذا تغيّر شكل الأمل بالنسبة لي. لم يعد وعداً سهلاً بالطمأنينة، ولا وهم عودة كاملة إلى ما قبل. صار أملاً واعياً، يستند إلى معرفةٍ عميقة بما حدث، وإلى إدراك أنّ العدالة لا تبدأ من المؤسسات فقط، بل من إصرار الإنسان على حفظ تجربته كما عاشها، لا كما يُفترض أن تُروى.
ومع هذا الفهم، لم تعد الكوابيس تهديداً بقدر ما أصبحت وظيفة. هي علامة على أنّ الذاكرة ما تزال قادرة على حماية نفسها، وأنّ الحقيقة، مهما تراجعت، لم تختفِ. وكلما عاد الحلم بصوره الثقيلة، عاد معه صوت داخلي يذكّرني بأنّ ما نحمله ليس عبئاً فقط، وإنّما شاهد ضروري على الطريق نحو عدالة لم تكتمل بعد.