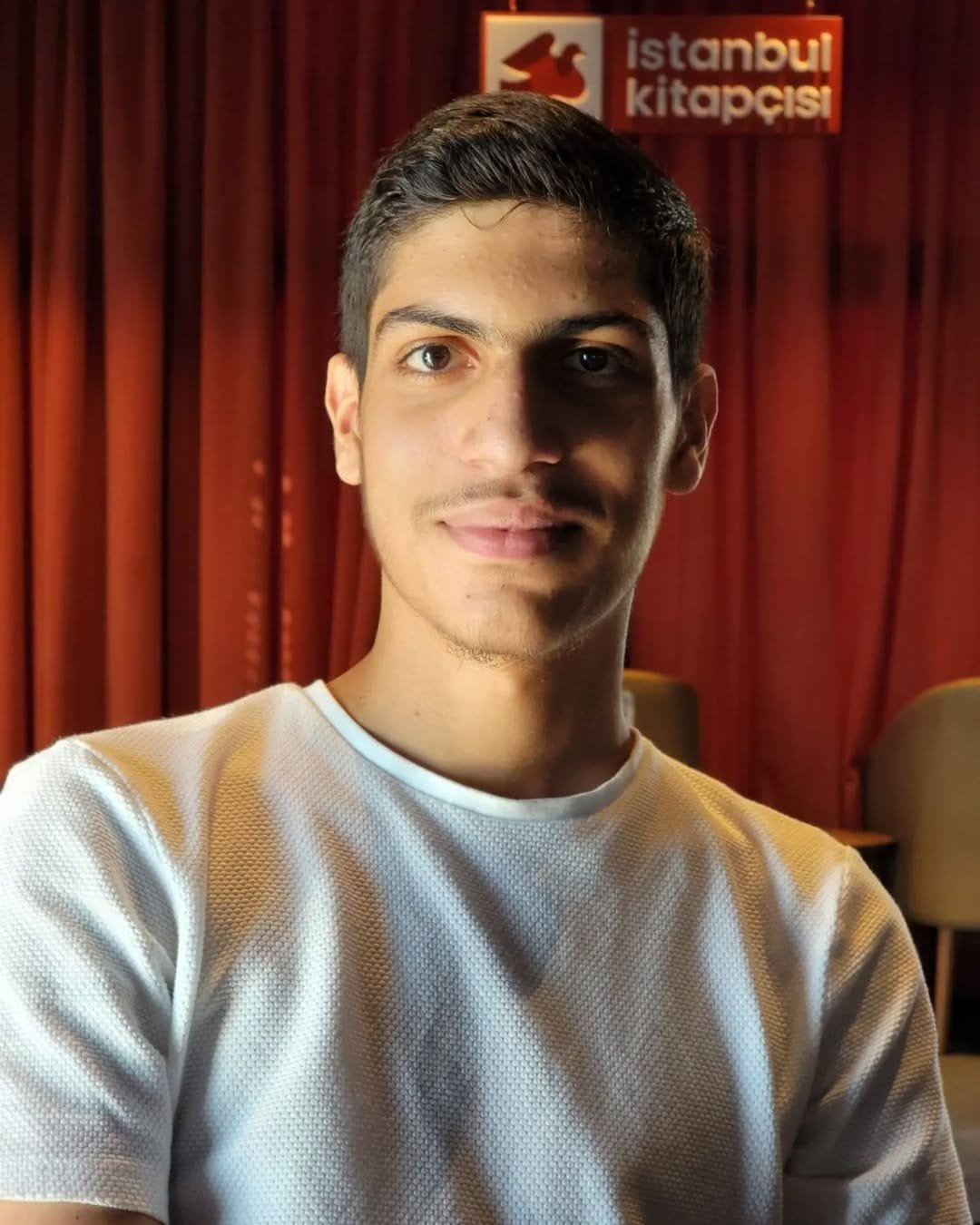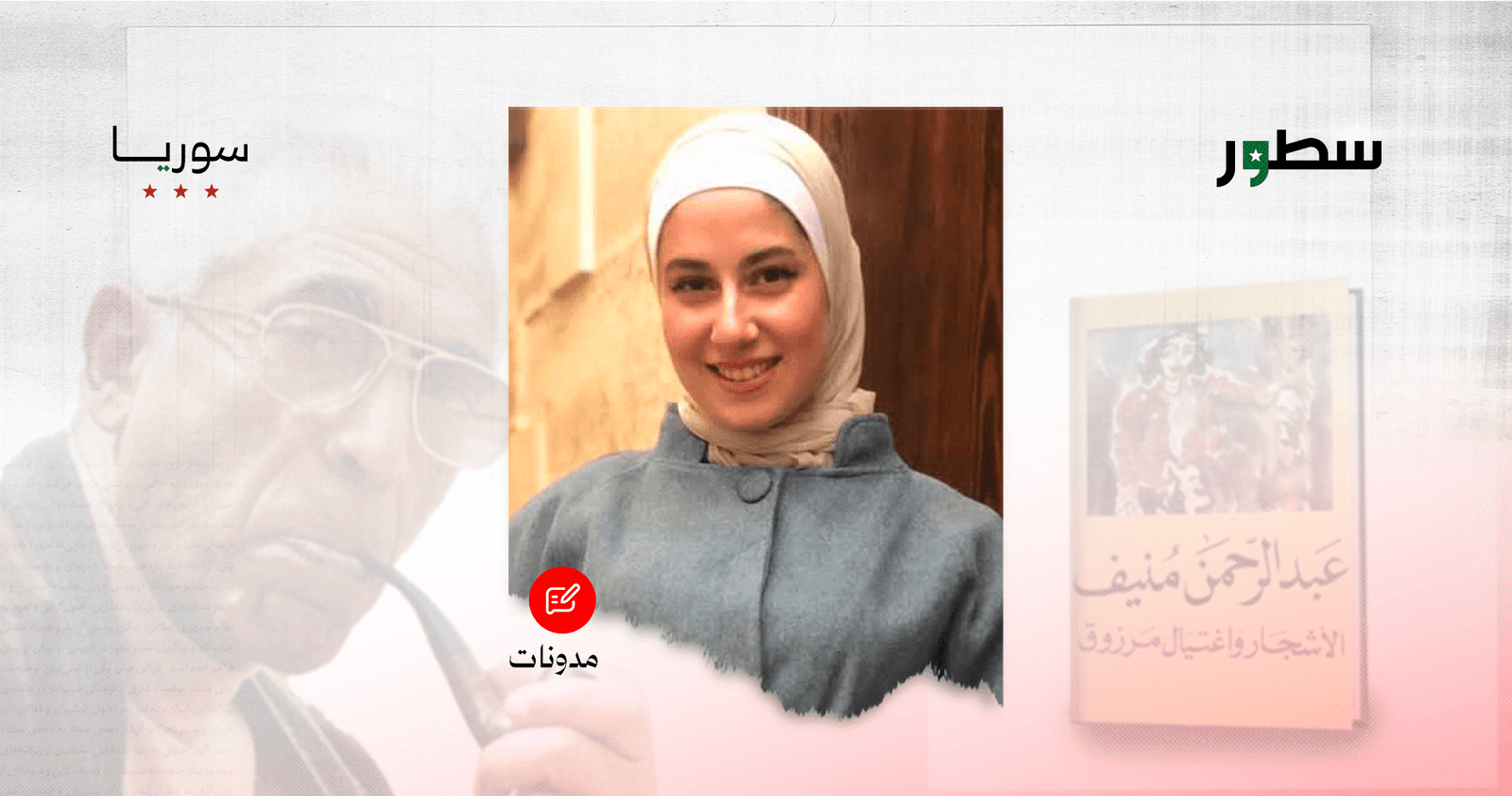مجتمع
العشائر السورية بين الفزعة والهوية القاتلة: قراءة في التاريخ والمصير
العشائر السورية بين الفزعة والهوية القاتلة: قراءة في التاريخ والمصير
قد يعتقد البعض أن ما حصل من “فزعة عشائرية” في السويداء لنصرة البدو ضد الدروز حدث عابر، لكن المسار التاريخي وعلم الاجتماع السياسي في الشرق الأوسط يبرهن أنه حدث غير عادي، بل هو حدث عابر للتقسيمات التقليدية والهويات الضيقة، ويحمل في طياته أخطاراً وإشاراتٍ ينبغي التوقف عندها ودراستها بعناية.
يدرك أبناء العشائر العربية جيداً معنى الفزعة العشائرية؛ فعندما ينادي أحد شيوخ القبائل للنفير العام، تلبي بقية العشائر النداء مدفوعةً بالنخوة والتضامن الذي شكّلته تجارب الظلم والمظلومية المتراكمة عبر أجيال، فالتعبئة العشائرية ليست ردة فعل عابرة، بل تمتد لتكون ردّاً على المظالم التاريخية التي تحفظها ذاكرة جمعية مختزنة ومتراكمة للقبائل، في سياقات اجتماعية أقرب إلى منظومات الإقطاع في القرون الوسطى.
العشائرية في الوعي الجمعي: بين التضامن والتهميش
تفرض الصورة النمطية نظرة دونية ظالمة تجاه العشائر في سوريا عموماً؛ إذ يُختزل وجودهم أحياناً بوصفهم مجرد مجتمعات تقليدية مغلقة لا تصلح إلا للسخرية والتهميش، دلالةً على التخلف والبدائية في الوعي الشعبي والمدني. لكن الحقيقة التي تُغفلها هذه التنميطات أن الفزعة العشائرية ليست مجرد استنفار حربي أو قبلي عنيف، بل هي قبل كل شيء تعبير اجتماعي وأخلاقي أصيل يتجلى في لحظات المحن الإنسانية والوطنية الفارقة، مع أن بعض أفراد ووجهاء العشائر، عبر تصرفات فردية ومصالح ضيقة، حاولوا تشويه كل ذلك.
فهل تقتصر الفزعة على الحرب والثأر وسفك الدم؟ الوقائع الحديثة تُظهر العكس. فخلال زلزال عام 2023 في شمال سوريا، حضرت الفزعة الأخلاقية العشائرية بقوة في إغاثة المنكوبين، عبر تسيير أكبر قوافل إغاثة أهلية عرفها الشرق الأوسط في قرن كامل، متجاوزةً الحدود التي فرضتها سلطات الأمر الواقع، في تجسيد لثقافة نصرة الضعيف والمظلوم، ودحض للصورة النمطية القائلة إن العشائر قوة عنفية أو رجعية لا غير.
محطات تاريخية: حين صنعت العشائر الفارق
وربما يتبادر إلى الأذهان أن الفزعات العشائرية ذات طابع ثأري كما حصل في داحس والغبراء أو في طلب دم كليب في بني ربيعة قبل الإسلام، إلا أن التاريخ يحكي قصة أكثر تعقيداً. من معركة ذي قار التي واجهت فيها القبائل جيوش كسرى دفاعاً عن الكرامة العربية، أو حتى من خلال فاعليتها في جيوش الفتح الإسلامي التي وصلت مشارف الصين شرقاً وتجاوزت الأندلس غرباً.
في لحظات التحول التاريخي، كانت الفزعة العشائرية حاضرة بقوة، لا مجرد استنفار طارئ، بل فعلاً جماعياً واعياً نابعاً من الذاكرة والمظلومية المشتركة. في القرن الـ18، وقفت قبائل الفرات والبادية سدّاً منيعاً أمام التمدد الصفوي نحو العراق، وفي أواخر القرن الـ19، اعتمد السلطان عبد الحميد الثاني على ولاء العشائر عبر تشكيل فرسان الحميدية، مستثمراً عصبيتها كقوة رديفة للدولة. أما الثورة العربية الكبرى، فلم تكن لتولد من فراغ، بل نهضت على سواعد القبائل التي لبّت نداء الشريف حسين بدافع النخوة والرغبة في التحرر، فشكّلت نواة الجيش العربي الذي زحف إلى دمشق. هذا الدور لم يغب عن المشهد العراقي أيضاً، حيث برزت العشائر في الجنوب والوسط خلال ثورة العشرين كقوة مطالبة بالاستقلال ضد البريطانيين.
لم تغب هذه الحقيقة عن أذهان القوى الكبرى التي انخرطت في الشرق الأوسط؛ فقد أدرك البريطانيون والفرنسيون والألمان أن مفتاح السيطرة يمر عبر فهم تركيبة المجتمع القبلي. فعلى سبيل المثال، وضع تي. إي. لورنس خطة لاستقطاب شيوخ القبائل لضمان انضمامهم للثورة العربية، ونجح في توحيد كثير من القبائل تحت لواء فيصل بن الشريف حسين. كما أدت البريطانية غريشد بيل دوراً محورياً في رسم حدود العراق بعد الحرب العالمية الأولى، معتمدة على علاقاتها مع شيوخ العشائر. أما المستشرق الألماني ماكس فون أوبنهايم، فقد أمضى سنوات طويلة يدرس أوضاع العشائر البدوية في الجزيرة وسوريا والعراق، ووضع موسوعة ضخمة بعنوان “كتاب البدو” ساعدت بلاده في فهم مفاتيح الصحراء. هكذا أدركت الدول الكبرى أن العصبية القبلية قد تكون سلاحاً ذا حدين: قوة لدعم الاستقرار إذا تم استثمارها بشكل صحيح، أو معول هدم إذا أُهملت.
وتكشف دروس التاريخ أن الفزعات أدت أدواراً سياسيةً مفصلية، فقد منعت الصفويين من احتلال العراق، وواجهت العثمانيين في الحجاز والشام، لكنها أيضاً جُيّرت أحياناً بشكل سلبي واستخدمت أداة ضغط سياسي أو وقوداً لصراعات الآخرين.
التوظيف السياسي للعشائر: السلطة، الفتنة، والتفتيت
كثيراً ما استُخدمت العشائر كأدوات في يد الأنظمة، حيث استُغلت قوتها الاجتماعية وجُيّشت ضد الخصوم، ثم تُركت وحيدة تدفع ثمن أي تجاوزات. هكذا فعل نظام الأسد عندما روج بأن أبناء العشائر “الشوايا” هم المسؤولون عن مذابح حماة في الثمانينيات، ليترك القبائل وحدها تحت عبء العنف والعزلة، متبرئاً من أدواره. مثل هذا التوظيف السلبي يُعمق التنميط والمظالم، ويجعل القبائل كبش فداء لإخفاقات السلطة، إضافة إلى أنه عمل على تفتيت البنية العشائرية في سوريا لإدراكه بأنها قوة إذا توحدت يمكنها الإطاحة بحكمه.
وبعد الثورة، تشظت هويات العشائر بصورة مرعبة؛ تفرقت الولاءات والانتماءات داخل العشيرة الواحدة والبيت الواحد، وفقدت العشيرة عمودها الفقري بفقدان شبابها في السجون أو معارك التحرير، وزاد تنظيم داعش من المأساة، خصوصاً في مجزرة الشعيطات التي راح ضحيتها أكثر من ألف من أبنائها، فتراجعت قوة الهوية العشائرية أمام آلة التدمير. جاءت قسد فيما بعد لتزيد من التفتت، عبر استثمارها في الولاءات والانقسامات، ولم تنجح الهويات العشائرية في الصمود خلال انتفاضة دير الزور 2023 إذ سرعان ما أُجهضت. وعقب سقوط النظام، عادت الهويات الفرعية للواجهة، وظهر أبناء العشائر يرفعون هويتهم بوجه تنمر مديني صريح، يذكرنا بصورة المقاتلين الأتراك الذين أزعجوا تجار بغداد في عهد المعتصم العباسي.
السويداء تعيد العشائر للواجهة: فزعة عابرة للحدود
أما في أحداث السويداء الأخيرة، فقد برزت العشيرة كهوية جامعة، وأحياناً قاتلة، حين فوجئ الجميع باحتشاد أكثر من 50 ألف مقاتل جنوب دمشق وفي مثلث الحدود الأردنية السورية الإسرائيلية، في مشهد يذكر بغزوات القرون الوسطى، قريباً من وادي اليرموك الذي تنافس فيه قبائل عرب الجزيرة في صفوف المسلمين والغساسنة في صفوف بيزنطة، أو حرب البطيخ القيسية اليمانية شمال نهر الأردن مطلع العهد العباسي، واليوم في نفس القاطع الجغرافي احتشدت عشائر العرب ضد نظيرتها المعروفية التنوخية. ورغم أن المعركة لم تدم طويلاً، فقد تركت أثراً كبيراً، ومع ذلك، من الظلم تحميل الفزعة وحدها مسؤولية ما جرى؛ فقد بقيت المعركة خارج مدينة السويداء فعلياً، واستطاعت سلطة دمشق إدارة الحشد وامتصاص الاندفاع بسرعة وفاعلية، رغم تشكيك كثيرين دولياً ومحلياً في قدرتها على ضبط هذا الحراك العاصف.
من جديد تجاوزت الفزعة العشائرية كونها حراكاً اجتماعياً إلى حدث سياسي عابر للحدود السياسية لدول الشرق الأوسط، ففي حين تمكنت فزعة الإغاثة التي انطلقت من دير الزور لإغاثة منكوبي الزلزال من عبور حواجز سلطات الأمر الواقع بمختلف ألوانهم عام 2023، كادت فزعات السويداء قبل أيام أن تكسر حدود سايكس بيكو، من خلال بيانات انتشرت بوقت قصير بالاستعداد للمشاركة من العراق والأردن ولبنان وفلسطين ودول الخليج العربي، في مشهد فاجأ توقعات أمهر مراكز الأبحاث وصناع السياسات.
العصبية وخطرها على مستقبل الدولة
إن واقع الجزيرة السورية اليوم أشبه ببركان على وشك الانفجار طالما جرى تجاهل صوت العشائر في المعادلة السياسية. فالعشائر ليست كتلاً سكانية محايدة، بل قوة بشرية وعسكرية حاسمة في أي ترتيبات أمنية وسياسية شرق سوريا. التجربة أكدت أن موقف العشائر يتراوح بين التعاون والمعارضة الصريحة بحسب ما يُعرض عليها من ضمانات وحقوق. فعندما دارت معارك طرد داعش، تعاونت العشائر مع قسد والتحالف الدولي، لكن ما إن هدأ غبار المعركة حتى وجد أبناء القبائل أنفسهم مهمشين في إدارة تديرها نخبة حزبية كردية لا تمثلهم. غاب التمثيل العربي العادل في الهياكل الحاكمة، واستأثرت النخب بالموارد، ما خلق حالة غليان تبرزها بيانات العشائر، ودعوات الانشقاق، بل حتى الصدامات المسلحة المتفرقة.
والواقع أن لعشائر سوريا، وخاصة الشرق السوري، دوراً اجتماعياً وسياسياً تقليدياً في المنطقة، وتجاهل هذا الدور أو قمعه يُولّد شعوراً بالغبن يدفعهم لاستعادة حقوقهم بالعصبية أو حتى السلاح إن استدعى الأمر. العشائر العربية لم تعد تقبل بعد اليوم أن تُدفع إلى الهامش أو تُعامل كضحية. وإذا استمرت “قسد” في نهج الإقصاء، فهي تفتح الباب على مصراعيه لانفجار كبير، قد يبدأ باحتقان دموي بين العرب والأكراد، وسرعان ما سيمتد للعراق وتركيا، وهذا هو السيناريو الذي لا يتمناه أحد.
إن النداء اليوم موجّه أولاً إلى “قسد” وقياداتها الكردية، التي رغم تبنّيها خطاب اللامركزية والشراكات، اختارت فعلياً أداة الإقصاء وسياسة التهميش المنهجي للعشائر العربية، متناسيةً أن هذه العشائر هي العمود الفقري للجزيرة السورية. لقد تجاهلت “قسد” على مدى سنوات الأصوات الداعية لإشراك العرب في السلطة والثروة، وراهنت على تهميشهم واحتكار القرار، في وقت لا تتوقف فيه عن التباكي على حقوق الأقليات في باقي أنحاء سوريا.
إن استمرار “قسد” وأذرعها السياسية في سياسة المماطلة ورفض تنفيذ اتفاق الاندماج مع الحكومة الجديدة -التي تراها العشائر اليوم سفينة نجاة من جور إدارة قسد الإقصائيةـ هو مقامرة خطيرة تهدد استقرار المنطقة ومستقبلها، وربما يفسر ميل العشائر للحكومة الانتقالية في سوريا برئاسة الشرع من منطلق القبول بأي بديل عن قسد، خاصة أن الحامل الهوياتي المقدّم أنهم يمثلون تياراً عروبياً سنياً. رغم أن العشائر في غالب سلوكها تغلّب رابط الدم العروبي على أي هوية دينية أو طائفية.
نحو عقد اجتماعي جديد يدمج العشائرية في الدولة
ما يهدد سوريا اليوم ليس فقط غياب الاستقرار الأمني والسياسي، بل تصاعد الهويات المجتزأة التي تختزل المجتمع في طوائف أو أعراق أو انتماءات محلية، وتُستخدم كوقود لصراعات عبثية. وعندما تُفصَل الهويات الفرعية عن مشروع وطني جامع، تتحوّل إلى هويات قاتلة مهما بدت عدالتها في الظاهر. وكما قال أمين معلوف في “الهويات القاتلة“: “الهويات لا تُجزّأ، ولا تُختزل دون أن تصبح قاتلة“، وهو تحذير يتجدد اليوم في واقع سوريا المنقسم.
وليست العشائرية استثناءً من هذه القاعدة؛ فهي قد تتحول إلى أداة فتنة حين تُختزل في الفزعة القتالية أو تُسخّر للإقصاء وترتكب باسمها الانتهاكات والاعتداءات، لكنها يمكن أن تكون رافعة لمشروع الدولة حين يجري احتضانها وتوظيفها إيجابياً ضمن عقد اجتماعي عادل. وهذا ما فهمه ابن خلدون بعمق حين رأى أن العصبية القبلية هي “الروح التي تقيم الدول وتحميها من الانهيار”، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن غلبة العصبية وانفصالها عن فكرة العمران والدولة تؤدي إلى الفوضى والخراب، قائلاً: “إذا فسد أمر العصبية فسد أمر الدولة وتداعى بنيانها”.
وأثبتت العشائر عبر التاريخ أنها ليست بنية جامدة أو مجرد بقايا تقاليد، بل نظام اجتماعي حي قادر على ضبط النزاعات وصون الكرامات حين تغيب الدولة أو تنهار مؤسساتها، وهي أيضاً الحامل الذي يُعتمد عليه في نهوض الدول. المطلوب اليوم ليس إلغاء هذه الهويات أو تقزيمها، بل دمجها في مشروع وطني جديد يعترف بها كركيزة للسلم الأهلي والتماسك المجتمعي، وليس سيفاً بيد أي سلطة تستخدمه ثم تتناسى مظالم تلك العشائر.
والدرس الأهم الذي تعلمناه من ابن خلدون والتاريخ معاً، أن العشيرة لم تكن يوماً عائقاً أمام الدولة، إلا إذا تحولت الدولة إلى خصم لمجتمعاتها. أما إذا بُنيت الدولة على أساس العدالة والتمثيل الحقيقي، فإن العشيرة ستكون أول من يقف إلى جانبها دفاعاً عن الأرض والكرامة والحق.