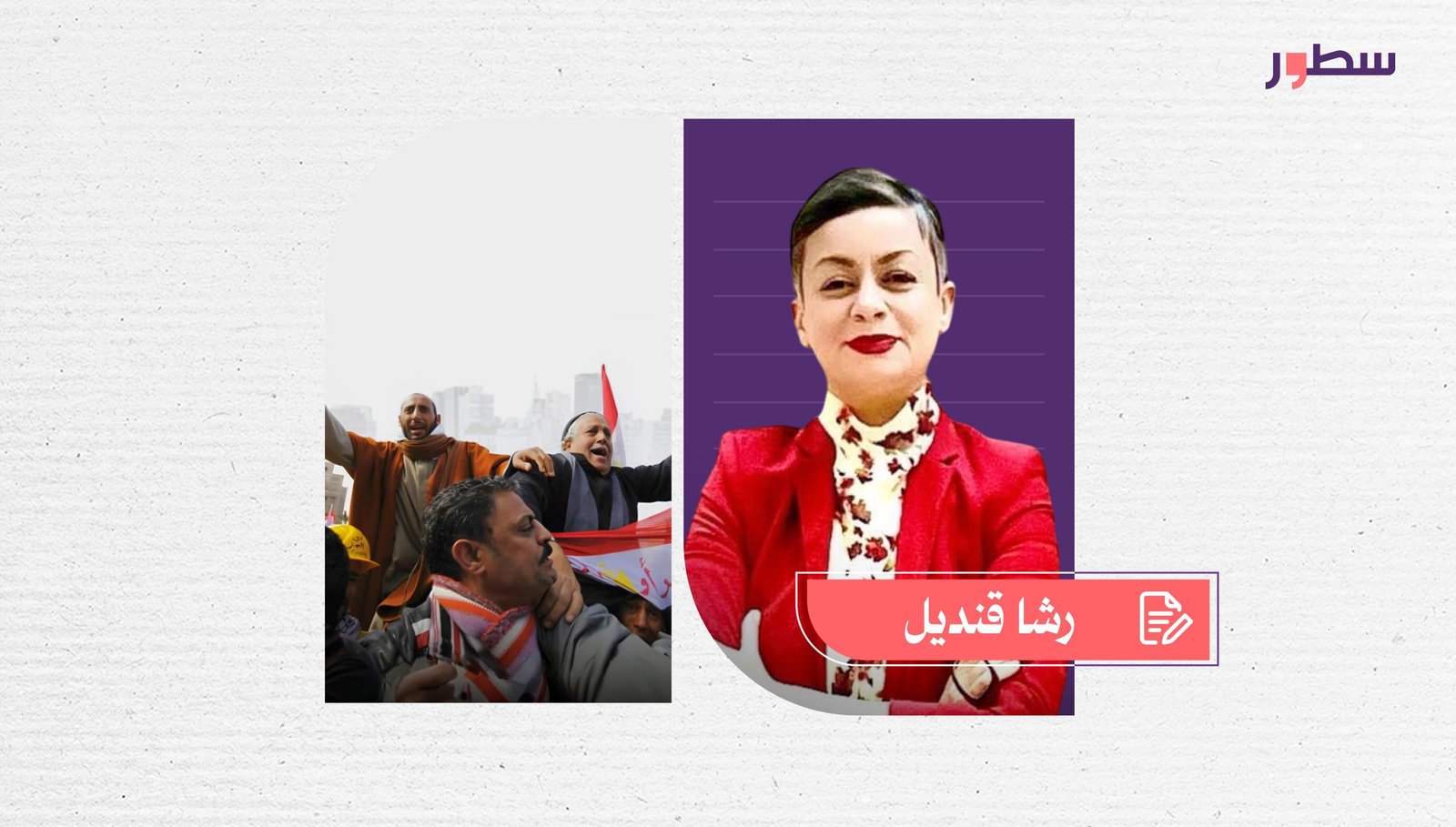آراء
موضوعياً كم اقتربنا من مخطط تصفية القضية ومن المسؤول؟
موضوعياً كم اقتربنا من مخطط تصفية القضية ومن المسؤول؟
بعيداً عن العواطف والتنظير والتخوين والانحيازات، أرغب هنا في الحديث عن بعض الحقائق وتقديم تحليلات موضوعية بناءً عليها. الأمر جلل أكبر من أن يتم مناقشته بشعارات وعواطف وأهواء.
لا يختلف أحد على أن القضية الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر كانت تسير في اتجاه واحد، وهو منزلق التصفية عبر الموت البطيء الذي تعود عليه العالم.
لكن هذا من ناحية القضية والحقوق الفلسطينية، أما من ناحية المطامع الصهيونية، فكانت مخططاتها لتصفية القضية تسير على قدم وساق من خلال التهجير البطيء، الحصار، الجدار العازل الذي يأكل الأراضي الفلسطينية ويباعدها عن بعضها حتى تتفتت، وتضاعف المستعمرات لتبلع هي أيضاً الأراضي الفلسطينية، حتى وصلت إلى ما يقارب الأربعة أضعاف منذ أوسلو، لتأتي أول دفعة نحو الهاوية لتسريع المسار بوعد بلفور الجديد أو صفقة القرن، وما اقترن بها من نقل السفارة، وتطبيع العلاقات سواء كلياً أو من تحت الطاولة، حتى لم يتبق سوى سبعة دول فقط لا تمتلك أي نوع من العلاقات مع إسرائيل.
أما من الناحية الفلسطينية، فلم يأتِ أي عامل سواء من الضفة أو غزة ليغير المسار أو يبطئ منه، إلى أن أتى الطوفان.
الوقت ليس مناسباً لتحليل جدواه أو لومه أو تبرئته، أو تحليل ما إذا كان عناصر من إسرائيل على دراية به، فهو فعل وتم Fait accompli.
لكن من المجدي أن نناقش مسار القضية الفلسطينية بعده.
أولاً، تصفية القضية بالإبادة. بعيداً عن الأهواء، كلنا نعلم أن إسرائيل لا تتوانى عن استخدام العنف بسلاح أو دونه. وأن عام 2023، قبل الطوفان، كان أكثر الأعوام فتكا للأطفال الفلسطينيين.
لكن، الواقع أيضاً، مما لا شك فيه، أنها لم تعكف على هذا المستوى من القتل والدمار في تاريخها. فإن كانت لا تحتاج إلى ذريعة لكي تقتل أو تطهر عرقياً، فإنها تحتاج إلى ذريعة كي تبيد. فوفقاً لتقديرات مختلفة لعدد الشهداء، خلال عام ونصف فقط، قتلت إسرائيل على الأقل نصف العدد الذي قتلته في الـ 75 عاماً الماضية من الصراع، بينما في أقصى تقدير، مع تقارير تشير إلى مئات الآلاف، قد يكون عدد القتلى أكبر بكثير، بل وربما يعادل عدد الشهداء في الـ 75 عاماً السالفة.
لا نستطيع أن ننكر أنها اتخذت من 7 أكتوبر تلك الذريعة. نعم، إسرائيل تتخذ من المقاومة المسلحة ذريعة للعنف، ولكن إن كانت تتخذ من العنف ذريعة، فهي تتخذ من السلم وسيلة للاستيلاء على الأراضي والتطهير العرقي.
ربما أوضح صورة مقارنة وضع غزة بمسافر يطا في الضفة الغربية، التي يمكننا مشاهدة قصتها في فيلم “لا أرض أخرى”. قاوم أهل القرية التهجير بكل شجاعة وصبر، دون مقاومة مسلحة.
لم يُسمح لهم بترخيص البيوت فعيشوا في الكهوف. لم يُسمح لهم بإنشاء المدارس، فقاومت السيدات. بنت النساء المدرسة نهاراً وبنى الرجال مساء. كسبت تلك المقاومة الجميلة والحزينة تعاطف العالم، وحتى أن توني بلير أتى ليلقي ضوءاً على المعاناة ويهنئ أهل القرية بالمدرسة. ورغم ذلك هدمت المدرسة. وقتل أحد المواطنين – هارون – بالرصاص. أصيب ثم مات موتاً بطيئاً وهو محرم من العلاج.
وحتى عندما قاوم باسل عدرا وبلال شحادات بالحكاية وصناعة الأفلام – الوسائل التي يرضى عنها الغرب للمقاومة – بل وحتى تعاونوا مع إسرائيليين، لم يمنع ذلك المستوطنين من خطف بلال والاعتداء عليه وشج رأسه والقبض عليه ترهيباً له.
قد يقول تيار السلم – التسليم، أن ذلك ما زال أفضل، فهو يحقن الدماء، ووتيرة الخسائر بطيئة. ولا أجد أننا – كغير فلسطينيين – من حقنا أن نقول للفلسطينيين ما هو أفضل لهم، بل فقط أن نتضامن معهم ونفكر معهم ونحلل. فهنا يكون السؤال: نعم وإن كان ذلك يحقن الدماء ويبطئ وتيرة الخسائر إلى حد ما، فإلى متى؟
ثانياً، تصفية القضية “بالسلمية”.
لم تجد إسرائيل ممثلاً عن الشعب الفلسطيني أودع وألطف مثل محمود عباس، الذي وعلى عكس سلفه ياسر عرفات، لم يطلق رصاصة واحدة على الاحتلال. لكن هل لكل وداعته تلك ستنجيه، وتنجي السلطة، والدولة الفلسطينية، أو حتى جزءًا يسيرًا منها؟
رأى بعض العرب – وساءهم – إفطار الإمارات مع رموز من إسرائيل في رمضان. ليتها كانت مجرد رموز. ليت الأمر اقتصر على أنه في رمضان، وأنه في وقت إبادة. بل الأمر أكبر وأجل.
جلست شخصيات رسمية من الإمارات مع وفد لا يقل عن مجلس يشع. مجلس تمثيل المستوطنات، التي حتى الولايات المتحدة تقيم عليها العقوبات لمخالفتها لصريح نص القانون الدولي، ولا تستخدم إسرائيل أي ذريعة لإقامتها.
كان من أهداف مجلس يشع، إضافة إلى تقنين وضع المستوطنات ونموها، هو حل السلطة الفلسطينية! لماذا يحتاج الفلسطينيون لتمثيل؟ فليكتفوا بالمجالس المحلية! هذا ما بقي مهمًا طبعًا.
وبهذا، ومع حتى طرح الفكرة، لن تكون مسألة حل السلطة، وبهذا حل الدولة وحلمها، إلا مسألة وقت. مجلس يشع ليس مجلسًا يمينيًا متطرفًا معزولًا، بل هو متغلغل في المجتمع والمؤسسات الإسرائيلية، بل كان رئيسه – نفتالي بينيت – هو رئيس الوزراء يومًا! أي أنه هو الوسيلة “السلمية” للاستحواذ على الأراضي تمهيدًا للتطهير العرقي.
وبخطة حل السلطة الفلسطينية وتقنين المستوطنات حتى يتم الاعتراف بها دوليًا لتصبح جزءًا “قانونيًا” من إسرائيل، لن يتبق سوى التخلص من سكان الضفة لأكبر درجة ممكنة. وستفعل ذلك بعدة وسائل. أولها هو مكتب الهجرة الذي تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء الإسرائيلي، تمامًا كما كان المجلس الذي أنشأته ألمانيا النازية للتخلص منهم. ولو أن المجلس يتم إعداده الآن لغزة، لكنا نعلم أن تلك هي الخطوة الأولى، فإسرائيل تعمل وفق خطوات. في المخططات الصهيونية، وفي خطابات نتنياهو، لا سيما في السابع من أكتوبر، وحتى قبل السابع من أكتوبر بالخريطة التي أراها للعالم في الأمم المتحدة، فإن إسرائيل تتضمن كل فلسطين التاريخية، ليس فقط في القطاع، بل أيضًا في الضفة، أو “يهودا والسامرة” كما يسميها.
شاهدنا أيضًا خطابات ترامب وويتكوف والاجتماع مع عاهل الأردن والمبالغ المقترحة لتحفيز والضغط على الدول العربية، خصوصًا الأردن ومصر، كي يقبلا مخطط التهجير.
إذاً، النتيجة هي أن الحل السلمي وحل المقاومة – نعم، المقاومة المخذولة المعزولة التي لم يتحرك لنصرتها دولة عربية أو إسلامية واحدة – في ظل الوضع الراهن الذي تمكنت فيه الصهيونية من تحقيق أهدافها، لم يتمكنا من إيقاف أو حتى تبطيء تصفية القضية الفلسطينية، وإفساح المجال لأن تعلو إسرائيل وتكمل في مخططاتها للهيمنة على المنطقة.
هذا ما لم… نتصدى لها.
فما الحل؟ قبل أن نتناقش الحلول، علينا أن نعترف بالأمر الواقع الآن، وأعني هنا خصيصًا واقع الدول العربية اليوم، دون التراشق بالاتهامات والخطوات التاريخية التي أودت بنا إلى هنا. والواقع أن دول الجوار، لا سيما مصر ولبنان وسوريا، قد خسرت كثيرًا واستنزفت كثيرًا منذ عام 1948، وأن كل واحدة منها وضعها دقيق، وتستطيع إسرائيل أن تفعل بها بدرجات متفاوتة، ما فعلت بغزة، إن حاربت وحدها.
إذا الحل في أمرين. الأول هو إدراك أنه لم يعد مجالًا للشك، أن إسرائيل دولة توسعية لن تكتفِ يومًا بالمكاسب التي تحققها عامًا بعد عام، وأنها لن تلتزم بأي اتفاقات وقانون دولي مهما هادنتها الدول وسلمت لها، بل واستسلمت لها. إن لم يكن كل ما عرضنا وكل ما رأينا كافيًا، فدعونا نلتفت حتى لتصريحات شخصيات أمريكية معروفة مثل سفير أمريكا لإسرائيل – مارتن إيندك، بأنه كان ساذجًا على مدى عقود عمله حين أقنع العرب بأن إسرائيل جادة في تنفيذ حل الدولتين، وأيضًا توماس فريدمان – مناصر إسرائيل – حين صرح تصريحًا مشابهًا بان حل الدولتين لم يعد واقعيا، وكل ذلك حتى قبل السابع من أكتوبر. حتى تاكر كارلسون، في حديثه مع ويتكوف، قال، منذ سنوات لم يعد أحد منا يسمع بحل الدولتين، ويبدو أن ويتكوف لم يسمع عنه أصلاً.
إذاً، أحلام العرب، بأن يسلموا من إسرائيل، وبأنها ستتوق إن توقفوا، عليها أن تتبدد الآن، ويدركوا أن الخطر آتٍ آتٍ، وأن المواجهة آتية آتية. أما الأمر الثاني، وكما انبرى صوت البرادعي وهو يصدح منذ الطوفان، أن بإمكان الدول العربية اتخاذ مجموعة من القرارات الدبلوماسية والاقتصادية للتصدي لإسرائيل. نعم الحرب والسلم نقيضان، ولكن هناك بحار أفعال بينهما – وبين التسليم والخنوع.
التسليم والخنوع والحلول الفردية لم تجلب لنا سوى هيمنة إسرائيل، إبادة إخوتنا في غزة، والآن، الوقوف على هاوية تصفية القضية للأبد، حتى نحن نكون القادمون! فهل ستقوم دولنا بإدراك حجم الكارثة بعد، أم أن تسير في أحلام اليقظة أن إسرائيل ستتركها وحدها إن سلمت، وقدمت الفلسطينين والقضية ككبش فداء؟