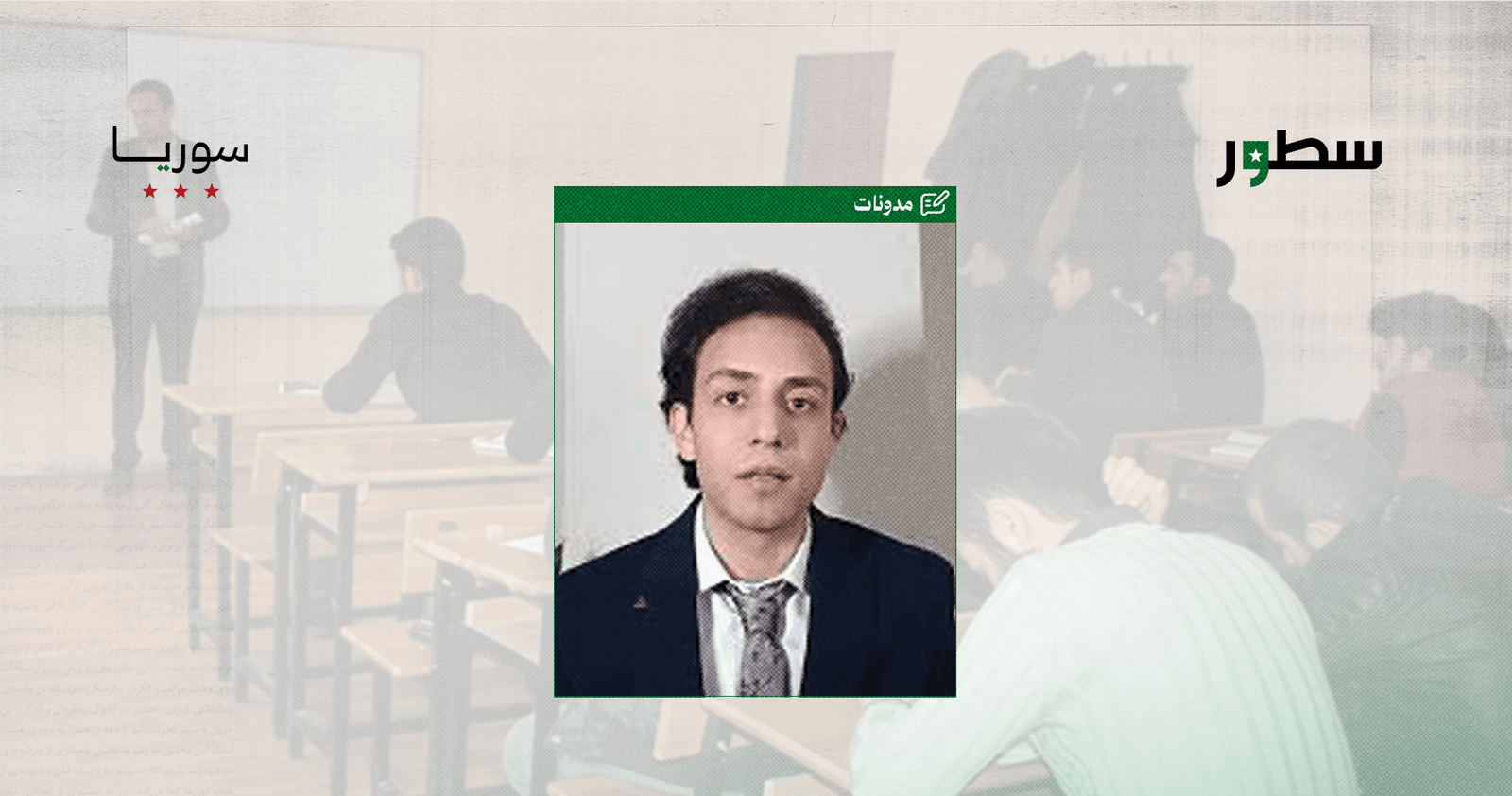Blog
الحرق السياسي.. تفريغ السخرية للدولة من كفاءاتها
الحرق السياسي.. تفريغ السخرية للدولة من كفاءاتها
تُولَد الحكومات بعد الثورات في بيئةٍ سياسية ونفسية شديدة الاضطراب. لا تصل إلى السلطة عبر مسارٍ إداري طبيعي، بل تتسلّم إدارة دولة فوق أرض مفكّكة، ومؤسسات مستنزفة، واقتصاد مثقل بالعجز، ومجتمع منقسم ومحمّل بتوقعات تكاد تكون غير واقعية. في مثل هذا المناخ لا يكون الخطأ استثناءً، بل احتمالاً راجحاً، ويصبح الأداء المثالي أقرب إلى تصور نظري منه إلى معيار قابل للتحقّق. غير أنّ ما يضاعف هذه الهشاشة لا يقتصر على ضعف الخبرة أو ارتباك الإدارة أو نقص الكوادر، بل يتجسّد أيضاً في ظاهرة أشد خطورة، ألا وهي الاغتيال المعنوي المنظم عبر حملات السخرية والتشويه، التي لا تكتفي بمساءلة السياسات، بل تتعمد استهداف الأشخاص لتقويض الشرعية وإضعاف الثقة العامة.
الحكومة السورية الوليدة، كغيرها من حكومات ما بعد الثورات، ارتكبت أخطاء عديدة. هذا توصيف واقعي لا يحمل تبريراً ولا تجريماً مسبقاً. فبيئة العمل غير المنظمة، والانقسام الاجتماعي الحاد، والإرث الثقيل من الفساد المؤسساتي، إضافة إلى محدودية الخبرة العملية لدى بعض الوزراء والمدراء، تجعل من كل قرار خطوة معقدة ومحفوفة بالمخاطر. كما أن أغلب المؤسسات ما تزال تعمل ضمن جهاز إداري لم يُعد بناؤه فعلياً، وتواجه شبكات مصالح أعادت تموضعها بعد سقوط النظام السابق. وفي الوقت ذاته، تُطالب الحكومة بتقديم نتائج سريعة لجمهور أنهكته السنوات الماضية ويريد تغييراً ملموساً لا وعوداً مؤجلة، وهذا حقّه بلا شك.
لكن الاعتراف بهذه التعقيدات لا يعني منح الحكومة حصانة سياسية أو أخلاقية. الخطأ، حين يتكرر، يصبح نمطاً. والارتباك، إن طال أمده، يتحوّل إلى عجز. والقرارات غير المدروسة، حتى لو صدرت بحسن نية، تُنتج آثاراً ملموسة على حياة الناس. من حقّ المجتمع أن يسأل، وأن ينتقد، وأن يطالب بتصحيح المسار. بل إنّ النقد الصريح شرط لبقاء أيّ تجربةٍ انتقالية على قيد الحياة. الحكومة التي لا تتعرض للمساءلة تميل سريعاً إلى الغرق في وهم الصواب الدائم.
غير أنّ الإشكال يبدأ حين يختلط النقد بالمناكفة، وتتحوّل المساءلة إلى حملة تشويه. التمييز بين النقد والاغتيال المعنوي ليس ترفاً لغوياً، بل ضرورة سياسية. فالنقد يركز على القرار والسياسة والنتائج، يقارن بين البدائل، يستند إلى أرقام ووقائع، ويطرح حلولاً ممكنة. أمّا الاغتيال المعنوي فيتجاوز الفعل إلى الشخص، يشكك في النوايا دون دليل، يختزل المسار المهني في لقطة مجتزأة، أو حذاء مسؤول أو شكله وصوته، ويحوّل النقاش العام إلى ساحة تهكم.
الخطورة تكمن في الأثر التراكمي. حين تتكرّر حملات السخرية المنظمة ضد وزير بعينه أو مجموعة محددة من المسؤولين، يتشكّل انطباع عام بأنّ هؤلاء فاقدو الأهلية بصورة مطلقة، بغض النظر عن تفاصيل أدائهم. ومع الزمن، يتآكل الحد الفاصل بين الخطأ الفردي والفساد البنيوي، وبين التقصير المهني والخيانة الوطنية. هذا المناخ لا ينتج وعياً نقدياً، بل يولّد إحباطاً عاماً وشعوراً بالعجز. المواطن الذي يتلقى يومياً رسائل تشكيك وسخرية يفقد ثقته لا بالشخص المستهدف فحسب، بل بالمؤسسة التي يمثلها.
ومن الأمثلة الدالة ما جرى مع وزير الإعلام، الذي تحوّل إلى هدفٍ دائم لحملات ترصّد ممنهجة، حتى في ملفات لا تقع ضمن اختصاص وزارته. فخلفيته السابقة وعمله في قطر، واعتباره محسوباً على التيار القطري، استُخدمت كإطارٍ ثابت لتأويل كلّ قرار بوصفه امتداداً لاصطفاف سياسي، لا اجتهاداً إدارياً قابلاً للخطأ والصواب. ورغم أنّ الوزارة ارتكبت أخطاء، منها تعيين بعض المحسوبين على نظام الأسد في مكاتب محددة، فقد صُحّح جزء منها مباشرة بعد التواصل مع المسؤولين، مع وعود واضحة بمعالجة ما تبقى. غير أنّ النقد تجاوز الوقائع إلى تبنّي سياسة شبه ثابتة لدى بعض المنصات التي تقوم على استهداف الوزارة بكلّ قراراتها وشكلها وخطابها، بل وتحميل العاملين فيها تبعات افتراضية باعتبارهم امتداداً لشخص الوزير. ومع تحوّل صوته وشكله إلى مادة للسخرية والتنمر، تكرّس مناخ من الاغتيال المعنوي لا يضعف فرداً بعينه فحسب، بل يضرب معنويات مؤسسة كاملة ويشوّه النقاش العام.
مع ذلك، من الخطأ تحميل الحملات الإعلامية وحدها مسؤولية هذا الانحدار. فبعض الأخطاء الحكومية توفّر الوقود اللازم لتلك الحملات. حين تصدر تصريحات متناقضة، أو تُتخذ قرارات بلا شرح كافٍ، أو يُستبعد الرأي العام من معرفة المعايير التي بُني عليها القرار، فإنّ الحكومة تفتح الباب واسعاً أمام التأويل والسخرية. الغموض في المراحل الانتقالية ليس حياداً، بل ضعف في إدارة المشهد. والفراغ المعلوماتي يُملأ دائماً بروايات بديلة، بعضها حسن النية وبعضها مسيّس بوضوح.
التجارب المقارنة بعد الثورات تُظهر أن الهشاشة ليست استثناءً. الحكومات الانتقالية غالباً ما تتعرض لضغط مزدوج، ضغط الشارع الذي يطالب بنتائج فورية، وضغط النخب القديمة التي تسعى إلى استعادة نفوذها. في هذا المناخ، تُستخدم أدوات متعددة لتقويض السلطة الجديدة، من بينها الإعلام والسخرية المنظمة. حين يتكرر استهداف وزير بعينه، لا بدّ من طرح سؤالين: هل السبب هو أداؤه الفعلي، أم موقعه في شبكة المصالح المتضررة؟ وفي المقابل، هل توفر الحكومة معايير واضحة لتقييم الأداء والمساءلة، أم تكتفي بردود فعل دفاعية؟
ليس الاغتيال المعنوي مسألة أخلاقية سطحية، بل هو خلل يصيب بنية المجال العام نفسه. فالمجال السياسي يفترض أن يكون ساحة نقاش عقلاني للسياسات والخيارات، لا منصة للتشكيك الشخصي والسخرية. وعندما تتحول المساءلة إلى استباحة، يختل التوازن بين الشرعية والكرامة: المساءلة تبقى شرطاً للحكم، لكن صون الكرامة شرط لاستمرار المشاركة.
في هذا المناخ يتغير معيار من يدخل العمل العام. لا يتقدّم الأكفأ بالضرورة، بل الأقدر على تحمّل التشهير. يحدث فرز عكسي ينسحب فيه أصحاب السمعة المهنية خوفاً من “الحرق”، ويبقى من يملك صلابة نفسية لا تعني دائماً كفاءة عالية. وهكذا تدفع الدولة ثمناً طويل الأمد، لأنّ إدارة الشأن العام تحتاج إلى معرفة ونزاهة بقدر ما تحتاج إلى تحمل الضغط.
ثقافة الاغتيال المعنوي تزرع الخوف من الفضاء العام، وتجعل الانكفاء خياراً عقلانياً لحماية السمعة. وعندما يتآكل “رأسمال الثقة” بهذا الشكل، يتحوّل المجال السياسي من فضاء مشاركة إلى ساحة ردع. عندها لا تُدار الخلافات، بل تُصفّى الحسابات، وتخسر الدولة قدرتها على جذب أفضل طاقاتها.
في المقابل، لا يجوز استخدام تهمة “الاغتيال المعنوي” لإسكات النقد المشروع. بعض المسؤولين يميلون إلى وصف أيّ اعتراضٍ بأنّه حملة تشويه، وهذا انحراف خطير. النقد الصريح، حتى لو كان قاسياً، جزء من العملية السياسية الصحية. المشكلة ليست في حدّة اللغة بقدر ما هي في موضوعها. عندما ينصب التركيز على القرار وتأثيره، وعلى الأرقام والنتائج، فنحن أمام مساءلة مشروعة. أمّا عندما يتحوّل النقاش إلى التشكيك في الذمم بلا دليل، أو إلى تعميمات تحطّ من الكرامة الشخصية، فنحن أمام تدمير متعمد للثقة.
الحكومة، إن أرادت تحصين نفسها، تحتاج إلى ثلاث ركائز واضحة: تقوم على، بناء آليات شفافة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين داخلها، بحيث لا يبقى الرأي العام رهينة تسريبات أو شائعات. وتطوير استراتيجية تواصل احترافية تشرح القرارات بلغةٍ بسيطة وتعرض التحديات بصدق، دون مبالغة أو إنكار. يضاف إليها، الفصل الصارم بين الدفاع عن السمعة الشخصية للمسؤولين وبين قمع النقد السياسي. القوة الحقيقية لا تظهر في إسكات الأصوات، بل في القدرة على الرد بالحجة والبيانات.
أمّا المجتمع والنخب الإعلامية، فعليهم مسؤولية موازية. حرية التعبير لا تعني تحويل الفضاء العام إلى ساحة تنمّر جماعي. الصحافة الجادة مطالبة بالتدقيق، لا بإعادة نشر كلّ محتوى ساخر يحقق تفاعلاً سريعاً. المثقفون والناشطون مدعوون إلى رفع مستوى النقاش، لا إلى الانجراف وراء موجات التهكم، فالديمقراطية الناشئة لا تُبنى فقط عبر صناديق الاقتراع، بل عبر ثقافة سياسية تحترم الحدود الفاصلة بين النقد والهدم.
المعيار النهائي لأيّ تجربةٍ انتقالية ليس خلوّها من الأخطاء، بل قدرتها على التعلم والتصحيح. وإذا كانت السخرية المنظمة تهدف إلى إقناع الناس بأنّ كلّ محاولة فاشلة سلفاً، فإن الردّ الأمثل ليس الانجرار إلى معركة شتائم، بل تقديم أداء أفضل وخطاب أوضح. في المقابل، على القوى السياسية والإعلامية أن تدرك أن تقويض الثقة بالمؤسسات الناشئة قد يحقّق مكاسب قصيرة المدى، لكنّه يترك فراغاً قد تملؤه سلطات أكثر صلابة وأقل انفتاحاً.
في النهاية، الاغتيال المعنوي ليس مجرّد ظاهرة إعلامية عابرة، بل اختبار لمدى نضج المجال السياسي. إذا تحوّل إلى أداة يومية، فإنّه يهدد بتقويض أي فرصة لبناء مؤسسات مستقرة. أمّا إذا جرى ضبطه بثقافة نقدية مسؤولة، فإنّه قد يتحوّل إلى حافزٍ لتحسين الأداء. الخيار ليس بين الصمت أو السخرية، بل بين نقاش جاد يرفع مستوى الحياة العامة، وضجيج مستمر يستهلك الطاقة دون أن يبني شيئاً.