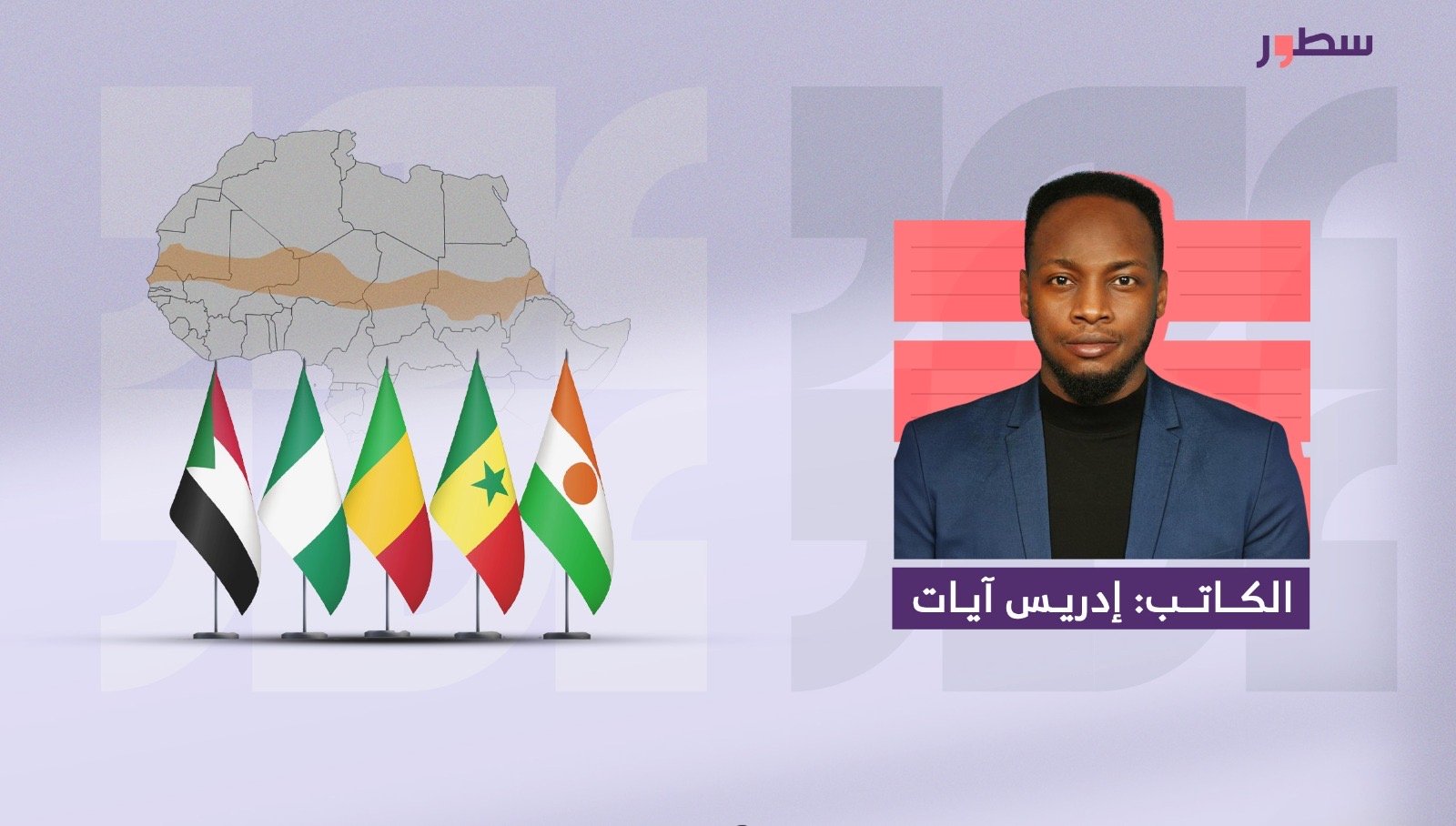سياسة
روسيا، الصين، وتركيا: ماذا يمكن للشرق أن يقدم لأفريقيا؟
روسيا، الصين، وتركيا: ماذا يمكن للشرق أن يقدم لأفريقيا؟
في ميدان العلاقات الدولية، تتبلور نظريتان بارزتان تشكلان فهمنا للواقع الجيوسياسي: الواقعية، التي تعتنق مبدأ تقبل الأمور كما هي على أرض الواقع، والمثالية، التي تنشد عالمًا يسوده ما ينبغي أن يكون. في سياق القارة الأفريقية، نرى أن الواقعيين يفهمون جيدًا أن الدول الأفريقية، بلا تكنولوجيا أو خبرة كافية لاستخراج ومعالجة مواردها الطبيعية، محكومة بالتعاون مع القوى الكبرى لإنجاز هذه المهام. من هذا المنطلق، يبحثون عن الفائدة الأكبر لبلدانهم مع الشرق بشروط أفضل وأكثر إنصافًا مقارنةً بالغرب.
على الجانب الآخر، يسأل المثاليون بسذاجة مثلاً: “لمن أُعطيت مناجم اليورانيوم في النيجر بعد انتهاء الوصاية الفرنسية؟”، دون التعمق في تقييم النسب المئوية للأرباح التي تجنيها الدولة مقارنةً بالسابق. هذا النهج يغفل أن الموارد الطبيعية هي للتسخير لا للعرض.
الدول الشرقية مثل الصين وروسيا وتركيا، بالرغم من عدم كونها منظمات خيرية، إلا أن الأرقام تُظهر أن الشروط التي تُقدمها للدول الأفريقية هي بالفعل أفضل من تلك التي كان يُقدمها الغرب سابقًا، مُعززةً بالثورة المعلوماتية وقدرة أفضل على التفاوض. ومثلتْ هذه التحولات بحقٍ ما يُطلق عليه “تغييرًا جذريًا في قواعد اللعبة”.
في الجانب الأمني؛ وفي غمرة الصراعات التي شهدتها جمهورية أفريقيا الوسطى بين الأعوام 2012 و2015، سيطرت الفصائل المتمردة، على 90٪ من الأراضي. وفي خضم هذه الفوضى، اتخذت فرنسا قراراً بسحب قواتها، مما فاقم الأوضاع، في خطوة اعتُبرت عقابًا للرئيس تواديرا على خلفية الخلافات السياسية مع فرنسا.
استجابةً لهذه الأزمة، سارع تواديرا إلى طلب العون من روسيا، لضمان وحدة بلاده. نتيجة لهذه الخطوة الاستراتيجية، وللمرة الأولى -في نصف قرن- كان عام 2019، وما تلاه من سنوات عرفت أفريقيا الوسطى ثلاث سنوات متواصلة من السلام وفقًا لتقارير مؤشر السلم العالمي.
هذا التحول الأمني في أفريقيا الوُسطى شجع الدول الأفريقية الأخرى التي تعاني من تحديات مماثلة، لتحذو حذوها بعدما اكتشفت بُعد روسيا عن الازدواجية السياسية التي تمارسها القوى الغربية، والتي أظهرت قدرتها على دعم جيش دولة ما وفي نفس الوقت تسليح المتمردين ضده.
في حالة جمهورية مالي، لم يستغرق الأمر سوى عامين من التعاون العسكري مع روسيا لتستعيد السيطرة على ثلث الأراضي التي فقدتها بسبب الإرهابيين والمتمردين. ففي نوفمبر 2023، باغت الجيش المالي، بمساعدة روسيا، مدينة كيدال، التي كانت تُعتبر معقل المتمردين في الشمال، وحقق نصراً كبيراً تمكن خلاله من استرداد المدينة التي لم تفلح فرنسا في استعادتها خلال عشر سنوات مع قواعدها العسكرية.
وفي بوركينا فاسو، بعد أن دفع الصراع في منطقة الساحل أكثر من 1.5 مليون شخص للنزوح في غضون عامين بحسب مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وبعد تولي الكابتن إبراهيم تراوري السلطة وتحالفه مع روسيا، أشارت تقارير صادرة في مايو 2024 إلى عودة أكثر من 673,500 نازح إلى ديارهم بأمان وإعادة فتح أكثر من 1100 مدرسة في غضون سنتين.
على خارطة التسليح أيضًا، رسمت أفريقيا مساراً جديداً نحو الشرق، بحثاً عن شركاء يفهمون ضروراتها الأمنية. وكأن القدر يُخط لنا ملحمة جديدة، فبالتزامن مع سلسلة المقالات هذه، شهدنا أول مؤتمر على طاولة مستديرة بين دول الساحل وأوروبا، بتاريخ 27 يونيو 2024. خلال المؤتمر الذي وُصف بـ “الصريح جدًا” وحمل عنوان “الساحل الجديد”، وَجّه وزير خارجية مالي، عبد الله جوب، كلاماً للمسؤولين الأوروبيين، قائلاً: “عندما كنا نكابد الإرهاب الذي ينهش أجساد الآلاف من أطفالنا، طلبنا السلاح من حلفائنا الأوروبيين بمالنا لا بالمجان؛ لكن جوابهم كان رفضاً قاطعاً بحجة سياسات الاتحاد التي تمنع بيع الأسلحة الفتاكة. وبينما نحن على هذا الحال، أتت الأزمة الأوكرانية فبدأت أوروبا لا تبيع الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا فحسب، بل تمنحها إياها مجانًا. هذا هو تجسيد ازدواجية المعايير الغربية. وعندما توجهنا إلى روسيا لشراء الأسلحة، لم نواجه سوى التفهم لأننا في حالة حرب.” وتابع قائلاً: “هل يتوقع منا الأوروبيون أن نقاتل داعش والقاعدة بالعصي والرماح؟”.
وخلال ثلاث سنوات من التعاون مع روسيا، تسلمت مالي ست جولات من الأسلحة الروسية المتطورة والثقيلة، بما في ذلك نظام الدفاع الجوي S-300، لحماية أراضيها. وتلقت بوركينا فاسو ثلاث جولات من الأسلحة، كما استلمت النيجر، التي شهدت انقلابًا مؤخرًا، في أبريل 2024 شحنة ضخمة من العتاد العسكري الروسي عبر طائرة “إليوشين – 76.”
بالمثل، توجهت هذه الدول نحو تركيا، الرائدة في الصناعات العسكرية المضمونة والميسورة التكلفة، فمن ديسمبر 2022 حتى يناير 2024، تسلمت مالي عددًا من الطائرات المسيرة التركية، بما في ذلك طائرات بيرقدار وأكنجي. وبهذا المنوال، وجدت بوركينا فاسو نفسها تتلقى خمس طائرات من طراز “بيرقدار أكنجي” واستخدمتها في عملية ناجحة في مارس 2023 أسفرت عن مقتل 400 عنصر من داعش، وهو العدد الأكبر في عملية واحدة في تاريخ مكافحة الإرهاب بالساحل. كما أقبلت الدول الأفريقية أيضًا على شراء الأسلحة الصينية التي بدأت تغزو الأسواق بفعاليتها وتكلفتها التنافسية.
وفي مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات العسكرية، خذ مثلاً، دولة مالي، استطاعت في أقل من عامين من تحالفها مع روسيا أن تحقق نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا العسكرية والاتصالات. بالفعل، وقعت مالي روسيا اتفاقية لتصنيع وإطلاق أول قمر صناعي لها، لمراقبة أراضيها وتعزيز أمنها القومي.
إن هذه البيانات تتحدث بلغة لا لبس فيها عن فاعلية التعاون الأمني والعسكري مع روسيا، في وقت يظهر فيه المعسكر الغربي عجزاً واضحاً وتناقضاً في مواقفه، مما يعكس فهم الواقعيين للأوضاع الجيوسياسية الراهنة أفريقيًا.
وفي التعاون الاقتصادي يبرز الدور البارز للصين في إبرام عقود تتسم بمبدأ المنفعة المتبادلة و”الربح للطرفين”، فقد وجهت الأنظار نحو نماذج مثل العقود النفطية في النيجر. هذه العقود أفضت إلى إنشاء خط أنابيب وبدء إنتاج النفط لأول مرة في البلاد، مع تقديم قروض تتميز بأسعار فائدة منخفضة تبلغ 7٪، بالمقارنة مع 23٪ التي تطالب بها شركات غربية مثل إكسون موبيل وتوتال في تشاد. بفضل هذه العقود حظيت دول أفريقية بمشروعات للبنية التحتية مثل الطرق المعبدة والقطارات السريعة، مما ساهم في تسهيل تصدير الموارد الطبيعية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا الإطار، لا بد من تسليط الضوء على دور روسيا في التنمية، بالإضافة إلى دورها المعروف في الجوانب الأمنية والعسكرية. حيث يسود اعتقاد خاطئ بأن روسيا، كدولة عسكرية نووية، لا تقدم سوى الدعم العسكري، مما يغفل العديد من جوانب قدراتها التنموية الأخرى.
تمتلك روسيا الخبرات والتكنولوجيا التي تحتاجها الدول الأفريقية، خاصة في مجالات مثل التعدين والطاقة والبنية التحتية والزراعة. هذه المجالات هي ما تتطلع إليه الدول الأفريقية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام واستغلال مواردها الطبيعية بفعالية. فمن النقاط الجوهرية التي تم إغفالها عن الوعي الجمعي الأفريقي، هي حقيقة أن روسيا، بمساحتها الواسعة التي يقارب 17.1 مليون كيلومتر مربع، تعتبر الدولة الأكبر عالمياً. هذه الرقعة الشاسعة -على النقيض من فرنسا وعدة دول أوروبية أخرى فقيرة في الموارد، مما يدفعها للتغول والاستيلاء على ثروات أفريقيا- تزخر بثروات طبيعية تُعد من بين الأكثر غنى على مستوى العالم، تشمل النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، ومن المعادن الاستراتيجية، بريادية في إنتاج النيكل والبلاديوم، وتحوز كميات معتبرة من البلاتين، الذهب، الماس والعناصر الأرضية النادرة. بالإضافة إلى ذلك، تُعتبر روسيا منتجًا هامًا لليورانيوم، ومن مناجمها صنعت قنبلتها النووية عكس القوى النووية الأوروبية والأمريكية التي اعتمدت في أسلحتها النووية على يورانيوم دول مثل النيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
الافتراض بأن روسيا تتوجه إلى أفريقيا بنفس نوايا الغرب الاستعمارية يُعد مغالطة فادحة ونتاج عدم معرفة. بالطبع، لا تُقدم روسيا الدعم التنموي بالمجان؛ الدول ليست جمعيات خيرية، ولكن الفكرة القائلة بأن روسيا تفتقر إلى هذه الموارد وتسعى لنهبها هي فكرة مضللة. كما أن الشائعات حول سيطرة مجموعة فاغنر على مناجم الذهب في أفريقيا الوسطى، والتي تناقلتها وسائل الإعلام الغربية وتم تعميمها دون التحقق من صحتها، تُظهر تقصيرًا في البحث الدقيق عن الحقائق. إنها دعاية لا أساس لها من الصحة.
لنتحدث عن دولة بوتسوانا، التي تمثل نموذجًا فريدًا في أفريقيا من حيث استثمار مواردها الطبيعية، بتعاونٍ روسيا. بوتسوانا كثاني أكبر منتج للماس في العالم بعد روسيا، قبل التعاون مع روسيا، كانت تواجه تحديات كبيرة في استخراج وإنتاج الماس، واستغلت الدول الغربية نقص خبرتها لمصلحتها. تغير الوضع جذريًا مع تأسيس تحالف كيمبرلي في العام 2003، وهو نظام دولي لتصديق تجارة الماس الخام، الذي يُستخرج في مناطق النزاعات ويُستخدم في تمويل الحروب.
وفي هذا التحالف نسجت روسيا علاقة خاصة مع بوتسوانا، حيث عرضت الشركة الروسية Alrosa، المملوكة للدولة، خبراتها للتعاون مع شركة “دي بيرز” التي تدير مناجم الماس في بوتسوانا، تضمنت استخدام الخبرات الروسية في تقطيع وصقل وتجارة الماس عالميًا. بفضل هذا التعاون، شهدت بوتسوانا زيادة ملحوظة في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 8-9٪ سنويًا، حيث ساهم قطاع الماس بحوالي 20% من هذا الناتج، بينما أسهم قطاع تقطيع وصقل الماس وتجارته بحوالي 5%. مما أدى إلى تحسن كبير في مستوى المعيشة، وجعل بوتسوانا واحدة من دول الدخل المتوسط العالي في أفريقيا، وأصبح التعليم والرعاية الصحية مجانيين، وتجاوزت نسبة الطبقة الوسطى 50% من السكان.
هذا النجاح البوتسواني، تسعى الدول الغربية جاهدة لإحباطها حاليًا، كما ظهر جليًا خلال اجتماع مجموعة السبع الذي عُقد خواتيم 2023، وتم التباحث حول فرض المزيد من العقوبات على روسيا، مستهدفين هذه المرة صناعة الماس. قررت المجموعة إنشاء موقع أحادي يلزم جميع الماسات بالمرور من خلاله للتحقق من مطابقتها لمعايير المجموعة. وقد تضمنت الإجراءات فرض حظر مباشر على واردات الماس من روسيا، بالإضافة إلى توسيع نطاق العقوبات ليشمل الماس الروسي المصقول في دول ثالثة، وهو ما تضرر منه بوتسوانا راهنًا وسبب تراجع نمو اقتصادها بحسب الرئيس موكجويسنتي ماسيسي.
في السياق السياسي، أشرتُ في المقال الثاني، أن تاريخ أفريقيا شهد فظائع، حيث اغتيل قرابة 21 رئيسًا وأُطيح بأربعين آخرين في غضون ستين عامًا، تحت ظل الهيمنة الفرنسية. فهل يُتوقع من القيادات الجديدة في منطقة الساحل ووسط أفريقيا، بعد طردهم للغرب، أن يجلسوا مكتوفي الأيدي في انتظار أن يُكرر التاريخ نفسه؟ وبعد إقصاء فرنسا من أفريقيا الوسطى، والساحل سعت لفرض عقوبات على هذه الدول، وفي مواجهة العقوبات المفروضة على مالي ودول الساحل الأخرى المتحالفة مع الشرق، لم تتردد روسيا والصين في استخدام فيتو مزدوج لمنع هذه الإجراءات، رغم أن فيتو واحد كان كافيًا.
وفي المقابل، تُظهر هذه الدول استقلالية ملحوظة برفضها الانحياز للغرب في قضايا دولية مثل التوترات في البحر الصيني الجنوبي وملف تايوان، أو رفض إدانة روسيا ومقاطعتها في القضايا المتعلقة بأوكرانيا أو أفريقيا.
في الختام؛ نطبع هذا النقاش العميق الذي تطلّب ثلاث مقالات، للإجابة عن سؤال: هل التحالف مع الشرق، استعمار جديد أم شراكة استراتيجية؟ أود الإشارة إلى أنّ تعريف الاستعمار هو: عملية يقوم من خلالها بلد ما بإحكام سيطرته على أراضٍ أخرى بعيدة، دون إرادتهم وذلك بإنشاء مستعمرات يُديرها مباشرة أو بواسطة وكلاء. ويتضمن الاستعمار غالبًا استغلال الموارد الطبيعية للمنطقة المُستعمَرة وتسخير سكانها في العمليات الاقتصادية، بالإضافة إلى فرض الثقافة والقوانين واللغة للقوة المستعمِرة.
وهنا يبرز لي مفهوم “عدم الإرادة” كعنصر جوهري في الاستعمار. فإذا كان التعاون الأفريقي مع الشرق يأتي بمحض إرادة هذه الدول وشعوبها، فمن الجلي أن استخدام مصطلح الاستعمار لا يعدو كونه ترديدًا لصدى المفاهيم الغربية الحديثة، ويعكس نوعًا من الاستلاب الفكري لمستخدميه.
على النقيض، فإن الغرب، رغم إعلانه نهاية الاستعمار، لا يزال هو من يمارس بعض أشكاله كفرض اللغات الفرنسية والإنجليزية، القوانين، والتعليم الغربي. مقابل ذلك، لم تفرض دول كالصين وروسيا وتركيا لغاتها أو ثقافتها، بل تُترك الخيار لمن يرغب في تعلمها كاكتشاف لثقافة أخرى لا أكثر.
إذنْ، إن الزعم بأن التعاون الاقتصادي مع الصين أو الشراكات الأمنية مع روسيا، أو التعاون في مجال الدفاع مع تركيا يُعد استعمارًا، يدل على نقص في الفهم العميق للتاريخ والظروف الحالية. فالاستعمار الغربي للقارة الأفريقية، بجرائمه ونتائجه المروعة التي أثرت على مئات الملايين، يجعل من الصعب قبول أي مقارنة تقلل من شأن تلك الفظائع. ومن هنا، ينبغي للأفارقة، كما يفعل اليهود بخصوص المحرقة النازية، ألا يسمحوا بتشبيه أي من الظروف الحالية بجرائم الاستعمار، التي لا يُمكن مقارنتها بأي بشائع اليوم، خاصة أن جميعها مقارنات وهمية ومصطنعة من الغرب الذي يخسر هيمنته.