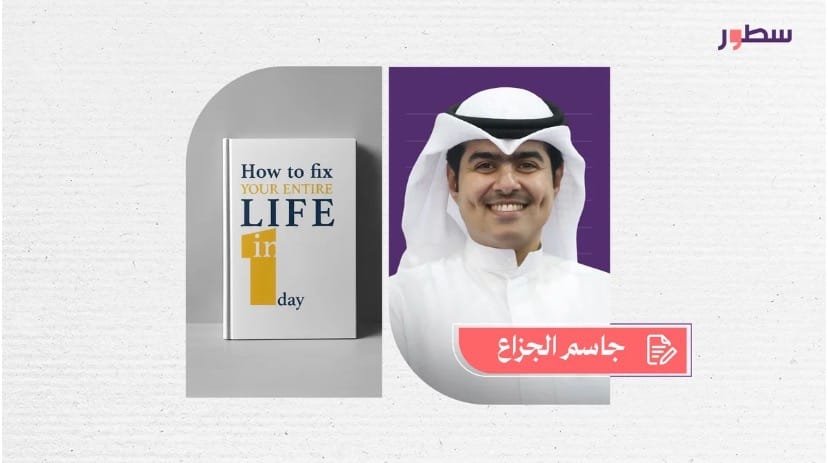آراء
نهاية الدولة الحديثة: صعود وكلاء العنف وانهيار الشرعية في الشرق الأوسط
نهاية الدولة الحديثة: صعود وكلاء العنف وانهيار الشرعية في الشرق الأوسط
ليست أخطر لحظات الحرب تلك التي تسقط فيها القذيفة الأولى، ولا حين يعلو دخان المدن المحترقة في الشاشات، بل تلك اللحظة الرمادية في منتصف المعركة حين تكتشف الدولة أنّها لم تعد صاحبة القرار في الحرب التي أطلقتها. هناك، في تلك النقطة تحديدًا، يتقدّم “الوكيل المسلّح” إلى المسرح، لا كأداةٍ في يد السلطة، بل كفاعلٍ مستقلّ ينازعها احتكار العنف، ومن ثمّ ينازعها حقّ تعريف النصر والهزيمة، والسيادة ذاتها.
على امتداد خمسة وعشرين عامًا من العمل في الصحافة والحرب، من أفغانستان إلى العراق، ومن دارفور إلى غزّة وسوريا واليمن، رأيت هذا التحوّل يتكرّر كأنّه قانون خفي: دولة تُنشئ ميليشيا لسدّ فجوة في قوتها، أو لتمرير عنفٍ لا تريد تحمّل كلفته السياسية والقانونية، ثمّ تستيقظ بعد سنواتٍ لتجد أنّ “الميليشيا” لم تعد ذراعًا بل جسدًا كاملًا، له اقتصاده، وسلاحه، وحاضنته، ورعاته في الإقليم والعالم.
في أحد التعريفات الكلاسيكية للدولة في نظريات العلاقات الدولية، تُعرَّف السيادة بقدرة الدولة على احتكار العنف “المقنّن”، عبر أجهزةٍ بعينها: جيش، شرطة، أجهزة أمنية واستخبارية. ما جرى في حروب الربع قرن الأخير في الشرق الأوسط هو قلب هذا التعريف رأسًا على عقب: لم تعد الدولة وحدها تحتكر أدوات الإكراه، بل شاركها فيها لاعبون مسلحون من خارج جهازها البيروقراطي، ثمّ تطوّر الأمر في حالات كثيرة إلى أن احتكر هؤلاء اللاعبون العنف ضدّ الدولة، وضد المجتمع معًا.
من العرب الأفغان الذين عادوا إلى المنطقة محمّلين بخبرة قتال عابرة للحدود، إلى ميليشيات العراق بعد حلّ الجيش، إلى فصائل سوريا المتناسلة، إلى الحشد الشعبي، وقوات الدعم السريع، وأنصار الله، وغيرها من التشكيلات الموزّعة بين الخرائط؛ تتكرّر المعادلة ذاتها: كلما أوكلت الدولة جزءًا من عنفها لـ“وكيل”، ضعفت هي، وتقوّى هو. وكلما تغوّل الوكيل في الاقتصاد والسلاح والتمويل والتحالفات، ضاق هامش قدرة الدولة على استعادته إلى بيت الطاعة، حتى تأتي تلك اللحظة التي تصرخ فيها على جبهة القتال: “قف”، فلا تسمع إلا صدى صوتها.
هذا المقال ليس دفاعًا عن دولة في مواجهة ميليشيا، ولا العكس؛ بل محاولة لقراءة اللحظة التي تفقد فيها السلطة المركزية السيطرة على الحرب التي خاضتها أو سُمِح لها أن تُخاض على أرضها. لحظة الانفصال بين “قرار الحرب” و“من يمسك بالسلاح فعلًا”.
من احتكار العنف إلى “خصخصة” العنف.
في الكتب، تبدو الأمور بسيطة: الدولة كيان ذو سيادة يحتكر العنف المقنّن، ويوكله إلى أجهزة تمثله وتعمل باسمه، في إطار قانون واضح وحدود واضحة ومسؤولية سياسية وقضائية عن كلّ رصاصة تُطلق.
لكن في خرائط الشرق الأوسط خلال ربع القرن الأخير، بدا هذا التعريف رفاهية فكرية لا تنطبق على الواقع إلا لمامًا. في أفغانستان الثمانينيات، رعت دول عديدة “المجاهدين” ودفعت بهم إلى معركة بالوكالة ضد السوفييت. بدا أنّ الدولة الأفغانية نفسها تُدار من خارجها، وأنّ قرار استخدام السلاح لا يمرّ عبر مؤسساتها. لاحقًا، تحوّلت طالبان والقاعدة، وهما وكيلان سابقان لمعادلة دولية معقدة، إلى سلطةٍ استولت على الدولة نفسها. سقطت أول قطعة دومينو في تعريف “احتكار الدولة للعنف”.
بعدها بعقدين، تكرر النموذج بصورة أكثر فجاجة في العراق. الدولة التي تعجز عن بسط هيبتها في الأطراف، أو تخشى مواجهة مباشرة مع خصومها، أو تريد قمعًا من دون بصمات على أصابعها، تلجأ إلى طريق أسهل: نقل جزء من العنف إلى الخارج. تسمّيه “قوات مساندة”، “لجان شعبية”، “صحوات”، “دفاعًا وطنيًا”، “قوات خاصة”، أو تترك له اسمًا غامضًا يمشي بين القبيلة والحزب والطائفة. في الجوهر، هي تمارس ما يمكن تسميته: خصخصة العنف.
تتنازل الدولة طوعًا عن جزءٍ من حقّها في استخدام القوة، وتمنحه إلى كيانٍ مسلّح لا يخضع لذات درجات الرقابة والمساءلة، ولا لذات سلّم العقاب والثواب. قد تصدر له الأوامر نفسها في البداية، لكن نفق الحرب طويل، وكلّ سلاح يحمل في داخله سؤالًا مؤجَّلًا: لمن سيكون الولاء حين تتغيّر الموازين؟
كيف تُولَد الميليشيا من رحم الدولة؟
الميليشيا نادرًا ما تهبط على بلدٍ كصاعقةٍ من السماء. في الأغلب، هي ابنة شرعية لسياقٍ سياسي وأمني واقتصادي فاسد أو هش، وابنة غير شرعية لدولةٍ تظنّ أنّها أذكى من الجميع.
تكوين “وكيل مسلّح” يخدم السلطة لا يأتي من فراغ. غالبًا يلبي واحدة أو أكثر من الحاجات الآتية: سدّ فجوة ضعف في الجيش النظامي، تنفيذ أعمال لا تريد السلطة تحمّل مسؤوليتها (تصفيات، تطهير طائفي أو قبلي، معارك قذرة في مناطق “منسية”)، أو خلق قوة موازية للجيش نفسه، تدين بالولاء لشخص أو عائلة أو حزب، لا للمؤسسة أو للدستور.
بهذه الطريقة وُلدت عشرات الميليشيات: من المجاهدين الذين رعَتهم أجهزة دولية وإقليمية في أفغانستان، إلى الصحوات في العراق بعد الغزو، إلى فصائل مسلّحة في ليبيا وسوريا واليمن نشأت تحت شعارات مقاومة أو ثورة أو حماية مجتمع مهدّد، ثمّ وجدت نفسها تدريجيًا أمام فرصة أكبر: امتلاك الأرض لا حمايتها فقط.
في اللحظة الأولى، تُقدَّم الميليشيا كحلّ مؤقت لأزمة حادّة.
في اللحظة الثانية، تستقرّ.
وفي اللحظة الثالثة، تُدرِك أنّها لم تعد في حاجةٍ إلى إذن أحد لتبقى.
منتصف المعركة: حين تنفصل رصاصة الميليشيا عن قرار الدولة.
“منتصف المعركة” ليس توقيتًا زمنيًا بقدر ما هو حالة سياسية – عسكرية: اللحظة التي تتعارض فيها مصلحة الدولة مع مصلحة الوكيل المسلّح، بينما السلاح في يد هذا الأخير.
رأيت هذه اللحظة بأشكالٍ مختلفة: دولة تريد التهدئة حفاظًا على ماء الوجه الدولي، وميليشيا ترى أنّ استمرار القتال يزيد من رصيدها التفاوضي. حكومة تريد صفقة سياسية، وذراع مسلّح لا يربح إلا في الفوضى. سلطة تخشى الانهيار الاقتصادي، وميليشيا تعيش على اقتصاد الحرب وتزدهر به.
في العراق، حين حُلّ الجيش وسُلّحت الصحوات، تُرك قطاع واسع من العسكريين السابقين في فراغ قاتل؛ انفتح الباب لولادة تنظيمات أكثر عنفًا، استثمرت خبرة هؤلاء وسلاحهم ونقمتهم. من موكِّل واحد للعنف، صار هناك كثيرون: دولة ضعيفة، قوات نظامية مشطورة، ميليشيات طائفية، وتنظيمات جهادية عابرة للحدود.
في السودان، تحوّلت قوات أنشأتها الدولة أصلًا كأداةٍ “أمنية” إلى قوّةٍ موازية تمتلك ذهبًا وحدودًا وتحالفات، حتى انفجرت الحرب بين “الدولة” و“الوكيل” في قلب العاصمة. وفي سوريا واليمن وليبيا، تراجعت الدولة إلى أطراف المشهد، وتقدّمت التشكيلات المسلحة إلى مركزه، تحكم بالسيطرة على الأرض لا بمراسيم تصدر من قصر رئاسي.
هذه اللحظة الفاصلة – لحظة فقدان السيطرة – لا تُعلَن في نشرات الأخبار. لكن الصحفي الذي يقف على الحاجز، ويرى من الذي يأمر ومن الذي ينفّذ، يعرفها جيدًا: حين يصبح تصريح الوزير مجرّد ضوضاء، وقرار القائد الميداني هو الحقيقة الوحيدة على الأرض.
اقتصاد الحرب: من البندقية إلى المؤسسة.
الميليشيا لا تعيش على الشعارات؛ من دون اقتصاد، تبقى مجرّد بندقية مستأجَرة. حين تنجح في بناء اقتصاد حرب، تتحوّل من أداة إلى مؤسسة.
اقتصاد الحرب له أشكال لا تُحصى: تهريب على الحدود، ذهب في باطن الأرض، نفط يُباع في الظل، ضرائب وإتاوات تُفرَض على السكان، رواتب تأتي من داعمين إقليميين أو دوليين، تجارة سلاح وبشر وخوف. رأيت ذلك في مناجم الذهب السودانية تحت يد الدعم السريع، وفي التهريب عبر الحدود السورية–التركية الذي موّل عشرات الفصائل، وفي النفط المسروق في ليبيا، وفي ضرائب الحوثيين التي حوّلت الجماعة إلى دولة فعلية، وفي أموال “داعش” من الفديات والنفط أثناء سيطرته على الموصل والرقة.
هذه الموارد تعني شيئًا واحدًا: استقلالية القرار.
حين تتقاضى الميليشيا راتبها من خزينة الدولة، يمكن –نظريًا– للدولة أن تعاقبها أو تحاصرها أو تساومها. لكن حين تمتلك خزينة وحدودًا وتراتبية قيادة موازية، تصبح علاقتها بالدولة أقرب إلى علاقة شريكين متنافسين في شركة مفلسة، لا إلى علاقة رئيس بمرؤوس.
الظهير الشعبي: من يحمي من؟
لا تعيش أيّ ميليشيا على السلاح وحده؛ لا بدّ من ظهرٍ اجتماعي يحميها أو يخشاها أو يتعايش معها. أحيانًا تنشأ من رحم قبيلة أو طائفة أو منطقة مهمَّشة، فتقدّم نفسها كـ“درع” لمجتمع مهدّد. وأحيانًا تُفرض على الناس فرضًا، فيتعايشون معها تحت منطق: “شرّ أعرفه خير من فراغ لا أعرفه”.
سمعت في أكثر من بلد الجملة نفسها تقريبًا:
“هم مسلحون… نعم، لكنّهم على الأقل من أبنائنا، لا من غرباء جاءوا من الخارج”.
هذه العلاقة الملتبسة بين المجتمع والميليشيا تزيد من تعقيد المشهد: فكلّ محاولة من الدولة لاستعادة احتكار العنف قد تُقرأ شعبيًا كاستهدافٍ لمكوّن اجتماعي بأكمله، لا لسلاحٍ منفلت فحسب. وهنا تتضاعف مأزقية الدولة: لا هي قادرة على القبول بوجود شركاء في العنف، ولا هي قادرة على إعلان حربٍ شاملة على شرائح اجتماعية واسعة تستند إليها هذه الميليشيات.
أنماط النهاية… في كل مرة، تعود الدولة إلى النقطة صفر.
في كل بلد من هذه البلدان، انتهت قصة “الدولة والوكيل” إلى واحدة من ثلاث نهايات:
1. الدمج الشكلي
كما حدث في محاولة بغداد دمج فصائل الحشد الشعبي في أجهزة الدولة: اسم جديد، زيّ جديد… لكن الولاء القديم باقٍ.
2. الحرب المفتوحة
كما في السودان واليمن وسوريا: حين يفشل “الدمج”، تشتعل الحرب الأهلية داخل الدولة قبل أن تشتعل ضد الآخرين.
3. قشرة الدولة
كما في ليبيا: حكومة شكلية، ورئيس وزراء رسمي، ووزارة دفاع… لكن السيادة الحقيقية في يد الميليشيات.
في كل هذه النهايات، يظلّ السؤال الأخلاقي والسياسي واحدًا: من الذي خلق هذا الوحش أصلًا؟ الميليشيا التي اغتنمت الفرصة، أم الدولة التي فتحت لها الباب، وسلّمتها مفاتيح العنف، ثمّ اشتكت من ضراوته حين كبر؟
خاتمة: الدولة التي صنعت وحشها سيلتهمها
الخلاصة التي تفرض نفسها بعد خمسة وعشرين عامًا من تتبّع الحروب والعمل على تغطيتها وتحليلها وتدريس أنماطها أكاديميًا في الشرق الأوسط: الدولة التي تصنع وكيلاً للعنف تفقده دائمًا. والوكيل الذي يفقد حاجة الدولة إليه… يلتهمها.
فالسؤال ليس: كيف نحلّ الميليشيا؟ السؤال هو: كيف نمنع الدولة من إعادة إنتاجها كل مرة؟
ذلك هو الامتحان الحقيقي للدولة الحديثة في الشرق الأوسط:
هل تختار سيادة كاملة تتحمّل مسؤوليتها، أم سيادة منقوصة تشاركها مع وكلاء لا يعترفون إلا بمنطق القوة؟
حين تصرخ الدولة ولا يردّ أحد، تكون قد وصلت إلى لحظة الحقيقة:
لم تعد الحرب حربها… ولم يعد السلاح سلاحها.