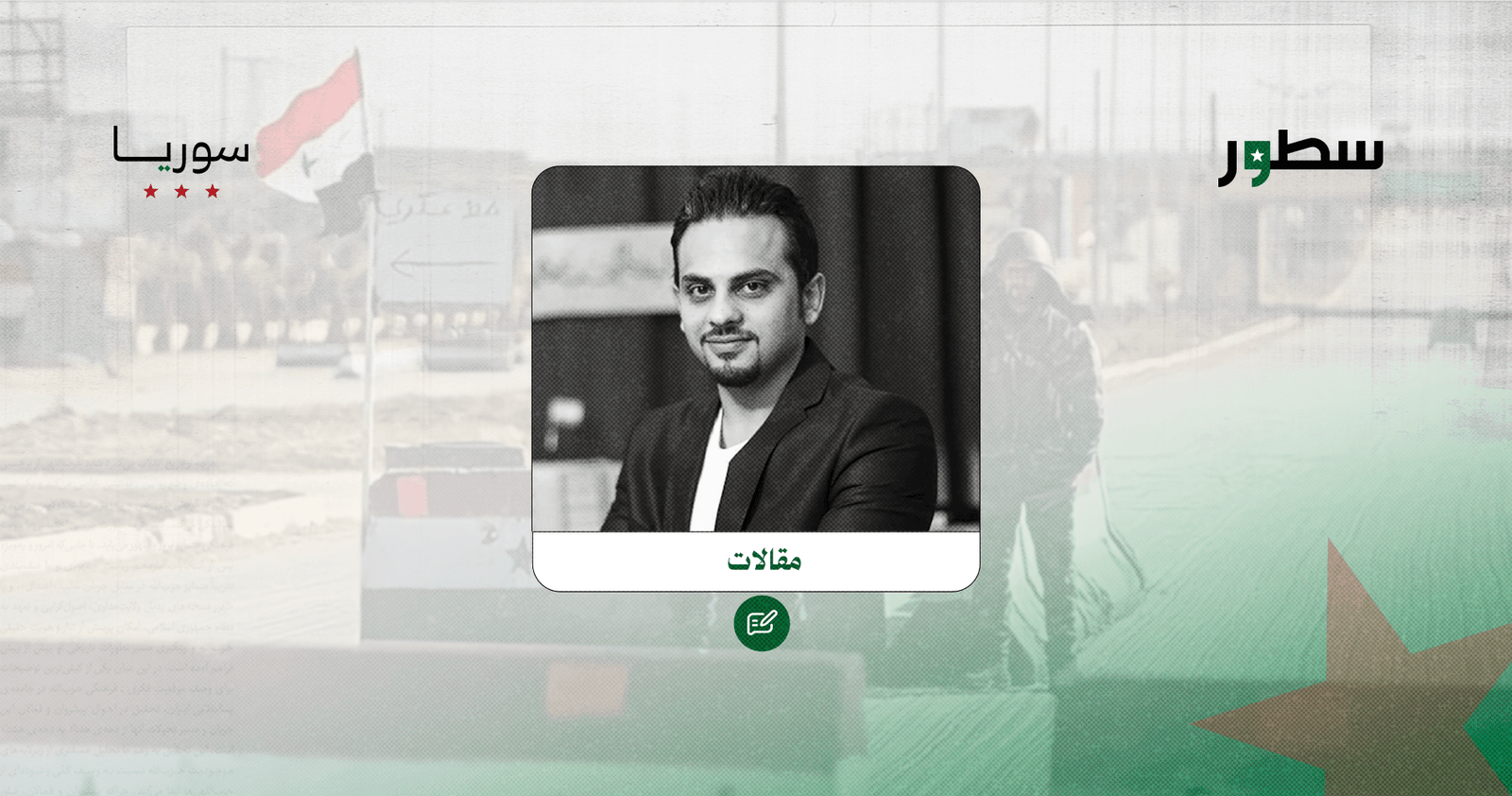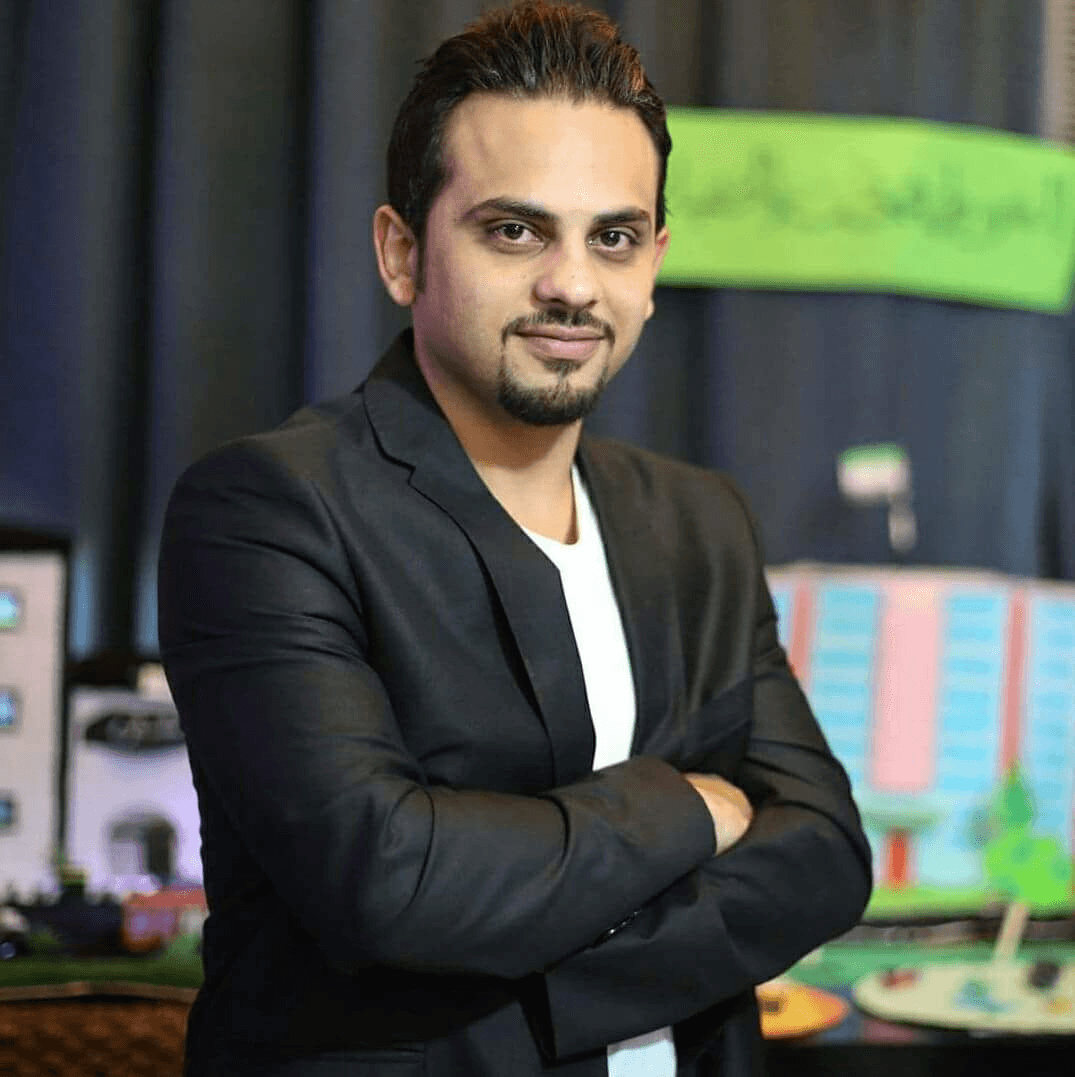مجتمع
حين يصبح المنفى وطناً والمهجّرون أبناءه
حين يصبح المنفى وطناً والمهجّرون أبناءه
في مشهدٍ مؤثر هزّ قلوب السوريين، ظهرت طفلة صغيرة تجهش بالبكاء وهي تغادر إدلب، عائدة إلى ريف دمشق، الأرض التي تنتمي إليها أصولاً لكنّها لا تعرفها، إذ وُلدت ونشأت في حضن إدلب، المدينة التي احتضنتها كما احتضنت آلاف المهجّرين من شتى أنحاء سوريا خلال سنوات الثورة.
لم تكن دموع الطفلة مجرّد لحظةٍ عابرة، بل كانت صدى لصوتٍ داخلي يعرفه كل مهجّر، صوت الانتماء المتجذّر في الذاكرة، والحنين إلى مكان لم يكن مجرّد جغرافيا، بل أماً ثانية، دافئة، حنونة كما يحب السوريون أن يصفوا إدلب.
تداول السوريون هذا الفيديو بكثافة، وجعلوه رمزاً لحملة “الوفاء لإدلب“، وشاهداً على عمق التعلّق العاطفي الذي تكنّه قلوب المهجّرين لهذه المدينة، التي كانت ملاذهم حين ضاقت بهم الأرض.
في هذا المقال، نستعرض قصصاً حقيقية لعائلات سورية، بعضها ما يزال في إدلب يرفض فكرة المغادرة، وأخرى غادرت جسدًا لكنّها تركت قلبها هناك، فما الذي يجعل إدلب بهذا القرب من الروح؟ وكيف تنشأ علاقة حبّ كهذه بين الإنسان والمكان؟
ذاكرة المهجّرين
يبقى الأطفال أكثر تأثراً بالبيئة المحيطة وخاصة إن كانوا قد ولدوا وكبروا فيه، وذلك ما حدث مع رنا ابنة مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق البالغة من العمر ستة أعوام.
في قلب هذا التعلّق، تبرز مشاهد الطفولة التي تنشأ في المكان الجديد، لتشكّل ذاكرة يصعب التخلي عنها، الطفلة رنا مثال حي على ذلك حيث قالت والدتها إنّ الطفلة وُلدت في إدلب بعد تهجير عائلتها من مدينة دوما عام 2018، ولم تعرف غير شوارع إدلب وأزقتها، كبرت بين الأطفال هناك، حتى باتت ترى في إدلب بيتها الأول والأخير.
وتابعت أنّه حين اضطرت العائلة للعودة إلى ريف دمشق بعد تحرير سوريا لم تستطع الطفلة أن تخفي دموعها، وبدأت بالسؤال “ليش رح نترك إدلب؟ ح نزورها مرة ثانية؟” ومن خلال تلك الأسئلة، التي كانت تنتظر أجوبتها من والديها، عبّرت عن عدم رغبتها في المغادرة.
وتابعت حديثها لسطور، إلى اليوم لا تتوقف عن ذكر أصدقائها في الحارة، وتذكر إدلب وكأنّها ما تزال تعيش بين أزقتها، بالنسبة لرنا، “إدلب ليست مجرّد مدينة، بل هي طفولتها وذكرياتها وأمانها الذي يصعب محوه من قلبها بوقتٍ قصير” على حد تعبيرها.
وحول الارتباط العاطفي قالت الباحثة الاجتماعية آلاء الدالي لسطور إنّ ارتباط الناس بالمكان يتأثر بالمدة التي يعيشونها فيه وفي الظروف المحيطة بهم، موضحة أن إدلب لم تكن محطة عابرة، بل تحولت لملاذ لآلاف المهجّرين خلال سنوات صعبة، ما خلق ذاكرة جمعية مليئة بالتجارب المتناقضة من ألم وخوف، لكن أيضاً من محبة وتعاطف.
وأضافت أنّ الكثيرين شكّلوا في إدلب حياة جديدة عبر صداقات وزواج وأطفال وعمل، وهو ما عزّز الروابط العاطفية مع المدينة حتى لدى من عادوا لاحقاً إلى مناطقهم الأصلية.
التأقلم يحتاج إلى وقت
خلف مشهد الحنين لإدلب، تتشكّل حكايات أكثر عمقاً لا تتوقف عند لحظة الوداع، بل تمتد إلى تفاصيل التأقلم اليومي والانتماء الشعوري، فالعلاقة بين الإنسان والمكان لا تُبنى فقط على الأصل والجغرافيا، بل على التجربة وعلى كمّ المشاعر والروابط التي تنسجها الأيام في ظلّ التهجير والبحث عن الأمان.
منذ سنوات، لجأت عائلة من حي الخالدية في مدينة حمص إلى إدلب بعد أن اضطرهم تهجير الحماصنة عام 2016 إلى اللجوء إلى إدلب، تاركين خلفهم منزلاً تحطّمت نوافذه وتبعثرت ذكرياتهم تحت الركام.
أفادت مريم لسطور، أنّ الخطة في البداية مجرّد إقامةٍ مؤقتة في إدلب لحين أن تهدأ الأوضاع في حمص، لكن السنوات مضت وتحوّلت المدينة من محطة مؤقتة إلى حياة كاملة، حيث فتح الأب ورشة نجارة صغيرة والتحق الأطفال كرم ولينا بالمدراس وسط بناء العائلة شبكة من العلاقات الاجتماعية مع أبناء المحافظة.
وبحسب الوالدة، فإنّهم أسسوا في إدلب حياة كاملة من الصفر والأطفال أصبح لديهم أصحاب وذكريات، وطفلها البالغ 5 سنوات لا يعرف حمص ولم يزرها مطلقاً، بسبب سيطرة النظام البائد على المدينة، حيث يُخشى أن يتم اعتقال زوجها على الفور إن عادوا، كونه كان مسعفًا ميدانيًّا خلال سنوات الثورة الأولى، أمّا لينا لا تذكر منزلها بحمص إذ خرجت في عامها الثالث.
وأشارت الباحثة آلاء الدالي إلى أنّ الانتقال إلى بيئةٍ جديدة ليس سهلاً، حتى لو كان مجرّد تغيير منزل في نفس المنطقة، فكيف إذا كان إلى مدينة أخرى مختلفة اجتماعيًّا ومعيشيًّا، مؤكدة أن تقبل المكان الجديد يحتاج وقتاً وبناء ذكريات وتجارب جديدة بالتدريج.
وتابعت حديثها قائلة، عندما أتيحت فرصة العودة إلى حمص أمامنا مؤخراً بعد تحسّن الظروف الأمنية في المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام البائد سابقاً، كان القرار أصعب مما توقّعنا ورغم بدء تجهيز أشيائنا للعودة رفض الأطفال الفكرة بشدة، وتحديدًا لينا التي قالت لأمها: “ليش نرجع على مكان ما إلنا فيه رفقة ولا بيت؟ نحن عايشين هون مرتاحين”.
تؤكد مريم لسطور، أنّ القرار الآن لم يعد يخصهم فقط بل الأطفال أيضًا لهم الرأي والدور في اتخاذ القرار المصيري، وما زالوا يحتاجون وقتاً لكي يقتنعوا أنّ العودة ستتحقق يوماً ما إلى مدينتهم الأصلية، مشيرة إلى أنّه “يمكن نرجع يوم من الأيام، بس بقلبي بحس إدلب صارت مدينتنا الثانية وفكرة العودة صعبة علينا وعلى أطفالنا”.
وبيّنت الباحثة آلاء الدالي، أنّ توفر الخدمات الأساسية والأمان يسهّل الاندماج، ثمّ تأتي العلاقات الاجتماعية الجيدة وأجواء العمل الصحية لتسريع تقبّل البيئة الجديدة، وختمت بالقول إنّ الحنين للمكان الأول شعورٌ طبيعي لا يُمحى لكن على الإنسان أن يتوجه أيضاً نحو مستقبله لبناء حياة جديدة وذكريات مختلفة.
في إدلب، لم يجد المهجّرون فقط مأوى، بل وجدوا فيها وطناً بديلاً صاغوه من الألم والأمل معاً، ومهما تنوّعت الحكايات، يبقى القاسم المشترك بينها هو ذلك الخيط الرفيع الذي يربط الإنسان بالمكان، حين يتحوّل الغريب إلى قريب، والمؤقت إلى دائم، والمهجر إلى بيت، إدلب لم تكن مجرّد مكانٍ عبور بل أصبحت ذاكرة حيّة في وجدان كثير من العائلات التي احتضنتها.ٍ