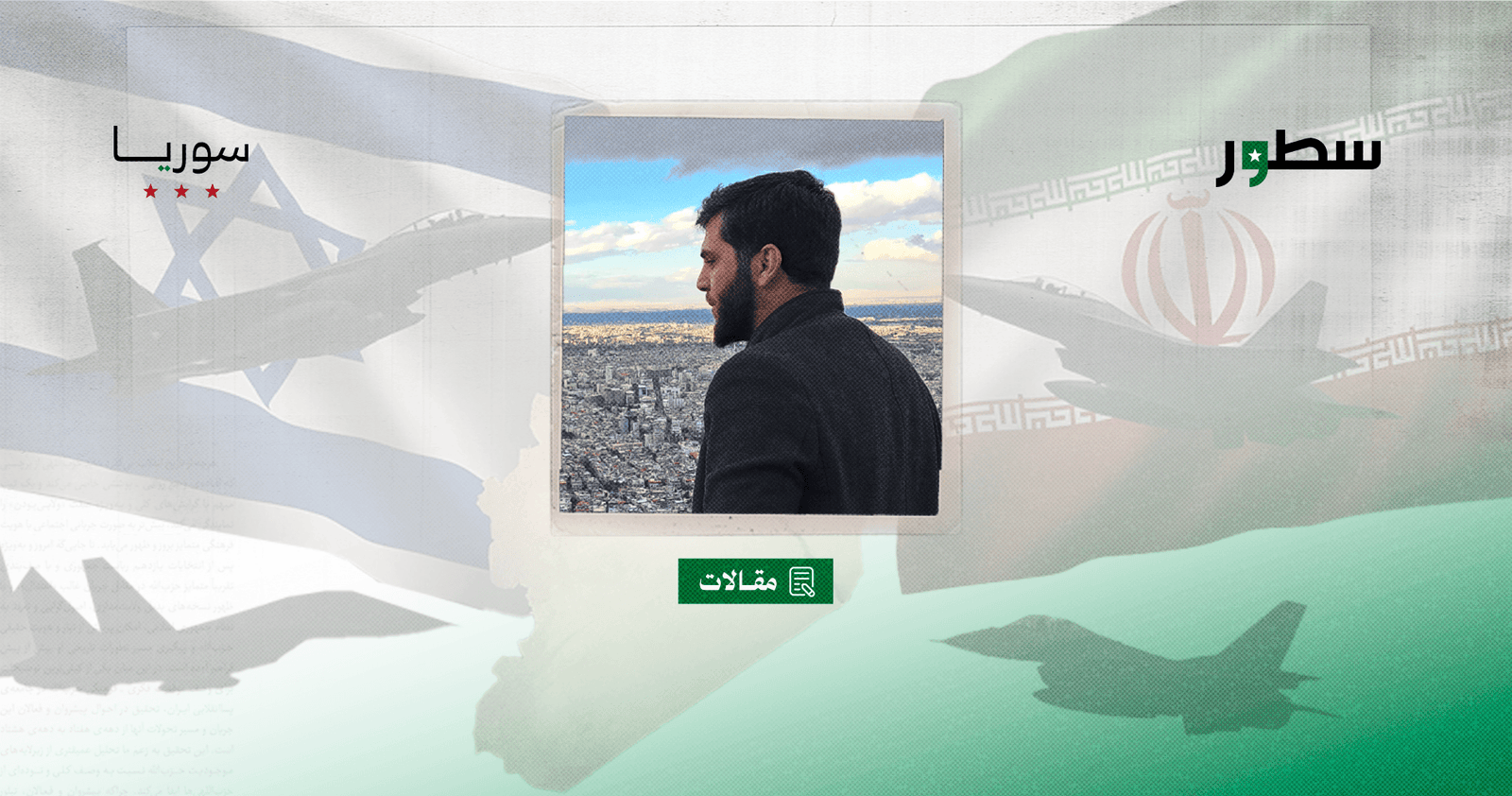مجتمع
أمل عنيد في زمن الانقسام: كيف تصنع سوريا الوطنية من صدور الخائفين
أمل عنيد في زمن الانقسام: كيف تصنع سوريا الوطنية من صدور الخائفين
– الكاتب: محمد العماري
الفتنة اليوم ليست جديدة، لكنها أكثر خبثاً.. تتغذى على وجع الناس، على فقرهم، على وحدتهم، على قلة ثقتهم بكل شيء؛ في الدولة، في الغد، وحتى في أنفسهم. تبحث عن شرخ صغير لتكبر، وعن كلمة غاضبة لتشتعل.
لكن رغم كل هذا، هناك شيء فيها ما يزال عاجزاً عن الانتصار الكامل. لأن في صدور الناس نبضاً ما زال يعرف الحق من الباطل. في قلوبهم، مهما خذلتهم الأيام، ذاكرة تعود بنا إلى أيام كان اسم العائلة أهم من الطائفة، وكان السلام عادة لا استثناء. وربما في لحظة ما، أقسى ما نمرُّ به، سنكتشف أن ما يجمعنا أقوى من كل ما يُراد بنا أن ننساه.
أعرف الفتنة لأنها مرّت من أمام بيتي ولم تدخل، حاولت أن تزرع الشك بين من عاشوا عمراً في بيت واحد، لكن الأرض أذكى والذاكرة أصدق. أنا من درعا، من قرية ترى في السويداء امتداداً لا حدوداً، عشت فيها وعرفت أهلها، تقاسمنا الخبز والماء والخوف والفرح.
هذه ليست استثناءات بل هي الأصل الذي تريد الفتنة أن تمحوه، لكن الحقيقة أعمق من الخطابات وأرسخ من كل ما يُقال على العلن. واليوم في قلب هذه الحقيقة، نرى مشروعاً يُعاد تدويره بوجوه جديدة، يحاول تفتيت ما تبقى من الروابط العميقة بين أبناء الوطن الواحد.
ولا بد لنا من التعمق في فهم أن ليس كل من اتبع النهج الذي يسعى إلى عزل الطائفة الدرزية عن محيطها الوطني، والترويج لفكرة تحالفها مع الاحتلال، شريكاً فيه عن قناعة. كثيرون فعلوا ذلك مكرهين، بدافع الخوف لا الإيمان. فقد نجحت الجهات التي تعمل تحت عباءة الاحتلال، منذ بداياتها، في زرع القلق في نفوس الناس، عبر خطاب التخويف والتشكيك، لا الإقناع. قدّمت نفسها على أنها المخلّص الوحيد، في وجه مستقبلٍ مشوّش، وبذلك تحولت إلى مظلة يلوذ بها الخائفون، لا المؤمنون.
هذا النوع من السيطرة لا يُبنى على محبة، بل على فزع؛ فزع من المجهول، من الانتقام، من العزلة، وحتى من أهلهم. وهكذا تجد أنفساً مقهورة تتظاهر بالولاء، وتخفي في داخلها حسرة، لأنها أُجبرت أن تتنازل عن إرثٍ من الكرامة والانتماء، مقابل شعور زائف بالأمان.
لكن الخوف لا يصنع مستقبلًا، والرهان على الذعر لن يبني طائفة قوية. بل على العكس، هو ما يدفعها تدريجياً إلى العزلة، ثم إلى الكسر. لأن أي مشروع يُبنى على الرهبة، لا على القيم، لا يمكن أن يستمر طويلاً. والمجتمع الذي لا يُعطى مساحة ليقول “لا” بحرية، لن يكون قادراً على أن يقول “نعم” بثقة.
قد نكون اليوم في قلب العاصفة، لكن البوصلة ما زالت في أيدينا، نحن من نقرر أن نبني جسوراً لا خنادق، وأن نحفظ إرث المحبة لا أن نُورّث الكراهية. فمن عرف طعم الأمان لا يقايضه بالوهم. ومن تربى على احترام الجيرة لا يرضى بالغدر.
وهنا يأتي دورنا، أبناء الوطن الواحد، أن نُميّز بين من سُرق صوته بالخوف، ومن باع صوته بالخيانة. بين من أُجبر على الصمت، ومن اختار التواطؤ. فالصمت أحياناً يكون وجعاً، أما التبرير فهو سقوط لا شفاء منه.
الوعي هنا هو المعركة الحقيقية. أن نفهم ما يُراد بنا، وأن نُفرّق بين الخائف والمُتآمر، بين الضحية والجلّاد، بين من يسير في الظلمة باحثاً عن نور، ومن يطفئ النور عمداً ليبقى سيداً على العتمة.
والوعي لا يكون بكلمات فقط، بل بفعلٍ يومي صغير ومستمر، كأن نصغي لبعضنا بصدق، أن نسأل لا لندين، بل لنفهم، أن نروي الحكايات التي تخبئها البيوت لا تلك التي تبثها المنابر. أن نحمل الكلمة الطيبة كدرع، والموقف الشريف كسيف. أن نمدّ أيدينا لمن انزلق قبل أن يُصبح خصماً، وأن نذكّر من تاه بأن الطريق ما زال مفتوحاً للرجوع. أن نبني المساحات التي تُشعر الناس بالأمان ليقولوا الحقيقة، لا تلك التي تدفعهم للانكفاء أو التمثيل. هكذا فقط، نحاصر الفتنة لا الأشخاص، ونكسر دائرة الخوف لا ظهر من وقع فيها. هكذا، نمنح الوطن فرصة ليشفى.