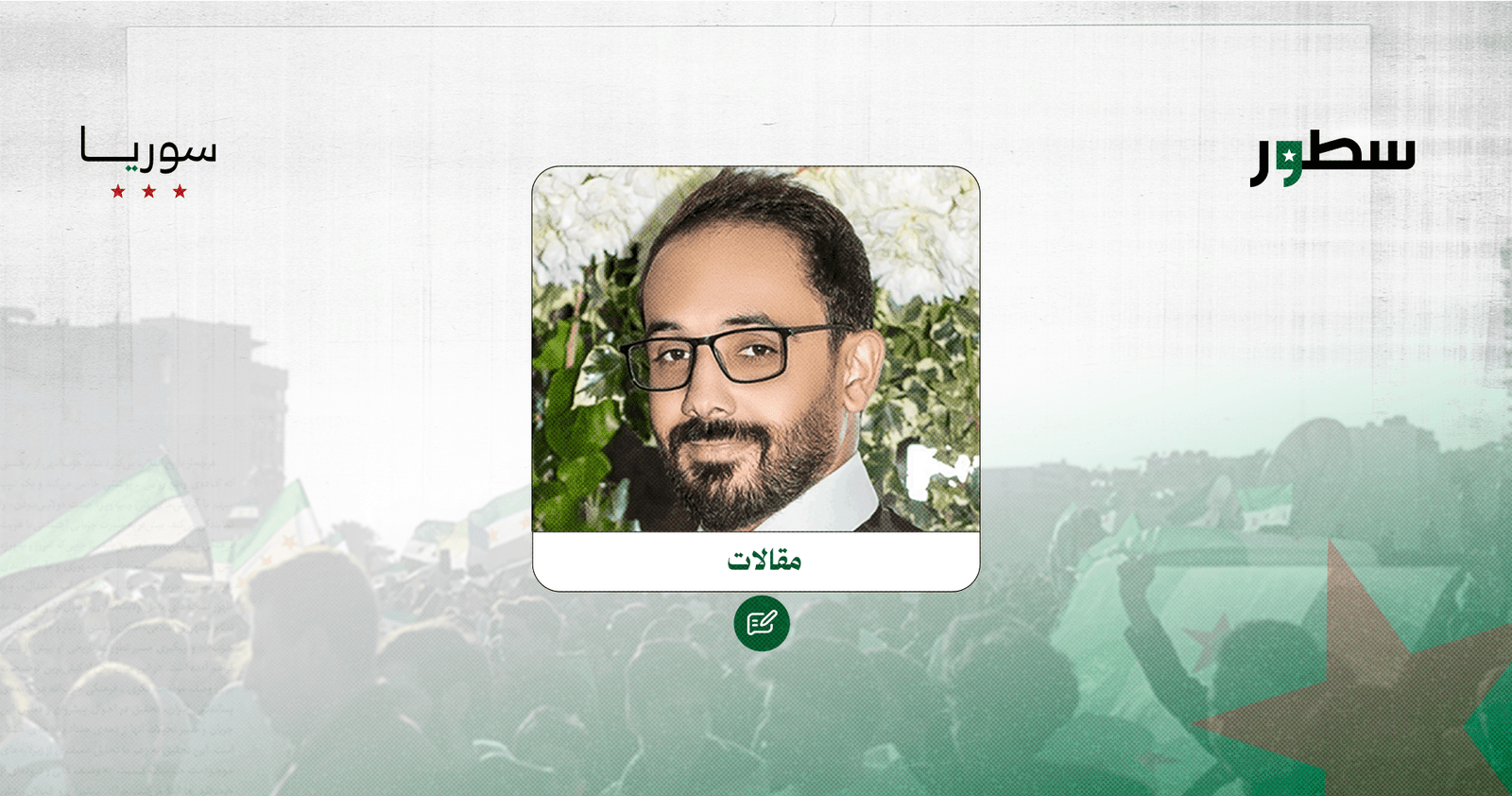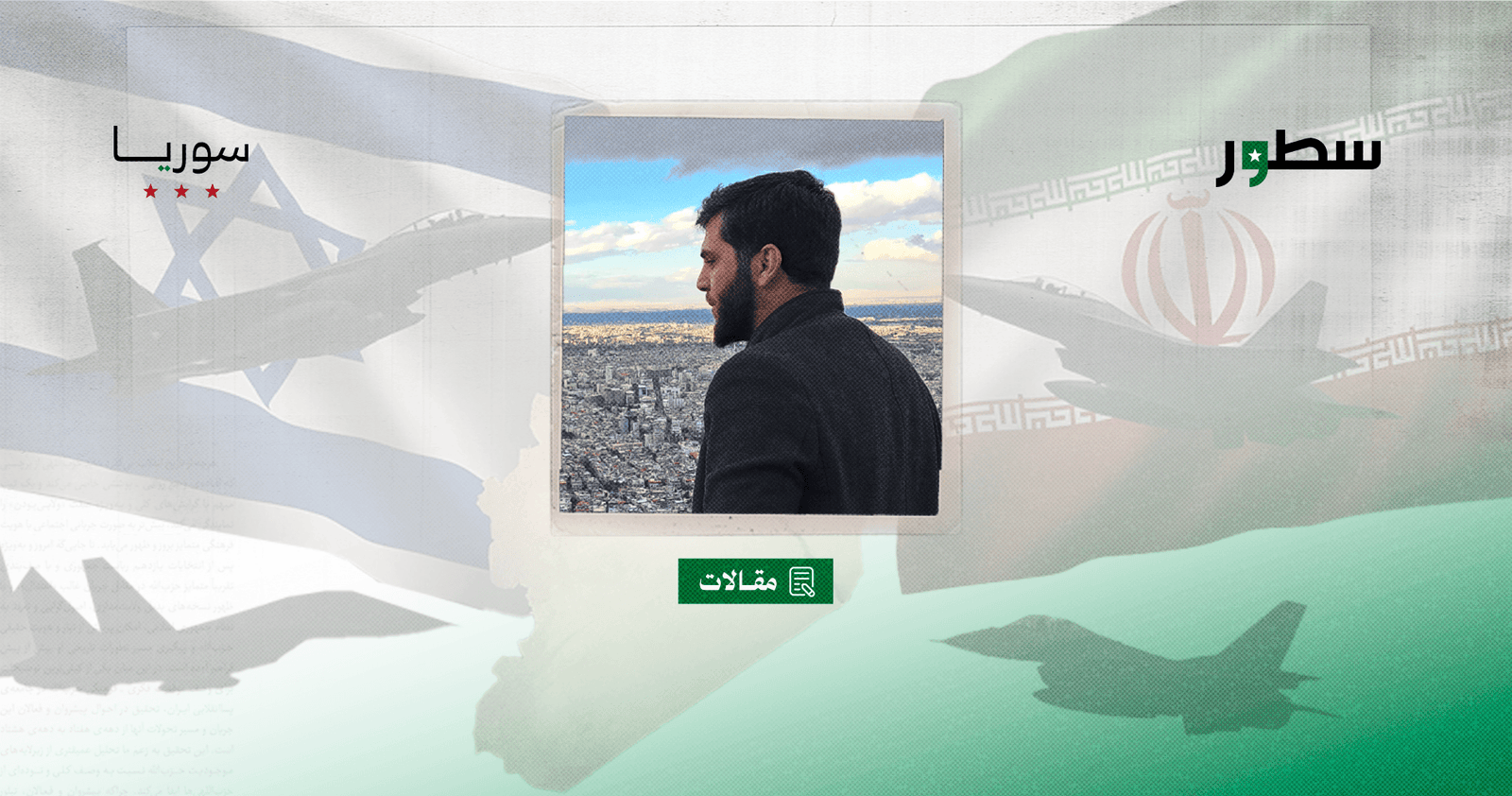سياسة
ما بعد الحروب والثورات: لماذا تزداد الانتهاكات في الفترات الانتقالية؟
ما بعد الحروب والثورات: لماذا تزداد الانتهاكات في الفترات الانتقالية؟
تاريخياً، لم تخرج أي دولة من الحرب أو الصراع أو الثورة إلى برّ الأمان مباشرة. كل البلدان التي مرت بتجارب عنيفة أو انهيار سلطوي دخلت في ما يُعرف بـ”الفترة الانتقالية”، وهي مرحلة معقدة تتأرجح فيها البلاد بين الماضي الذي لم يُطوَ بعد، والمستقبل الذي لم يتبلور.
في هذه المرحلة بالذات، تحدث الانتهاكات الأوسع والأكثر التباساً، لا لأن الأطراف المتصارعة ما تزال قائمة فحسب، بل لأن الدولة التي يُفترض أن تضمن العدالة والكرامة، تكون هي ذاتها غير مستقرة، أو في طور إعادة التشكل، أو حتى شريكة في الانتهاك.
لكن المهم في هذا السياق ليس الاعتراف بهذه الحقيقة فقط، بل فهم كيف تعاملت دول أخرى مع هذه المرحلة، وكيف خرجت منها، ثم نقيم الواقع السوري وفق هذا السياق، لمعرفة ما يمكن فعله الآن قبل أن يتجذر الانهيار.
لماذا تحدث الانتهاكات بعد الحروب والنزاعات؟
خلال الفترات الانتقالية، تنشأ حالة من الفراغ: فراغ في السلطة، فراغ في القانون، فراغ في الضمير. الانتهاكات بحق المدنيين تصبح سلوكاً مكرراً لا لأنه مشروع، بل لأنه لا يُقابَل بأي شكل من أشكال الردع. هذا الانفلات له أسباب كثيرة، أبرزها: انهيار أو ضعف مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية والقضائية، فعندما تغيب سلطة الدولة أو تتفكك، تتعدد الجهات التي “تملأ” الفراغ، من مليشيات محلية، إلى جماعات مسلحة، إلى أفراد يستخدمون العنف لأغراضهم الخاصة.
كما أن عقليات الحرب تظل حية لدى كثير من المجموعات إذ إن الكثير ممن يحملون السلاح، أو يعملون في أجهزة أمنية، لا يتخلون عن ذهنية “العدو”، ولا يستطيعون التحوّل بسهولة إلى مواطنين في دولة قانون. يستمرون في التعامل مع الآخر باعتباره تهديداً لا مواطناً.
والفساد البنيوي المتجذر فالأجهزة المنهارة تُعيد إنتاج نفسها على صورة أسوأ، وتغدو أدوات فساد بدلاً من أدوات حماية، وتنتقل الانتهاكات من منطق “الحرب” إلى منطق “الابتزاز اليومي”، وبقاء السلاح خارج سيطرة الدولة يجعل المدنيين عُرضة دائمة للتهديد، سواء على يد جماعات رسمية أو غير رسمية.
وتضارب الولاءات السياسية والمناطقية والطائفية إذ إن المرحلة الانتقالية غالباً ما تشهد صراعاً على من سيحكم المستقبل، مما يولّد رغبة في تصفية الحسابات باسم العدالة أو التاريخ.
دول عانت من هذه الانتهاكات في فتراتها الانتقالية: التجارب والدروس
رواندا (1994 حتى بداية 2000)
خرجت رواندا من إحدى أبشع المجازر في التاريخ الحديث، حيث قُتل حوالي 800 ألف شخص خلال 100 يوم فقط في إبادة جماعية مدفوعة بالكراهية العرقية. بعد توقف المجازر، دخلت البلاد مرحلة انتقالية قادتها الجبهة الوطنية بقيادة بول كاغامي، تميزت بتحديات أمنية وإنسانية هائلة.
خلال هذه الفترة، وقعت انتهاكات خطيرة بحق مدنيين عزل لم يكن لهم أي دور في الإبادة الجماعية، خاصة من قبائل الهوتو الذين لم يشاركوا في العنف، لكنهم وجدوا أنفسهم مستهدفين بسبب الاشتباه الجماعي أو بدافع الانتقام. شملت هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، ظروف احتجاز غير إنسانية، وأحياناً القتل خارج نطاق القانون، خاصة في المخيمات أو المناطق الحدودية. الكثير من هؤلاء لم يحصلوا على محاكمة، وتم تصنيفهم ضمن “البيئة الداعمة” للجناة دون أدلة فردية.
في محاولة لمعالجة هذا الواقع، أُنشئت محاكم غتشاتشا التقليدية التي سعت لتقديم شكل من العدالة المجتمعية السريعة، وركزت على الاعتراف والمصالحة أكثر من العقاب. كما أُطلقت برامج لإعادة بناء الثقة، شملت حملات تعليمية وتجريم خطاب الكراهية، إلى جانب مشاريع لإعادة دمج الضحايا والجناة في نسيج اجتماعي موحد.
استغرقت هذه المرحلة أكثر من 10 سنوات، ورغم أنها واجهت انتقادات لعدم احترامها الكامل لمعايير العدالة وحقوق الإنسان، فقد ساهمت في إحلال درجة من الاستقرار والنمو، وإن ظلت الديمقراطية مقيدة والهامش السياسي محدوداً.
سيراليون (2002 – 2013)
بعد انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون عام 2002 دخلت البلاد مرحلة انتقالية شهدت استمرار الانتهاكات بحق المدنيين من بعض عناصر الحكومة والأجهزة الأمنية وشملت هذه الانتهاكات الاعتقالات التعسفية والعنف الجنسي والقمع المفرط للمظاهرات وتجاهل احتياجات الضحايا في برامج التعويض.
رغم أن التركيز كان موجهاً أساساً نحو محاسبة المتمردين فقد تم التعامل مع هذه الانتهاكات عبر إنشاء المحكمة الخاصة بسيراليون التي حاكمت بعض المسؤولين الحكوميين ولجنة الحقيقة والمصالحة التي وثقت شهادات الضحايا بمن فيهم من تضرروا على يد الدولة، كما جرت إصلاحات في قطاع الأمن والشرطة شملت التدريب والتطهير وتوصيات بعدالة اجتماعية أوسع، ورغم أن العدالة لم تكن كاملة فإن البلاد تمكنت خلال عقد من احتواء الفوضى وتحقيق درجة من الاستقرار.
كولومبيا:
خلال المرحلة الانتقالية في كولومبيا بعد توقيع اتفاق السلام عام 2016، ورغم الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة، وقعت انتهاكات متواصلة بحق المدنيين، وكان أبرزها:
استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة الاجتماعيين، حيث قُتل المئات منهم منذ الاتفاق، على يد جماعات مسلحة أو مجهولين، بسبب نشاطهم في الدفاع عن الأرض وحقوق المجتمعات المحلية.
تهجير قسري مستمر في بعض المناطق الريفية، بسبب الصراع بين الجماعات المسلحة التي لم يتم تفكيكها بالكامل أو التي ظهرت بعد اتفاق السلام.
الاغتيالات الانتقائية ضد المدنيين المرتبطين بعمليات نزع السلاح أو التعاون مع مؤسسات العدالة الانتقالية.
تأخير في تطبيق بعض بنود اتفاق السلام، خاصة المتعلقة بالإصلاح الريفي والتعويض للضحايا، مما فاقم من مشاعر الظلم والإقصاء لدى المجتمعات المهمشة
ورغم أن الحكومة أنشأت منظومة “العدالة الخاصة للسلام” لمحاكمة الجرائم وكشف الحقيقة، وأطلقت برامج لإعادة دمج المقاتلين، فإن ضعف سيطرة الدولة في بعض المناطق وتباطؤ تنفيذ الإصلاحات جعلا الانتهاكات مستمرة إلى حد ما.
ماذا عن سوريا؟
سوريا اليوم تعيش مرحلة سلم غير مستقر، لكنها بلا شك تعيش مرحلة انتقالية واقعية، سواء اعترفت بذلك النخب السياسية أم لا. هناك انهيار اقتصادي شامل، نظام سياسي مأزوم، مناطق متعددة النفوذ، مؤسسات مفككة، وانعدام الثقة بين المواطن والدولة.
الانتهاكات في سوريا خلال هذه المرحلة لا تقل عن مثيلاتها في تلك الدول كونها تحدث في ظل تعدد الجهات المنفذة (حواجز أمنية، فصائل مسلحة، أطراف خارجية، استمرار عقلية الفوضى التي كانت تسمح لكثير من العناصر بالتجاوزات في زمن الثورة، سلاح منتشر ومنفلت، وجود مجموعات تابعة رسمياً وأخرى غير رسمية). وتشمل طيفاً واسعاً من الممارسات: من الإهانة والتعذيب والتغيب، إلى الابتزاز، وحتى القتل خارج القانون.
ومع ذلك، إذا قارنّا حجم الكارثة السورية بما حدث في رواندا أو سيراليون أو حتى لبنان، يمكن القول إن الوضع السوري ما يزال من حيث الإمكانية قابلاً للمعالجة، إذا تم التحرك الآن بجدية ومسؤولية
لا يمكن للسوريين مواصلة تجاهل الانتهاكات.. الاعتراف وحده لا يكفي
في أي دولة تمر بمرحلة انتقالية بعد صراع دموي طويل، مثل سوريا، تصبح الانتهاكات ضد المدنيين اختباراً حقيقياً لجدّية أطراف المرحلة الجديدة. لا يمكن للسوريين شعباً وحكومة ومجتمعاً أن يواصلوا التعامل مع هذه الانتهاكات بوصفها “تفاصيل عابرة” أو “ظواهر وقتية”. فالسكوت عنها يفتح الباب لتحولها إلى سلوك مؤسسي، تصبح معه الكرامة الإنسانية مجرد استثناء، لا قاعدة.
صحيح أن الفترات الانتقالية بطبيعتها هشّة، وغالباً ما تكون مضطربة، لكن الدول التي تحترم نفسها وتطمح إلى بناء مستقبل آمن، لا تكتفي بالاعتراف بوقوع الانتهاكات، بل تتحرك بجرأة لمعالجتها. الاعتراف وحده، دون خطوات عملية واضحة، لا يُعد حلاً، بل قد يتحول إلى تلاعب بمشاعر الضحايا ومحاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون نية حقيقية للتغيير.
على الدولة أن تتحمل مسؤلياتها بوضوح من خلال:
الاعتراف العلني بوقوع انتهاكات، لا التهرب منها أو تبريرها، ويجب أن يصدر الاعتراف من أعلى المستويات، مع تحديد نوع الانتهاكات والجهات المسؤولة عنها، دون محاولة التغطية على الفاعلين أو تحميل الضحايا جزءاً من اللوم.
إنشاء هيئة وطنية مستقلة للتحقيق والتوثيق، ويجب أن تكون هذه الهيئة محمية قانونياً من التدخل السياسي أو الأمني، وتضم حقوقيين مستقلين وخبراء دوليين، وتُمنح صلاحيات كاملة للوصول إلى الضحايا والمشتبه بهم، في كل مناطق السيطرة دون استثناء.
تشريع قوانين واضحة لمحاسبة الفاعلين في كل الأطراف، فلا يمكن بناء عدالة انتقائية تُحاسب طرفاً وتتغاضى عن آخر. المحاسبة يجب أن تطال جميع المنتهكين بغض النظر عن انتمائهم السياسي أو العسكري.
إصلاح جذري لأجهزة الأمن والسجون، فأي تحول حقيقي يتطلب إعادة بناء هذه المؤسسات من جديد، بفكر مدني شفاف، وتحت رقابة فعالة، مع التخلص من العقليات الأمنية التي ترى المواطن عدواً.
إعادة تأهيل النظام القضائي ليكون محايداً بالفعل، إذ لا عدالة بدون قضاء نزيه. كما يجب تطهير القضاء من التبعية السياسية، وتدريب القضاة على مبادئ حقوق الإنسان، وضمان استقلالية المحاكم بشكل كامل.
دعم التوثيق المهني للحقيقة، لا الشائعات أو التسييس
يجب دعم المبادرات المستقلة التي تجمع الأدلة والشهادات بطريقة مهنية، بدل الانخراط في نشر أخبار غير موثقة أو استغلال المآسي في الصراعات السياسية، وإنشاء مبادرات مدنية محلية لرصد السلوكيات وتقديم البدائل، كما يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في مراقبة ممارسات السلطات المحلية، وتقديم نماذج إيجابية لإدارة الخلافات وفض النزاعات دون عنف.
المطالبة الجدية بمسارات عدالة انتقالية وطنية فالعدالة ليست ترفاً، بل شرطاً أساسياً لأي استقرار حقيقي. إذ يجب أن تكون هناك مطالبات شعبية صريحة بإنشاء مؤسسات للعدالة الانتقالية، تشمل الحقيقة والمصالحة وجبر الضرر، لا تقتصر فقط على المحاكمات
سوريا اليوم تقف على مفترق طرق تاريخي: إما أن تدخل في مرحلة إعادة بناء حقيقية للعدالة والمجتمع، أو تستمر في التدهور حتى تُصبح “الانتهاكات” جزءاً من الهوية السياسية والاجتماعية. ما مرّ على رواندا، سيراليون، وكولومبيا، تعيشه سوريا، لكن تلك الدول اختارت في وقت ما أن تتوقف، أن تراجع، أن تُحاسب، وأن تبني. فهل نملك نحن الشجاعة أن نقف وقفة مشابهة؟
ليس فقط لمحاسبة من انتهك، بل أيضاً لمصالحة أنفسنا مع فكرة أن الكرامة والحرية ليست ترفاً، بل أساس الدولة الحقيقية.