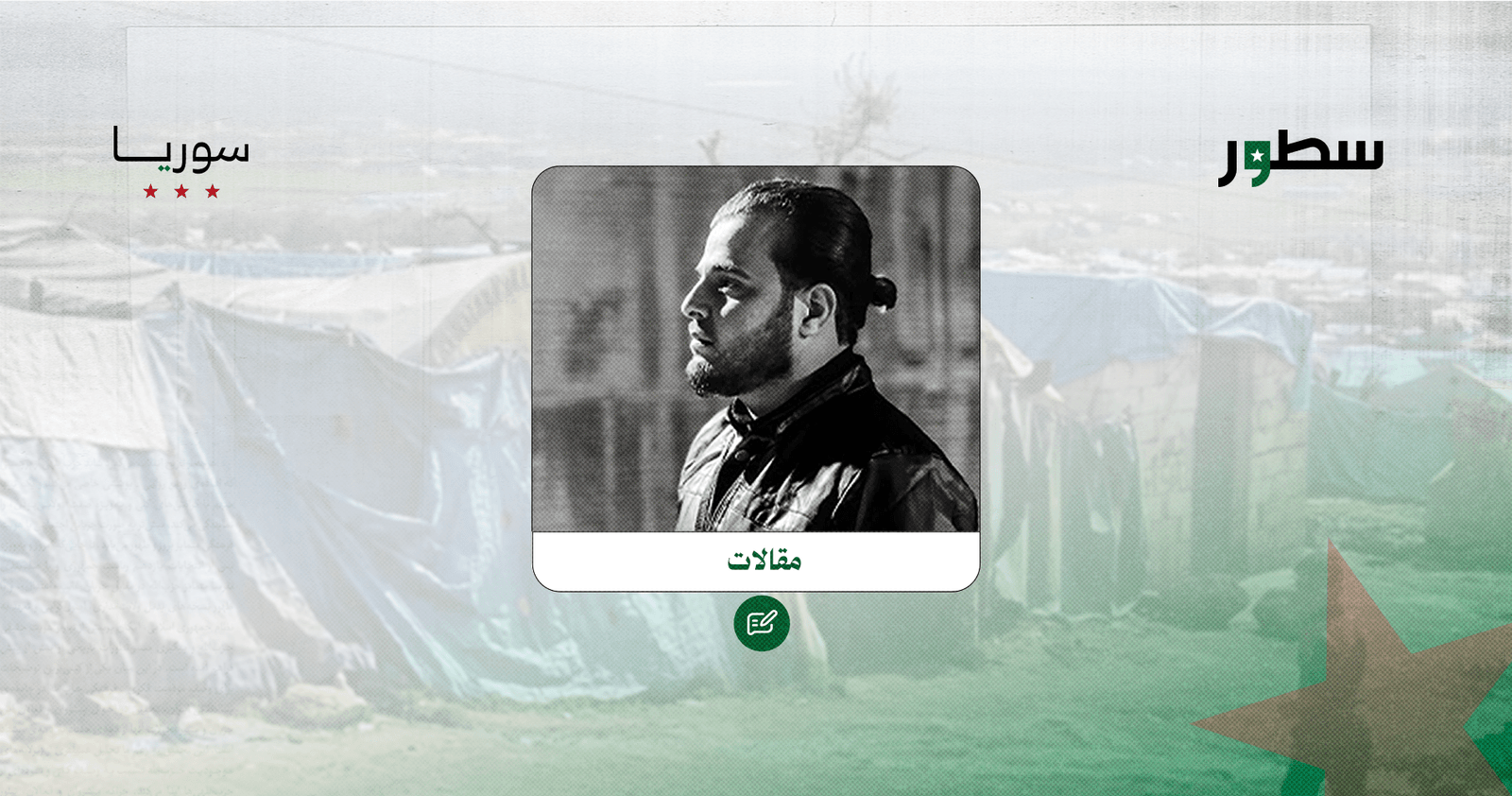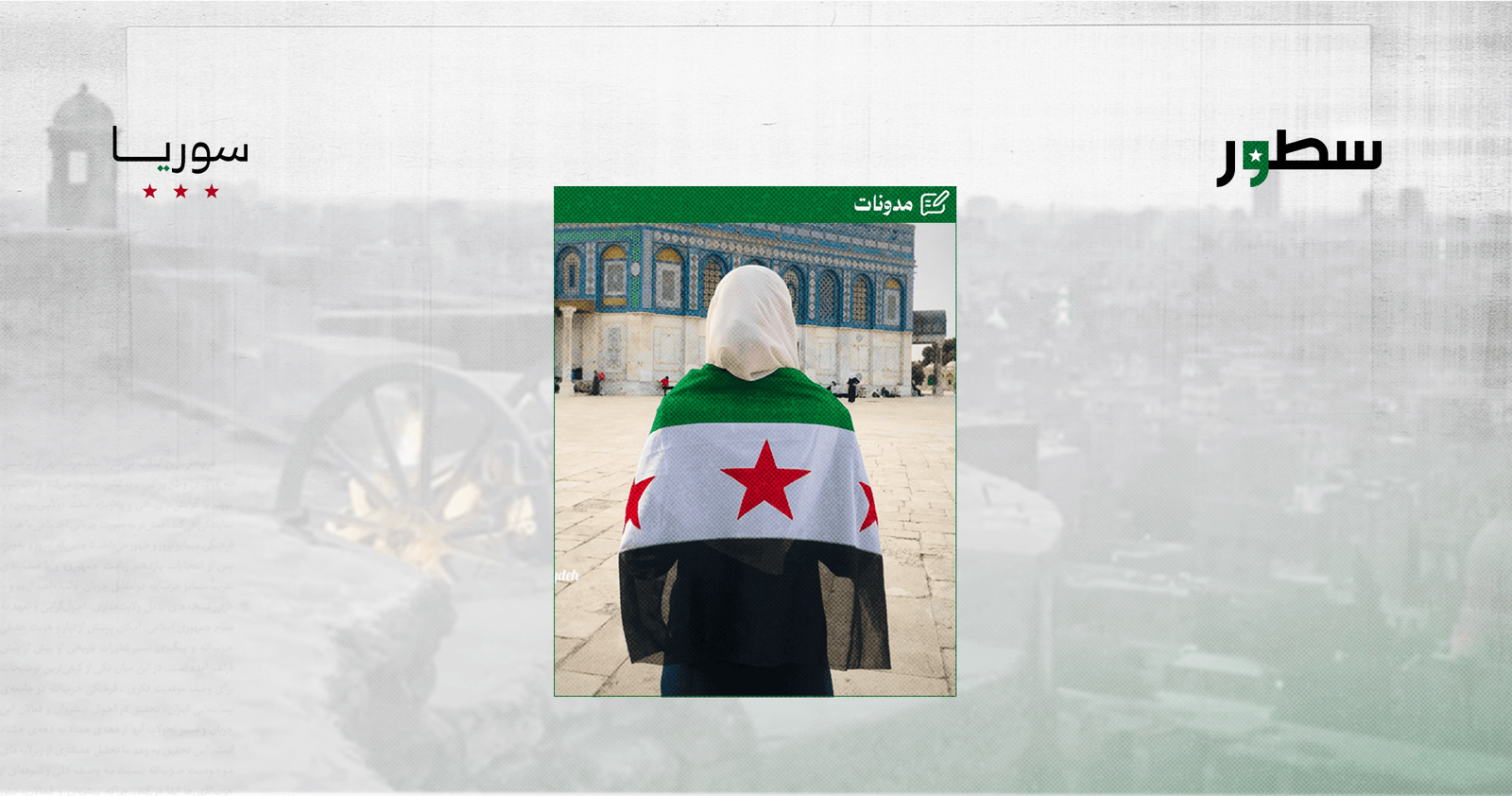مجتمع
مرآتنا المكسورة.. مشكلة الهوية الوطنية في المشهد السوري
مرآتنا المكسورة.. مشكلة الهوية الوطنية في المشهد السوري
يطلُّ سؤال الهوية بعنقه على السوريين منذ الاستقلال وميلاد الجمهورية، ويتجدّد في منعطفات البلاد كلما عصفت بها نازلةٌ جديدة. والآن يسيطر على مجموعة لا يستهان بها من طاولات النقاش وأحاديث الناس منذ التحرير. من نحن؟ من هو السوري؟ وما الذي يجمعنا؟ لم تكن الإجابات بطبيعة الحال مرضيةً وقابلة للاستقرار في الوجدان لفترات طويلة. كما أن هذه الهوية التي قُدّمَت كإجابة طوال تاريخ البلاد كانت تتحوّل كل مدة، يُعاد تعريفها، تُمتَحن، تسقط، تنجح، تتمزّق، وأحياناً كانت تُقتَل.
من الجذور الاستعمارية، ثم مشكلات التنوّع والتقسيمات والتعريفات. إلى اكتشاف السوريين لأنفسهم في إطار الدولة، ثم استحضار الماضي في محاولة إثبات الاستحقاقات. لماذا لم تحلّ المشكلة؟ وما الآفاق الممكنة لصناعة هوية وطنية سورية جامعة، في ظل المواطنة وشكل الدولة الحديثة؟
الهوية في ظلّ الدولة: من الاستعمار إلى الاستقلال
تُعد فترة الانتقال من الانتداب الفرنسي إلى تأسيس الدولة السورية الحديثة إحدى أهم المراحل التي شهدت محاولات حثيثة لتعريف “الهوية الوطنية السورية”. غير أن هذا التعريف لم يكن وليد توافقٍ اجتماعي شامل، بل كان في كثير من الأحيان نتاجاً لتحالفات سياسية، ومحاولات لصياغة هوية مستعجلة تحت ضغط الصراعات الإقليمية والدولية. إذ تضمنت هذه المرحلة ثلاثة مفاصل محورية:
الانتداب الفرنسي (1920–1946): تكريس الهويات الطائفية
بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى، وُضعت سوريا تحت الانتداب الفرنسي وفق اتفاقية “سايكس بيكو”. وبدلاً من تعزيز وحدة الأراضي السورية، لجأت فرنسا إلى تقسيم البلاد إلى كيانات طائفية ومناطقية من أبرزها دولة دمشق، ودولة حلب، ودولة العلويين، ودولة جبل الدروز.
هذا التقسيم لم يكن جغرافياً فقط، بل هوياتياً أيضاً. فقد تعاملت فرنسا مع السوريين كطوائف منفصلة، ومنحت بعض الأقليات امتيازات إدارية وعسكرية، مما ساهم في تعميق الحساسيات الطائفية، وأوجد شعوراً بالتمييز والارتياب المتبادل. أُفرغت فكرة الهوية الوطنية من مضمونها، وفُكك الرابط الوطني لصالح روابط طائفية ومناطقية مفتعلة. لم تكن “سوريا” كياناً سياسياً موحّداً، بل مجموعة وحدات محكومة من قبل سلطة استعمارية تُغذّي الانقسام.
الاستقلال وتأسيس الدولة الحديثة (1946–1963): الهوية العربية الواحدة
مع جلاء القوات الفرنسية عام 1946، دخلت سوريا مرحلة بناء الدولة الوطنية. لكن هذه المرحلة لم تُصاحبها عملية شاملة لإعادة بناء الهوية الوطنية بشكل ديمقراطي وتعددي، متجاوزٍ لتقسيمات الاستعمار، ومتبنٍّ لشكل الدولة الحديثة في تعريف المواطنة. بل تم القفز مباشرة إلى تبنّي هوية قومية عربية ذات طابع أيديولوجي، انطلاقاً من المزاج العام بعد الاستقلال، ومن صعود التيارات القومية في عموم العالم العربي. هذه الأيديولوجيا القومية اعتبرت أن العرب أمة واحدة، ذات رسالة خالدة، وأن “الوطن العربي” يمتد من المحيط إلى الخليج. وبالتالي، أصبحت الهوية الوطنية السورية جزءاً من مشروع قومي أوسع.
العروبة والإسلام: ازدواجية المرجعيات.
رغم سيطرة الخطاب القومي العربي، بقيت هناك مرجعيات إسلامية تقليدية في المجتمع السوري، لا سيما في المدن الكبرى (دمشق، حلب)، التي احتفظت بنفوذها الاجتماعي والديني، من خلال المؤسسات الشرعية، والعائلات الدينية المحافظة، ومدارس الأوقاف. لكن هذا التوازن بين القومية العربية والإسلام السياسي لم يكن مستقراً، فقد نشب توتر بين الطرفين، بلغ ذروته في مواجهات أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات، والتي انعكست لاحقاً على تعاطي الدولة مع الهوية.
وهكذا، لم تُبنَ الهوية السورية على أساس عقد اجتماعي جامع، بل كانت دائماً أداة بيد السلطة، تتشكل بحسب مصالحها السياسية والأيديولوجية. ما فاقم من هشاشة الشعور الوطني، وجعل الهوية القومية سريعة التشكّل، غير قادرة على احتواء جميع مكونات الشعب السوري.
مقاربة الفسيفساء والنسيج
لم يكن الفاعل السياسي خصوصاً بعد استيلاء حزب البعث على السلطة، مهتماً بالهوية الوطنية الجامعة في ظلّ المواطنة. بل سعى عبر تعريف المشكلة لترسيخها أكثر. لهذا علقنا أكثر من عقد في كلمات مثل “الفسيفساء السورية” و”النسيج السوري”. وأعدنا تدويرها مراراً، في تعريف السوريين أنهم مجموعات مختلفة عرقياً ودينياً يشكلون نسيجاً واحداً وكلّاً واحداً اسمه المجتمع السوري. استخدام مثل هذه السردية عمّق من فكرة التنوع، لا كشكل من أشكال الثراء تحت مظلة جامعة للسوريّين، بل كتقسيمات حادة، جغرافياً واجتماعياً، تستدعي إلحاق هذه الانتماءات بكلمة سوري في التعريف.
الإصرار على هذا الشكل من التنوّع، يكون خادماً للقضية (الهوية الوطنية الجامعة) بعد بحث المُشترَكات والمقتَسَمات والحقوق المدنية والتأكيد عليها. أما تبنّيه في غياب هوية وطنية، يدفعه لملء الفراغ، وتبنّي المفترقات والاختلافات وتركيز الضوء عليها. مع الوقت أخذ هذا الخطاب بالتسرّب إلى الوجدان والاستقرار في الحياة اليومية، حتى وصل إلى النكتة المحكية والحياة اليومية. التقسيمات المناطقية والعرقية والدينية، في بلادٍ لا يشبه ناسها بعضهم ولا يجمعهم فيها إلا جوازات السفر وبطاقات الهوية.
ما بعد 2011: الثورة وكيف ساهمت في صناعة سردية مشتركة
“واحد واحد واحد.. الشعب السوري واحد”.
يمكن للمراقب لهتافات الثوار واللافتات في الثورة السورية أن يدرك بسهولة أنّ الحس الوطني كان حاضراً في كل الأطياف. وقد كسر الحواجز المناطقية والطائفية. هذه اللحظة الجماهيرية العابرة للطوائف كانت نادرة في تاريخ سوريا المعاصر، وجسدت إمكانية بناء سردية وطنية جديدة تقوم على الانتماء إلى المواطنة لا الطائفة والانتماءات العرقية، ورفض الاستبداد والفساد، والمطالبة بدولة مدنية ديمقراطية، وإعادة تعريف “سوريا” كهوية تشمل الجميع.
رغم تنوع التوجهات والخلفيات، حاول الناشطون السوريون بطريقة ممنهجة كانت أو عفوية، أن يؤسسوا لسردية جديدة للهوية السورية، تتجاوز الهويات العرقية والطائفية القديمة. وتجلت هذه السردية في شعارات الثورة والهتافات، والفن الثوري متمثلا بالأغنيات والمرئيات، والتغطية الإعلامية التي قدّمت الثورة كحراك وطني ليس مقتصراً على أحد أو مقصياً لغيره. هذه السردية لم تكن فقط سياسية، بل ثقافية ووجدانية، تعكس حلماً سورياً مشتركاً بهوية وطنية مدنية، غير مسكونة بالخوف أو الولاءات الطائفية.
رغم هذه البداية الواعدة، واجهت الثورة تحديات عميقة شكّكت في مشروع الهوية الوطنية الجامعة. ففي مساهمةٍ من النظام لتحويل الثورة إلى صراع طائفي يورّط المحيط الإقليمي بأكمله، دفع بالتدخلات الخارجية القائمة على أساس طائفي وقدّم نفسه درعاً لحماية الأقليات، وساهم في تسليح فصائل منها. كما عقّد دخول داعش المشهد ككل.
أطلقت الثورة السورية أكبر نقاش جمعي في تاريخ سوريا الحديث حول معنى “الهوية الوطنية”. من حناجر المتظاهرين في درعا، إلى اللافتات في كفرنبل، وأغاني الفنانين في المنافي، تمت محاولة استرداد سوريا من براثن الطائفية والاستبداد. ورغم كل ما أصاب السردية الوطنية من تشويه، تبقى الفرصة قائمة لإعادة بلورتها، على أنقاض بلادٍ مدمّرة، وحلمٍ لم يمت تماماً.
ما هي المشكلة؟ صراع الانتماءات وتعريف النفس عبر الآخر
تتداخل انتماءات كثيرة وتساهم مجتمعةً في تشكيل هوية الفرد والجماعة، لكن المأزق يكون في دفع إحدى هذه الانتماءات نحو السطح واختزالها تعريفَ الهوية. تحدث هذه الظاهرة غالباً في نموذجين.
الأول، عندما يشعر الأفراد بتهديد يطال أحد انتماءاتهم حتى لو كان متخيّلاً. ففي أوقات الحروب مثلاً، يتحد المواطنون على اختلاف خلفياتهم تحت مظلة الدولة، لأن التهديد يوجَّه إلى المواطنة ذاتها، ما يجعل هذا الانتماء يطغى على سواه. ويُقاس على ذلك ما يحدث في الحروب الداخلية، حيث تشعر بعض الجماعات بالخطر، فتلجأ إلى التمسك الشديد بهوياتها الفرعية كوسيلة لحماية ذاتها.
الثاني، حين تسعى جماعة ما إلى تعريف نفسها نقيضاً لغيرها. ففي محاولة للتنصل من صفة ما تُنسب إلى أحد الانتماءات، تُبرز الجماعة أو الفرد الانتماء المناقض له، وكأنها تعلن عدم انتمائها للهوية الأوسع التي قد تضم النقيضين معاً. وبهذا، تُعيد الجماعة تموضع هويتها في مستوى أدنى لتأكيد الاختلاف، ونفي أي تقاطع مع الجماعة الأكبر.
مداخل لإعادة بناء الهوية الوطنية
أول مراحل فهم المشكلة هو الاعتراف بوجودها. فمشكلة تعريف السوريين لأنفسهم تتجاوز التنظير، وتعشش في السياسة والمتجمع والثقافة والتعليم والاقتصاد داخلَ البلاد وفي المهجر. ومما عمّق المشكلة بعد التحرير أن هذه التعريفات قد أُخذَت عن قصدٍ ودون قصد نحو مساحاتٍ لا تخدمها، وحُمّلت انتماءات لا تعنيها أيضاً في سياقها المعاصر. فصارت سوريا سوريّات كثيرة إلا سوريّتنا الحديثة.
يقتضي بناء هوية وطنية سورية جامعة مقاربة متعددة الأبعاد، تبدأ أولاً بترسيخ مبدأ المواطنة، الذي يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات على قاعدة الانتماء للدولة، لا على أساس الأصل القومي أو الديني. ويتطلب هذا إعادة النظر في بنيات الدولة ومؤسساتها، بما يضمن تفكيك منطق المحاصصة غير المعلنة، واستبداله بمنظومة حكم قائمة على العدالة، وتكافؤ الفرص، والشفافية.
ثانياً، تؤدي السياسات التعليمية والثقافية والإعلامية دوراً حاسماً في إعادة إنتاج تصورات الهوية الجمعية. فمراجعة المناهج التعليمية لتأكيد الرواية الوطنية المشتركة، والانفتاح على سرديات المكونات المختلفة، وتقديم سردية متوازنة للتاريخ السوري، تمثل شرطاً أساسياً لتجاوز الانقسامات. كما ينبغي للإعلام العام والخاص أن يتحول من منبر للاستقطاب أو التحيّزات إلى فضاء حرّ يخدم السوري لأنه سوري، ويرسّخ ثقافة العيش المشترك والانتماء المتعدد ضمن إطار وطني موحّد.
وأخيراً، لا يمكن تجاوز أزمة الهوية الوطنية دون مسار جاد للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، يعترف بالانتهاكات، ويكرّس العدالة بالمساءلة والمحاسبة، ويفتح المجال أمام بناء ثقة جديدة بين الدولة والمجتمع.
في المحصلة، إن بناء هوية وطنية سورية جامعة ليس خياراً ثقافياً فحسب، بل ضرورة سياسية وتاريخية لإنقاذ الدولة السورية من مزيد من التفتت. ويتطلب هذا المشروع التزاماً طويل الأمد، تشارك فيه النخب السياسية والفكرية، والمؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، لصياغة تصور وطني جديد يتسع لجميع السوريين على اختلاف انتماءاتهم، ويمنحهم شعوراً حقيقياً بالانتماء، والمساواة، والمصير المشترك.