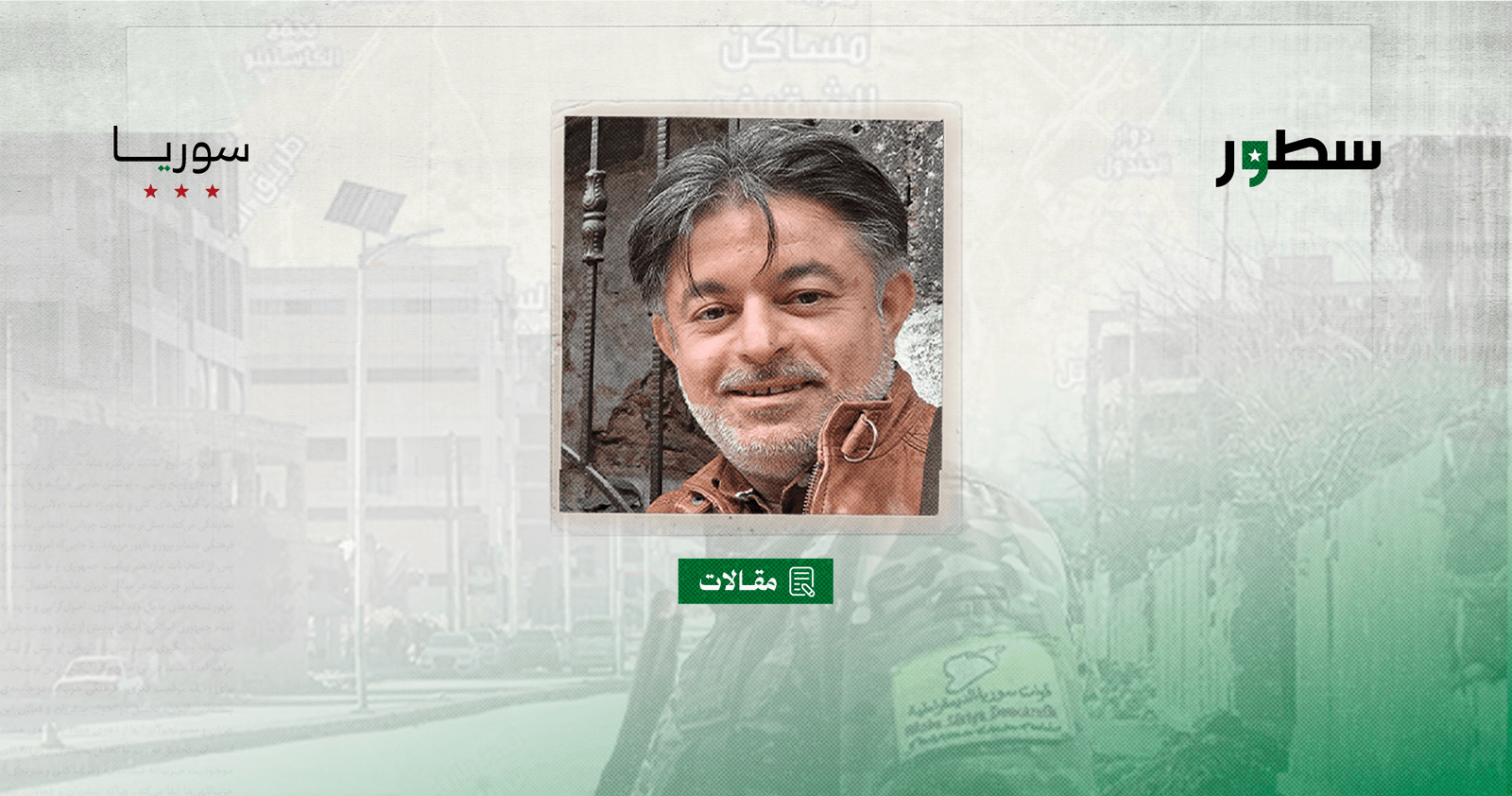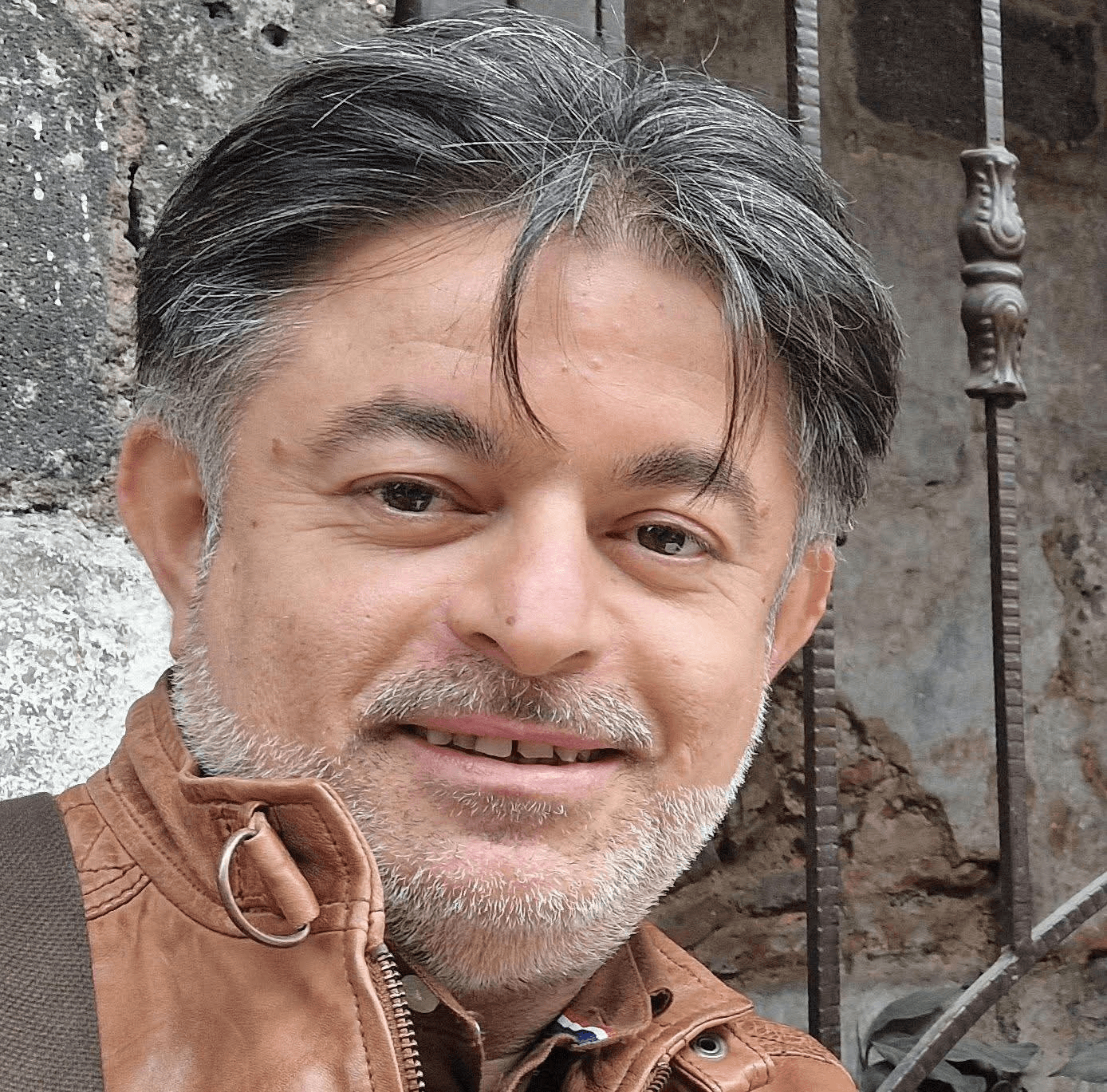مجتمع
التطبيل: ظاهرة تدمير الوعي وتشويه الحقوق في سوريا
التطبيل: ظاهرة تدمير الوعي وتشويه الحقوق في سوريا
– صلاح الدين الدباغ
في زمن يُعاد فيه بناء الدولة السورية، تتسلل ظواهر الماضي لتعيد إنتاج القمع بصور جديدة، ومن أخطرها ظاهرة التطبيل، التي لا تقتصر على التملق، بل تتجاوز ذلك لتصبح أداة لتكميم الأفواه وتزييف الوعي وتجميل القبح.
ما هو التطبيل؟
التطبيل هو المبالغة المفرطة وغير الموضوعية في مدح شخص أو جهة أو مؤسسة، وتقديمها على أنها فوق النقد ومعصومة من الأخطاء، غالباً بدافع التملق، تحقيق المصالح، أو الخوف من العقاب. وقد أخذ التطبيل اسمه من صورة قرع الطبول الصاخبة لجذب الانتباه والتأثير على العقول، حتى لو كانت الحقائق معاكسة تماماً.
التطبيل في السياق السوري
في سوريا، تحوّل التطبيل من مجرد ظاهرة خطابية إلى حالة شبه تشبيحية أحياناً، حيث لا يكتفي البعض بالتمجيد والتهليل، بل بالضغط على الناس لقبول خطاب التقديس وترديده، ومن أسباب شيوع هذه الظاهرة:
- الخوف من الملاحقة الأمنية أو الإقصاء الاجتماعي: في بيئة تهيمن عليها الأجهزة الأمنية، يصبح أي تعبير نقدي مخاطرة شخصية. كثيرون يخشون أن يُصنَّفوا “معارضين” أو “خونة” لمجرد انتقادهم بعض السياسات أو الشخصيات. هذا الخوف لا يقتصر على العقاب القانوني أو الاعتقال، بل يمتد إلى التهديد بخسارة الوظيفة، أو التضييق على العائلة، أو وصم الشخص اجتماعياً. لذلك يفضّل كثيرون المبالغة في المديح وسيلة حماية ودليل حسن نية.
- الطمع في منافع شخصية أو امتيازات مادية ووظيفي: التطبيل قد يكون وسيلة للوصول إلى مكاسب مباشرة: منصب إداري، ترقية وظيفية، استثناءات في القانون، أو تسهيلات اقتصادية. إذ يلجأ البعض للتطبيل كاستثمار نفعي، فيقدّم الولاء العلني والتهليل المبالغ فيه ليحصل على مقابل أو ليُثبت جدارته بالثقة والامتياز. في حالات كثيرة، يصبح التطبيل بمثابة “عملة” يتداولها أصحاب الطموح في بيئات تفتقر لمعايير النزاع.
- ضعف ثقافة النقد وغياب المساءلة: في سوريا، مثل كثير من المجتمعات التي خضعت لحكم مركزي صارم، لم تُبنَ تقاليد راسخة للحوار النقدي والمحاسبة. فظل النقد لفترات طويلة يُنظر إليه كتهديد للنظام أو عمل عدائي. مع الوقت، ترسخت ثقافة الصمت والتسليم، وتلاشت فكرة المساءلة الحقيقية. هذه الأرضية جعلت التطبيل يبدو “طبيعياً”، لأنه ينسجم مع غياب أي آليات لتقييم الأداء أو محاسبة المسؤولين.
- الانتماء الضيق والولاء العاطفي: كثيرون يربطون بين هوّيتهم الشخصية وانتمائهم السياسي أو الطائفي أو المناطقي. هذا الانتماء قد يصبح عاطفياً لدرجة يختفي فيها التمييز بين الولاء للجهة والدفاع عن الحقيقة. حين يشعر شخص أن انتقاد زعيمه أو مؤسسته هو إهانة له شخصياً، ويصبح التطبيل رد فعل دفاعياً، وطريقة لإثبات الإخلاص أمام الآخرين وأمام ذاته. في هذه الحالة، يقدّم الفرد “الولاء المطلق” كقيمة عليا على حساب الحقائق والمنطق
- الإعلام الموجّه الذي يكرس الرواية الواحدة ويجرّم الاعتراض: الإعلام الرسمي والموجّه أدى دوراً هائلاً في ترسيخ ظاهرة التطبيل، من خلال تقديم صورة مثالية بلا عيوب، ومنع تداول الروايات المختلفة. الأخبار والبرامج والاحتفالات تكرّر نفس العبارات والمدائح، وتصور كل نقد خيانة أو مؤامرة. مع الزمن، تتشكل بيئة معرفية ضيقة، لا يجد فيها الناس إلا خطاباً واحداً يصفق للسلطة، فيعتادون على هذا النمط ويعيدون إنتاجه تلقائياً.
الآلية النفسية التعويضية في المرحلة الانتقالية
في سياق التغيرات والصراعات، كثيرون ممن عانوا ظلماً أو تهميشاً في حقب سابقة يشعرون بأن قربهم من السلطة الجديدة أو جهة صاعدة تعويض عن ماضيهم. فيلجؤون إلى التطبيل وكأنه إعلان انتصار شخصي، أو إثبات أنهم اليوم في موقع قوة، وكأنهم “يستعيدون اعتبارهم” الذي سلبه النظام القديم. هذا الجانب النفسي يجعل بعضهم يتبنّى خطاب التقديس بحماس يفوق حتى أصحاب الامتيازات المباشرة، في محاولة لإغلاق جراح الماضي بالانتماء إلى القوة الجديدة.
التطبيل حالة تشبيحية
التطبيل كحالة اجتماعية هو ظاهرة تتحوّل فيها المبالغة في المدح إلى سلوك جماعي ضاغط يفرض على الناس ترديد خطاب التمجيد بلا تمييز. في هذه الحالة، لا يقتصر الأمر على مجرد تملّق طوعي، بل يصبح التطبيل بمثابة عرف اجتماعي أو التزام غير مكتوب يضغط على الأفراد للانصياع له.
يتحوّل التطبيل هنا إلى أداة تشبيحية، أي إلى سلوك يهدف إلى إرهاب الأصوات المستقلة، بحيث يُتّهم كل من يعبّر عن رأي نقدي بالخيانة أو قلة الولاء. يتم تخوين أي نقد وتصويره كعداء للوطن أو المجتمع، فيُجرّم الاعتراض، ويُدفع الناس لترديد عبارات التقديس حتى لو لم يقتنعوا بها.
هذا الجو الاجتماعي المغلق يخلق مناخاً أحادي الرأي، فتضيع الحقيقة، وتختنق المساحة العامة للتفكير الحر، ويصبح الناس أسرى نمط سلوكي يقوم على التظاهر بالولاء والمبالغة في المدح، خوفاً من العواقب أو طمعاً في الامتيازات
التأثيرات الخطيرة لظاهرة التطبيل
هذه الظاهرة تفرز نتائج كارثية على كل المستويات فعلى المستوى الإداري تفرز تجميد الإصلاح، فعندما يسود التطبيل، يفقد المسؤول أو المؤسسة القدرة على تلقي النقد البناء. فلا أحد يجرؤ على الإشارة إلى الأخطاء أو القصور. وهكذا تُصوَّر القرارات دائماً على أنها صائبة وعظيمة حتى لو كانت مليئة بالثغرات. ومع غياب النقد والمحاسبة، تتوقف أي محاولات إصلاح حقيقية، لأن الإصلاح يتطلب الاعتراف أولاً بوجود أخطاء ونواقص. في بيئة التطبيل، هذا الاعتراف يُعد عيباً أو تهديداً للهيبة، فتظل المشكلات قائمة وتتعفن المؤسسات.
وعلى المستوى الاقتصادي تؤدي إلى إهدار الموارد فالخطط والمشاريع تُضخّم إعلامياً وتُقدّم على أنها نجاحات خارقة، في حين قد تكون هشة أو غير مدروسة أو بلا مردود فعلي، وبسبب غياب النقد والرقابة يهدر المال العام على مشاريع استعراضية هدفها التباهي وإرضاء الخطاب الرسمي، لا لتلبية احتياجات الناس. ومع الوقت، يتعمق العجز المالي وتتآكل الثقة بالاقتصاد لأن الواقع ينكشف مهما طال الزمن، فيظهر أن جزءاً كبيراً من الموارد ذهب في تضخيم الإنجازات الوهمية.
وعلى المستوى الاجتماعي تتعمق الفجوة بين السلطة والناس، فحين تروج السلطة أو المؤسسات لنفسها عبر التطبيل المبالغ فيه، بينما يعاني الناس واقعاً صعباً، تتسع الفجوة بين الخطاب الرسمي وتجربة المواطن اليومية، ويشعر الناس بالإحباط والاحتقار والاغتراب عن الدولة أو الإدارة ويصبحون مقتنعين أن صناع القرار يعيشون في عالم منفصل لا يهمه إلا المظاهر. ومع تكرار هذا المشهد، يتكرس الإحباط الجماعي ويضعف التماسك الاجتماعي وتختفي الثقة.
وعلى المستوى الأخلاقي والحقوقي تُقتل قيمة العدالة، حين يخطئ مسؤول أو مؤسسة بحق المواطنين ثم يُطبّل لهم وكأنهم فوق المساءلة، يفقد الناس إيمانهم بالعدالة، ويصبح الظلم سلوكاً طبيعياً لأنه لا يُحاسَب، بل يُكافَأ بالمديح والتقديس وتتحول معايير الإنصاف إلى شعارات فارغة، وبدلاً من أن يكون الخطأ سبباً للمحاسبة أو الإصلاح، يصير مناسبة للاحتفال والتمجيد، فينعدم التوازن الأخلاقي وتُشرعن الانتهاكات.
أما على المستوى الثقافي والمعرفي يفسد الوعي وتتشوه المعايير إذ يؤدي التطبيل المستمر إلى تزييف الوعي العام، ويُربّى الناس على تصديق الخطاب الواحد ورفض أي تفكير نقدي، لتتحول المبالغة في التمجيد إلى قاعدة لا يمكن الطعن فيها، وتغيب الموضوعية تماماً، فينشأ جيل كامل يعتقد أن الولاء يعني التقديس المطلق، وأن النقد خيانة، ويتراجع مستوى التفكير الحر والمساءلة. على المدى الطويل تضعف القدرة على التمييز بين الحقيقة والزيف ويقضي على ثقافة الحوار.
نماذج من دول مارست التطبيل وأثّر ذلك عليها
في التاريخ الحديث، التطبيل المفرط كان مشتركاً بين أنظمة سقطت بعد أن أغرقتها دعايتها في الوهم. هذه أبرز الأمثلة :
1ـ سوريا في عهد الأسد الأب والابن
منذ وصول حافظ الأسد إلى الحكم عام 1970، جرى بناء صورة القائد الضرورة الذي “حقق الاستقرار وحمى البلاد”. الإعلام الرسمي والأجهزة الأمنية عممت خطاب التمجيد، وصار الأسد يُقدّم باعتباره قائداً تاريخياً لا يخطئ، وصاحب الفضل في كل منجز، واستُخدم التعليم والإعلام لتكريس هذا التقديس. ومع انتقال السلطة إلى بشار الأسد، استمر التطبيل بل زاد في بعض المراحل، بحيث صار أي انتقاد للسياسات الداخلية أو مطلب للإصلاح مساساً بكرامة الدولة وخيانة وطنية.
عندما اندلعت الثورة السورية ضده عام 2011، اعتبر الإعلام الرسمي أنها “مؤامرة كونية”، واستمر في تقديم صورة النظام كمنقذ للشعب رغم تصاعد الأزمة. خُوِّن أي صوت مستقل، وقُمِع النقد بعنف. أدى هذا التطبيل المستمر إلى عجز تام عن الاعتراف بالمشكلات الحقيقية (الفساد، التهميش، غياب العدالة)، فاستمرت الأزمة سنوات طويلة وتحولت إلى حرب مدمرة.
2ـ كوريا الشمالية
منذ تأسيسها، قام نظام كوريا الشمالية على عبادة شخصية الزعيم (كيم إيل سونغ ثم ابنه وحفيده). الدعاية الحكومية صوّرته على أنه قائد شبه إلهي، وجرى إلزام الناس بالاحتفال والتمجيد في كل المناسبات، وأي انتقاد أو حتى عدم إظهار الحماس في التطبيل يعاقب بالسجن أو الإعدام. النتيجة كانت عزلة تامة عن العالم وفقراً مدقعاً يعيشه معظم السكان رغم أن البلد يملك موارد طبيعية يمكن أن تؤهله لوضع اقتصادي جيد، وصار التطبيل غطاءً دائماً لفشل الإدارة وقمع الناس.
3ـ الاتحاد السوفييتي في عهد ستالين
ستالين قاد حملة واسعة لتقديس صورته باعتباره “الأب الحكيم للشعوب السوفيتية”. الإعلام والفنون والتعليم كانوا مجنّدين لتقديمه كقائد ملهم. التطبيل لم يكتفِ بإخفاء الجرائم، بل صنع رواية مزيفة عن النجاح المطلق. نتيجة ذلك، تعرض الملايين للموت في حملات التطهير والمجاعات (مثل مجاعة أوكرانيا) وقُمِعَ أي تفكير حر أو نقد. حين انهار الاتحاد السوفييتي لاحقاً، ظهرت الحقائق الصادمة عن حجم القمع الذي أُخفي وراء الدعاية الممجدة.
4ـ العراق في عهد صدام حسين
صدام حسين قدّم نفسه كبطل قومي وتاريخي، وروّج عبر الإعلام صورة القائد المنقذ الذي لا يخطئ، ولم يكن ممكناً لأي وسيلة إعلام أو كاتب أن ينشر نقداً أو حتى إشارة إلى القصور، وخضعت كل مؤسسات الدولة لخطاب التطبيل، الذي برر مغامرات عسكرية كارثية (كالحرب على إيران وغزو الكويت)، التي جلبت لاحقاً الحصار المدمر على الشعب العراقي والانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وعند سقوط النظام، انكشف التناقض الهائل بين الصورة الدعائية والواقع المأساوي.
5ـ ليبيا في عهد القذافي
القذافي صنع لنفسه صورة الزعيم صاحب “النظرية العالمية الثالثة”، وروّج أنه مفكر عبقري وقائد تاريخي. الإعلام والتعليم والكتب المدرسية كلها كانت تمجد القذافي وتفرض تقديسه على المجتمع، ولم يكن الاعتراض أو حتى التساؤل عن جدوى سياساته ممكناً، وفي النهاية، أدت سنوات القمع والتطبيل إلى تراجع مؤسسات الدولة، وخلق فجوة عميقة بين النظام والمجتمع، وحين اندلعت الانتفاضة انهارت البلاد بسرعة ودخلت في فوضى طويلة.
والقاسم المشترك بين هذه التجارب أن النتيجة النهائية لهذه التجارب وغيرها الكثير كانت الخراب والدمار وسقوط الأنظمة بعد أن استنفدت قدرتها على خداع الناس
نحو بناء دولة حديثة قائمة على الحقوق والحريات
لكي نؤسس دولة حديثة تحترم الإنسان وتبني نهضة حقيقية، لابد أن نفهم أن التطبيل ليس مجرد رأي إيجابي، بل مرض جماعي يدمّر القيم والمؤسسات فكثيرون يظنون أن التطبيل هو مجرد “حماس” أو “حب للوطن أو القائد”، لكن في الحقيقة هو حالة مرضية تشبه العدوى الجماعية، لأنه يفرض رواية واحدة ويمنع التفكير النقدي، فتتآكل القيم الأساسية مثل الصدق، النزاهة، احترام الحقائق. مع الوقت، يتحول هذا النفاق العام إلى نظام حياة، فيصبح الموظف مضطراً لتطبيل لرئيسه، والمواطن مضطراً للتطبيل للمسؤول، والإعلام مضطراً لتزييف الوعي. وهكذا ينهار جوهر المؤسسات التي لا تقوم إلا على الصدق والمحاسبة.
وأن نفهم أن احترام الشخص أو المؤسسة لا يعني تبرير أخطائهم أو إخفاء تجاوزاته فلا يوجد إنسان معصوم، ولا مؤسسة كاملة. في المجتمعات السليمة، يتم التفريق بوضوح بين احترام المكانة والحق في المساءلة. يمكنك أن تحترم رئيس الدولة أو أي شخصية عامة وتقدّر إنجازاته، لكن دون أن تمنحه شيكاً على بياض أو تبرر أخطاءه مهما كانت جسيمة. التطبيل يخلط بين الاحترام والتقديس، فيجعل الخطأ فضيلة والتقصير إنجازاً، وهذا أخطر ما يهدد مستقبل أي مجتمع.
المجتمعات التي ازدهرت هي التي شجعت على النقد البنّاء والمحاسبة العادلة
كل التجارب الناجحة (مثل الدول الاسكندنافية، وكندا، وألمانيا الحديثة) قامت على الشفافية وتشجيع النقاش العام واحترام النقد. عندما يشعر المواطن أنه يستطيع مساءلة المسؤول بلا خوف، تتحسن القرارات ويكبر الإحساس بالمسؤولية، لأن السلطة تدرك أنها خاضعة للرقابة الشعبية، أما حين يصبح التطبيل هو القاعدة، فإن ذلك يطرد الكفاءات، ويكافئ المنافقين، ويقود إلى الفشل مهما توفرت الموارد.
من حق الشعب محاربة التطبيل لأنه يؤذيه ويهدد مستقبله والشعب هو أول من يدفع ثمن وهم التمجيد والتقديس ويُحرم من معرفة الحقائق حول السياسات والمشكلات ويتعرض للفساد والظلم لأن من يُطبّل لهم لا يُحاسبون. كما أنه يفقد ثقته بالدولة والمؤسسات، وتضيع حقوقه لأن الإعلام لا ينقل صوته الحقيقي فيما يعيش أجياله القادمة في بيئة مريضة تعتبر النفاق فضيلة والنقد خيانة. لذلك من حق الناس، بل واجبهم، أن يكسروا دائرة التطبيل.
من حق الشعب أن يعرف الحقيقة مهما كانت صادمة
المواطن ليس قاصراً يحتاج إلى “تجميل الواقع”، بل هو صاحب الحق الأول في الحقائق. عندما تحجب الحقيقة باسم “الوحدة الوطنية” أو “عدم الإحباط”، يتحول التعتيم إلى أداة لتبرير الإخفاق. الشفافية شرط أساسي للنهوض.
كيف يحمي المجتمع نفسه قانونياً من ظاهرة التطبيل؟
وضع ضمانات دستورية بتضمين الدستور مواد صريحة تحظر تمجيد الأشخاص والمؤسسات بشكل يقيّد النقد من خلال نصّ دستوري يقرر أن “حرية التعبير والنقد مكفولة ولا يجوز تقييدها أو تجريمها أو معاقبة صاحبها إلا إذا تضمنت تحريضاً على العنف أو الكراهية”، ومادة تقول إن “الدولة ومؤسساتها وموظفيها ليسوا بمنأى عن النقد والمساءلة، وكل شخص أو جهة تعيق ذلك تخالف الدستور”. وتجريم أي محاولة لتقديس الزعماء أو المؤسسات أو رفعهم فوق المساءلة (مثلما حدث في سوريا حين اعتُبرت “هيبة القيادة” مقدسة).
كما يجب ضمان حق المواطن في الوصول إلى المعلومات العامة، حتى لا يُستخدم التعتيم الإعلامي ذريعة للتمجيد، وسن قوانين مكافحة التطبيل السياسي والإعلام، وقانون يحظر استخدام المال العام أو المنابر الرسمية (التلفزيون الحكومي، الوزارات) للدعاية الشخصية لصالح مسؤولين أو سياسيين.
ونص قانون يعاقب أي وسيلة إعلامية تتعمد ترويج صورة القائد المخلّص أو الزعيم الأسطوري بهدف تضليل الرأي العام، وتحديد غرامات مالية أو عقوبات إدارية بحق المؤسسات أو الأفراد الذين يثبت تورطهم في حملات تمجيد مبنية على الأكاذيب، وإلزام وسائل الإعلام بوضع تنويه عند نشر مادة دعائية أو ترويجية كي لا تلتبس بالدعاية الموضوعية.
هذه القوانين ستردع التمجيد الممنهج وتفرض معايير مهنية على الإعلام الجديد وتمنع انزلاقه إلى ما يشبه إعلام المرحلة السابقة
إقرار حق المساءلة والمحاسبة
إتاحة آليات قانونية واضحة لمحاسبة أي مسؤول أو جهة تمارس الدعاية التضليلية أو تمنع النقد من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة (مثلاً هيئة النزاهة والشفافية) تتلقى الشكاوى حول حملات التطبيل الممنهج، وتراقب وسائل الإعلام الرسمية، وتصدر تقارير سنوية عن التزام المؤسسات بالشفافية، وتضمن حق أي مواطن أو منظمة مجتمع مدني في رفع دعوى قضائية على أي مسؤول يستخدم سلطته لقمع النقد أو إجبار الناس على التمجيد.
وتجب حماية القضاء من التدخلات السياسية حتى يبتّ في قضايا التلاعب بالرأي العام بحياد، ليشعر كل مواطن بوجود باب مفتوح للمحاسبة فلا يضطر للرضوخ للتطبيل أو النفاق حمايةً لنفسه.
حماية الناشطين والمبلغين
النشطاء والصحفيون والمبلغون عن الفساد هم الخط الدفاعي الأول ضد التطبيل. إذا لم يشعروا بالأمان، سيصمتون، ولا بد من سن قانون خاص يضمن حماية المبلغين عن الفساد والمخالفات الإعلامية فيمنع ملاحقتهم قانونياً بتهم ملفقة مثل “تشويه سمعة الدولة”، ويضمن سرية هويتهم إذا طلبوا ذلك، ويفرض عقوبات صارمة على أي جهة تهددهم أو تعتدي عليهم، كما يجب إقرار نصوص قانونية تكفل للصحفيين حرية الوصول إلى المعلومات دون عقبات بيروقراطية، وتشكيل وحدة شرطة خاصة لحماية الصحفيين والنشطاء المهددين بالعنف.
كل ذلك سيشجع المواطنين على كشف الحقائق، ولن تكون لديهم خشية من انتقام الجهات التي يسعون لكشف تلاعبها.
ختاماً
لا يمكن تصور نهضة حقيقية في أي بلد دون الشجاعة الجماعية لقول الحقيقة. التطبيل أسوأ عدو للحقوق والحريات والتطور. إن واجب كل من يطمح لبناء سوريا حديثة أو أي دولة عادلة أن يعمل على كسر دائرة التطبيل واستعادة صوت النقد والوعي والضمير.