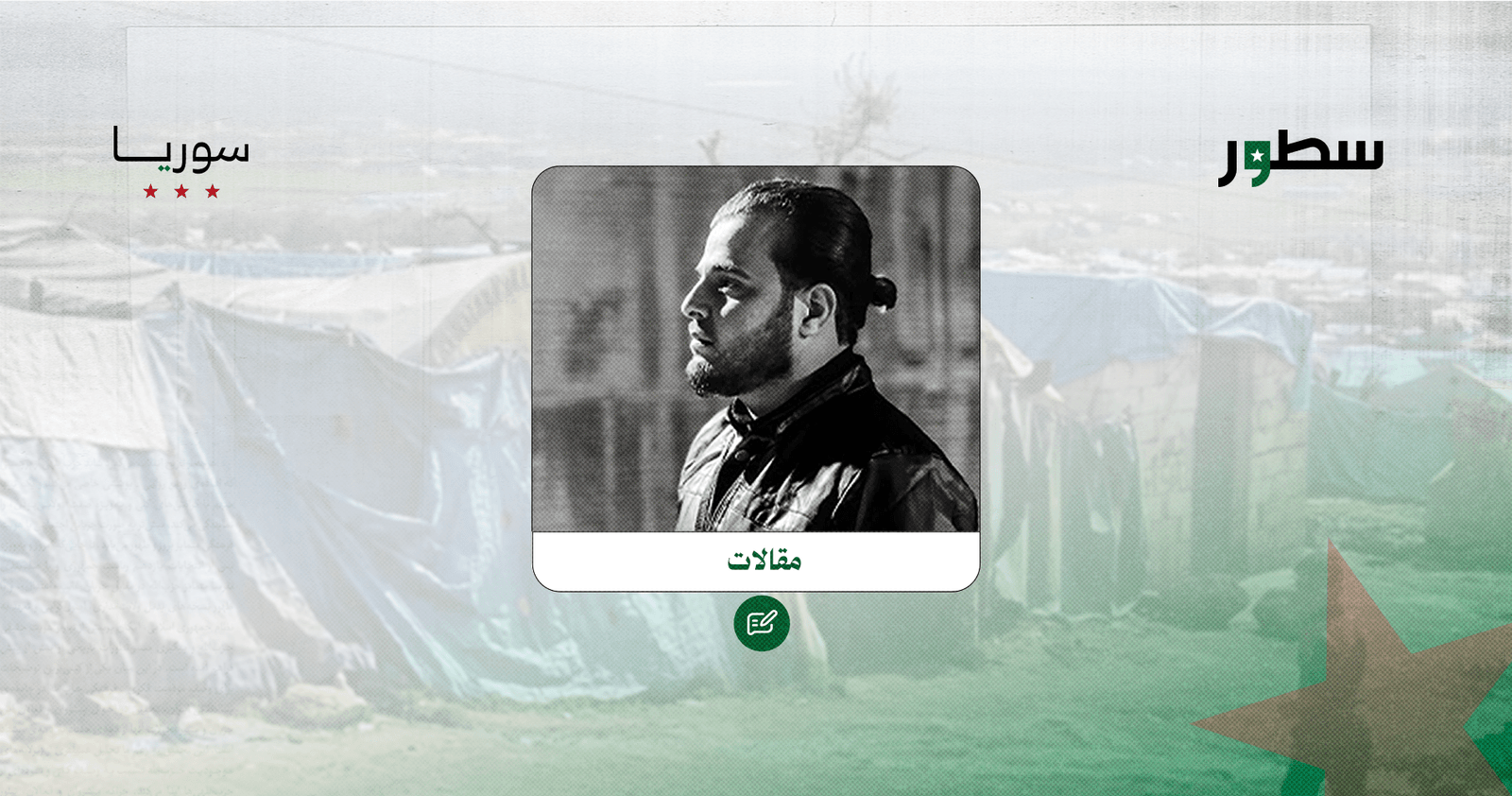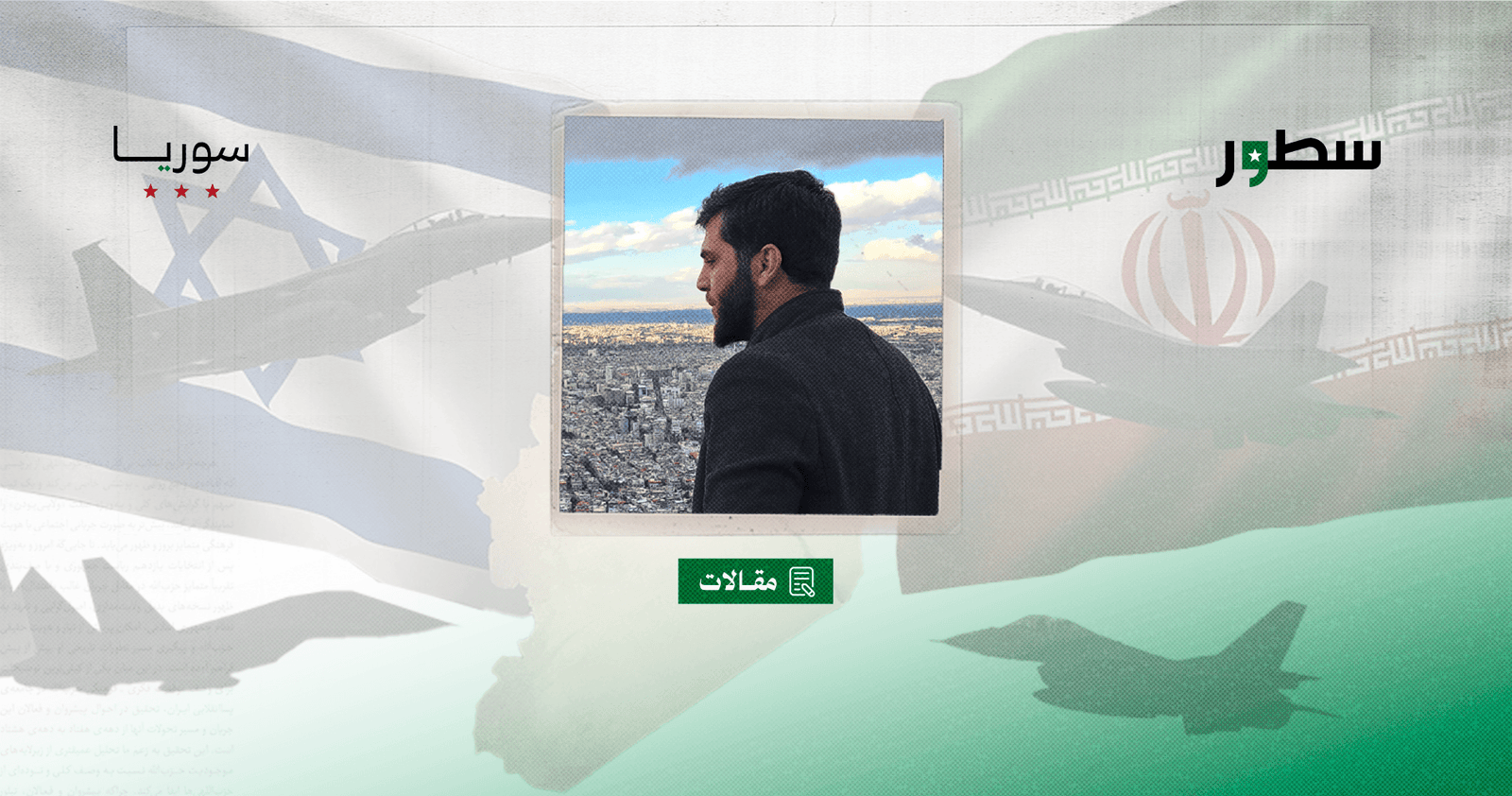مجتمع
حين زال الأسد.. لم يعد الوطن
حين زال الأسد.. لم يعد الوطن
مع كل مرّة يُقال فيها إنّ حكم نظام الأسد سقط، أخرج رأسي من نافذة الكتلة الإسمنتية بمخيمنا شمال سوريا، أنظر منها إلى قريتي، وكأنني أشاهد السقوط هناك وحده وما يعنيني، فرغم فرحتنا بزوال طاغية إلا أننا نقيس ذلك بمدى اقترابنا من العودة الحقيقية للوطن، العودة إلى منازلنا التي لم تُقصف لكنها سقطت على الأرض بحقد طائفي بداية تهجيرنا عام 2019 من ريف إدلب الجنوبي، فلم تكن القذائف هذه المرّة العدو الأول لنا بل أيادي الحقد التي اقتلعت الشجر وسرقت الحجر، دافنةً حكايات الناس وذكرياتهم في تلك الأرض، ثم قالوا لنا عودوا إن استعطتم.
لم نكن يوماً ضعفاء نتحدث بهذه الغصّة، بل لأن العودة صارت حلماً مستحيلاً بوجود هذه الظروف، فالحياة على ضفة الموطن الحقيقية باتت غير موجودة أصلاً، فلا بنى تحتية ولا كهرباء ولا ماء ولا حتى رائحة الوطن، فلم يبق سوى أسماء مدن وبلدات وقرى على خرائط باهتة ذابلة تتناقلها نشرات الأخبار بخجل، ثمّ تمّر كما تمر الخيبات.
الحقيقة أنني لم أكتب عن هذه اللحظة من قبل، ليس عجزاً بل لأنني ظننت أنّ هذه الكتابة خيانة للحلم، دوماً ما كنت أخبر الناس بأننا سنعود كلما تسرّب المطر إلى داخل الخيمة الأولى، أو عندما كنت أسمع جاراً لي يسأل نفسه لماذا لا أستطيع شراء منزل حقيقي؟
فأبتسم بخجل وأقول له إنّ كل شيء سيعود وستصبح الأمور على ما يُرام، وها أنا اليوم أكتب، لا لأنهي هذا الوعد، لكن حتى أعلن أننا نحن الذين انتظرنا كُتب علينا ان نبقى وسط الطريق، فقط مهجري المخيمات، كأنهم الصفحة التي نسيها التاريخ حين قلب فصوله.
لم أعد أفكّر بالعودة وحدي، بل أفكر بها كواجبٍ ثقيل، كأمانة أختنق بها حين أسمع عبارة “سقط الطاغية” فالحقيقة التي يعيشها مهجرو الشمال السوري تقول إنّ ما سقط هناك لم ينهض هنا، لا شيء عاد، لا الناس، لا البيوت، فقط نحن من بقينا ننتظر، نكتب، ونعدّ ما تبقى لنا من الأيام على أمل ألا تموت فينا الذاكرة قبل أن نلمس التراب مقيمين لا زائرين لأراضينا وكأنها معلم أثري!
عندما انتهت معركة ردع العدوان بعد وصول الثوار من شمال سوريا إلى دمشق في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، ظهر المشهد كأننا أمام كتابة تاريخ جديد لسوريا، فلم يكن حدثاً عادياً، بل كان بالحقيقة تتويجاً لسنوات من الصمود والدم، إذ لم يتخيل أحد أنّ ذلك النظام المجرم الذي أغرق البلاد في الدم والتدمير والتهجير، سيسقط على يد من خرجوا عليه قبل أكثر من عقد، لا بقرارات دولية ولا بتسويات فوقية بل بالسلاح نفسه الذي كان يطاردنا من حي إلى آخر ومن قرية لأخرى.
في خيام الشمال، لم تكن النشوة أقلّ من الجبهات، كثيرون ظنّوا أنهم سيستيقظون في صباح قريب وهم يجهّزون أنفسهم للعودة إلى مدنهم وقراهم، كنت ترى الدموع في عيون الشيوخ حين سمعوا أن “أبناءنا وصلوا إلى ساحة العباسيين”، والفرحة المرتبكة في وجوه الأمهات، كأنهن لا يعرفن من أين يبدأن توضيب الأمل، وأحاديث العودة بدأت تتصاعد، بشكل عفوي، متوتر، ومليء بالتفاصيل، من سيذهب أولاً؟ من بقي بيته صالحاً؟ هل سنحتاج لترميم أم لبناء جديد؟ بل إن بعض الأهالي في ريف إدلب الجنوبي بدؤوا يزورون صور بيوتهم القديمة، يتفقدونها على غوغل إيرث، كما لو أن المسافة أصبحت أخيراً قابلة للقياس.
لكن شيئاً ما انكسر بعد النصر، فبعد سقوط النظام في معركة “ردع العدوان”، لم تأتِ خطط واضحة، ولا مشاريع إعمار، فقط وعود مؤجلة وخطابات عن “إعادة ترتيب الداخل” و”المرحلة الانتقالية”، فيما غاب المهجّرون عن المشهد، وكأنهم لم يكونوا يوماً في قلب الثورة، بل حالة طارئة تُركت على الهامش.
صرنا نرى النصر سياسياً، لا شعبياً، لا يعيد البيوت ولا يعوّض الكرامة، فقط يفتح أبواباً جديدة للسلطة، ويغلق أبواب الأمل التي انتظرناها سنين، وبصفتي كاتباً وصحفياً عشت هذا الطريق بكل تفاصيله، أعلم أن الصمت الذي تلا النصر كان أقسى من الهزيمة، أن تُنسى قريتنا، وتُؤجَّل عودتنا، ونُعامل كأننا كنا مجرد أرقام، لا أصحاب حق، فصرنا نعدّ الخيبات بدل اللحظات، وهذه المرة، لا نملك أن نحمّل الطاغية المسؤولية فهو طاغية ومستبد، بل من جاء بعده معه آمالنا، ولم ينظر إلينا حتى الآن.
صحيح أن إدارة دولة خارجة من حرب طويلة ليست أمراً بسيطاً، وصحيح أن تأمين العاصمة والمفاصل السيادية أولوية، لكن من غير المنطقي أن تبقى هذه المخيمات خارج الحسابات، دون رؤية أو خطة واضحة، المهجرون اليوم لا يطلبون امتيازات، بل الحد الأدنى من الاهتمام، فهم ليسوا مجرد متلقّين للمساعدات، بل شركاء في الثورة، وكانوا دوماً جزءاً من النسيج السياسي والاجتماعي الذي صنع هذا التحوّل، وهم حتى هذه اللحظة يحملون الهم في البناء في كل دوائر الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإعلامية وكل شيء، لا ينامون لإعادة هيكلة المؤسسات التي كانت تحت سيطرة الأسد المليئة بالفساد وإصلاحها وترميمها معتبرين أنّ الوطن يحتاج الكثير رغم وجود ذويهم بالمخيمات حتى هذه اللحظة!
الأسئلة المطروحة الآن كثيرة: هل هناك نية حقيقية لإعادة المهجّرين إلى قراهم؟ هل وُضعت ميزانيات لإعادة إعمار المناطق المهجورة في ريف إدلب الجنوبي وحلب الغربي وغيرها؟ من يتحدث باسم هؤلاء الناس في مؤسسات الحكم الجديدة؟
ما لم تتم الإجابة على هذه الأسئلة، فإن شعور الخذلان سيتزايد، حتى في لحظة يُفترض أن تكون ذروة الأمل، المرحلة الانتقالية لا يجب أن تُبنى فقط على رمزية إسقاط النظام، بل على إعادة الاعتبار لكل من ناله ظلم هذا النظام، وأولهم من هجّرتهم آلة الحرب، فصاروا غرباء في وطنهم، ينتظرون من ينظر إليهم لا بعين الشفقة، بل كأصحاب حق يجب أن يُعاد إليهم، ولو جزء بسيط مما فُقد.
اليوم، أكتب وأنا لست في بيت كامل، ولا في غرفة دافئة، بل على أرض متواضعة تحت سقف مؤقت، وكل من حولي ينتظر شيئاً لم يتّضح بعد، لا مفاصل حياة، لا خطة واضحة للخروج من هذا الواقع، فقط وعود مؤجلة، وتصريحات عامة، وخدمات تتقلّص بدل أن تتمدّد، فيما تُنقل المشاريع والاهتمام نحو المدن المحررة حديثاً، وكأن المناطق التي قاومت من اليوم الأول باتت أقل أولوية، أو كأن الثورة بدأت هناك، لا هنا.
في لحظة ما، سألت نفسي: هل ما أكتبه الآن هو استمرار لما بدأته منذ سنوات؟ أم أنني تحوّلت من راوٍ للحلم إلى موثّق للخذلان؟ هل تكفي الكلمة اليوم؟ وهل نملك ترف التأمل أصلاً؟ كل قصة أسمعها من سكان الخيام صارت تكراراً للمأساة، دون أي طاقة تُدفع نحو أمل واضح.
هل أصبحنا نكتب فقط كي لا تُنسى الحكاية؟ أم لأننا لا نملك سلاحاً آخر؟ ربما لم يعد الوطن كما نعرفه، وربما باتت الذاكرة عبئاً نحرص عليه فقط لأننا لا نملك شيئاً سواه، فهل هذا يكفي؟ هل نكتفي بأن نكون حُرّاساً لذكرى وطن لم يعد، أم علينا أن نخلق شيئاً جديداً، نُرمم به ما تبقى، لا بالحبر فقط، بل بالفعل؟ أسئلة أطرحها من مكاني هذا، لا من برج ولا من قاعة، بل من منزل يُطلق عليه كتلة أسمنتية مؤقتة، يُقيم على أطرافه وطن لا أحد يعرف شكله بعد.