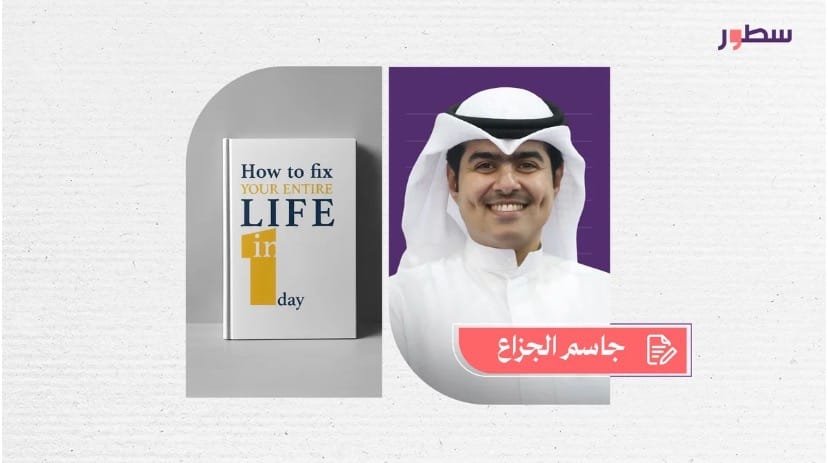آراء
عدالة لا يُهدرها الفرح بالمصيبة!
عدالة لا يُهدرها الفرح بالمصيبة!
حين يعجز الإنسان عن تحصيل العدالة بعد الظلم، لا يعود جرحه مقتصرًا على ألمّ بذاته، بل يتصدّع إيمانه بالعالم نفسه، يصبح كل تأخرٍ في الإنصاف نفيًا ضمنيًا لفكرة أن هذا الكون محكومٌ بقانون أخلاقي أو غيبي ينتصر للمظلوم، وربّما نفيًا للإيمان بوجود الخالق نفسه “أعرف أنني مظلوم، إن لم ينتصر ليَ الله فكيف يكون عدلاً؟” يقول لنفسه. في هذه الهوّة، تولدُ الحاجة إلى الشماتة، لا بدافع القسوة أو فقد البوصلة الأخلاقيّة/الإنسانيّة، بل كاستجابة متوهّمة تحاول ترميم صورة العدالة المحطّمة في عينيه ونفسه، وتجنيبه السقوط الأخير .
يتعامل العقل البشري مع الظلم بما يتجاوز واقعيته، فحين لا يحصل المظلوم على إنصاف، يبحث لاشعوريًا عن رموز بديلة لذلك الإنصاف، موت الظالم هنا لا يكون حدثًا محايدًا، بل يُحمّل بتأويلات رمزية تُسهم في استعادة بعض من الاتزان النفسي. في علم النفس، يُعدّ هذا الميل نمطًا من “التأكيد الزائف للعدالة”، أي محاولة استعادة السيطرة على الواقع من خلال نسب الأحداث لقناعات متوهّمة غالبًا: “دعوة مظلوم استُجيبت”، “السماء لم تنسَ”، أو “الكون يُصفّي الحساب”، وهذا كلّه قد يوفّر للمظلوم تنفيسًا مؤقّتًا وأمانًا متوهّمًا دون أن يحقّق له أي شيء، فلا حقّ عاد ، ولا ظالم عوقب، ولا عدالة تحقّقت.
ففي اللحظة التي يفرح فيها المظلوم بمصيبة من ظلمه، يُستعاد وهمٌ بأنّ صورةً من العدالة تحقّقت، هذا الوهم على دوره المهدّئ (كالمخدّرات تمامًا)، قد يكون بوابةً إلى القعود، فالمأساةُ أن تتحوّل الشماتة إلى بديل للفعل، ويُصبح انتظار العقاب الغيبي بديلاً عن النضال، ساعتها يتحوّل الأمل في السماء إلى ذريعة لمخالفة تعليماتها، والتهرّب من مسؤوليّة كلّ تجاه واقعه، وتجاه السماء ذاتها.
فربط الأحداث الطبيعيّة كالموت والزلازل والحرائق مثلاً، بالسماء مجرّدة-بالله أقصد- دون القيام بالدور في مواجهة القهر، تحريفٌ للإيمان في غالب تصوّراتنا النظريّة عنه، لا إيمانًا به؛ فالدين نفسه لا يتوقّف عن التكرار والإلحاح: “وقل اعملوا”، و”إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم”، “وأعدّوا لهم ما استطعتم” …إلخ، أمّا انتظار السماء أن تنتصر لنا أو نيابةً عنّا هو خيانةٌ للعهد معها-مع الدين أو الله أقصد، وتنكّر لحقيقة مبررات خلق الإنسان وإنزاله من الفردوس.
فوكو- من منظور فلسفي، لا يرى الظلم سلوكًا فرديًا بل ممارسة بنيوية، وبالتالي يرى أنّ موت الظالم لا يلغي أدوات إنتاجه، ولا يسقط المنظومة التي أفرزته؛ لذا فإن الفرح بموت ظالمٍ، دون تفكيك النظام الذي أنتجه، مجرّد خداعٍ عاطفيّ، “مات الجلاد، وسيولد غيره غدًا”، أما ألبير كامو، فكان يرفض القعود في مواجهة عبثية العالم، ويرى أنّ الواجب الأخلاقي يحتم على الإنسان التمرّد على ما لا يطيق، لا الاكتفاء بالفرح بزوال رموزه.
لا لوم على من يشمت في موت ظالم، فهو انفعال طبيعي، بل ضرورة نفسية مؤقتة في بعض الأحيان، لكنها تصبح خطرًا حين تتوقّف عند هذا الحدّ ، وتتحوّل إلى تعويض عن العمل المقاوم؛ إن لم تُترجم إلى وعي يُنتج بديلًا، فإنها ستظل دائرة انفعالات مؤقّتة قائمة على التنفيس ومحكومة بالشعور اللحظي.
فالعدالة ليست شعورًا بل نظام، والشعور بانتصار مؤقت على الجلاد لا يعني نهاية الظلم، المهم ليس سقوط ظالم، بل سقوط المنظومة التي تحميه وتعيد إنتاجه، إن لم نسعَ إلى ذلك، كلٌّّ في موقعه وبأدواته؛ فإننا نتحوّل -من حيث لا ندري – إلى شركاء في ديمومة الظلم، نكتفي بالابتهاج بسقوط ظالم بينما نصمت أمام توليد طغاة جدد ربّما أشد بطشأ وأشدّ تنكيلا.
الفرح بزوال الظالم لا يجب أن نتعامل معه كموقف، إنّما كشعور، مؤقّت وزائل بل ومضرّ إن لم يتحوّل إلى إرادة مقاومة وفعل مقاومة، سيبقى مجرّد طقوس تحايل من المقهور على ذاته ترضيه لحظة ويندم عليها عمرًا؛ إذ لا عدالة تُمنح، ولا تنزل من السماء دون أسباب وفاعلين، نحن من يحقّقها أو يفرّط فيها، ومن يظنّ أن الغيب ينتصر للمظلوم دون سعيه، فقد وهب الظلم دورة حياة جديدة، بل وشارك فيها متواطئًا، بمنطق الغيب نفسه.