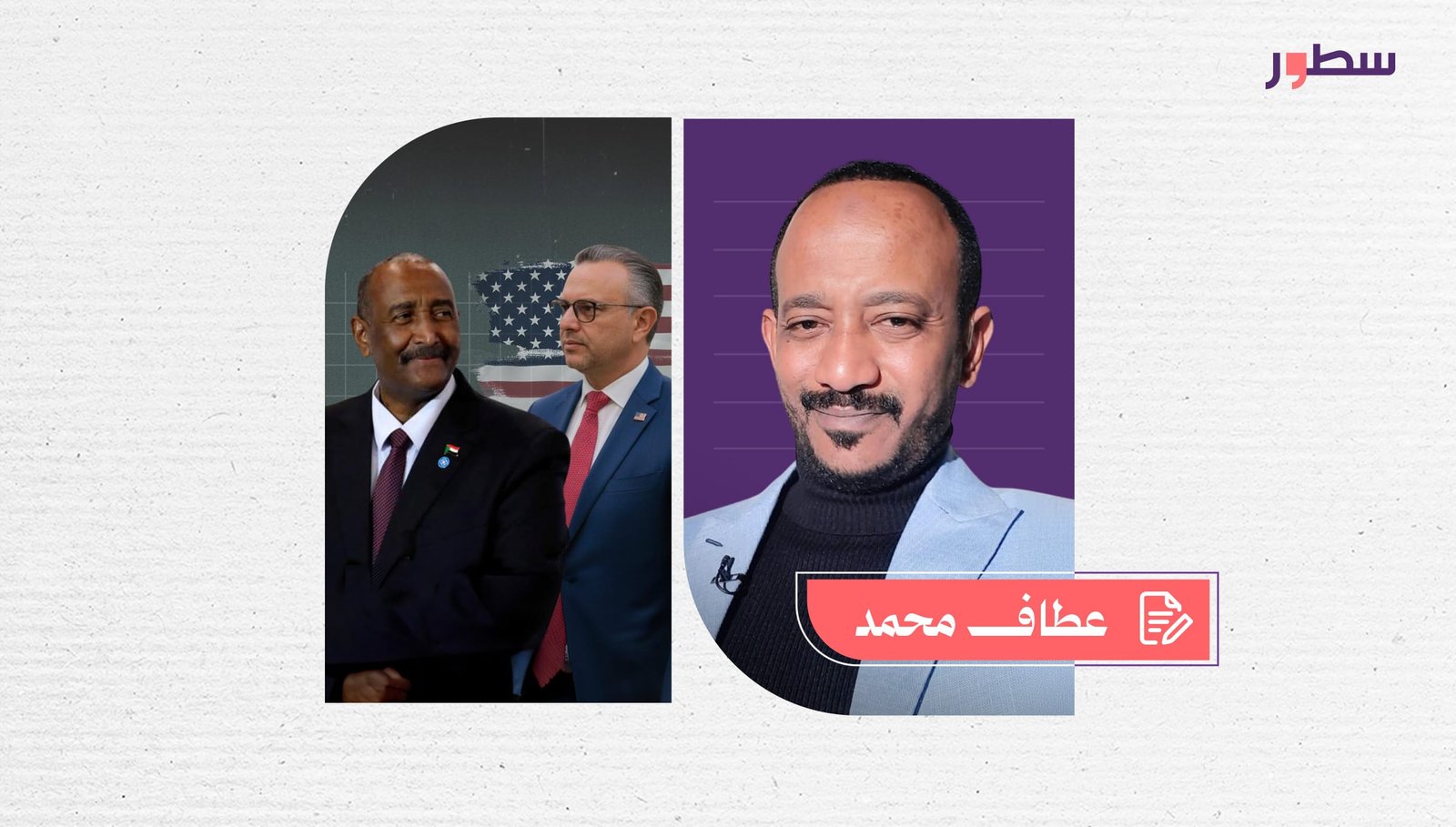سياسة
من الجسد كحيّز احتلال.. إلى الجسد كأداة مقاومة
من الجسد كحيّز احتلال.. إلى الجسد كأداة مقاومة
نبتهجُ لابتهاجِ الأهل، كما نأسى لأَساهم، لا مكان لتحليلاتنا وآرائنا الغارقة في الحكمة أو السذاجة في لحظةٍ كتلك، إذ لم يكن مكانٌ لنا في المقتلة ولو على الهامش إلا كجمهرة متفرّجة تعنى بسلامتها النفسيّة أكثر مما بحقيقة المأساة، لم نكن يمنًا ولا جنوبًا ولا حتى معبرًا يتواطؤ مع الجانبين.
ليس غريبًا على غير العارف أن يتيه، وغياب المقياس الذي يقيسُ أهل المعركة عليه عنّا يفقدنا القدرة لا على الحكم وحده إنّما على مجرّد الفهم، فمشهد السيّدة التي تصيح ابتهاجًا في الشارع وقد ارتقى أبناؤها وتهدّم بيتها وهي في طريق عودتها الآن لحطامه بعد تهجير، سيعطّل الأفهام حتمًا، فتنكره كجنون أو تؤسطره، لكنها لن تقبله كحقيقةٍ على أيّة حال.
الجسد تعبيرٌ عن الوجود واستمرار حضوره ولو مُقعدًا أو مبتورًا دليلُ انتفاء حضورهم المضاد، وإقصاؤه تمامًا صورة انتصارٍ تكاد تكون وحيدة، إذ هو شاهدٌ كذلك على ما لا يجب شهوده، وبجانب إقصاءِ مادته تمامًا بقتله، أو التطرّف في ذلك بتبخيره كما حدث في غزّة ترسيخًا للهلع المؤبّد، يمكن “تحييده” أسرًا أو نفيًا أو إقعادًا، لكنّ ذلك لا يكفي-لطبيعة المستهدَف- ولذا يسعى العدوّ لترسيخ الجسد كحيّز احتلال، يسري عليه -قسرًا- مايسري على البلاد والأرض.
بالمقابل، إدراكًا لهذا الغرض، أو بدافع فطرة تتحرك في اللاوعي الجمعي في فلسطين وغيرها من ساحات المواجهة، يتحوّل الجسد أيضًا كساحة مقاومة، سواء باستخدامه المباشر كأداة ضغط، عبر الإضراب مثلاً، أو تفجيره في عمليّة استشهاديّة، إنّما ابتداءً من إعادة صياغته في الذهن كأداة ماديّة على الطريق للغاية الكبرى.
ولعلّ الحياة كلّها تحوّلت مع الوقتِ في الصراعات الممتدّة، من حيّز محتلّ لمساحة مقاومة، كما شهدنا ونشهد في فلسطين.
قبل الذهاب إلى “مهمّة” في مخيّم المغازي، بقطاع غزّة أثناء معركة الفرقان ٢٠٠٨م، ترتّب أن أُسجّل والصحب رسالةً عن المهمّة وما بعدها في حال عدم العودة منها حيًّا، وموضوعها ليس المقصود هنا، لكن ما كان أثناء تصويرها من ضحك وممازحات و”قلش” مصري وفلسطيني على الموت والعدو والحياة واختلاف اللهجات والطائرة المقاتلة التي أسقطت ما كنّا نصوّر به لتصادف مرورها بالجوار (كنّا نسندُ المسدّس بمشبك ملابس)، كانت حالة جنونيّة بالكامل، في غير نظر العارفِ لما وراءها، لما يحرّكها، لكنّ أصحابها أدركوا تمامًا الغرض من وجودهم وقضائهم المحتمل صعودًا وراحوا يعدّون له عدّة الواثق من طريقه وختام ما سيلتقي فيه.
فالنظر إلى الحاصل من زاوية كلفته (المرعبة وممتدّة الأثر حدّ الخلود لا شكّ) قصورٌ في إدراك حقيقة الصراع كما هو جهلٌ بالمقاومة -خاصّةً العقديّة منها، وجوهر معارك التحرير في التاريخ الإنساني، ولعلّ التذكير بنماذج ڤيتنام والجزائر ومصر وحتى سوريا لمن يتعامل مع ما جرى فيها كانتصار، ينبّه لأضعاف ما تكبّدته فلسطين في هذه الإبادة، ورغم ذلك احتفى أهل كل تجربةٍ بانتصارها حين انتصرَت، ومازالت البشريّة تحملها كنموذج ملهم دون إغفال ما تقدّم في كلٍّ منها على سبيل الحريّة/التحرير.
بعيدًا عن المراجعة التاريخيّة يمكن للمرء إجراء مراجعة “أدبيّاتيّة”، في منطلقات المقاومين وتعريفاتهم للنصر والهزيمة، وهو ما سيُعيد حتمًا لنصوص دينيّة وتراثيّة تتعامل مع الموت باعتباره واحد من المكاسب النهائيّة (غاية) لا مجرّد مرحلة حتميّة، إذ أنها منتهى السعي وصولاً لرضا الربّ على أتمّ صورةٍ وفي أعلى مرتبة، والواحد.ة منهم يتمنى لو يقتل ويعود فيقتل ألف مرّة تأسيًّا بالنبي وصفوة صحبه قصدًا لما وراء الحياة والموت.
على الوجه ذاته، تجد هؤلاء المستهزئين بالموت والإبادة والدمار، العابثين به كأنه لا شيء حفاة عراة لا يسترهم إلا معتقدهم، جائعين لا يقوتهم إلا إيمانهم بعدالة القضية وحتميّة النصر، تجدهم حريصين على انتزاع ما أمكن ما الحياة وما استطاعوا إليه سبيلاً، كأن كل هذا وهو لما بعدها، إلا أن جانبًا منه لانتزاع حقّهم في الحياة التي أرادوا، بشوقٍ وكرامة وحريّة.
هذه المعادلة المتناقضة للناظر للقشور، العاجز عن إدراكِ الماوراء، ستربكه ليحكم على هؤلاء المحتفين بانتصارٍ رغم ما تكبّدوه من عشرات الآلاف من الشهداء ومئات آلاف المصابين وتهدّم غالب سبل الحياة رئيسيّها ومكمّلها، سيحكم عليهم بالإنكار والجنون، أو تلفيق الشعور تلفيقًا جماعيًا، لكن يلزمه سؤالٌ واحد ليعرف ما وراء ذلك كلّه: ما الغاية الكبرى لهؤلاء؟