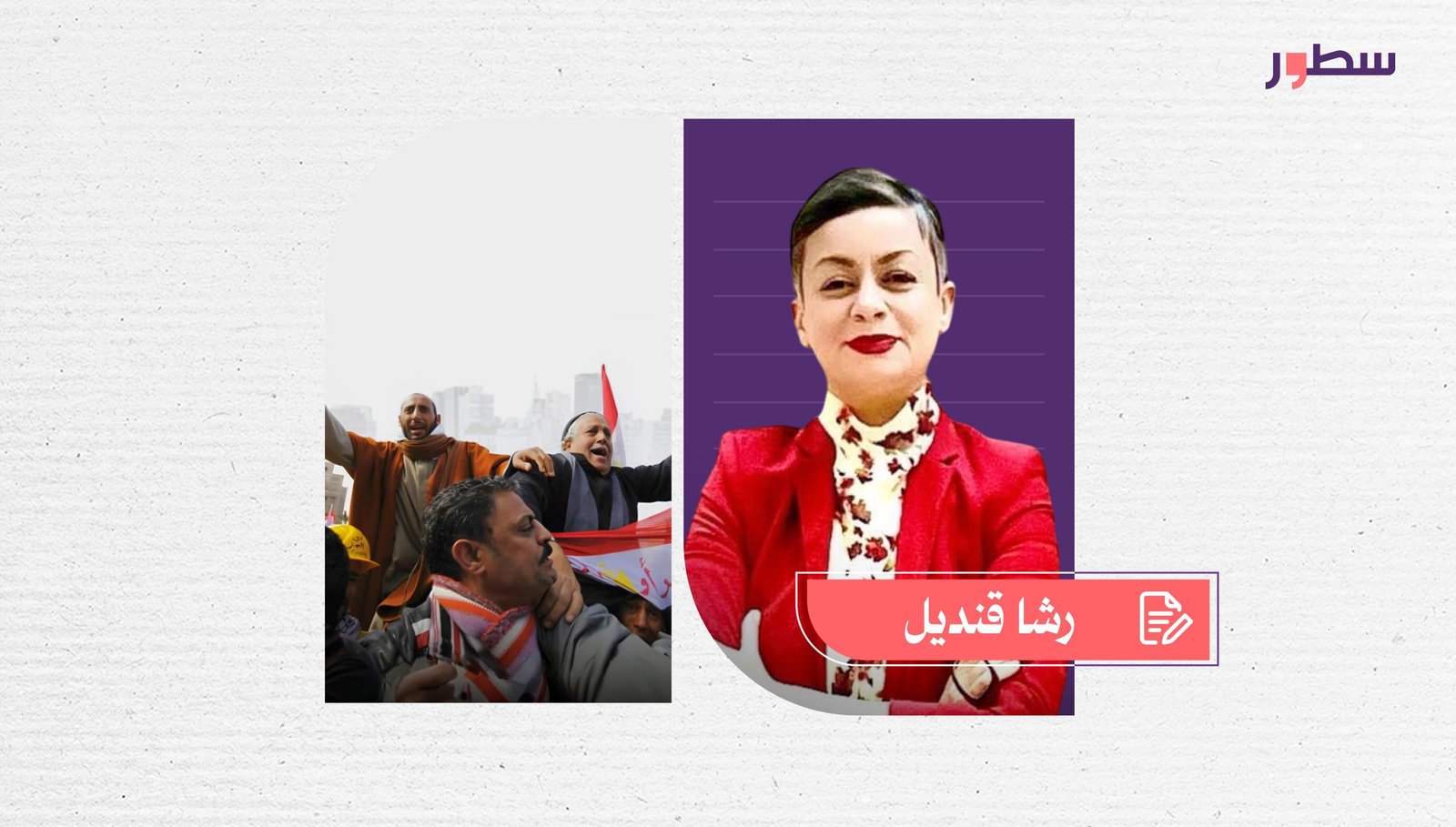آراء
مذكرات يهودي عربي: عوالم آفي شلايم (1)
مذكرات يهودي عربي: عوالم آفي شلايم (1)
سيرة أحد المؤرخين الجدد
منذ قرأت إعلان دار النشر الأجنبية عن قرب صدور مذكرات المؤرخ الإسرائيلي آفي شلايم بعنوان “العوالم الثلاثة: مذكرات يهودي عربي”، أترقَّب الترجمة العربية لها، فالرجل ترك الصهيونية وأصبح واحدًا من أشهر المؤرخين الجدد، وهم نخبة قليلة من المؤرخين الذين قدّموا مراجعة نقدية للتاريخ الصهيوني وكشفوا زيف الدعاية الصهيونية، ومن أشهرهم المؤرخ إيلان بابيه مؤلف كتاب “التطهير العرقي في فلسطين”، وآفي شلايم، وفي سجله عديد من الدراسات الرصينة والمتميزة، من بينها على سبيل المثال: “تواطؤ عبر نهر الأردن: الملك عبد الله والحركة الصهيونية وتقسيم فلسطين”، وبعضهم قدّم مراجعة نقدية للتاريخ الصهيوني في بعض مراحله لكن ظَلّ على أفكاره الصهيونية، مثل المؤرخ بيني موريس الذي كتب سيرة لجلوب باشا قائد القوات العربية في الأردن بعنوان “آخر الباشوات”.
لذلك زرت “مكتبة جرير” أول مرة للبحث عن الترجمة التي صدرت عن دار “تكوين” بقلم علي عبد الأمير صالح، وأخبرني البائع أن الكتاب سيصل إليهم قريبًا، وعدت مرة ثانية بعد أسبوعين وحصلت عليه من رفّ “وصل حديثًا”. ولم يكُن هذا هو اللقاء الأول مع كتابات آفي شلايم، فقد عرفته من خلال سيرة الملك حسين بعنوان “أسد الأردن”، وكانت سيرة مشوقة يعيبها فقط الخط الصغير في طبعة الكتاب العربية.
عقدة النقص
يستفتح المؤرخ آفي شلايم قصة حياته بحكاية من الطفولة، ففي يوم صيفيٍّ قائظ، اقترب والد منه فيما كان شلايم يقضي وقتًا مع أصدقائه خارج عمارتهم السَّكَنية في مدينة رَمات گان الإسرائيلية، شرق تل أبيب.
كان شلايم الطفل وأصدقاؤه يرتدون بناطيل قصيرة وصنادل، في حين ارتدى والده بدلةً رسمية من ثلاث قطع، وقميصًا أبيضَ وربطة عنق، وخاطبه باللغة العربية، وهي لغة أجنبية في إسرائيل، وكان على شلايم الردّ باللغة العربية. غمر الطفلَ شلايم الخجلُ واحمرّت وجنتاه، كانت إجاباته عن أسئلة والده مشوَّشة ومقتضَبة، أي بالكادِ مسموعة، أراد أن يقول له إنه في حين كان من المقبول التحدث باللغة العربية داخل البيت، فإن عليه أن يتحدث معه باللغة العبرية عندما يجده برفقة الآخرين.
لكن أمام أقرانه، لم يسع قول الطفل أيِّ شيء. حتى في وقت لاحق في المنزل، لم يستطع التعبير عن هذه المخاوف. كان يتمنى فقط أن تنْشقَّ الأرضُ وتبتلعَه.
عدم قدرته على التواصل مع أبيه خلقَ فجوةً في علاقتهما لم تلتئم تمامًا طوال حياته. إبَّان سنوات طفولة شلايم لم يفكر قطُّ كم كانت هذه الواقعة مُهينةً حتمًا له، وسببت عقدة نقص.
طفولة بغدادية
أخذت في قراءة الكتاب الذي يعود فيه آفي شلايم لحكاية قصة حياته، ويتخلل ذلك تحليل تاريخي عن تاريخ اليهود العرب وبدايات قيام إسرائيل. وُلد آفي في بغداد عام 1945 لأسرة يهودية قبل ثلاثة أعوام من ولادة دولة إسرائيل، انتقلت أسرته من بغداد إلى إسرائيل في عام 1950 حين كان في الخامسة، في البيت كانوا يتحدثون بالعربية، أما لغة دولة إسرائيل الوليدة، فهي العبرية، تَعلَّمها آفي وشقيقتاه بسرعة شديدة في المدرسة، وتحدثوا بها مع الأصدقاء، في حين ظل والده، الذي كان في منتصف خمسينياته، يسعى جاهدًا من أجل تَعلُّم لغة صعبة للغاية، وقد كان يخاطب آفي بالعربية أمام رفاقه، ممَّا ولَّد عقدة نقص داخل الطفل الذي يريد إنكار جذوره العربية، لقد كتب شلايم سيرته وهو يحاول فهم طفولته وجذور تاريخ عائلته، وتتزامن قصة أسرته اليهودية مع حكايات من تاريخ الشرق الأوسط، خصوصًا كون جدتَي شلايم لأبيه وأمه، اللتين جاءتا إلى إسرائيل، شعرتا بحنين كبير إلى العراق، وكانتا دائمًا تشيران إليه باسم “جنة مال الله”. كان العراق عندهما هو الوطن المحبوب، وإسرائيل هي المنفى.
اختراع العراق
كان لصعود وسقوط الإمبراطوريات خلال القرن العشرين عواقب بعيدة المدى على الحياة اليهودية في الشرق الأوسط. شكل الاستعمار البريطاني سياسة العراق الحديث وحسم مصاير اليهود العراقيين، بمن فيهم أسرة شلايم، لذلك يؤسّس شلايم لقصة أسرته بالعودة إلى حدث مركزي وهو ما يسميه “اختراع العراق”، أي ظهور مملكة فيصل بن الحسين، ويحاول أن يستقرئ أوضاع الطائفة اليهودية منذ بداية القرن العشرين، ويشير إلى تَمتُّع اليهود، بل إنه يقدم مقدمة قصيرة جدًّا عن وضع اليهود في ظل الإمبراطورية العثمانية التي حكمت المنطقة طوال القرون الخمسة الفائتة، بالوضع القانوني لـ”أهل الذمة، أناس مَصونون”، ويذكر أن اليهود خضعوا لأكثرية ذات أحكام تمييزية، بما فيها الجزية السنوية، لكنهم، في المقابل، حصلوا على حماية الحكومة المركزية.
هنا يتخلى شلايم عن دقته مؤرِّخًا ويبدو أن انشغاله بحكاية قصة عائلته جعله يلخّص قرون الحكم العثماني في عبارة قصيرة تمتلئ بالأحكام المتحيزة، يقول شلايم:
“كان النظام العثماني استبداديًّا، ومتداعيًا، ومتبلدًا وفاسدًا، لكنه امتلك ميزةً واحدة تشفع له، هي الاستقلالية التي منحها لمختلف أقلياته الدينية والعرقية كي تدير شؤونها بنفسها. كانت الإمبراطورية مسلمة، لكنها ضمنت قانونًا الاستقلالية الدينية والثقافية لسائر أقلياتها. وفقًا لنظام الملل، سمح لكلّ طائفة دينية بأن تحكم نفسها وفقًا لقوانينها الخاصة: قوانين الشريعة الإسلامية، أو القانون الكنسي المسيحي، أو الهالاخاه اليهودية”.
هنا يتجرَّد شلايم من حصافة المؤرخ ويطلق الجكم جزافًا، كانت هذه هي البداية لكي انتبه وأنا أقرأ قراءة مسترخية للكتاب، أن شلايم لن يتوانى في تلخيص الحقب والتاريخ حتى يصل إلى سردية متماسكة عن يهود العراق. اعتدلتُ في جلستي حتى استقبل الصفحات القادمة، وكانت المفأجاة مع صورة الملك فيصل بن الحسين في الكتاب.
فيصل في عيون يهود العراق
يقدّم شلايم مدخلًا لحكاية الثورة العربية وتفاصيل سقوط العثمانيين وظهور أسرة الشريف حسين، يشرح شلايم احتياج بريطانيا إلى عراق مستقر وصديق بسبب مخزونه الضخم من النفط والطرق التجارية الجذابة التي يوفرها هذا البلد إلى الهند، يوضح شلايم أن لورنس العرب والخاتون غيرترود بيل ممثِّلة المكتب الاستعماري في العراق، اقترحا بديلًا من الحكم المباشر: استخدام النفوذ البريطاني بطريقة غير مباشرة من خلال نُخبة عربية سياسية تابعة، وبالتالي مخلصة، أي مملكة غير رسمية.
يوضح شلايم كون لورنس وبيل نصيرَيْن مقتنعين بهذا الاقتراح، فقد كانا (لورنس وبِل) مُعجَبَين أشدَّ الإعجاب بالأمير فيصل. في البداية قابلت بيل فيصل في مؤتمر باريس للسلام عام 1919، وفي الحال أعجبها كثيرًا مظهره وشكله الجميل، وفطنته وصدقه الجليّ وروح الدعابة لديه. ظنَّ بعضهم أنها وقعت في حبه، ثم يذكر شلايم ما فعله وزير المستعمرات ونستون تشرشل بتعيين فيصل ملكًا، وذكر أن ذلك أعطى أملًا بـ”أفضل وأرخص حلّ”.
يختار شلايم عبارة قد تكون وردت على لسان الوزير المتهكم المغرور تشرشل الذي يحتوي سجله الضخم على سطر من خطاب ألقاه أمام مجلس العموم في مارس/آذار من عام 1936م، ذكر فيه أن “الأمير عبد الله بن الحسين في شرق الأردن، حيث وضعته بعد ظهيرة أحد أيام الأحد في القدس”.
هنا لنا وقفة في اختيار شلايم تقزيم صورة الملك فيصل بن الحسين والثورة العربية، نعم، ساعدت القوى الغربية وبريطانيا على صناعة عرش فيصل، لكن ذلك لا ينكر مواهب فيصل نفسه الذي قال عنه لورنس العرب إنه وُلد ليكون ملكًا، ويمكن الاستعانة بوصف فيصل من معاصريه الذين خاضوا درب الكفاح للحصول على دولة عربية، انظر مثلًا وصف ساطع الحصري عن شخصية فيصل، لقد كان فيصل وثورته إحدى الفرص الضائعة في تاريخ المنطقة العربية، خصوصًا في مرحلته السورية إذ أسَّس مملكة دستورية التفَّ حولها الشعب والنخبة، وكما تسرد إليزابيث تومبسون في كتابها “كيف سرق الغرب الديمقراطية من العرب؟”، فإن هذه الفرصة قد دمَّرَتها فرنسا وقوى التحالف الغربي التي طمعت في تقاسم المنطقة.
وينفي الصورة الساذجة لفيصل التي وصفه به شلايم، أنه لم يكن عميلًا لبريطانيا، بل يجادل مع تشرشل نفسه ولا ينفّذ كل الوصايا ويحاول أن يعتمد سياسة “خذ وطالب”، وربما يميل المؤرخون الأجانب إلى تعظيم أدوار بيل وتشرشل وصناع الملوك وجعل العنصر الغربي هو صانع التاريخ في منطقتنا، ويتجاهلون القدرات الذاتية والكاريزما الشخصية لبعض العرب، وهي صورة تستبطن أن العرب دائمًا أمة لا تدرك أمور السياسة، وأنها يقودها الغرب.
تعجبت من أمر، هو تأكيد شلايم أن فيصل ليس عراقيًّا، لا نجد لديه أي حساسية من وجود بريطانيا نفسها في العراق، فيصل هو شخص عربي، ولم تكُن الحدود مخترَعة بشكلها المعاصر، فكما يذكر هو نفسه لقد اختُرع العراق، فلماذا يُحاكَم فيصل بأنه قدِمَ من الجزيرة العربية؟ ومن العدل التاريخي أن نقرأ سيرة فيصل في ضوء شخصيات أخرى عاصرته، لذلك أختلف مع شلايم في وصف فيصل بأنه أرخص حلّ.
سيرة الطائفة اليهودية في العراق
تعجبت من التفاصيل التي يذكرها شلايم عن الطائفة اليهودية في العراق، يقول شلايم في مذكراته:
“حين خلق البريطانيون المملكة العراقية، وجدوا طائفةً يهودية نشطة يقودها حاخام رئيس ولجانٌ من علية القوم، والتجار الذين سيطروا على قسمٍ كبير من تجارة الاستيراد والتصدير من ذوي الارتباطات الوثيقة مع بومباي وكلكتا في الهند، ومصرفيون و(صرَّافون) أو مُقرِضو المال بفائدة ممَّن كانوا يوفرون قسمًا كبيرًا من الموارد المالية كي تستمرَّ عجلاتُ التجارة في الدَّوران. مع أنَّ اليهودَ لم يشكِّلوا سوى 2٪ من سكَّان العراق، فإنهم سيطروا على 75٪ من وارداته. ضمَّت غرفة تجارة بغداد عام 1935 تسعة يهود، وأربعة مسلمين واثنين من البريطانيين، باختصار، كان اليهودُ العمودَ الفقري للاقتصاد العراقي”.
وزير المالية ساسون أفندي
نحن هنا نسمع شهادة من مؤرخ يهودي عن الطائفة التي ينتمي إليها في العراق، ليست رواية مغرضة أو نظرية مؤامرة، بل تفاصيل تحكي عن علاقة اليهود والمال في العراق، ثم يتحدث شلايم عن وزير المالية ساسون حسقيل (1860-1932) المعروف باسم ساسون أفندي. حسقيل هو سليل أسرة يهودية أرستقراطية عريقة ذات ثروة كبيرة، وبالعودة إلى كتاب “مؤتمر القاهرة” لسي برادفوت، نرى أن حسقيل كان مع وزير الدفاع العراقي جعفر العسكري التي شارك في مؤتمر القاهرة الذي سيُعَدّ فيه قرار تعيين فيصل ملكًا على العراق، وسيُسأل حسقيل عن هذا الترشح ويُبدِي رأيه فيه بالموافقة، وهذا يدلّ على حضوره في أوساط الدبلوماسية الدولية.
كان حسقيل يحظى بإعجاب بيل البالغ وثقتها الكبيرة، وكانت تقول: «الرجل الذي أُحبه هو ساسون أفندي، وهو الرجل الأقدر في المجلس الوطني العراقي”.
يتحول شلايم من صورة فيصل الملك الضعيف إلى تبجيل وصف فيصل في تعامله مع الطائفة اليهودية، يقول:
“لم يخذل فيصل رعاياه اليهود، كان ملكًا متنورًا آمن بصدق بالحقوق المتساوية لجميع رعاياه وفي محاولة صهر سائر الشرائح المختلفة من السكان في أمة عراقية موحدة. في أحاديثه كان فيصل يؤكد مرارًا أنه لا اختلاف بين المسلمين والمسيحيين واليهود: إنهم عراقيون جميعًا وكلُّهم ينتمون إلى العِرق السامي. ربّاه والده على احترامِ اليهود الذين أُشيرَ إليهم في القرآن باعتبارهم «أهل الكتاب». شجّعَتْ غيرترود بيل فيصل على التواصل مع رعاياه اليهود، وزيارة مدارسهم وكُنُسِهم”.
يوضح شلايم مواقف الطائفة اليهودية من وعد بلفور، وأن الظروف التي أدَّت إلى ظهور الصهيونية في أوروبا كانت غائبة إلى حد كبير في الشرق، فكما يحكي آفي شلايم عن حوار دار بينه وبين والدته وهي في سن التسعين، سألها إن كان لديها أيُّ أصدقاء صَهاينة في شبابها، نظرت الأم إليه نظرة توحي بأنّ هذا سؤال غريب، ثم قالت بثقة: “لا! الصهيونية شيء أشكنازيّ، لا علاقة لها بنا!”. كان هذا في جوهره رأي كبار أسرة شلايم في الصهيونية قبل أن يذهبوا إلى إسرائيل.
ويذكر شلايم أن السير أرنولد ويلسون، الذي عمل مندوبًا مدنيًّا في بغداد بين عامي 1918 و1920، أرسل إلى المكتب الاستعماري تفاصيل نقاش خاضه مع أفرادٍ من الطَّائفة اليهودية العراقية وقتذاك، وجاء في التقرير: ”أشاروا (أي يهود العراق) إلى أنَّ فلسطين بلدٌ فقير والقدس مدينةٌ سيئة لا تصلح للسُّكنى، بلادُ ما بين النهرين جنةٌ مقارنةً بفلسطين، إنَّها جنة عدْن، -قال أحدهم- من هذه البلاد انطلقَ آدمُ، أنعموا علينا بحكومةٍ جيدة، ولَسوف نجعل هذه البلاد تزدهر، بالنسبة إلينا فإنَّ بلادَ ما بين النَّهرين هي الوطن، الوطن القومي الذي سيكون يهودُ بومباي وبلاد فارس وتركيا سُعداءَ بالمجيء إليهِ هنا”.
لقد عملت هذه التيارات المتداخلة في النصف الأول من القرن العشرين على تجاذبات بين الاستعمار البريطاني وأفكار القومية العربية، وظهور الصهيونية، وكلها كان لها تأثير في حياة أسرة شلايم، وانتهى العالم الذي عاشت فيه أسرته قبل ذلك، لقد استوعب شلايم تأثير كلمات وعد بلفور التي بلغت 67 كلمة، لكنها قلبت حياة ومصاير أسرته على مدى عقود لاحقة.