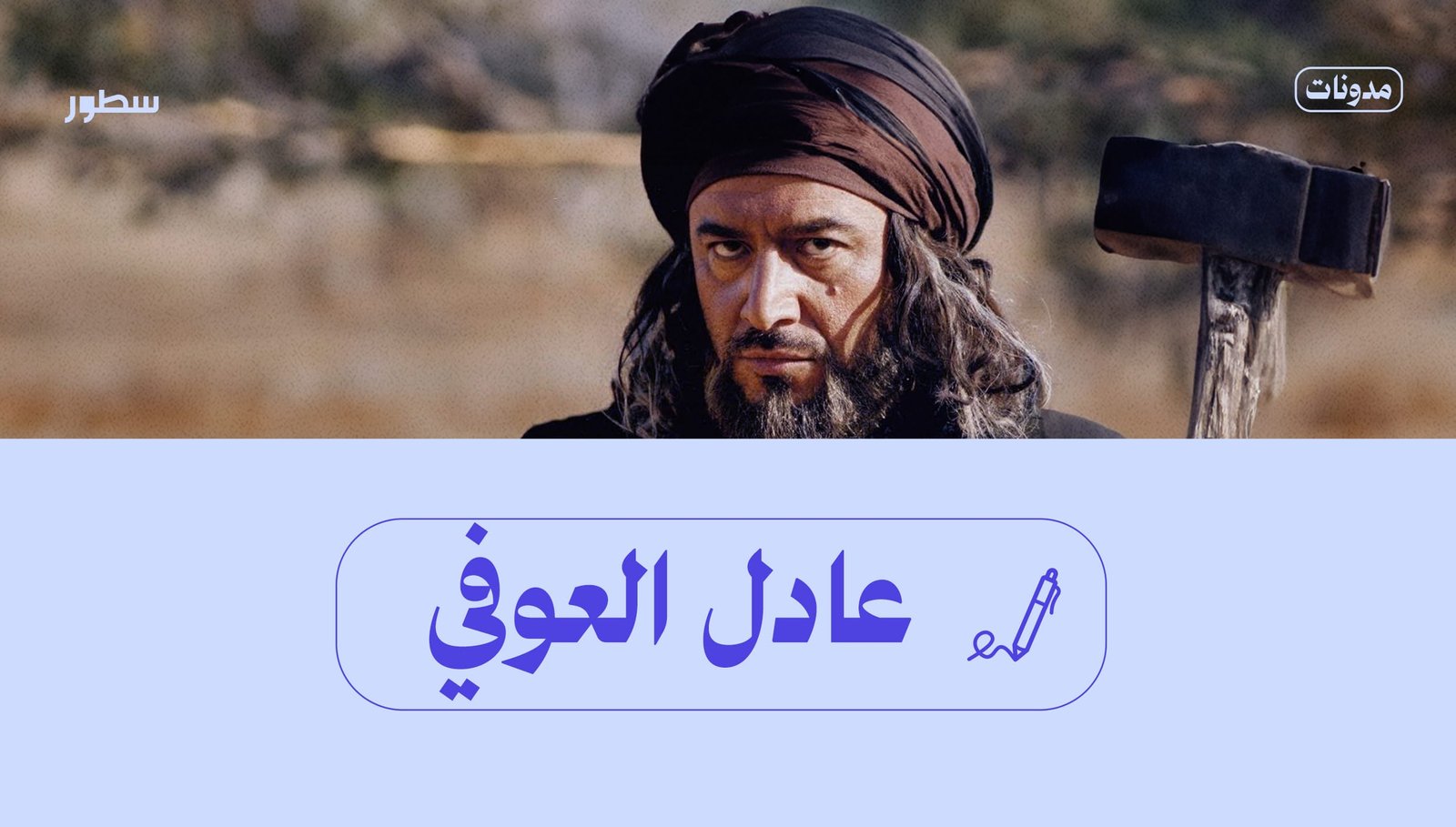مدونات
حرب المصطلحات: سلاح السيطرة على العقول
حرب المصطلحات: سلاح السيطرة على العقول
الكاتب: محمد الميموني
في عصر الهيمنة الفكرية والثقافية التي تفرضها التفاعلات “الصهيوغربية”، لم تعد البنادق والمدافع هي الأدوات الوحيدة للسيطرة، فقد برزت “المصطلحات” كسلاح بالغ الفتك، يعيد تشكيل الوعي الجمعي، ويرسم ملامح الواقع على أرضية تتلاءم مع أطماع قوى الاستكبار العالمي.
“الصهيوغربية” ليست مجرد دمج بين فكرين، بل هي منظومة متشابكة تتلاقح فيها النزعة الإمبريالية التوسعية، حيث ينهل كل منهما من الآخر لتبرير الهيمنة، وإعادة تشكيل الخرائط الجغرافية والفكرية والثقافية، بما يخدم مشروعهما المشترك. ومع ذلك، لا يمكن لأي كاتب أو محاضر في هذه الفترة، أن يتناول موضوعا ما بمعزل عن السياق الذي فرضته هذه الأحداث، ولذلك لن أتطرق للموضوع من زاوية شمولية.
إذا تأملنا الفكر “الصهيوني” بعمق، نجد أمامنا ماكينة محترفة في ابتكار وتصدير المصطلحات ببراعة وإتقان. “معاداة السامية”، “حق الدفاع عن النفس”، و”أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”… ليست مجرد توصيفات لغوية بريئة؛ بل أدوات استراتيجية ذات أبعاد نفسية وسياسية. فالكيان الصهيوني فهم اللعبة مبكرا، وأتقن فنون الغزو الفكري عبر صناعة “مصطلحات” تخدم سرديته، يستخدمها لانتزاع الحق المتشكل في وعي الشعوب، واستبداله بأكاذيب تتخذ من الألفاظ أقنعة لتجميل الباطل، فيخفت صوت المظلوم تدريجيا، وتظهر شرعية زائفة للمعتدي.
إن الكيان الصهيوني لا يكتفي بابتكار مصطلحات جديدة، بل يستثمر في مصطلحات جاهزة ومألوفة لا تشوبها الشكوك، وذلك من خلال تدويرها وقلب مفاهيمها. ومن المصطلحات المثيرة للجدل؛ “حق الدفاع عن النفس”، هو ليس من اختراع الفكر الصهيوني، لكنه تلاعب بمفهومه الطبيعي، وحوله إلى شماعة لشرعنة الجرائم وتبرير التدمير، مما يلغي جوهر “الاحتلال” باعتباره تحركا عدوانيا من أساسه، ويتجاوز لحظة البداية التاريخية لميلاد القضية.
فالحقيقة التي لا يمكن طمسها، أن “الدفاع عن النفس” هو حق أصيل للشعب الفلسطيني وحده ما دامت أرضه محتلة. ومن هنا تظهر أكذوبة “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”، التي تسعى إلى إنكار وجود الفلسطيني على أرضه، كأن التاريخ قبل 1948 كان صفحة بيضاء تنتظر القلم الصهيوني ليكتب عليها تاريخا وحضارة أولية.
في حرب المصطلحات، يُستخدم الاعلام كأداة فاعلة ورئيسية لترويج مفاهيم مغلوطة، حيث يعاد تشكيل الوعي الجمعي عبر التكرار المستمر لهذه المصطلحات في الأخبار والمحتوى الرقمي، مع تدعيمها بمشاهد تعبر عن الوعي الذي يقودها ويُحركها. مثال على ذلك، ما أورده الدكتور “فاضل سليمان” عن بروز مصطلح “الإسلاموفوبيا” وازدهاره في أعقاب أحداث 11 سبتمبر. حيث تحدث عن تجربته الشخصية في الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحدث.
فقد تحول التعامل مع المسلمين في أمريكا من حالة التعاطف، إلى كراهية عميقة خلال شهر واحد فقط، وهذا الانقلاب في الوعي تشكل عبر استراتيجية مدروسة قادها الإعلام آنذاك، عبر بث متكرر لمشاهد تشيطن المسلمين، فكان الشخص إذا جلس أمام شاشة التلفاز ليتابع برنامجا ما، سيرى مشهدا متكررا لـ “طالبان” وهي تعدم امرأة بالرصاص على ملعب كرة. هذا المشهد كانت تبثه القنوات عبر برامجها المختلفة قبل بدء البث، وعند كل فاصل إعلاني أثناء البرنامج، ثم يعود ليظهر بعد نهاية البرنامج. فيكون الشخص قد شاهده في جلسة واحدة لأكثر من خمس مرات.
إن الأمة الإسلامية في حاجة ملحة للاستثمار في بناء مصطلحاتها الخاصة، إن هي أرادت استعادة وعي أبنائها الذين تأثرت عقولهم بالاختراقات الفكرية والثقافية، ولترويج سرديتها الخاصة والأصيلة أمام العالم. فلا استقلال بالوعي إلا عن طريق الاستقلال بالمصطلحات والمفاهيم، ولا سبيل لهذا التحرر إلا بابتكار مصطلحات تنبع من هويتنا الثقافية والفكرية، وتخدم مصالح أمتنا وصورتها أمام العالم. وهذا هو الدور المحوري الذي يجب أن يتحمله نُخب الأمة ومثقفوها؛ أن يتجنبوا استخدام المصطلحات “الصهيوغربية” في تحليلاتهم وكتاباتهم، وأن يبتكروا مصطلحات جديدة تعكس واقع أمتنا وتطلعاتها.
على سبيل المثال لا الحصر، نجد في خطابنا العربي استخدام مصطلحات مثل “الجدار الأمني” بدلا من “جدار الفصل العنصري”، فالأول يُظهر الفلسطيني دائما في صورة “المهاجم”، والمحتل في صورة “المدافع المسالم”. كذلك، مصطلح “الاستيطان” بدل “الاحتلال” أو “النهب المقنن” أو “السرقة”، فالأول يُضفي شرعية كاذبة على الاحتلال، ويُستخدم لتبرير مفهوم “العودة للوطن الأم” و “حق الشعب اليهودي في أرض فلسطين”.
إن معركة المصطلحات لا تختلف عن معركة الميدان، بل هي حرب وجودية على هوية الأمم ووعي الشعوب، ووسيلة للسيطرة على عقول المجتمعات وإعادة تشكيل فكرها وثقافتها. ولذلك، فإن انتزاع زمام المبادرة في صياغة المفاهيم ليس ترفا فكريا، بل واجب حضاري ومقاومة ثقافية تعيد للأمة مكانتها، وتضبط إحداثياتها على بوصلة النهوض واستعادة الوعي والقيم. إن بناء المصطلحات الأصيلة هو بمثابة استرداد اللسان وتحرير العقول من أقفال الروايات الزائفة، فلا يهزم شعب يمتلك قوة الكلمة، ولا تكسر أمة تحسن صناعة مفرداتها. ففي صراع الأفكار، كما في ميادين القتال، إما أن تكون صانعا للسرديات أو ضحية لها.