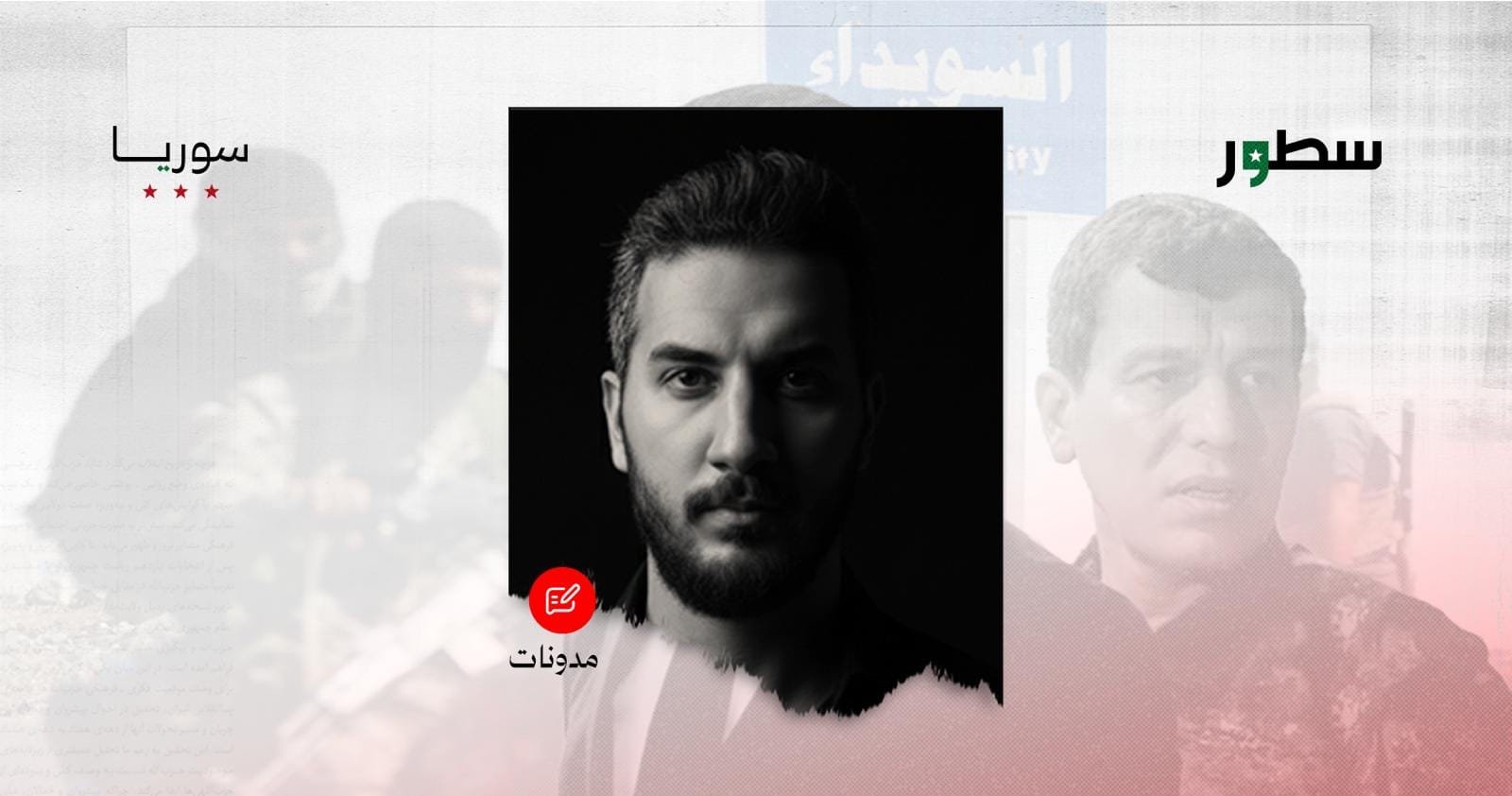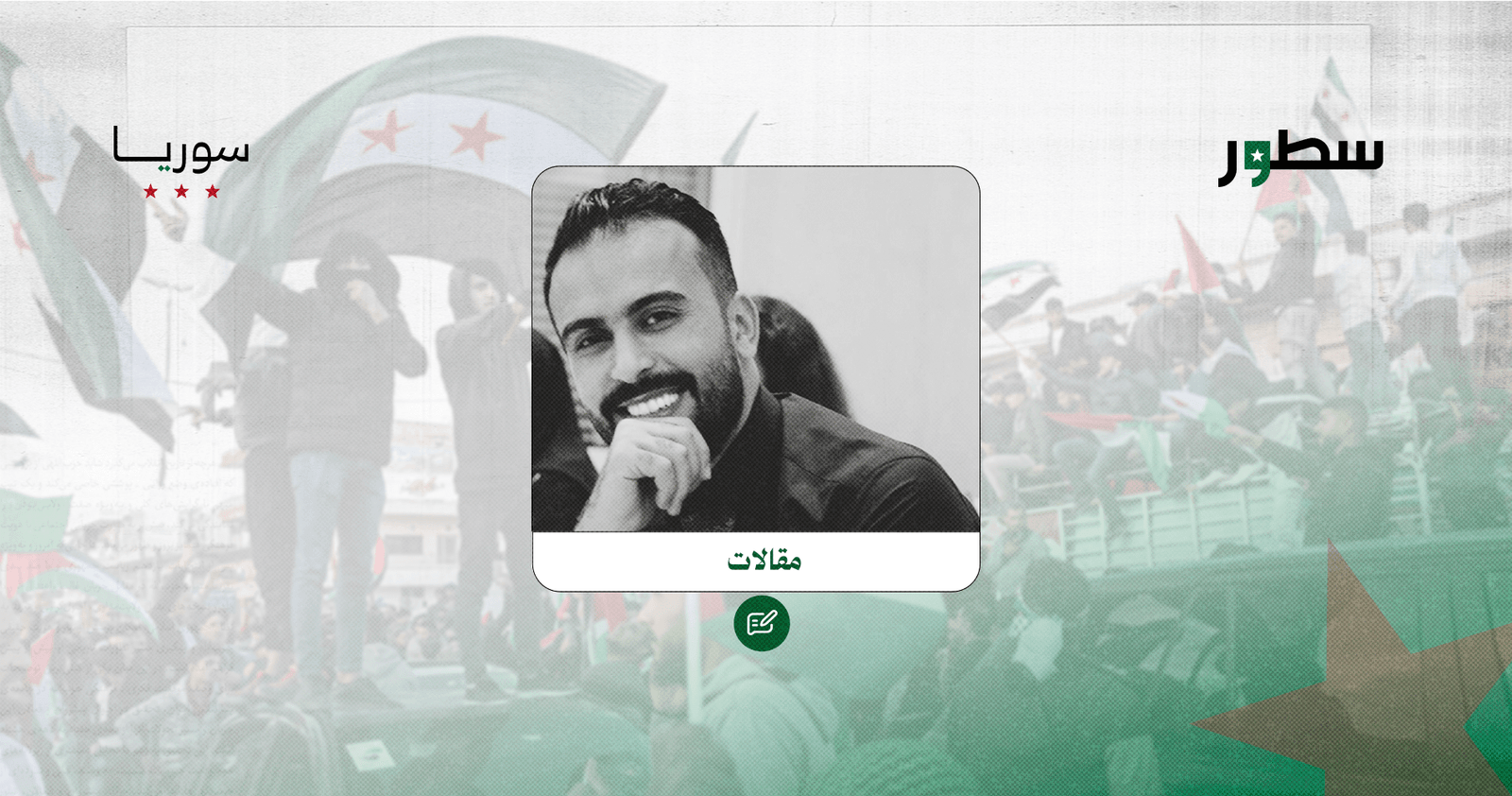Blog
فلاحو الباشا.. حكايات عن الفلاح المصري
فلاحو الباشا.. حكايات عن الفلاح المصري
وُلد أبي عام 1924. إذا كنت بدأت حساب عمري وعمره، فقد أنجبني في الستين من عمره، رحمه اللّه، وتُوفي وأنا طفل صغير. وما سمعته منه بسيط، لكنّي سمعته مرّة يقول إنّه دخل فيلم «الأرض» في السينما، بطولة محمود المليجي، وكبرت ورأيت الفيلم وعاملت الفيلم بإجلال كبير لأنّه مهم ولأنّه ذكرى من والدي. لأصدقائي نكتة عني يقولون فيها إنّني أنتمي إلى عصر والدي حسابيًّا أكثر ممّا أنتمي إلى عصري حاليًّا، وهو مَيْل لا أعرف سببه إلا أنّه محاولة لفهم التاريخ وكيف سارت الأمور على ما هي عليه، لذلك أعيش أحيانًا في عصر بين الثورتين، بين عامَي 1919-1952.
في فيلم «الأرض» تلخيص كبير لحال الفلاح المصري في هذا العصر، قهر متراكم، وباشوات يريدون أن يتحكموا في أهل القرية.
دليل ذلك نراه في «مذكرات نجيب الكيلاني» وصفًا لحال هذه القرية. يقول: «وهناك نسبة كبيرة لا يمتلكون شبرًا من الأراضي الزراعية، فكانوا يشتغلون أُجَراء… ويقضون أعمارهم في ضيقٍ وصبر دون الكفاف من الرزق… وكنّا ونحن أطفال نرى الشاحنات الكبيرة تأتي في مواسم معيَّنة من العام، ثمّ يُحشر فيها مئات الفلاحين، ويُحملون إلى مناطق بعيدة يطلقون عليها (الوسايا) حيث الإقطاعيات الكبيرة خارج حدود المحافظة، وهناك يقضون شهرًا أو شهرين في العمل الشاق، سواء في زمهرير الشتاء أو في قيظ الصيف، ثمّ يعودون بقروشٍ قليلة، وأمراض كثيرة. هؤلاء هُم عمّال التراحيل التعساء، الذين يسافرون وليس على أجسادهم إلا الملابس المهترئة وجوَال به أرغفة جافة قاتمة، وكثيرًا ما كان البعض يقضي نحبه، ثمّ يطويه النسيان إلى الأبد».
ووصفُ الرحّالة الأجانب لقرى مصر مؤلم، وكذلك وصف الرحالة الأتراك، كما في رحلة محمد مهري في نحو عام 1894م، فهو يصف أكواخ الفلاحين وحالات أمراض الرمد في أعين النساء والأطفال، ويتساءل كيف يعيش هؤلاء الفلاحون في تلك المساكن البدائية فيما يغلي هذا الإقليم تحت ألسنة اللهب في يوليو وأغسطس، ويُنهي وصف تلك القرى بأنّها تشبه أعشاش الحمام، لتصور عشوائيتها وبدائيتها.
وعندما تريد أن ترى تاريخ الفلاح منذ عهد محمد علي، ستجده مبنيًّا على الظلم والسخرة، والصراعات بين الملتزمين والفلاح وخلافات حول دفع الضرائب. والصورة التي يقدّمها الجبرتي لحال الفلاحين بشعة، لما تفشّى فيهم من الظلم، واستغلال المحصلين لهم بالهدايا والعمل بالخدمة، حتى يصف حالهم بأنّها أقرب إلى العبودية. ثمّ لفت نظري تعليق مهمّ للجبرتي بأنّ الظلم أفسد نفوسهم وأخلاقهم، فربما تولّى أمرهم رجل عادل ورحيم، فتكون ردة فعلهم أن يستهينوا به، بل ربما أطلقوا عليه اسمًا من أسماء النساء، وماطلوا في دفع الأموال. ثمّ يكمل أنّ أثر الظلم جعلهم يكثر بينهم إيقاع الشرّ بعضهم ببعض، فكان يقع بينهم كثير من الخصام وحوادث القتل. ثمّ يشير إلى ظاهرة أكل أعيان الريف لمال الأوقاف بالباطل، حتى تخربت مساجد كثيرة وأسبلة لأنّ أعيانهم كانوا يأكلون ربع ريعها. وتحليل الجبرتي لأثر الظلم في فساد الأخلاق يذكّرنا بحديث الكواكبي في «طبائع الاستبداد».
وكان أسوأ ما يُبتلى به الفلاحون فوق ما يقع عليهم من ظلمٍ وسخرة، القحط بنقص فيضان النيل، أو الغرق بزيادة الفيضان والأوبئة. والقحط كان يلازمه بوار الأراضي، وتلف الزرع، وموت البهائم، وكانت الزيادة بالفيضان توقع تلف الزرع.
وقد يجيء الفيضان والوباء بالطاعون معًا كما حدث عام 1800، فكان الناس لا عمل لهم إلا دفن الموتى كما يصف الجبرتي، وكان يموت نحو 600 كلّ يوم كما وصف الشيخ حسن العطار الحال لصديقه الجبرتي في رسالةٍ له. وقد قدّر مسيو جومار، أحد مهندسي الحملة الفرنسية، عددَ الموتى بـ10 آلاف في شهر واحد من سكان القاهرة.
هذا وصفٌ للفلاح في عام 1800 وقريب منها، فهل تغيّر الأمر في أربعينيات القرن العشرين مثلًا؟ يُجيب يوسف الشريف في كتابه «ممّا جرى في برّ مصر» أنّه كانت لوالده أرض زراعية في قرية أبي صير بمحافظة الجيزة، فكانت أجرة الفلاح المسكين وحماره لا تزيد على خمسة قروش أواخر الأربعينيات، وعليه أن يواصل عمله في نقل السباخ والطمي أو المحاصيل من الصباح الباكر حتى تغيب الشمس، وأنّ طعام الفلاح مكوَّن من المشّ الأجاج (الجبن شديد الملوحة) والنباتات العشوائية مثل السريس والجعضيض. ثمّ يقول: ما كان في الريف عهدئذٍ مَن كان يعرف طعم لحم الأبقار والجاموس والأغنام والجِمال، إلا أن تأتيه صدَقةٌ من أحد المُوسِرين، أو ربما وقعت بهيمة في ساقية فتحطمت عظامها، فلحقها جزار القرية وذبحها وطاف في القرية مردّدًا وهو يشير إلى الذبيحة «مِن دا بكرة»، ويردّد وراءه الأطفال «بقرشين» أو ثلاثة على حسب وزن الرطل.
وانتشرت في الريف أمراض الرمد وأمراض العيون، فأنشأ الإنجليز مستشفيات لهذا الأمر بسبب تفشّيه، وفي هذه الفترة انتشرت مشاريع مواجهة الحفاء، ونادرًا ما كان لهم أحذية، فخصص بعض الأسر منحًا وهبات لمقاومة الحفاء، وفي المقابل يُنعِم عليهم الملك بلقب الباشوية، وأحيانًا يكون اللقب من نصيب طالب في المدرسة أو الجامعة لأنّه ابن باشا يريد أن يرث ابنه اللقب. ويتميّز أهل الريف بعادات، منها دقّ الوشم والرسومات على الصدر، وكتابة الاسم والعنوان على اليد بالوشم الأخضر، وقد رأيت على عضد والدي وشمًا أزرق عليه اسمه، كان يبهرني في طفولتي.
وفي عام 1937 نشرت عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ مقالات في جريدة «الأهرام» عن شرور صناعة تجهيز وحلج القطن على الأطفال، موضّحة كيف أنّ 25 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين الثامنة والخامسة عشرة كانوا مُستخدَمين في ذلك العام في حلج القطن، حيث كانوا يعملون وسط غبار خانق من الخامسة صباحًا وحتى العاشرة مساء، كلّ يوم بلا انقطاع.
وفي الفترة بين عامَي 1929-1934، حدثت أزمات اقتصادية تأثرت بحالة الكساد الكبير وتوقف سوق القطن، ولدينا كتاب يرصد تاريخ تلك الفترة بعنوان «أزمة الكساد العالمي الكبير وانعكاسها على الريف المصري»، وهو يضمّ شهادات تفصيلية من الجرائد والمجلات على حالات الغلاء الشديدة وبيع الفلاحين للمواشي، وبور كثير من الأراضي الزراعية في تلك الفترة، مع عدم القدرة على دفع الأموال الأميرية وضرائب مجالس المديريات وأقساط البنوك، بل حتى عجز الفلاحون عن تدبير المصروفات الدراسية. ويورد المؤلف حالات انتحار ارتبطت بضيق ذات اليد، فضلًا على زيادة البطالة، وحالات الشحاذة والتسول، وكذلك ظهور حالات السرقة بالإكراه والسطو المسلح. ورصد الكاتب نموّ ظاهرة تعاطي المخدرات في تلك الفترة، وزيادة دُور البغاء مع ارتفاع حالات الطلاق التي ذكرها الصاوي محمد في مقاله «ما قلّ ودلّ» عن وقوع طلاق لعدد 15 ألفًا من عدد زواجات تصل إلى 28 ألفًا، أي بمعدل 52%.
يجب الانتباه إلى أنّ في تلك الفترة حوّلت بريطانيا مصر إلى بلدٍ ذي محصول واحد يغذّي مصانع القطن في لانكشاير، ويجب الانتباه إلى نموّ مشاعر قومية منذ ثورة 1919 لدى الفلاحين، فبعد القبض على سعد زغلول اشترك كثيرٌ منهم في المظاهرات، وهاجموا خطوط السّكك الحديدية، وقطعوا خطوط التليغراف، واعتدوا على كثيرٍ من الأوروبيين، بالإضافة إلى إحراق الممتلكات الخاصة بهم، وثبّت حزب الوفد أقدامه في الحياة السياسية عبر الاعتماد على أصواتهم.
أوضاع الفلاحين منذ الحرب العالمية الأولى كانت سيّئة، فقد جرى استغلالهم والاستيلاء على مواشيهم، وبدأ الطعام يشحّ بسبب قلّة المحاصيل الزراعية مقابل زراعة القطن. وقد ظهر وباء الملاريا من عام 1942 إلى عام 1945، وكذلك وباء الكوليرا عام 1947، وتفاقم مرض البلهارسيا. وكانت حالة الفقر تعود إلى وجود طبقة من كبار الملّاك تتمثّل في 11% من الشعب تملك 90% من الأراضي الزراعية. وفي مذكّرات أحمد لطفي السيد تصوير لقسوة العُمَد في تحصيل الضرائب من الفلاحين بالضرب المبرح بالسياط.
صورة الفلّاح في الكتابات الغربية
يبدو أنّ جذور الاهتمام بالدراسات الفلاحية في الكتابات الغربية تعود لمحاولة الغربيين تفسير انتفاضات الريف وتمرّداته، مثل تمردات المناطق الريفية بعد الحرب العالمية الأولى، وكذلك الانتفاضات والثورات في فلسطين، التي كانت جذورها ريفية. ولعلّ الأحداث في فلسطين شجّعت الباحثين البريطانيين للكتابة عن الريف، مثلما شجّعت تمردات الفلاحين في الهند الصينية على كتابة بيير جورو كتابه بعنوان «فلاحو دلتا تونكين». وتُعتبر أول دراسة عن حالة الفلاح دراسة الأب عيروط بعنوان «طبائع وعادات الفلاحين» بالفرنسية عام 1938، الذي أشار إلى تأثره بكتاب جورو عن فلّاحي الهند الصينية. وهناك دراسة لكريتشفلد عن الفلاحين بعنوان «شحات مصري».
يفنّد تيموثي ميتشل في كتابه القيِّم «حكم الخبراء» أفكار عيروط في كتابه، بدايةً من وجود حياة قروية ثابتة لم تتغيّر ويعتبرها خرافة، ويعرض مظاهر هذا التغيّر في القرن التاسع عشر كمثال، ويذكر منطقة في صعيد مصر ويعدّد التغيرات التي حدثت فيها بداية من الأفول والزوال إلى تجارة المسافات البعيدة مع الهند وشبه الجزيرة العربية والسودان، وانهيار صناعة النسيج المحلية، وإدخال وانتشار الملكيات الخاصة بالأرض، وظهور المحاصيل التصديرية، ودخول ماكينات الريّ، وظهور وباء الكوليرا، مع زيادة نمط المزارع التجارية الضخمة المتمثلة في الأبعاديات والعِزَب، التي أصبح بعضها مثل القرى التي تزرع قصب السكّر مصدرًا للمواد الخام لمصنع كوم امبو لسكّر القصب.
ويرى ميتشل القرية بشكلٍ مختلف، فقد قاوم بعض القرى الاحتلال الفرنسي بقيادة نابليون، مثل قرية القرنة، وبعضها نظّم تمردًا على نمط التجنيد الذي فرضه محمد علي عليهم، وقد قامت في الصعيد انتفاضات على الضرائب مثل قيام قوات محمد علي بتطويق قرية البعيرات، ممّا يدل على تمرّدات إقليم الصعيد على كثير من السلطات واستعصائه على الإخضاع.
يلاحظ ميتشل أنّ في كتابات عيروط وغيره عمًى تاريخيًّا مقصودًا عند الحديث عن تحوُّلات الريف، فهناك ادّعاء يحاول أن يدحضه بوجود صورة عتيقة للريف تجعل وجوههم تعود إلى أوجه التماثيل في المعابد الفرعونية، كأنّ هناك خطًّا تاريخيًّا لم يتأثّر بتغيّر الأحوال السياسية والاجتماعية على حال الفلاح. ويقدّم نقدًا لدراسة عيروط ويفسّر كثيرًا من المسلَّمات عن الفلّاح والريف المصري، بأنّها استخدمت منهجًا غير تاريخيٍّ في تفسير تصرّفات الفلّاح، وجنحت بميلٍ استشراقيّ لتصوير عادات عقلية للفلاح، ونمط متكرّر يتجاهل الحدث التاريخي، وتحميل مشكلات الريف للعقلية الريفية بدلًا من النظر إلى التغيّرات في القوى السياسية والاقتصادية.
يوجد عديد من المعالجات لقضية الفلاح، سواء في علم الاجتماع كما ذكرنا، أو في الرواية والأدب مثل «يوميات نائب في الأرياف»، ورواية «زينب»، وغيرهما من الروايات والسير الذاتية مثل «الأيام» لطه حسين، التي تستحقّ أن تكون عنها دراسة عن صورة الفلاح في الروايات العربية وفي السير الذاتية، وكذلك صورة الفلاح في السينما.
مشاهد من فيلم «أفواه وأرانب»، بطولة فاتن حمامة، تظهر أمامي وأتخيل حياة الزراعة وعمل الفلاحين، وحُبّ والدتي لهذا الفيلم.
لعلّني أختم بملاحظة كيف عالجت السينما موضوع الريف والفلاح في غلالة من الوهم عن الواقع الفعلي على واقع القرية، فتحوَّل خيال عامة الناس عن الريف كأنّه قصيدة رعوية وثيقة الصلة بالطبيعة، ولذلك ظلت جاذبية الخيال أمام قاطني المدن لها فعل المغناطيس، فأصبح الريف هو المكان الذي يمكن اللجوء إليه هربًا من سرعة الخطى المتزايدة للحياة في المدينة. ولعلّ فيلم محمد خان «خرج ولم يَعُد» ينطبق عليه هذا النموذج. ونتذكر أغنية «محلاها عيشة الفلاح»، التي كتبها بيرم التونسي وغنّاها محمد عبد الوهاب، وتقول: «محلاها عيشة الفلاح، متطمّن قلبه مرتاح، يتمرغ على أرض براح، والخيمة الزرقا ساتراه، واللقمة ياكلها ومبسوط، إكمنُّه واكلها بشقاه. الشكوى عمره ما قالهاش، إن لاقى والّا ما لاقاش»… فنكتشف أنّ كلمات الأغنية جميلة لكنّها غير حقيقية، ولا تمُتّ بِصِلَةٍ إلى الفلّاح.