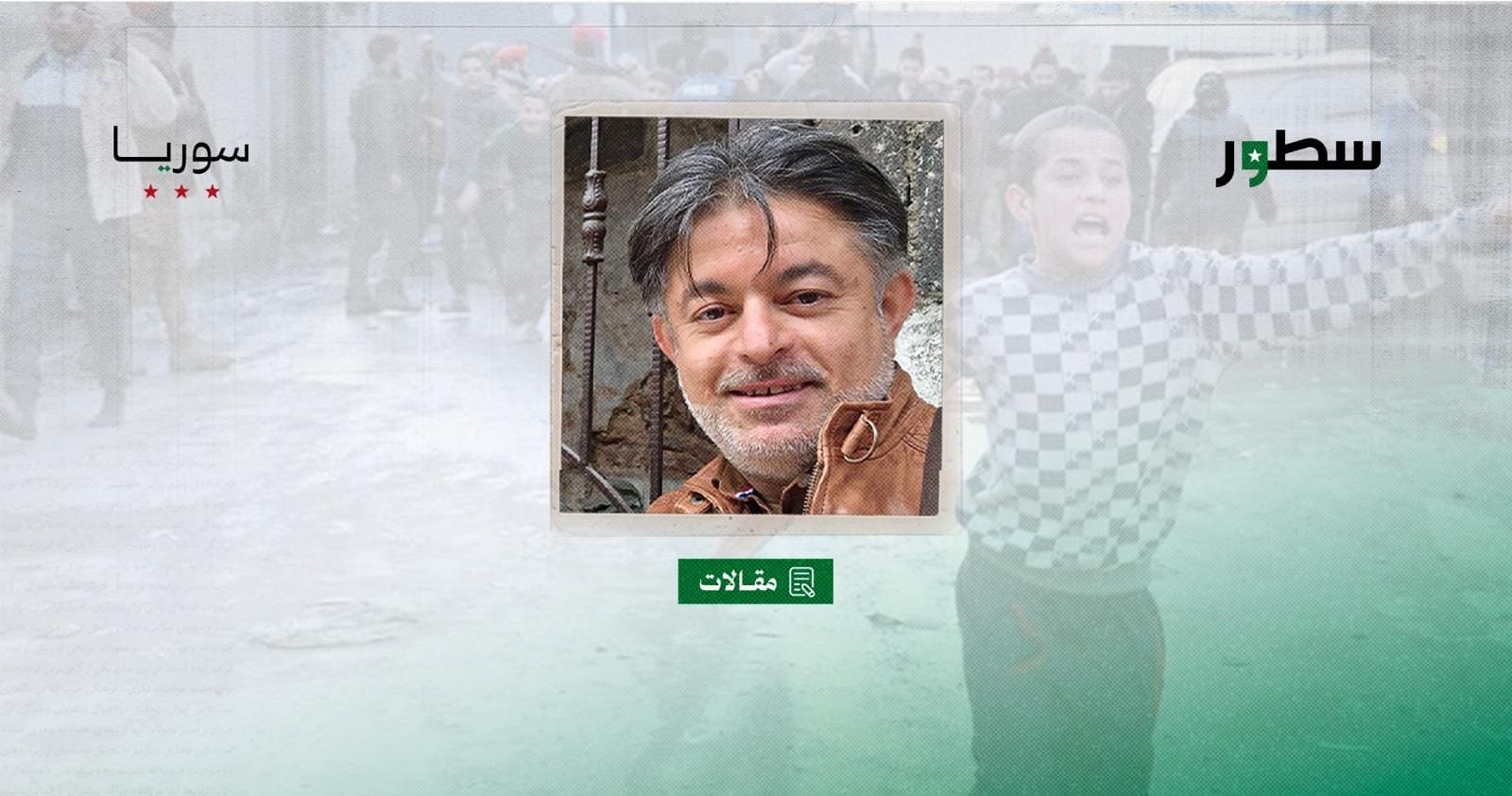أدب
بس تعالوا..
بس تعالوا..
يونس العيسى
الكثير من السوريين يتذكّرون لعبة (حاكم جلّاد، لص، مفتش) التي كنّا نلعبها في طفولتنا، وهذه اللعبة أصبحت تحاكي واقع الشعب السوري طوال حكم نظام الأسد البائد والذي كان ضحيةً لسلطةٍ طاغية تمارس كلّ أدوار تلك اللعبة.
ومع قيام الثورة السورية ضد نظام الأسد وسقوط سلطته وهروب جيشه وقوات أمنه من الكثير من المدن، ظنّ الشعب السوري الثائر أنّه لم يعد أحد يمارس عليه أدوار تلك اللعبة، إلا أنّ سلطة نظام الأسد كرّرت نفسها من خلال تنظيم داعش وبعده تنظيم قسد، واللص بقي لصاً، والجلاد بقي جلاداً، والسجون امتلأت بالثوار والأحرار بينما الجلّادون يستخدمون نفس الأساليب وأدوات التعذيب، تبادلت سلطاتهم المتعاقبة الأدوار كما يحلو لها، ووضعوا قواعد اللعبة طبقاً لأهوائهم ينهشون لحوم المعتقلين ويتلذّذون بعذابهم ويسمسرون على خروجهم من معتقلاتهم، وليس هناك أفظع من أن يعيش شعبٌ في وطنٍ يحكمه لصوص وجلادون، وفيه الكثير من السجون والزنازين.
تلك السجون التي تركت في الذاكرة جروحاً لا يمكن نسيانها، حيث للطغاة والمجرمين والقتلة أساليب غريبة وعجيبة في التعامل مع المعتقلين ولعلّ من أغربها وما يدل على السادية، أنّه كان مكتوب على السياط والكرابيج التي كان يستخدمها الجلّادون في سجن تدمر العسكري أغاني عاطفية، أحدهم مكتوب عليه “لو بيدي ماخليك تمشي” والآخر “نسيانك صعب أكيد” والثالث “ادلع ياكايدهم”، وكانت تختلف هذه السياط في الشكل والشدة حسب الأغنية المكتوبة عليها.
ومنذ سنوات طوال ما تزال الأوجاع ترافق الشعب السوري والدموع لا تطفئ نار انتظار ذوي المعتقلين والمفقودين، تعلو وجوههم تجاعيد الصبر أكثر من زيادة سنوات العمر، وفي عيونهم سؤال أين أبناؤنا ومتى يعودون؟
وهو سؤال تعجز الكتابة عن الإجابة عنه بدقة، فالأهل يعيشون في سجنٍ أعتم وأقسى رغم حريتهم الظاهرة، وكأنّهم بسجن يكاد يضيق بهم لدرجة الاختناق، وهذا الإحساس هو جزء بسيط شاهدناه عند سقوط نظام الأسد وكيف سارع السوريون لفك وكسر أبواب سجن صيدنايا، وذات المشهد يتكرّر مع سقوط تنظيم قسد بتجمع حشود كبيرة أمام سجن الأقطان لعل عيونهم تحظى بمشاهدة أبنائهم المعتقلين.
فتنظيم قسد وطيلة سنوات سيطرته على مناطق بريف حلب و الجزيرة السورية وضع أهل تلك المناطق في حالات انتظار متعددة: انتظار على المعابر العسكرية، انتظار أن يفتحوا صنبور الماء أو يشعلوا الكهرباء، وانتظار توزيع المحروقات، والآن انتظار الإفراج عن المعتقلين والذين يبلغ عددهم الآلاف في سجونها المتعددة التي أقامتها بالجزيرة السورية.
ومن المشاهدات التي رأيتها في الانتظار الطويل وأنا منهم أنتظر خبراً عن أخي المفقود، شاب من أهل الرقة يغني بصوتٍ جميل قائلاً: بس تعالوا.. وهي أغنية عراقية شجية جداً، ومعروف أنّ الغناء العراقي كلماته تقال بأقصى درجات الشعور، فالكلمات تعبر عن الحالة بشدة، الحزينة تُعطيك الشعور بالسواد القاهر الحزين، والكلمات السعيدة تَشعر كأنّها تضحك حين تخرج من شفاههم، والانتظار في المكان مع الأغاني له سلطة على آذان المستمع وتأثير مستمر لا يبلى مع تقادم الزمن.
من تلك الأغاني هذه الأغنية “بس تعالوا” كلماتها مثل وجع السوريين، الذي عاشه قبلهم العراقيون وغيرهم من الشعوب العربية وعكست حال الحزن القاتم الذي كان يطحن أرواحهم، وهم ينتظرون أحباءهم، فشاعرها أبدع بكتابة النصّ وولّده من لحظة حزن وبداية فراق موحش، والملحن والفنان المؤدي كذلك أبدعا وقدما سمفونية وجع تقول: “بس تعالوا”، والتي جسّدت أنين ونعاوي الأمهات المفجوعات، إذ كان قدرهن أن يربين أولادهن ويتعبن في رعايتهم، حتی إذا كبروا وصاروا شباباً، ركض خلفهم الموت من نظام طاغية ومن تنظيمات عابرة كوحوش لا تشبع من الدماء، وكثير منهم في غياهب وظلمات السجون، وتبعثرت أحلام الأمهات والآباء، وضاعت سنوات المحبة والحنان والذكريات والأمل.
تذاكر أغنية “بس تعالوا” ما زالت مفتوحة أمام سجن الأقطان وغيره من السجون الأخرى، كما وجع الحنين من الطرف المنادي والمنادى عليه أيضاً تذكرته مفتوحة، “بس تعالوا” أمام جدران السجن تلقفتها كلّ الآذان، وترددها بصمتٍ كلّ القلوب التي يقطعها الفراق ونار الانتظار، “بس تعالوا.. وما يجون، وما زلنا نتذكر ملامحهم”، فماذا فعل الشعب الثائر حتى صار نصيبه أن ينادي “بس تعالوا”؟
أمام السجن وبين الحشود التي تنتظر تجد صوراً للواعج ومآسي وآهات السوريين، وتكاد تسمع قطع سكاكين كأنّها تمر بين ثنايا الجسد لتقطع أحشاءه، وهو يتلظى بنيران المشاعر الجياشة التي تنزف أسى ولوعة لفراق الأحبة وأمنيات لرؤية من يعشقون، وكأنّ رؤيتهم أصبحت حلماً أقرب إلى المستحيل، ولسان حالهم يقول:
بس تعالوا
ولو إجيتوا جفوفنا نحنيها
بس تعالوا، ولو إجيتوا
كلّ عزيز بعمري أطشنّه فدى لعيونكم.