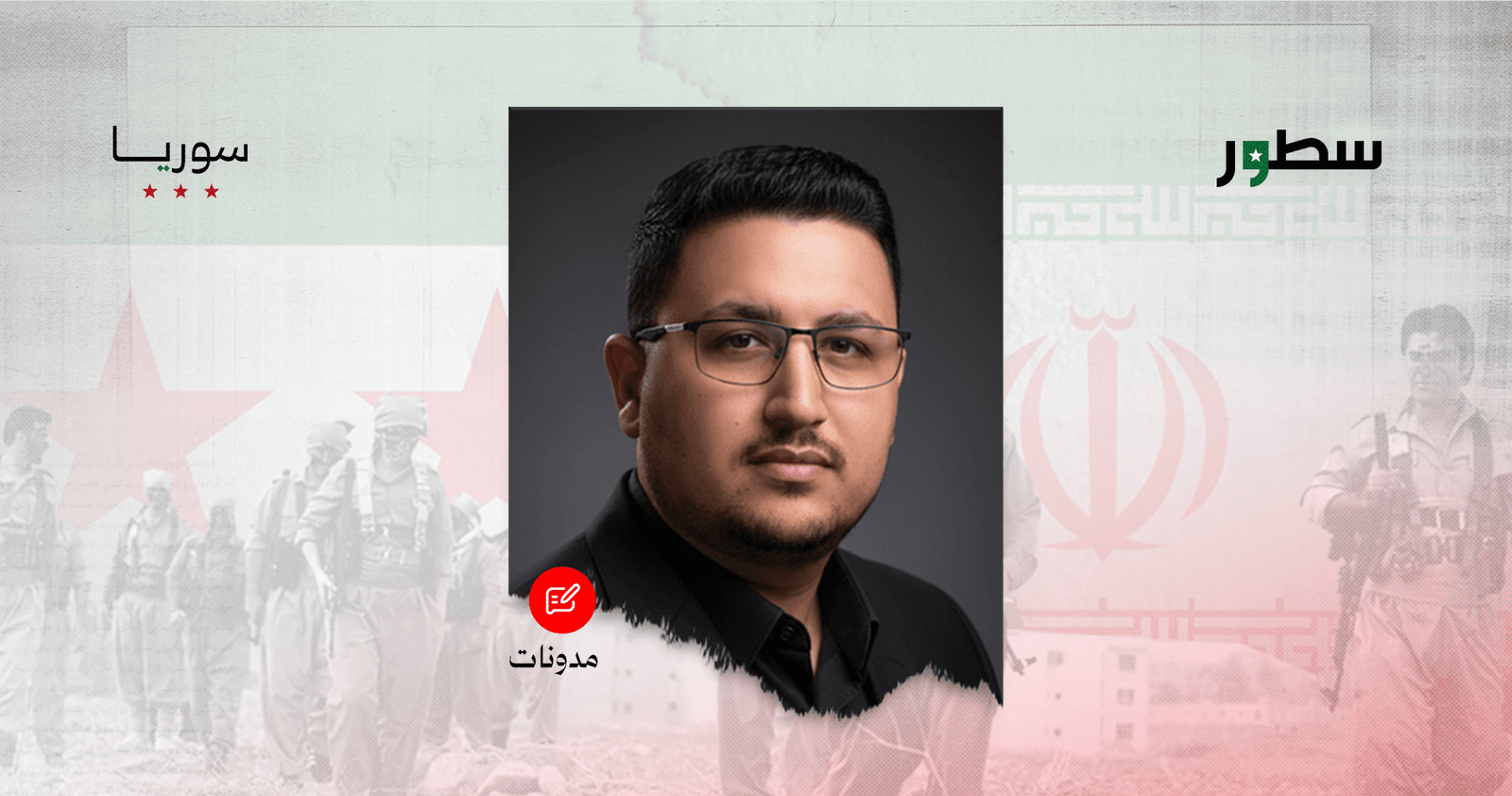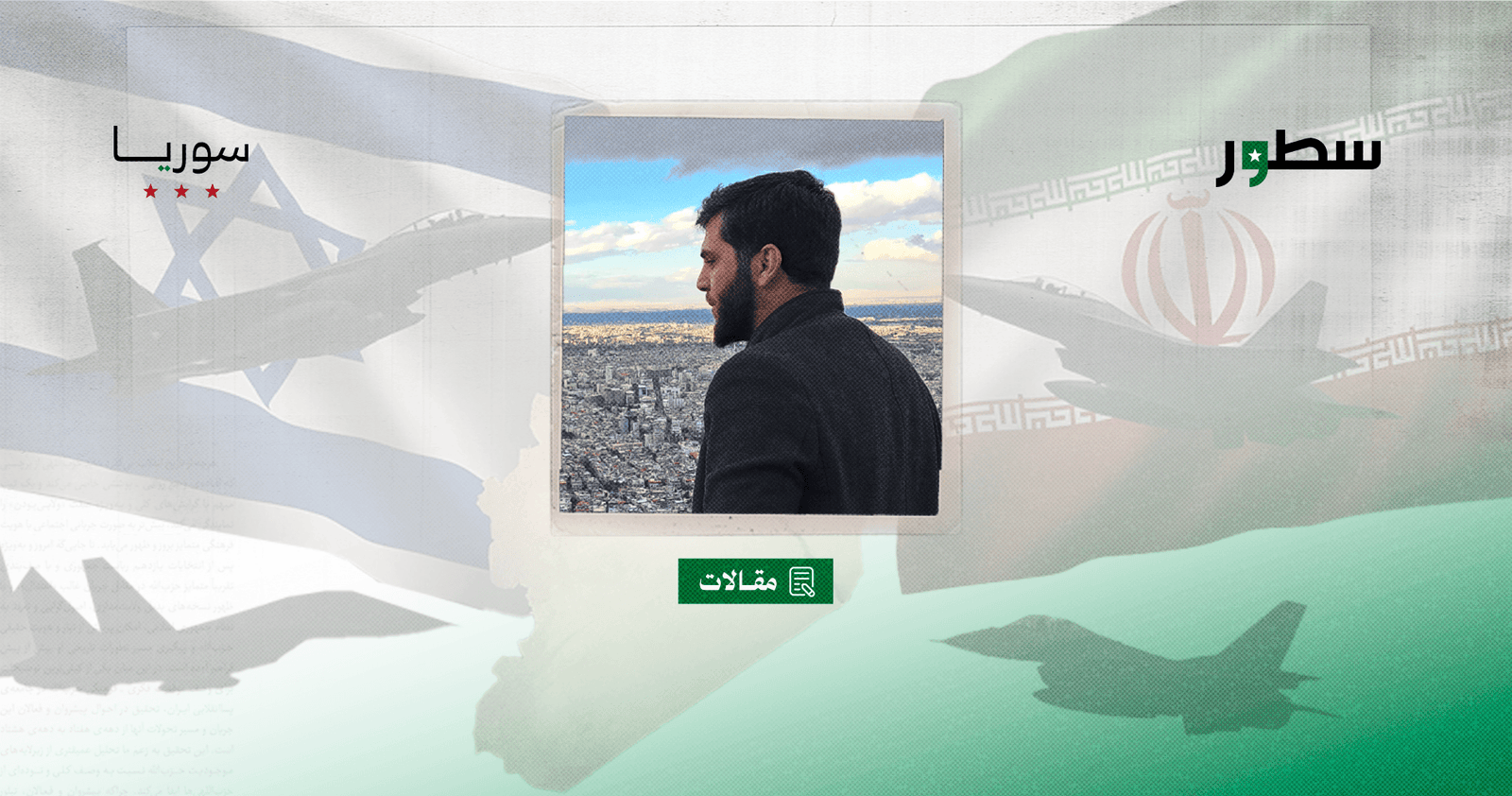سياسة
تفجير حمص.. التهديد المركّب في سوريا
تفجير حمص.. التهديد المركّب في سوريا
لم يكن السادس والعشرون من كانون الأول/ ديسمبر 2025 مجرّد ورقة تُنزع من روزنامة الألم السوري الممتدة لعقدٍ ونصف، بل كان يوماً يحمل في طياته نذير اختبار وجودي لصلابة “العهد الجديد” الذي تشكّل عقب سقوط نظام الأسد قبل عامٍ واحد. ففي قلب مدينة حمص، تلك المدينة التي طالما وُصفت بأنّها “بيضة القبان” الجيوسياسية والديموغرافية لسوريا، دوّى انفجار عنيف مزق سكون حي وادي الذهب، مستهدفاً مسجد “الإمام علي بن أبي طالب”. هذا الحدث الدامي لم يضرب جدران المسجد فحسب، بل اخترق عمق “العقد الاجتماعي” الهشّ الذي تحاول النخب السورية الجديدة صياغته وسط حقول ألغام من الفلول، والتنظيمات الراديكالية، والتدخلات الإقليمية، مشكلاً حالة نموذجية لما يُعرف بـ”عنف المفسدين” الذين يرون في استقرار السلام تهديداً وجودياً لمصالحهم.
هذا الفعل الدنيء والجبان لا يمكن تبريره أو التعامل معه كحدثٍ عابر؛ فهو جريمة مكتملة الأركان وانتهاك صارخ لحرمة الأرواح ودور العبادة، ومحاولة خسيسة لبثّ الخوف وإشعال الفتنة داخل المجتمع السوري. واستهداف المصلّين هو استهداف مباشر لقيم العيش المشترك ولُحمة النسيج الاجتماعي السوري، قبل أن يكون مجرّد اعتداءٍ أمني. في هذه المرحلة الحساسة، يصبح الوعي ضرورة قصوى أكثر من أيّ وقتٍ مضى. الوعي بخطورة الانجرار خلف التحريض، وبخطورة تحويل الألم إلى أداةٍ للكراهية، وبأهمية التمييز بين المجرم والمجتمع الذي يُستهدف معه. المطلوب اليوم ليس الخوف ولا الانقسام، بل التماسك ورفع الصوت في وجه كلّ من يسعى لجرّ البلاد إلى دوامة العنف من جديد.
في خضم الصدمة والحزن اللذين أعقبا التفجير، ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي بيان لمجموعة تُسمّي نفسها “سرايا أنصار السنة” أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم. هذه المجموعة وُصفت بأنّها تنظيم مسلّح جديد يتبع نهج تنظيم داعش ومعادٍ للشيعة والعلويين. وقد زعم التنظيم في بيانه أنّه فجّر، بالتعاون مع جماعةٍ أخرى، عددًا من العبوات الناسفة داخل مسجد علي بن أبي طالب (والذي وُصف في البيان بـ”المعبد النصيري”) ممّا أدى إلى مقتل وإصابة قرابة 40 شخصًا (بحسب التنظيم). علمًا أنّ حي وادي الذهب ذو غالبية علوية ويرتاد المسجد أبناء هذه الطائفة، الأمر الذي يفسّر الخطاب الطائفي المستخدم في البيان. ونفى التنظيم عبر منصاته ما تمّ تداوله في الإعلام من أنّ التفجير استهدف مسجدًا لأهل السنة والجماعة، مصرّحًا بأنّه استهدف من وصفهم بـ”الكفّار والمرتدّين”، ومتوعّدًا بتصعيد هجماته التي “ستطال جميع الكفار والمرتدّين” في سوريا. هذا التأكيد على الهوية الطائفية للضحايا يكشف نية متعمدة لإذكاء التوتر المذهبي.
ورغم هذا التبنّي الصريح للهجوم، تثير جماعة “أنصار السنة” علامات استفهام حول حقيقتها ودوافعها. فمنذ بدايات ظهورها بعد تحرير أجزاء واسعة من البلاد، دأبت على طرح خطاب طائفي مشبوه يُعزّز السرديات التي حاول فلول النظام وحلفاؤهم في المحور الإقليمي تأطير الأحداث السورية ضمنها. ومن الأمور المثيرة للريبة أيضًا التخبط الواضح في لغة ومصطلحات بيانات هذا التنظيم وضعف صياغتها المليئة بالأخطاء اللغوية الفاضحة في منشوراته (على خلاف أدبيات التنظيمات الجهادية المعروفة). هذه المؤشرات مجتمعةً تطرح احتمالًا مقلقًا، وهو أن يكون “أنصار السنة” مجرّد واجهة مفتعلة في إطار حرب التضليل وبثّ الفتن، أكثر من كونه امتدادًا لحركات التطرّف المعهودة.
يسلّط هذا التفجير، وما رافقه من خطابٍ طائفي صريح، الضوء على طبيعة التهديدات الأمنية المركّبة التي تتربص بسوريا في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد. إذ خرجت البلاد من حربٍ طويلة أفرزت حالة انفلات غير مسبوقة في انتشار السلاح، وظهور مليشيات متعددة الولاءات والأيديولوجيات، تتصارع على السلطة والنفوذ. وقد تزامن انهيار النظام مع إفراج واسع النطاق عن آلاف السجناء، لم يقتصر على المعتقلين السياسيين، بل شمل أيضًا المحكومين بجرائم جنائية خطرة، ما أطلق شرارة فوضى أمنية ما تزال الأجهزة المختصة تكافح آثارها حتى اليوم، في محاولات دؤوبة لإعادة ضبط المشهد وملاحقة المتورطين.
ولا يمكن إنكار وجود حوادث استهداف ذات طابع منهجي، إلا أنّ التركيز الحصري على هذا الجانب، وإغفال البُعد الجنائي والأمني العشوائي، يخلق سردية مشوّهة للواقع. فالمشكلة أعقد من مجرّد مؤامرة ضد طائفة أو جهةٍ بعينها، إنّها حصيلة تداخل عوامل عديدة، أبرزها الانهيار المؤسسي، وتفكك منظومة الضبط، وتعدّد مراكز القوى. ورغم ذلك، تُصر بعض المنصات الإعلامية والدعائية في كلّ مرة على تضليل الرأي العام، ومحاولة تصوير كلّ حادث فردي على أنّه استهداف طائفي ممنهج، متجاهلة السياق الأمني الأوسع وتعقيدات الواقع الناتج عن التهديدات المركبة التي تحاصر البلاد من كلّ اتجاه.
في المقابل، تتكاثر الأطراف التي تستثمر في هشاشة الواقع السوري لتعزيز نفوذها على حساب استقرار البلاد ووحدتها. فبعض القوى الإقليمية وجدت في مرحلة ما بعد سقوط النظام فرصة سانحة لإعادة رسم المشهد الداخلي وفق مصالحها، وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي، الذي سعى إلى تأسيس نفوذ غير مباشر من خلال دعم مليشيات محلية ذات خلفية درزية والتنسيق مع تنظيم قسد الكردي، بما يخدم هدفًا استراتيجيًّا يتمثّل في تفكيك البنية الوطنية السورية ومنع تبلور سلطة مركزية موحّدة. في الوقت ذاته، لا تزال التنظيمات الإرهابية مثل داعش حاضرة على الساحة، مستفيدةً من كلّ فراغٍ أمني لتعيد تنظيم صفوفها وشنّ هجمات نوعية كلّما سنحت الظروف، ما يجعل الخطر الإرهابي عنصرًا دائم التهديد في معادلة الأمن السوري.
ولا يمكن التغافل عن التهديد المتصاعد الذي يُمثله فلول النظام السابق. فبرغم انهيار السلطة المركزية، لم تتفكّك بالكامل البُنى الأمنية والعسكرية التي كانت تمسك بزمام الدولة، بل أعاد بعض القادة إعادة تجميع صفوفهم خارج البلاد، مستثمرين الفوضى للتخطيط لانبعاث جديد يهدّد الدولة الوليدة. من أبرز هؤلاء الجنرال سهيل الحسن، المعروف بلقب “النمر”، الذي تشير التقارير إلى أنّه يوثّق ويعد أكثر من 168 ألف عنصر من أبناء الطائفة العلوية في معاقل الساحل السوري، ويزوّد عدداً منهم بأسلحةٍ خفيفة وثقيلة استعدادًا لتحرّك محتمل في اللحظة المناسبة.
إنّ هذه الشبكات المتغلغلة في عمق البنية الطائفية والمسلحة بخبرةٍ قتالية واسعة، باتت تمثل لاعبًا غير معلن في المشهد السوري، خطورتها لا تقلّ عن خطر الجماعات الإرهابية أو المليشيات الانفصالية. وما يضاعف من أثرها التخريبي هو امتلاكها أدوات إعلامية منظمة وجيوشًا إلكترونية تعمل ليلًا نهارًا على إعادة تشكيل الوعي العام عبر روايات مضلّلة تعيد تدوير خطاب النظام بأساليب محدثة تستهدف بثّ الشك والانقسام داخل المجتمع.
أمام هذا المشهد المركّب الذي تتداخل فيه التهديدات وتتقاطع فيه مصالح متضاربة، يصبح تمسّك السوريين بالحقيقة ورفض الانقياد خلف الدعاية المشبوهة سلاحًا حاسمًا في معركة الوعي والسيادة. فالتعاطي مع الأحداث عبر ما يُتداول على منصات التواصل دون تمحيص لا يخدم إلا أجندات الفوضى والتفكيك، بل يعمّق الشرخ ويعيد إنتاج الهشاشة. المطلوب اليوم ليس الانفعال ولا الاصطفاف الأعمى، بل التزام جماعي بدعم التحقيقات الجادة ومحاسبة كلّ من تورّط في التخطيط أو التحريض أو التنفيذ.
فالعدالة ليست فقط استحقاقًا للضحايا، بل ضرورة استراتيجية لحماية ما تبقى من نسيج مجتمعي بات مستهدفًا بكلّ أدوات التآمر. السوريون، رغم الجراح، أظهروا في كلّ محطة أن قدرتهم على الثبات تتجاوز نوايا الخراب، وأنّهم إذا وعوا الخطر يستطيعون تحصين البلاد بوحدة داخلية تتجاوز الطوائف والمناطق والانتماءات الضيقة. ولأنّ ما يجري هو أكثر من تفجير، بل محاولة ممنهجة لإغراق البلاد في فوضى مركّبة تشترك فيها بقايا “الدولة العميقة”، وتنظيمات التطرّف، وأذرع إقليمية ذات أجندات خاصة، فإنّ الرد الحقيقي لا يكون بالأمن فقط، بل ببناء جبهة داخلية صلبة، ووعي جماعي يرفض الاصطفاف الطائفي، ويواجه الجيوش الإلكترونية بروح نقدية ويقظة وطنية.
كما يتطلب الأمر من الحكومة السورية أن تواكب هذه المرحلة بتحديث منظومتها الأمنية، وتجفيف منابع اقتصاد العنف، وتكريس الشفافية كأداةٍ لبناء الثقة. لقد بات واضحًا أنّ البلاد أمام مفترق حاسم: إمّا تحويل هذه المآسي إلى لحظة تأسيس لوحدةٍ وطنية جامعة، أو الانزلاق نحو نموذج العرقنة واللبننة، حيث تتحوّل سوريا إلى ساحة لصراعات الآخرين وأدواتهم. الخيار ما يزال بأيدي السوريين، والوقت لم ينفد بعد.