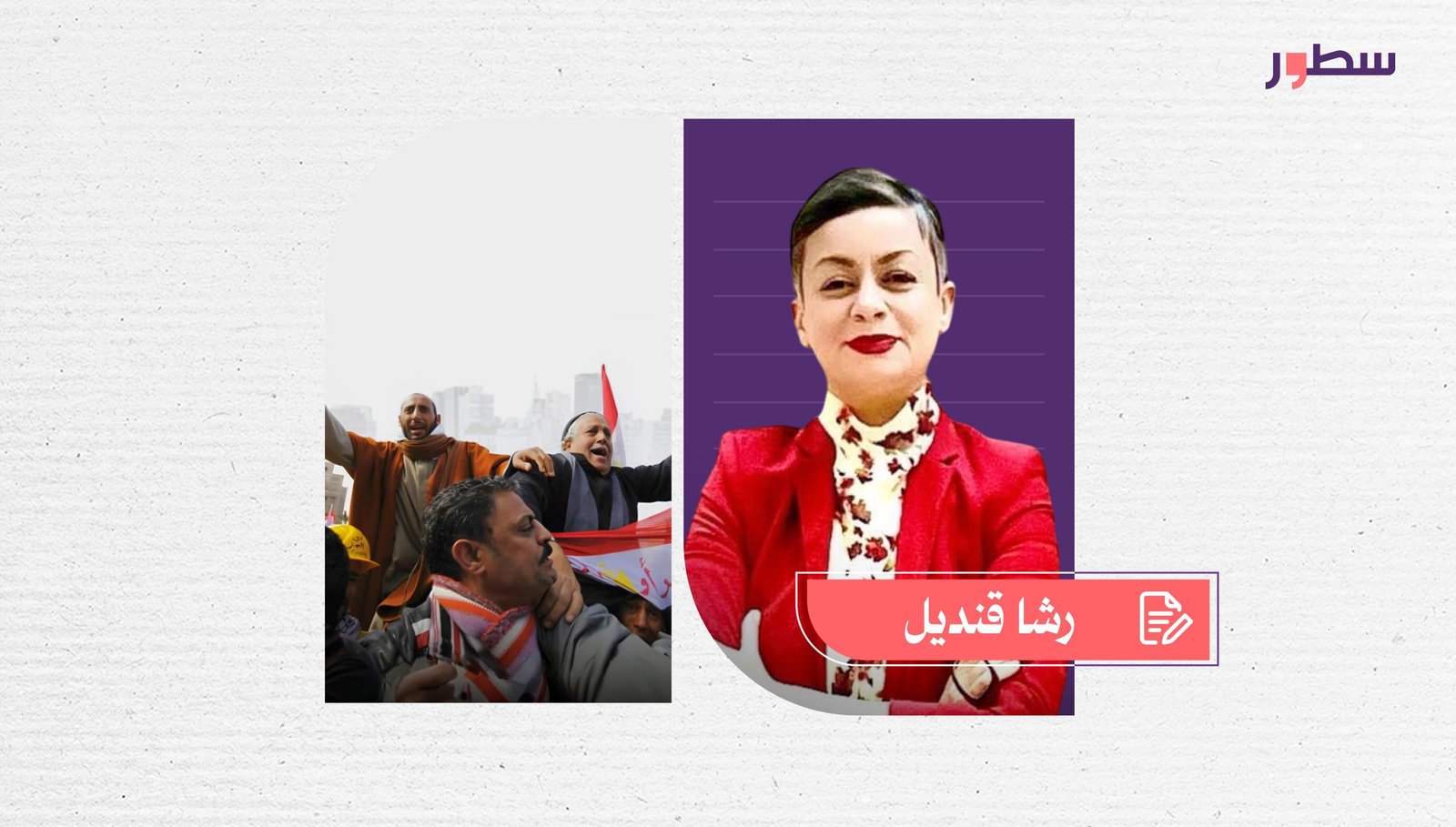آراء
عندما يفرح الكلب بطوقه!
عندما يفرح الكلب بطوقه!
ليس كلّ فرحٍ علامة عافية، ولا كلّ ابتسامة دليل رضا. أحيانًا يكون الفرح هو المرحلة الأخيرة من الأسر، حين لا يعود القيد محسوسًا، وحين يتحول الطوق من أداة سيطرة إلى رمز أمان. الكلب لا يولد عاشقًا لطوقه، لكنه يُدرَّب على ذلك؛ يُكافأ عند لبسه، ويُحرَم عند نزعه، حتى يختلط في وعيه معنى الحياة بمعنى الطاعة. ومع التكرار، لا يعود يرى في الطوق قيدًا، بل بوابةً لما يحب، فيفرح به، ويدافع عنه، وربما خاف يومًا أن يُنزع منه.
وفي عالم البشر، تتكرّر الصورة بصورةٍ أشد قسوة وأعمق أثرًا. إنسان يفرح بقيوده، لا لأنّه لا يراها، بل لأنّه أقنع نفسه أنّ هذا القيد هو ثمن النجاة، وأنّ الطوق هو الحدّ الفاصل بينه وبين العزلة أو الخسارة أو السقوط. ومع الوقت، لا يكتفي بالقبول، بل يتحوّل إلى مروّج، ثمّ إلى حارس، ثمّ إلى أداة تنفيذ في معركةٍ لا تخدمه، لكنّه يتوهم أنّه متفوّق فيها.
الأبشع من مجرّد القبول، أنّ هذا الكلب المُروَّض لا يكتفي بالجلوس عند قدم سيده، بل يُدفع – وهو فرِح بطوقه – لافتراس بني جلدته. يُلقى به في وجه قومه، فينهشهم بلسانه، وبقلمه، وبمنصته، وببلاغته المصنوعة. يُطلب منه أن يهاجم من يشبهه، وأن يشكك في نواياهم، وأن يجرّدهم من حقهم في الغضب والرفض. وكلما كان الافتراس أشد، كان الربت على الرأس أطول، وكان الطعام أوفر، وكان الطوق أمتن.
هؤلاء لا يُدفعون غالبًا إلى القتل المباشر، بل إلى قتل المعنى. يقتلون القضية باسم التهدئة، ويقتلون الذاكرة باسم الواقعية، ويقتلون الحلم باسم الحكمة. والمفارقة أنّ الكلب هنا لا يرى نفسه مفترسًا، بل “عاقلًا”، “متزنًا”، “منقذًا من الفوضى”. يهاجم أهله باسم الاستقرار، ويطعنهم باسم المصلحة، ويخونهم وهو يعتقد أنّه يحسن صنعًا.
أما التربية والترويض، فلا تتم فجأة، بل عبر مسارٍ طويل ومحسوب. تبدأ بالعزل؛ عزله عن سياقه الطبيعي، عن لغته الأولى، عن تاريخه الجمعي. ثمّ تأتي مرحلة الإغراء؛ منصّة، مساحة، قبول، شعور زائف بالتميّز. بعدها تُزرع المخاوف؛ التخويف من الإقصاء، من الوصم، من الخسارة. وحين يكتمل البناء النفسي، يُوضع الطوق برفق، ويُقال له: هذا من أجلك، هذه حمايتك، هذه فرصتك. ثم يُدرَّب على الطاعة الذكية؛ متى يتكلم، ومتى يصمت، ومتى ينبح، ومتى يهزّ ذيله. ومع التكرار، يصبح الطوق جزءًا من هويته، بل معيارًا لنجاحه.
وليس من الخطأ الظن أنّ هذه الظاهرة وليدة زماننا أو حكر على واقعنا. الحقيقة أنّ الكلب الذي يفرح بطوقه وُجد منذ أن وُجد الإنسان، في كلّ تجمع بشري، وتحت كلّ شمس. تغيّرت الأسماء وتبدّلت الأدوات، لكن النموذج واحد. في كلّ عصر، كان هناك من اختار الطوق طواعية، لا لأنّه أُجبر، بل لأنّه رأى فيه طريقًا أسرع للنجاة أو الصعود. لم يكن الأمر يومًا مرتبطًا بزمنٍ أو مكان، بل بطبيعةٍ بشرية حين تنفصل عن القيم وتتصالح مع الخوف.
ولهذا، فإنّ المجتمع الواعي لا يُفاجأ بظهور هذه النماذج، ولا يربكه صخبها. هو لا يخلط بينها وبين الكلاب الضالة، لأنّها ليست ضالة، بل موجهة، مدرَّبة، تعرف أين تعض ومتى تتوقف. مواجهتها بالغضب الأعمى قد يخدمها، وتجاهلها المطلق قد يتركها تنهش في الظل. التعامل الرشيد معها يكون بفضح الوظيفة لا تضخيم الأداة، وبإسقاط الخطاب لا صناعة البطولة، وبحماية الوعي الجمعي من أن يُعاد تشكيله على مقاس الطوق.
الحر لا يفرح بطوقه، ولو كان من ذهب. والواعي لا يقايض كرامته بأمانٍ مؤقت. وأخطر ما في هذا الزمن ليس كثرة القيود، بل كثرة الذين تعلّموا أن يبتسموا لها، وأن يفتخروا بها، وأن يفتكوا بغيرهم وهم يظنّون أنّهم أحرار.