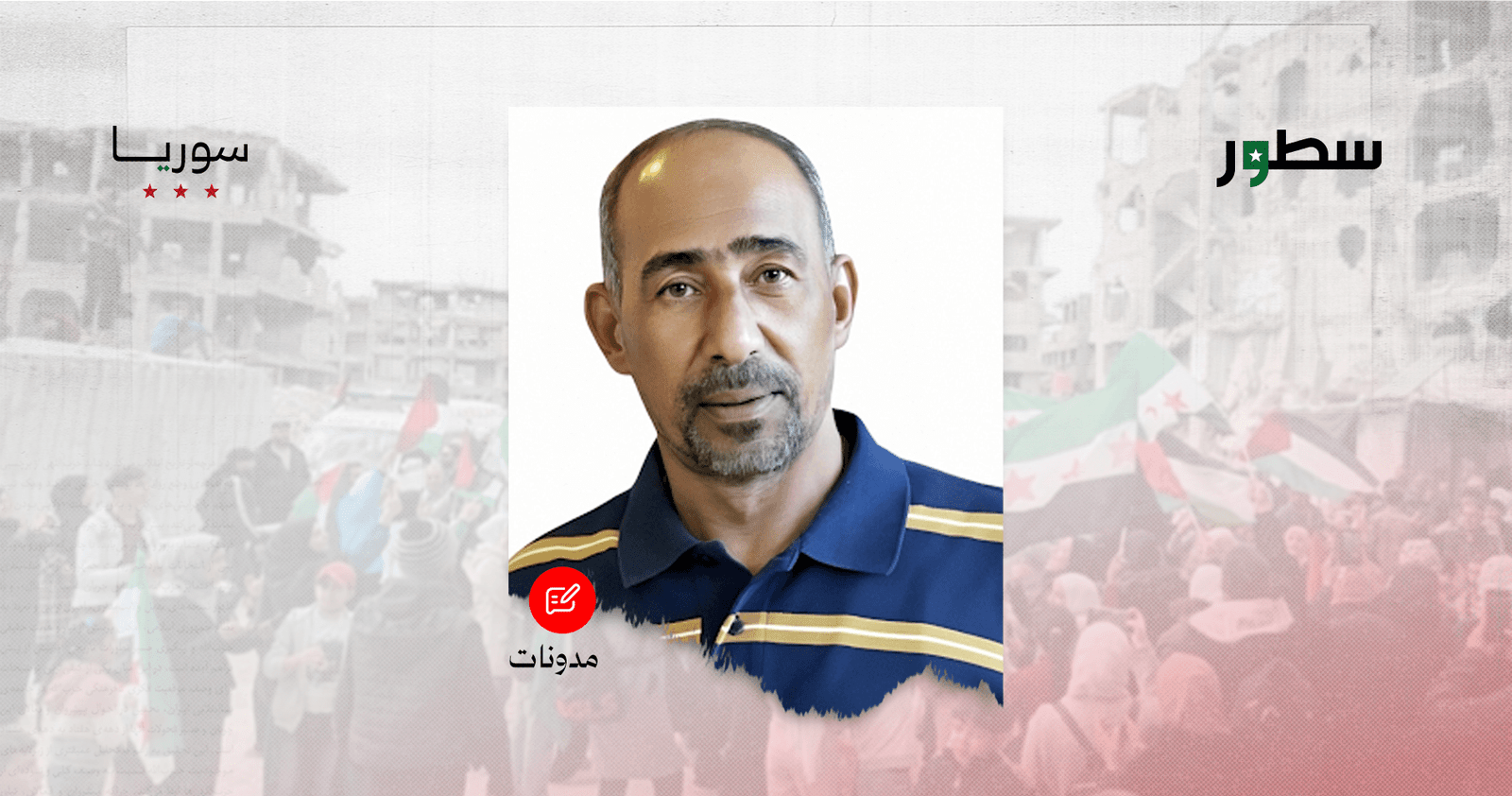فكر
خريفٌ أخضر بين تشرين وكانون.. سقوط الأبد
خريفٌ أخضر بين تشرين وكانون.. سقوط الأبد
تجرأنا على الحلم ولم نندم على الكرامة.. هذه الجملة هي أول ما تذكرته في بداية معركة ردع العدوان التي بدأت في 27 تشرين الثاني 2024، المعركة التي أطلقتها هيئة تحرير الشام مع فصائل الثوار المسلحة ضد نظام الأسد وحلفائه، والتي كان هدفها إعادة تشكيل المشهد العسكري والسياسي للثورة والمعارضة. لم يكن قرار بداية المعركة سهلاً؛ كانت الأعوام الأربعة عشر الماضية كفيلة ببناء تصوّرات وتوقعات عمّا قد يحدث، لكن معظم هذه التوقعات كانت قَلِقة، خوف وترقّب وأمل في كلّ لحظة، مع كلّ شبرٍ وتقدّم تحرزه القوى العسكرية.
أصبح صوت الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية، العميد حسن عبد الغني، الصوت المسموع في كلّ بيت، ترافقه دعواتنا بالتوفيق والسداد لشباب البلاد، شباب الثورة الذين تهجّروا من بيوتهم أطفالاً وعادوا إليها مُحرّرين يستردّون أرضهم وحقّهم في العيش على هذه الأرض وصنع القرار فيها. لكن ماذا قبل ذلك؟
الثورة السورية في الوعي الجمعي.
الثورة السورية وما واجهته، تغيّرت، وأرض سوريا التي تحوّلت إلى أرض صراع وحروب بالوكالة صارت مضرب مثل لدى شعوب المنطقة. تحوّلت الثورة السورية إلى كابوسٍ تُهدد فيه الأنظمة المستبدّة مواطنيها، تقنعهم بأن لا وجود للحرية في هذه المنطقة، وأنّ كلّ نداءات ومحاولات التحرر مصيرها الفوضى والصراعات ولاجئون ثُقْل على الدول المضيفة. تطبيع عالمي مع نظام الأسد، وبناء سردية كاذبة ومزيّفة عن انتصاره وانتهاء الثورة، أو “انتهاء الحرب” كما كان يصفها إعلام نظام الأسد ومواليه.
لكنّنا كسوريين لم تكن الثورة السورية كذلك بالنسبة إلينا؛ كانت الهوية حين أهلكنا الشتات. حملناها معنا في كلّ بقاع الأرض، كتبنا عنها في الأدب، وثّقناها في الأفلام والدراما والقصص والكتب، وأخذنا من العلم الأخضر ونجومه الثلاث كفناً في الشهادة والموت، وثوباً يزين أكتافُنا في الفرح، من أهازيج الثورة أغاني في احتفالاتنا، في نجاحنا، في كلّ مناسبةٍ مفصلية من حياتنا. أيُّ شعبٍ يمكن أن يحوّل أغاني تسخر من نظامٍ مُستبد كنظام الأسد إلى أهزوجة في زفاف؟ كيف يمكن أن تكون كلّ اجتماعاتنا عبارة عن ذكريات في الحصار والمعتقل والنجاة من القتل؟
جمعتنا الثورة السورية وخلقت لنا مجتمعات لم نكن نتخيّل أن نعيش فيها أو نعرفها، زرعت داخلنا صراعات يصعب فهمُها: بين حب الأرض والغضب منها، بين الرغبة في العودة والخوف منها. رسمت بيننا عقداً اجتماعياً لا يمكن بناؤه في ظروفٍ أُخرى، وروابط تجمعنا على قيمها التي نادينا بها منذ اللحظة الأولى: الحرية، الكرامة، العدالة.
تشرين الثاني شهر المعجزات.
بعد الحملة التي شنّها نظام الأسد وحلفاؤه على حلب أواخر 2016، بين تشرين الثاني وكانون الأول أيضاً، تبدّد الأمل لدينا. كانت حلب معركة دامية في تاريخ الثورة، وروّج النظام لنفسه بالانتصار حين سقوط حلب في يده.
لكنّنا لطالما انتظرنا حدثاً مفصلياً يعيد لنا الإيمان بالجدوى ومعنى المحاولة، يضيء داخلنا الأمل الذي ظنّناه قُتل مع ذكرياتنا وشهدائنا. وفي تشرين الثاني 2024 تحوّلت بيوتنا إلى صالوناتٍ سياسية؛ نقاشات لا تنتهي، مخاوف وأفكار لا تهدأ، مشاعر متضاربة وغير مفهومة، قلق وخوف من انتقام نظام اعتاد العنف والإجرام، وأمل في بلادٍ حرة، أو حتى في تقدّم عسكري يعيد الثورة والثوار إلى المشهد العام كفاعلٍ أساسي يفرض ويفاوض ويُسيطر بالقوة حتى.
أتذكّر جيداً وجوه السوريين الذين كنت ألتقيهم تلك الفترة؛ المسافات تفصلنا عن الوطن، فيما يجمعنا السؤال عن الخريطة ولونها الأخضر. كانت إدارة العمليات العسكرية تقدّم إحداثيات فورية لكلّ تقدّم يحرزه الجنود على الأرض، وتلوّن القرى والمدن باللون الأخضر، حتى أصبح هذا اللون رمزاً لنا، يوقظ فينا الأمل ويشعل الحنين. كنّا نتابع الأخبار بخوف، ونبارك لبعضنا البعض باخضرار أراضينا وزوال الطاغية عنها.
الحديث ذاته، والأسئلة ذاتها، كانت تتكرّر في المقهى، والبقالية، وبين الأصدقاء، وفي مكالمات الفيديو التي صارت وسيلتنا الأهم للتواصل خلال الشتات. لم نعرف النوم؛ نغفو ونحن نسمع الأخبار، ونستيقظ على خبرٍ جديد. نشاهد عبر وسائل التواصل الصور والفيديوهات: شاب من إدلب لم يرَ عائلته في حلب منذ 7 سنوات، سوريون يعودون من تركيا إلى بيوتهم رغم ضبابية المشهد، ترقب الوصول للسجون وكأنّ الجميع كانوا ينتظرون هذه اللحظة، هذه المعركة، لإعادة ترتيب مفاهيم الانتماء، الهوية، ومعنى الوطن.
في المناطق التي تحرّرت، انتشرت صورٌ لشبّانٍ من الفرق التطوعية وجنودٍ مقاتلين يطمئنون الأهالي، ويساعدونهم في تأمين احتياجاتهم الأساسية. وفي تلك المشاهد تجلّت فكرة الوطن والانتماء؛ إذ حرصت حكومة الإنقاذ في إدلب، والحكومة المؤقتة في ريف حلب، على توفير أدق التفاصيل التي يحتاجها الناس في مثل هذه الظروف: الأمن، والطمأنينة، والخبز، والغذاء. أخبرتني صديقةٌ لم تغادر حلب أنّها، ولأول مرة منذ سنوات طويلة، ترى وفرةً في الخبز وسهولةً في الحصول عليه. قالت لي: لقد نسيت كيف أتسوّق بلا البطاقة ذكية، وكيف أحصل على الأساسيات بهذه البساطة. في تلك الفترة، كانت معظم المواد والمستلزمات تتدفّق من إدلب وريف حلب، دون أن يُبتزّ المواطنون للحصول على غذائهم ووقودهم، كما كان يفعل نظام الأسد.
لم نتوقف عن استشعار نعم الله، ولا عن الدعاء بأن يكون المقاتلون أقوى من بطش الأسد وإجرامه. كنّا جميعاً نترقّب لحظة خروج المعتقلين؛ فكلٌّ منّا يفتقد أسيراً سرقت الزنازين من عمره أكثر ممّا عاش خارجه. ننتظر رؤيتهم أحراراً، نفرح لمن عاد، ونبكي معهم وعلى الذين لم يخرجوا أحياء من سجون الظلم ، نحصي شهداءنا ونسأل: في أيّ مقبرةٍ جماعية كان مصيرهم؟ حُرمنا حتى من أن نستطيع دفنهم ومعرفة أين رُفاتهم.
في تلك الفترة بكينا كلّ الدمع المؤجّل: بكينا شهداءنا الذين ودّعناهم على عجل، وبكينا المعتقلين ورسائلهم المحفورة على جدران السجون، وبكينا دماء الذين رحلوا في الحصار والتهجير وليالي القصف القاسية.
صور خالدة.
كانت الصور والفيديوهات تتحوّل إلى رموز أيقونية: هادي العبدالله يبكي في بلدته بحمص فنشارك دموعه، شباب غادروا حمص وحلب أطفالاً مُهجَّرين ثمّ عادوا إليها منتصرين، فتاة نجت من قصف الكيماوي نراها ضاحكة في المسجد الأموي، ومهجّرون يعودون إلى بيوتٍ لم يبقَ منها سوى الأنقاض، باحثين بين الركام عن ذكرياتهم التي تركوها خلفهم.
ورغم قرب المسافة بين المدن المحرّرة ومدن سيطرة الأسد سابقاً، حرمنا من التنقّل بين أراضينا، من العيش في بيوتنا ومدننا، وكان مصيرنا بين أصعب خيارين السجن أو المنفى إن نجونا من الموت .
مشاهد وصور كثيرة تستحق أن تُوثّق في متاحف تُخلّد هذه الثورة المباركة وهذا النصر المستحق، ومن بين الصور التي أعقبت تحرير حلب، برزت لقطةٌ خالدة حفرت حضورها في الذاكرة الجمعية: الثوار في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر يقفون أمام قلعة حلب، يرفعون العلم بنجومه الثلاث. ذلك العلم الذي ظلّ رايتنا، وسعى كثيرون للاصطفاف تحت ظلّه طلباً للقبول والتأييد. كان مشهداً يبدو مستحيلاً، وصورة لا يمكن للعقل أن يتخيّلها قبل تشرين.
سوريا خضراء بالكامل.
كما قالت الفنانة مي سكاف: هذه سوريا العظيمة، وليست سوريا بشار الأسد. في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 سقط “نظام الأبد”. هرب الأسد تاركاً خلفه كلّ من دعمه وتبنّى روايته طوال أ14 عاماً. لأول مرة أشعر بأنّ لديّ وطن… سمعتُ هذه العبارة عشرات المرات في ذلك اليوم. كنّا نختبر مشاعر لم نعرفها من قبل: كيف يمكن للإنسان أن يجتمع فيه الخوف والفرح معاً؟ كيف تضيق بنا مدن المهجر أمام اتّساع نشوتنا؟ كيف يرتفع صوت احتفالنا فوق ضجيج المنفى؟ وكيف تصبح الوجوه جميعها مألوفة، لدرجة أن نعانق أشخاصاً لم نلتقِ بهم من قبل؟ لقد ضحكنا وبكينا في اللحظة ذاتها؛ نعم، كانت تلك هي هستيريا الحرية.
صحيح أنّ بداية المعركة أعادت فتح جروح ظنناها اندملت، وأدخلتنا في تحديات جديدة: ملفات كبرى ما تزال عالقة، مثل وضع الجزيرة السورية والسيطرة عليها، ووضع السويداء في الجنوب، إضافة إلى الانقسامات والمشكلات المجتمعية، والاقتصاد المتهالك، والمؤسسات التي خلّفها النظام خراباً. ترك الأسد وراءه بلداً مدمّراً، بل منكوباً، يحتاج سنوات من العمل المضني. ومع ذلك، كلّ هذا ممكن لأنّنا انتصرنا: انتصرنا بخروج المعتقلين من زنازين الفروع الأمنية، وانتصرنا بعودة المهجّرين، وتحرّرنا من لقب لاجئ الذي حملناه كعبءٍ ثقيل طوال السنوات الماضية. تلاشى الخوف من المعتقل والحواجز والتشبيح. سقط وحش الإجرام وسقطت معه حاشيته، ولن يُسمح بتكرار مثل هذا النظام في بلدٍ دفع شعبه كلّ هذه التضحيات ليحيا حراً لا يقبل الظلم.
اليوم، بعد مرور عام على معركة ردع العدوان، نخوض المعركة الأصعب: معركة بناء الوطن، والحفاظ على مكتسبات الثورة، والعمل بقيمها الأولى: الحرية والكرامة والعدالة. مشاعر النصر صاخبة، لكنّها نضجت وتحوّلت إلى انتماءٍ راسخ. الطريق ليس سهلاً، وقد لا يكون الحاضر مريحاً، لكن معركة البقاء التي خضناها طوال سنوات أثبتت حقيقة واحدة: أنّ هذا الشعب، رغم كلّ ما مر به، ما زال قادراً على النهوض.
ويبقى السؤال الجوهري: ماذا سنقدّم لهذا الوطن؟ كيف نفي بدماء الذين رحلوا قبل أن يشهدوا هذه اللحظة؟ وكيف سنخرج -نحن السوريين جميعاً- من انتماءاتنا الفرعية لنضع الانتماء الأكبر لهذه الأرض فوق كلّ انتماء؟