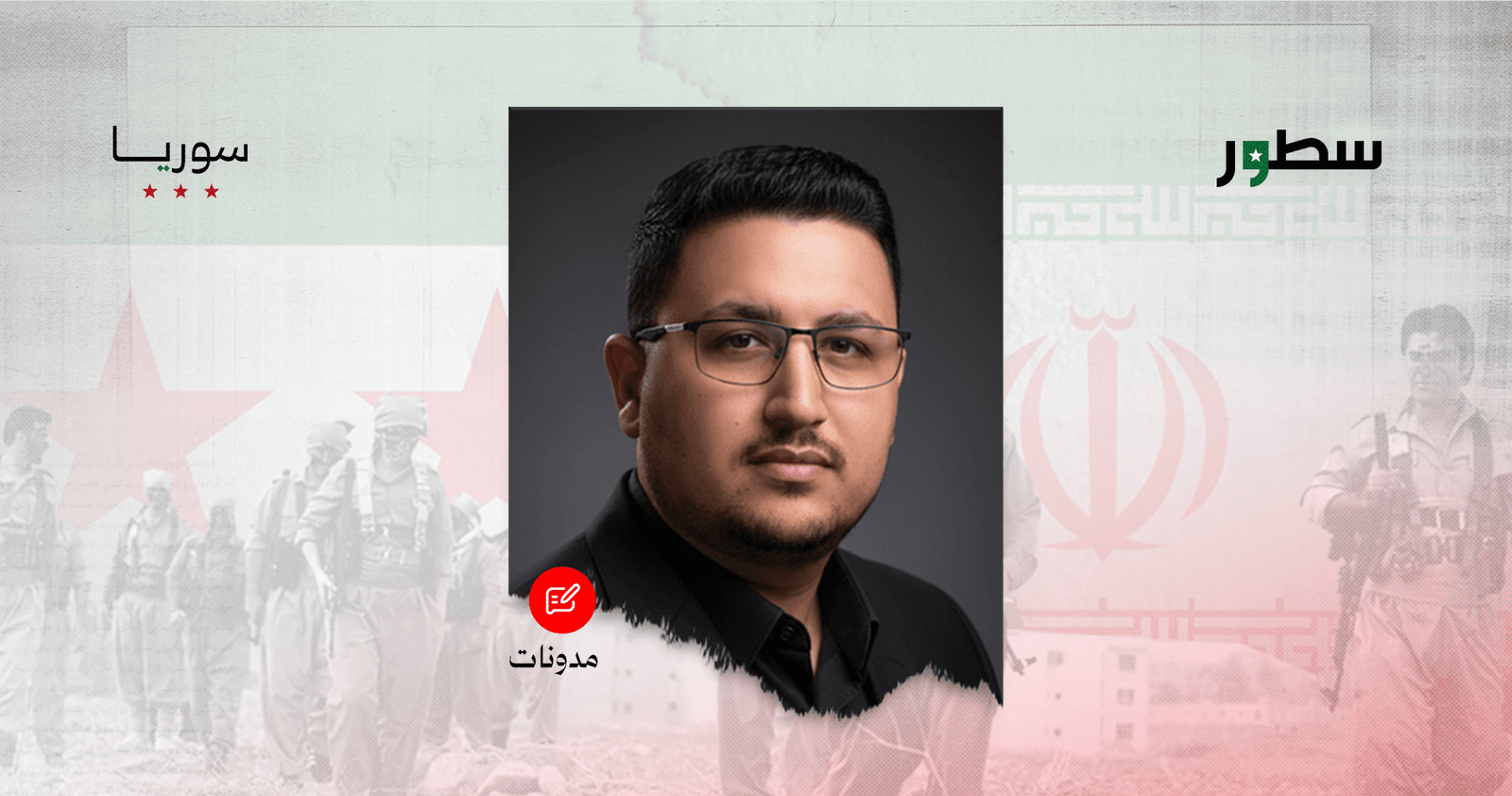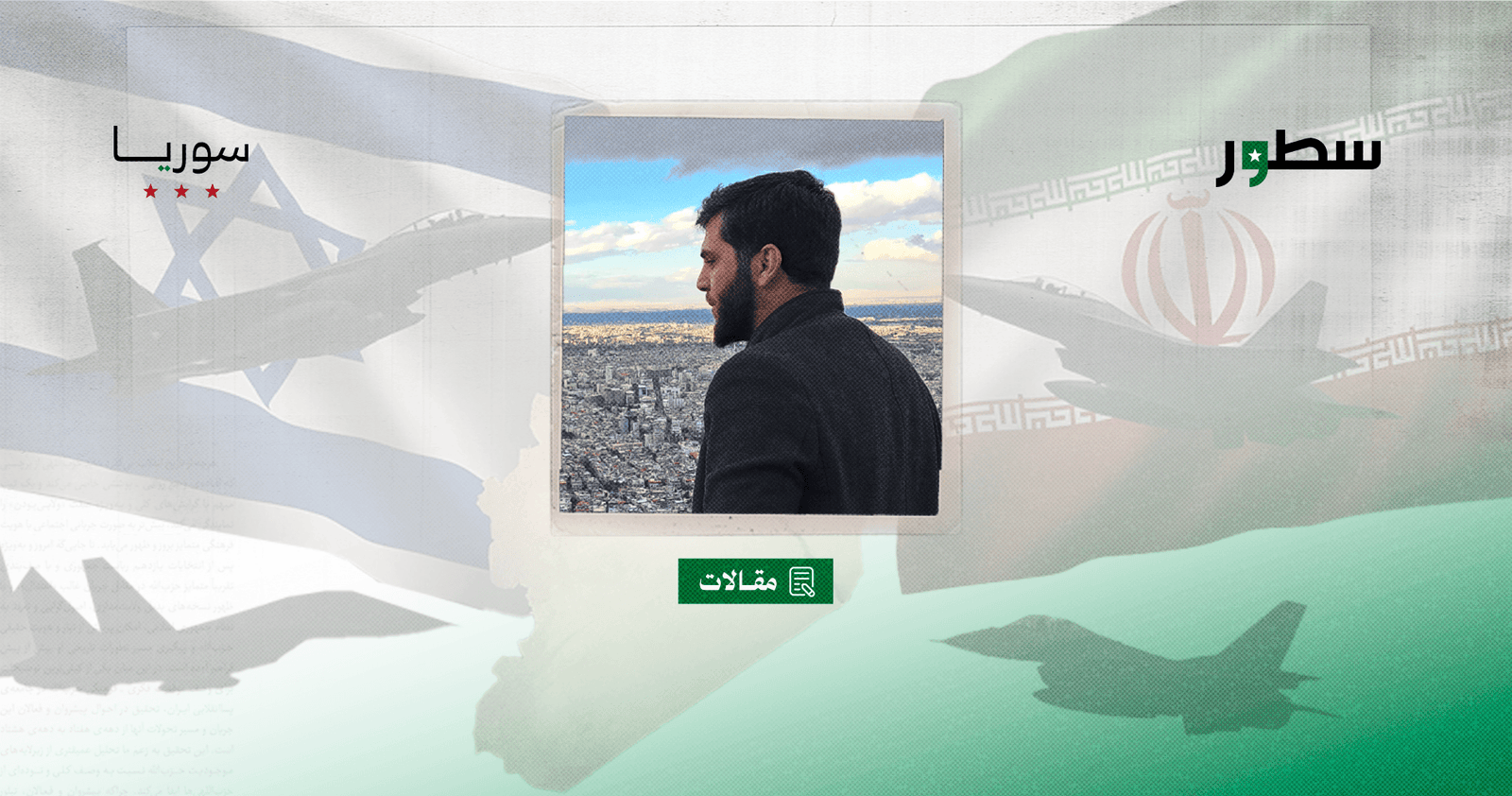سياسة
الشاهين التي غيّرت موازين “ردع العدوان”
الشاهين التي غيّرت موازين “ردع العدوان”
شهدت معركة “ردع العدوان” لحظة فارقة في تطوّر أساليب القتال داخل المشهد السوري، إذ شكّلت نقطة التقاء بين إرثٍ طويل من الابتكار العسكري غير التقليدي وبين واقع ميداني يفرض خيارات جديدة على الأطراف المتحاربة. فقد جاءت هذه المعركة في سياق تزايد الاعتماد على التكنولوجيا منخفضة الكلفة بوصفها بديلاً واقعياً عن الأنماط الثقيلة من التسليح، ما جعل الطائرات المسيرة تتقدّم تدريجياً نحو صدارة أدوات الاشتباك. وفي هذه البيئة المتحولة، برزت المسيّرات كعنصر لا يكتفي بدعم وحدات القتال، بل يسهم في إعادة صياغة الإيقاع العملياتي نفسه، ويمنح القوى الفاعلة قدرة أكبر على المناورة والتكيف وإرباك الخصم.
لقد أظهرت المواجهة أنّ امتلاك المعرفة التقنية لم يعد امتيازاً حصرياً للجيوش النظامية، بل أصبح قابلاً للانتقال والتطوير محلياً عبر شبكات صغيرة من الخبراء والمشغلين، الأمر الذي سمح بتسريع دورة الابتكار العسكري وتطويعه بما يتناسب مع متطلبات الميدان. ومع تراكم التجارب السابقة، تبلورت لدى الفاعلين المحليين قناعة بأنّ السيطرة على الفضاء القريب (لا الفضاء الجوي بالمعنى التقليدي)، باتت عنصراً حاسماً في أيّ عمليةٍ واسعة، وأنّ التفوق في هذا المجال يمنح ميزات تتجاوز حجم الطائرة ودقتها، ليصل إلى مستوى التأثير على المعنويات، وسير الحركة، وتوقيت الهجمات.
كما أتاحت هذه المرحلة الانتقال من استخدام المسيرة كأداة رديفة إلى التعاطي معها كجزءٍ من بنية قتالية متناسقة، تتفاعل فيها الحسابات التقنية مع الاعتبارات التكتيكية والنفسية في آن واحد. وبذلك أصبحت المعركة مناسبة لاختبار قدرة هذا السلاح على العمل في بيئةٍ تتسم بالتعقيد وكثافة العمليات، وما إذا كان قادراً على تقديم إضافة نوعية تتجاوز حدود التجريب النظري.
وانطلاقاً من هذه الخلفية، يحاول هذا المقال تقديم قراءة سردية وتحليلية لدور المسيرات خلال معركة “ردع العدوان”، مع التركيز على فهم الكيفية التي أسهمت بها في تشكيل مسار المواجهة، والحدود التي واجهتها، والدلالات التكتيكية التي يمكن استخلاصها من هذا التحول في بنية القتال المعاصر.
منذ الاستخدامات الأولى للمسيّرات لدى فصائل المعارضة كانت الفكرة في جوهرها استخباراتية واستطلاعية، كاميرات خفيفة للجمع البصري وتصحيح نيران المدفعية، لكن التجارب المبكرة سرعان ما أظهرت إمكانيات هجومية، خصوصاً بعد انتقال المعرفة التقنية من تجارب خارجية وتراكم مهارات الصانعين والمشغلين المحليين. وقد مهدت هذه المرحلة الأولى لتبلور قابلية تحويل المسيّرات إلى ذخيرة متفجرة قادرة على الوصول إلى نقاطٍ محصنة، ما دفع القادة الميدانيين لإعادة التفكير في موازين المخاطر والفائدة.
في معركة “ردع العدوان” خرجت هذه القابلية من نطاق الضربات المتفرقة إلى عمليات منظّمة وبأعدادٍ كبيرة. استخدمت الفصائل أسراباً من الطائرات الانتحارية (FPV) وأنواع معدّلة في تهديد مباشر للدبابات ومنصات المدفعية ومراكز القيادة الأمامية. السرد الميداني للمعركة يبيّن أنّ اعتماد تكتيك التمهيد الجوي عبر أسرابٍ متزامنة أدى إلى إحداث شلل مؤقت في سلاسل القيادة والتمركز، ما خلق نوافذ زمنية ثمينة أمام القوات البرية للتقدّم. هذا الأسلوب لم يكن نتيجة صدفة، بل تعبيرٌ عن فهم تكتيكي جديد لقيمة المسيرة كقذيفةٍ موجهة ذات تكلفة منخفضة نسبياً مقارنة بالسلاح التقليدي.
تكتيكياً اعتمدت الفصائل على دمج مهام مختلفة للمسيّرات:
- أولاً: ضربات انتحارية مركزة على المدرعات ومراكز إطلاق النار لتقليل قدرات النيران المضادة.
- ثانياً: مسيرات استطلاع تزوّد غرف العمليات بمعلومات آنية عن نتائج الضربات وتحركات الخصم.
- ثالثاً: مهام دعائية وتوثيقية عبر تسجيل إصابات وإرسالها كمواد إعلامية تُعزّز معنويات المقاتلين وتشكّل رسالة إلى الجمهور المحلي والإقليمي عن فعالية السلاح الجديد.
هذه اللوجستيات المتكاملة بين القتال والاستخبارات والدعاية جعلت للمسيّرات دوراً متعدد الأبعاد لا يقتصر على القضاء المادي فحسب.
مع ذلك، لم تكن الإمكانيات بلا قيود. تقنية المسيّرات الانتحارية، رغم تطورها المحلي، بقيت محدودة بالنطاق العملياتي والدقة في البيئات المعقّدة. الاعتماد على مكونات متاحة محلياً أو مستوردة بقدراتٍ متباينة أدى إلى تفاوت في الأداء. كما واجهت الفصائل مشكلات لوجستية في توفير قطع الغيار والبطاريات وأجهزة التوجيه ذات الكفاءة، فضلاً عن مشكلة التدريب على التشغيل والتنسيق بين وحدات المشاة والوحدات الجوية الصغيرة. هذه النقاط ظهرت بوضوح أثناء محاولات توسيع نطاق الهجمات أو عند مواجهة أنظمة تشويش متطورة.
أثر العوامل الخارجية كان أيضاً ملاحظاً. انتقال خبرات وتجارب من ساحات أخرى، ووجود شبكات تمويل ودعم تقني، سهّل زيادة كمية ونوعية المسيّرات المتاحة للفصائل. ومع ذلك، بقيت الاتهامات حول مصادر الدعم محط نقاش واستخبارات مضادة، إذ إن أجزاءً من تطوير الطائرة لا تنفك عن عناصر تصنيع وبرمجة تتطلب مهارات أعمق من ورش الصيانة التقليدية. هذا المزج بين تصنيع محلي وتلقّي خبرة خارجية شكّل عاملاً مهماً في بلوغ مستوى الأداء الذي شهدته معركة «ردع العدوان».
تأثير المسيرات على سلوك العدو كان ملموساً سريعاً. مواجهة تهديدات متكررة من أسرابٍ صغيرة دفعت قوات النظام إلى تغييرات تكتيكية شملت تشتت التحصينات، تعزيز دوريات الأمن القريب، ورفع جاهزية أنظمة الدفاع الإلكترونية والاعتماد على قواعد إمداد أكثر حماية. هذه التعديلات، رغم أنها حدّت من الخسائر المباشرة في بعض المحاور، لم تستطع إلغاء القدرة الضاربة للمسيّرات على نقاط محددة، لكنها رفعت كلفة الاستخدام الفعّال للدرونات وزادت متطلبات التخطيط لدى المهاجمين.
من زاوية التكلفة-الفعالية تُظهر المعركة أنّ المسيرات سلطت ضوءاً على مفهومٍ جديد في الحروب غير المتماثلة: إمكانية إحداث تأثير تكتيكي كبير بتكاليف مادية منخفضة نسبياً وبموارد محلية. كانت نتيجة ذلك إرباكاً مؤقتاً في مراكز القوة التقليدية وتقليصاً نسبياً في مزايا الدروع الثقيلة، على الأقل في الساعات الأولى من الهجوم. هذا الواقع الأخير جعل من تطوير قدرات مضادة للدروع والطائرات الصغيرة أولوية لدى الأطراف المدافعة، بما في ذلك زيادة الاستثمار في التشويش والاسقاط الإلكتروني.
تجارب “لواء الشاهين” تُعدّ حالة دراسية مهمة في هذه المعركة؛ فقد برز التحول من فرقة تجريبية إلى وحدة متخصصة قادرة على التخطيط والتوزيع والتنفيذ لعمليات بطولية نسبياً في ميدان محدود. هذا التطور التنظيمي يُعدّ مؤشراً على ارتفاع درجة الاحترافية في مجال المسيرات داخل صفوف المعارضة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مستقبل هذه الوحدات إذا ما توافر لها استقرار وتمويل طويل الأمد.
ختاماً، تترك معركة “ردع العدوان” إرثاً مزدوجاً:
- أثبتت المسيرات أنّها عنصر تغيير قادر على تعطيل معادلات تقليدية وإحداث تأثير تكتيكي جذري في مراحل الهجوم المبكّرة.
- أكّدت حدود هذا التأثير المرتبطة بالمدى، والدقة، والتزود، والتأثير المضاد من الخصم.
يتبيّن من مجمل ما أظهرته معركة “ردع العدوان” أنّ الطائرات المسيّرة لم تعد تفصيلاً تقنياً مكمّلاً، بل تحوّلت إلى ركيزة عملياتية تستوجب إعادة تعريف أسلوب إدارة المعركة في البيئات غير المتماثلة. فقد أثبتت التجربة أنّ امتلاك هذا النوع من الأنظمة لا يكفي لتحقيق التفوق، بل إنّ القيمة الحقيقية تكمن في القدرة على تشغيلها ضمن منظومة قتال متكاملة تتفاعل فيها الخبرة البشرية مع التطوير التقني، وتُستثمر فيها الإمكانات المحلية بأكبر قدر ممكن من الكفاءة. كما أظهرت المعركة أنّ التوسع في استخدام المسيّرات يفرض مسؤوليات جديدة على القوى التي تعتمد عليها، تشمل بناء وحدات تشغيل متخصصة، وتطوير برامج تدريب قادرة على مواكبة تطوّر المهارات المطلوبة، وتفعيل شبكات دعم فني ولوجستي تضمن الاستمرارية في البيئات القتالية المعقّدة.
وفي المقابل، أوضح سلوك الخصم وإجراءاته المضادة أنّ فعالية المسيرات ليست مطلقة، وأنّ قدرتها على التأثير مرتبطة بمدى قدرة الطرف المشغّل على تحسين الأداء، ومعالجة نقاط الضعف، ومواكبة تطور وسائل التشويش والإعاقة. وهذا يجعل الحاجة إلى إنتاج محلي مستدام، وإلى تطوير منظومات حماية رقمية وإلكترونية، شرطاً أساسياً للحفاظ على قدرة المسيّرات على إحداث أثر ملموس في مراحل الهجوم والدفاع على حدّ سواء.
وعليه، فإنّ الدرس الأوضح من المنظور العسكري يتلخّص في أنّ الطائرات المسيّرة خرجت نهائياً من إطار الاستخدام الهامشي لتصبح أحد أعمدة تكتيكات الحرب الحديثة، وأنّ التعامل معها يتطلّب مقاربة شاملة لا تقتصر على تحسين القدرات التقنية، بل تشمل أيضاً بناء تصور استراتيجي أوسع يضمن توظيفها بأعلى كفاءة ممكنة، وتقليل الهشاشة التي قد تنشأ عند الاعتماد عليها بصورة متزايدة. بهذه المقاربة فقط يمكن تحويل التفوّق التكتيكي الذي أظهرته المسيّرات في “ردع العدوان” إلى قدرة مستقرة وقابلة للاستمرار في معارك مقبلة.