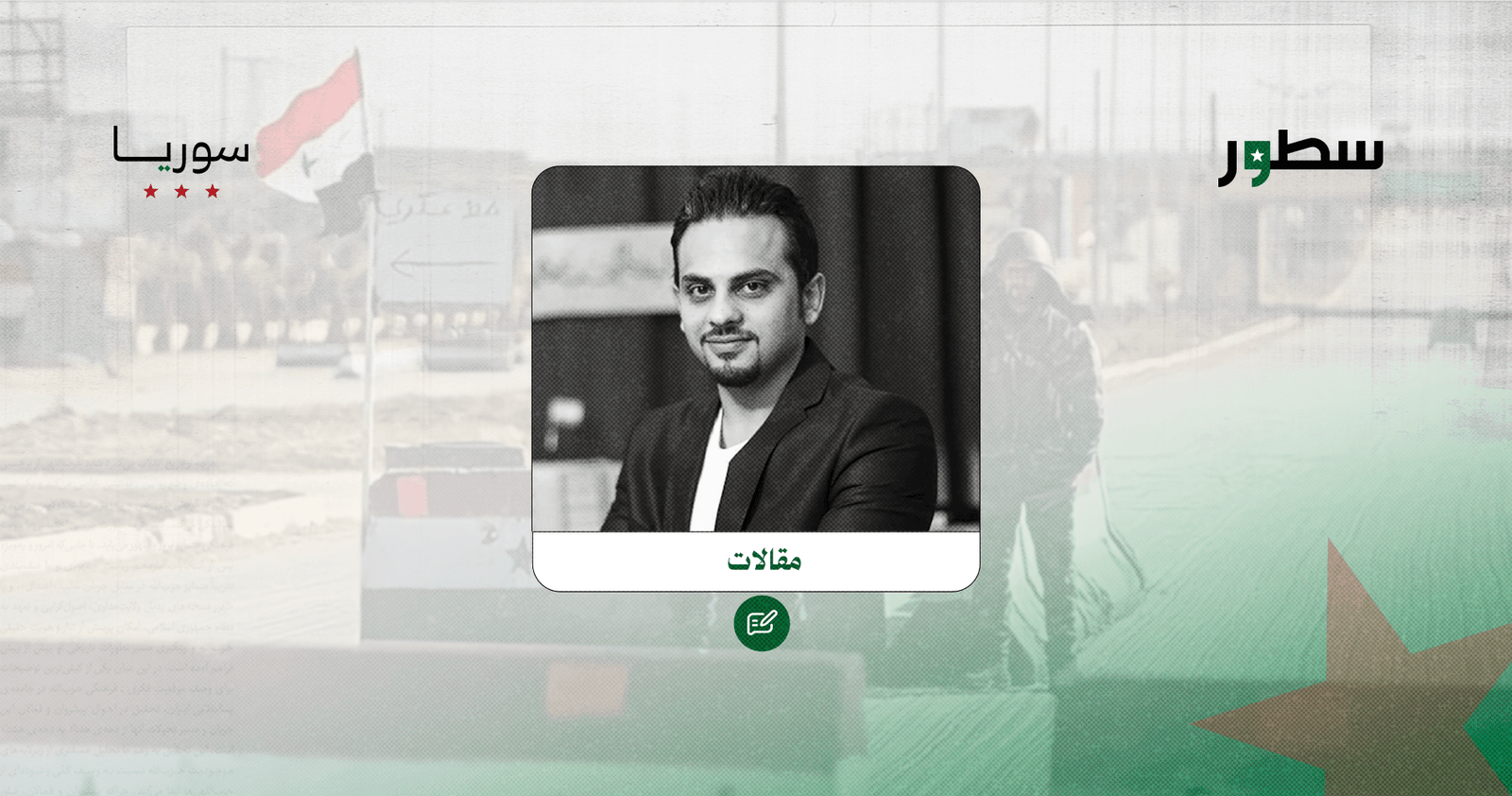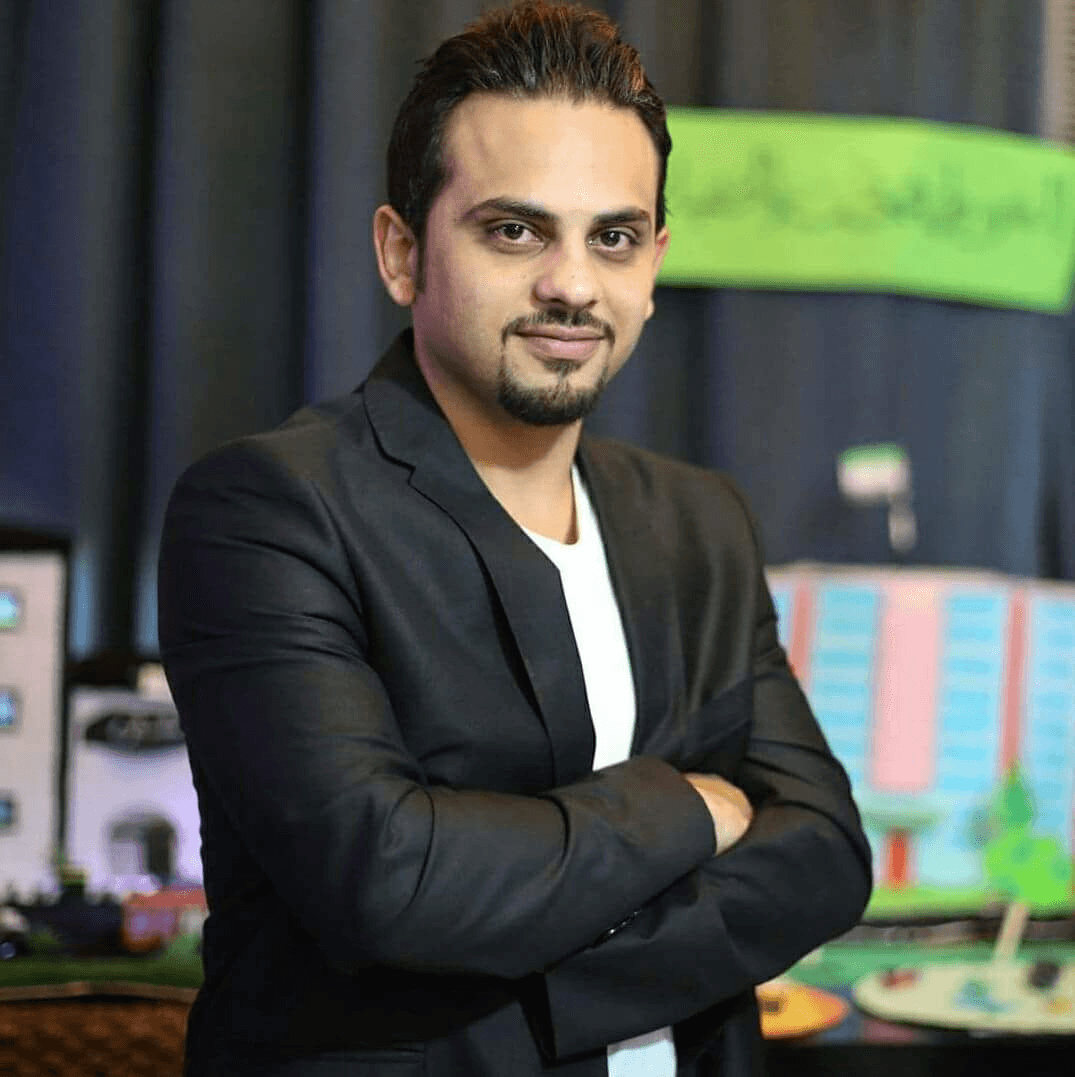سياسة
على حد السيف، حمص تروي قصتها
على حد السيف، حمص تروي قصتها
في الأيام الماضية، بدت حمص مدينة تمشي فوق حد السيف، تنهض من رمادٍ لا يبرد، وتعيد اكتشاف هشاشة الإنسان حين تشتعل العصبيات القديمة وتتكشّف النفوس على حقيقتها. حمص التي ذاقت من الأسد وعصاباته ويلات الموت والدمار، مدينة لم تسلم فيها عائلة واحدة من جرح، شهيد غاب أو معتقل لم يعد، منذ انطلاق الثورة السورية ضد نظام الأسد.
صبيحة الأحد الماضي استيقظ أبناء حمص، ومعهم السوريون جميعاً، على جريمة مروّعة في بلدة زيدل جنوب المدينة. زوجان قتلا بوحشية، كُتبت على جدران منزلهما عبارات طائفية مثل “يا حسين” و”بنو سمية” بدمائهما، ثمّ أحرقت جثتاهما. لم يكن الحدث مجرّد جريمة قتل، بل محاولة متعمّدة لنكء الجرح الطائفي وجرّ المدينة إلى هاوية تعرفها جيداً.
عقب الجريمة انتشر الأمن العام بسرعة في البلدة والأحياء المحيطة، مؤمّناً الطرقات ومحيط منازل المدنيين، ومُحبطاً أيّ محاولة لاعتداءات متبادلة بين السكان من الطائفتين السنية والعلوية. انتشرت مقاطع مصوّرة تُظهر عناصر الأمن وهم يرافقون عائلات من أبناء الطائفة العلوية ويوصلونهم إلى منازلهم، في محاولةٍ واضحة لاحتواء الغضب ومنع اشتعال الفتنة.
ومع ذلك، ظلّ الدرس القديم يقول عبارته المشهورة: إنّ المدن التي لم تتصالح مع ذاكرتها، تظلُّ سريعة الاشتعال، يكفيها جرح صغير كي تنفجر.
في صباح اليوم التالي ظهرت على السطح أسماء تجيد العزف على وتر الجراح المفتوحة. خرج بيان للمدعو “غزال غزال”، الذي يقدّم نفسه كممثل ديني للطائفة العلوية في سوريا، الرجل الذي ارتدى يوماً عباءة “الناشط المظلوم”، قبل أن يتكشّف لاحقاً أنّه أحد صُنّاع الانقسام في سوريا، وهم كثر في غرب البلاد وشرقها. دعوته إلى “الغضب والخروج إلى الشارع” لم تحمل روح بناء أو دعوة لتهدئة النفوس، بل جاءت مشبعة بنبرة الوقود الذي يُسكب على نار لم تنطفئ بعد.
غزال غزال، لمن لا يعرف صورته الحقيقية، ليس شاباً حالماً بمدينة أفضل، بل صاحب تاريخ طويل في ركوب الموجات والاتكاء على الفوضى لتحويل كلّ حدث إلى منصةٍ شخصية. أمّا أخوه موفق، فاسمه مرتبط بملفات موثقة من الانتهاكات في أحياء حمص خلال سنوات الثورة، من اعتقالاتٍ تعسفية، وضرب، وابتزاز، واستغلال.
هذه الخلفيات ليست تفاصيل هامشية، بل هي المفتاح لفهم سبب تعامل أهل حمص مع بيان غزال كعودةٍ لشبحٍ يلوّح بماضيه، لا كنداء إصلاح أو مطلب حقوق. فالدعوة لم تُقرأ كصرخة مظلوم، بل كمحاولة متجددة لفتح باب أغلقه السوريون بعد أن دفعوا ثمنه دماً وروحاً وعمراً.
تلبية لتلك الدعوة، خرجت في 25 تشرين الثاني مظاهرات واعتصامات في اللاذقية وطرطوس، رفعت شعارات عن “اللامركزية” و”الإفراج عن الموقوفين”. غير أنّ جوهر المطالب لم يكن سياسياً أو إصلاحياً كما حاول منظّموها إظهاره، بل التفاف مكشوف حول أسماء معروفة بارتكاب انتهاكات ثقيلة خلال سنوات الثورة، من ضباط وعناصر أمن تورطوا في التعذيب والقتل والإخفاء القسري، وما تزال أمهات ضحاياهم يحفظن وجوههم بالذاكرة كما تُحفظ الندبة على الجلد.
المفارقة الصارخة أنّ هؤلاء الذين تُرفع صورهم اليوم على أنّهم “موقوفون ظلماً” هم أنفسهم من تلطخت أيديهم بدماء السوريين، من فُتحت لهم السجون وأقبية التحقيق كي يمارسوا سلطتهم السوداء على المدنيين، قبل أن تنقلب موازين القوى، ويجدوا أنفسهم خلف القضبان. المطالبة بإطلاق سراحهم ليست دفاعاً عن الحرية، بل محاولة مموهة لاستعادة الشبكات الأمنية التي ترعرعت على القمع، وإعادة تمكين رجالٍ سقطوا أخلاقياً قبل أن يسقطوا قانونياً.
ما جرى في الساحل لم يكن حراكاً اجتماعياً بقدر ما كان إعادة تدوير لوجوه الماضي في لحظة فراغ سياسي. فرفع شعارات “الإصلاح” بينما يجري الدفاع عن أشخاص موثّقين بجرائم حرب هو تناقض لا يخفى على أحد. لا يمكن لمظاهرة تبحث عن العدالة أن تبدأ بمطالبة تُهين ذاكرة الضحايا، ولا أن تستحضر أسماء ارتبطت بالقهر لتقدّمها كضحايا جدد.
ورغم أنّ صوت المطالبين والمتظاهرين مألوف لكثير من السوريين خلال سنوات الثورة وما تلاها، إلا أن ما لم يكن مألوفاً في ذاكرتهم، هو اتخاذ قوات الأمن موقع الحماية للمتظاهرين لا موقع الهجوم، فلم تدفع الأجساد نحو الجدران لإخماد الغضب بالقوة، ولم تمل الزنازين بالمتظاهرين رغم إنكارهم المذبحة السورية بطلبهم إطلاق سراح الموقوفين على ذمة الجرائم التي ارتكبوها.
وقفت قوى الأمن العام في المساحة الرمادية بين الاحتجاج والفوضى، تدير التوتر بدل أن تشعله، وتحول دون أن تتحوّل لحظة غضب إلى كارثة. هذا التبدل لا يمحو سنوات طويلة من الخوف، لكنّه يلمّح إلى أنّ التعامل الأعمى مع الشارع بدأ يتراجع، وأنّ صون الحياة لم يعد فكرة ترفية بل ضرورة وجودية لبلد أنهكته المقابر.
يعيب بعض السوريين على من يتوقف عند هذا المشهد ويشير إليه بإيجابية، معتبرين أنّ ما جرى ليس إنجازاً، بل مجرّد واجبٍ بديهي على أيّ دولة. لكن هذا الاعتراض، رغم وجاهته من حيث المبدأ، يتجاهل الواقع السوري الذي عاشته المدن لسنواتٍ طويلة، حيث كان خروج الناس إلى الشارع يعني تلقائياً الدم، والرصاص، والاعتقال، وحضور الموت قبل حضور القانون. أن تقف قوات الأمن اليوم في موقع الحماية لا القمع، وأن تُضبط الأعصاب بدل أن تُستباح الأرواح، ليس فضلاً من أحد، لكنّه تحول يجب تسجيله، لأنّه يعيد تعريف القاعدة بعد أن كانت الاستثناء. وإذا كان ما حدث “طبيعياً” من حيث الأصل، فهو غير طبيعي إطلاقًا مقارنةً بما اعتاده السوريون. لهذا، فإن الإشارة إلى هذا التحول ليست تطبيلاً ولا تجميلاً، بل محاولة لقول إنّ ما هو طبيعي في العالم، بدأ أخيراً يجد طريقه إلى سورية، ولو ببطء مؤلم.
في خاتمة هذا المشهد المرير، لا بد لنا أن ندرك جميعاً أنّ النار الطائفية التي تُشعلها أيّ جهة أو جماعة، ما هي إلا شرارة تقود سوريا إلى هاوية بلا نهاية، حيث لا رابح سوى من اختبأ وراء جدران الذنب، متحججاً بجراح الجميع ليحمي نفسه. ومن لا يرى أنّ ابن طائفته يجب أن يُحاسب عمّا اقترفت يداه، يكون شريكاً في الجريمة، فلا سلام دون عدالة، ولا أمل يُبنى على ظلم يُغطى بصمت أو تواطؤ.