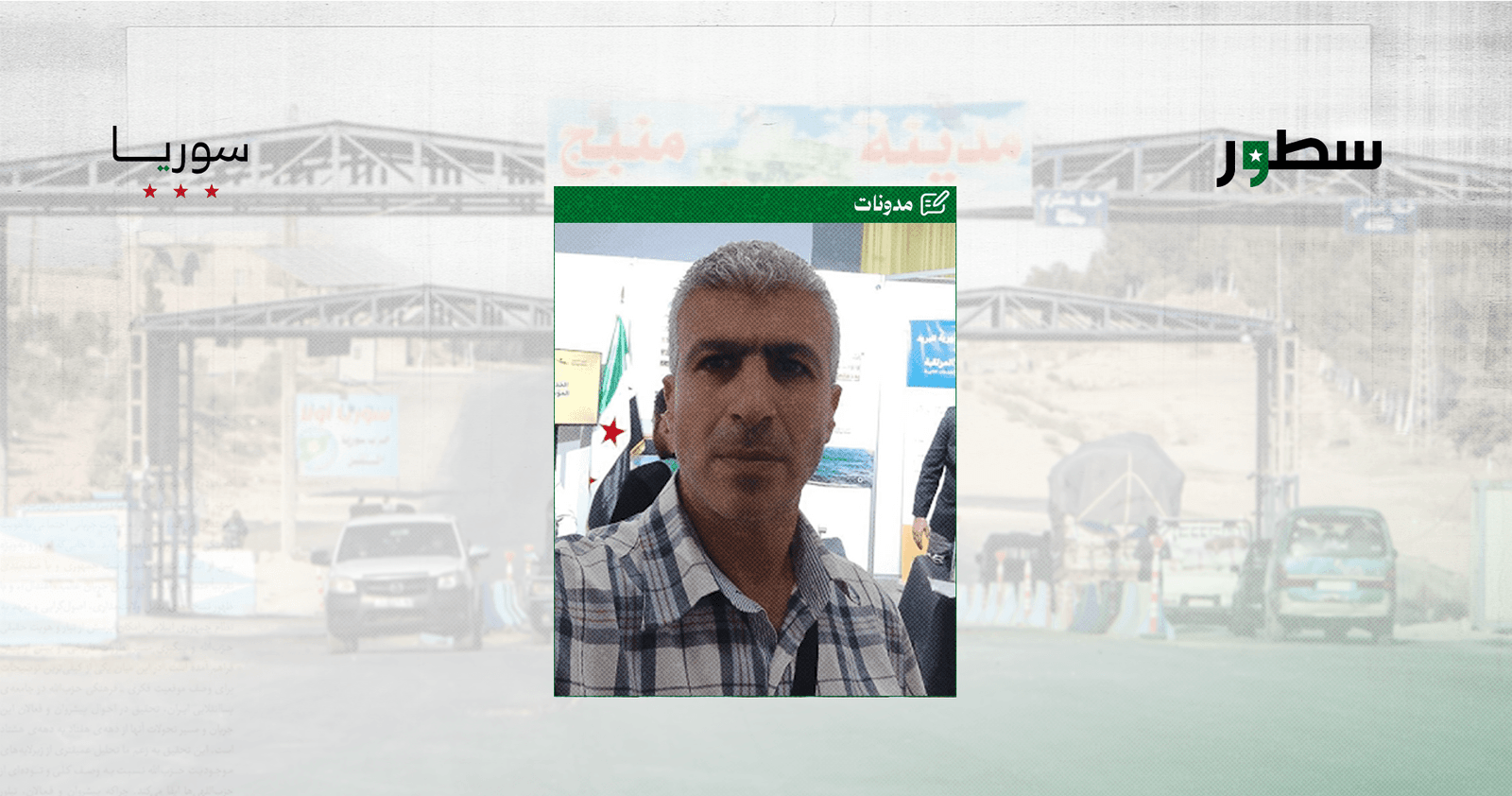مدونات
الصداقة كمرآة للذات: فلسفة اللقاء الإنساني بين العقل والعاطفة
الصداقة كمرآة للذات: فلسفة اللقاء الإنساني بين العقل والعاطفة
الكاتب: عبدالرحمن حسنيوي
هل يمكن للصداقة أن تكون طريقًا إلى الحقيقة؟ وهل يستطيع الإنسان أن يعرف ذاته ما لم يطلّ على مرآة الآخر؟ هذه الأسئلة تقودنا إلى عمق التجربة الإنسانية كما يصوغها أبو حيان التوحيدي (310 – 414 هـ / 922 – 1023 م) في كتابه الشهير الصداقة والصديق، حيث تتحوّل الصداقة من مجرّد رابطة وجدانية إلى تجربةٍ معرفية وروحية، تنكشف فيها النفس على حقيقتها، ويُختبر فيها العقل في أرفع درجاته الأخلاقية. فالتوحيدي، وهو من أكثر المفكرين حساسية تجاه العلاقة الملتبسة بين الفكر والعاطفة، يرى أنّ الصديق ليس مجرّد شريكٍ اجتماعي، بل كائن يفتح للإنسان أفقًا جديدًا لفهم ذاته والعالم من حوله.
في زمنٍ يتسع فيه فراغ المعنى ويثقل الشعور بالعزلة، يعيد التوحيدي إحياء مفهوم الصداقة بوصفها فضاءً للفكر والتزكية، لا للتسلية العابرة أو المنفعة المؤقتة. إنّه يستحضر الحكمة اليونانية التي صاغها أرسطو حين قال إنّ “الصديق مرآة لصديقه”، ويربطها بالموروث الإسلامي الذي يجعل من الأخوة قيمة أخلاقية تنبع من صفاء القلب واستقامة العمل. ومزجه بين الوافد والموروث ليس جمعًا ميكانيكيًا، بل إعادة بناء للمفهوم داخل رؤية فلسفية تجعل من الصداقة اختبارًا للإنسان في حدود الخير والشر، والمعرفة والجهل، والأنانية والعطاء. فالصديق عنده امتداد للذات في عالمٍ يضجّ بالزيف، واللقاء الحقيقي لا يتحقق إلا حين يتجاوز كلّ واحد حدود الأنا ليصل إلى منطقة الوعي المشترك، حيث يتحرّر الفرد من ضيق ذاته عبر الآخر.
لقد أدرك التوحيدي أنّ الصداقة ليست عاطفة زائلة، بل فعل عقلي وروحي يربط المعرفة بالأخلاق؛ لأنّ الصديق ليس من يُسعدك فقط، بل من يعيدك إلى ذاتك حين تنحرف، ويقف في وجه أخطائك حين تضل. وفي هذه النقطة يلتقي فكره مع ما قاله مارتن هايدغر: “الوجود مع الآخرين ليس حالة اجتماعية، بل شرط وجودي للإنسان”. وهكذا تتحوّل الصداقة إلى تجربةٍ وجودية يصبح فيها الآخر وسيلة لاكتشاف معنى الوجود، ويتحوّل فيها التبادل بين الأصدقاء إلى مشاركة في السؤال عن ماهية الإنسان نفسه.
ويرى التوحيدي أنّ الصداقة الحقّة لا تقوم على تبادل المنفعة، بل على الإخلاص في الفهم والمودة، وهي بهذا امتداد للتربية ولجملة القيم التي تنهض عليها الحياة المدنية. فالحياة المشتركة، كما يصورها، ليست ميدانًا للمجاملات، بل حقلًا لاختبار الأخلاق وامتحان المواقف. وهذا المعنى يجد صداه في الفكر الغربي المعاصر لدى إيمانويل ليفيناس الذي يؤكد أنّ “الآخر ليس موضوعًا للمعرفة، بل مسؤولية أخلاقية تفرض نفسها قبل أن تُفهم”، ممّا يجعل من الصداقة ميدانًا للمسؤولية قبل أن تكون علاقة وجدانية أو فكرية.
ويقف التوحيدي في رؤيته للصداقة على تخوم الفلسفة والأدب، حيث تصبح اللغة نفسها وسيلة للبحث في النفس، لا مجرّد أداة للتعبير عنها. ومن هنا تأتي مساءلته لطبيعة الصداقة في لحظات النعمة والمحنة، ووضعها في قلب التجربة الإنسانية بكلّ تناقضاتها. فالصديق يُختبر في الشدة، وتنكشف حقيقته حين تنطفئ الزينة وتُختبر النوايا. وهذه الفكرة تتقاطع مع رؤية فريدريك نيتشه للصداقة بوصفها “فنًا للبعد بقدر ما هي فن للقرب”، أيّ علاقة تحافظ على المسافة الضرورية بين الأنا والآخر، كي ينمو كلّ طرفٍ دون أن يذوب في الآخر.
إنّ تجربة التوحيدي في كتابه ليست تنظيرًا أخلاقيًا جامدًا، بل تأملًا في الحياة بوصفها تفاعلًا دائمًا بين العقل والعاطفة. فالعقل، في نظره، لا يكتمل إلا حين يتذوق معنى المودة، والعاطفة لا ترتقي إلا حين تستنير بالفكر. ولذلك تصبح الصداقة ممارسة فلسفية تكشف أنّ التفكير في الآخر طريق لفهم الذات. وربما لهذا قال تشارلز تايلور إنّ “الذات لا تتشكل في العزلة، بل في شبكة من الاعتراف المتبادل”، وهو ما يعزّز فكرة أنّ الإنسان لا يصير ذاته إلا بقدر ما يعترف بغيره.
وفي النهاية، تتحوّل الصداقة عند التوحيدي إلى تجربة إنسانية عميقة تعيد تعريف العلاقة بين العقل والقلب، بين الذات والعالم. إنّها بحث عن جوهر الإنسانية كما تُمارس لا كما تُدرَّس، وتجسيد لفكرة أنّ الأخلاق ليست قوانين مكتوبة، بل مواقف حيّة تُختبر في الواقع. فحين يكتب التوحيدي عن الصديق، فإنّه يكتب عن الإنسان الممكن، الإنسان الذي يسكن فينا ونبحث عنه في الآخرين. وبمقياس هذا الفهم، تصبح الصداقة، كما قال بول ريكور، “ذاكرة للخير في عالم ينسى بسرعة”، أيّ شكلٍ من أشكال المقاومة ضد تفكّك القيم وضياع المعنى.
وهكذا يقدّم التوحيدي نموذجًا فلسفيًا للصداقة يتجاوز حدود الزمن، يربط الفكر بالحب، والمعرفة بالتزكية، والوجود بالتواصل، ليذكّرنا بأنّ الإنسان، في جوهره العميق، لا يُعرف بما يملك أو بما يعرف، بل بمن يحب وكيف يحب.