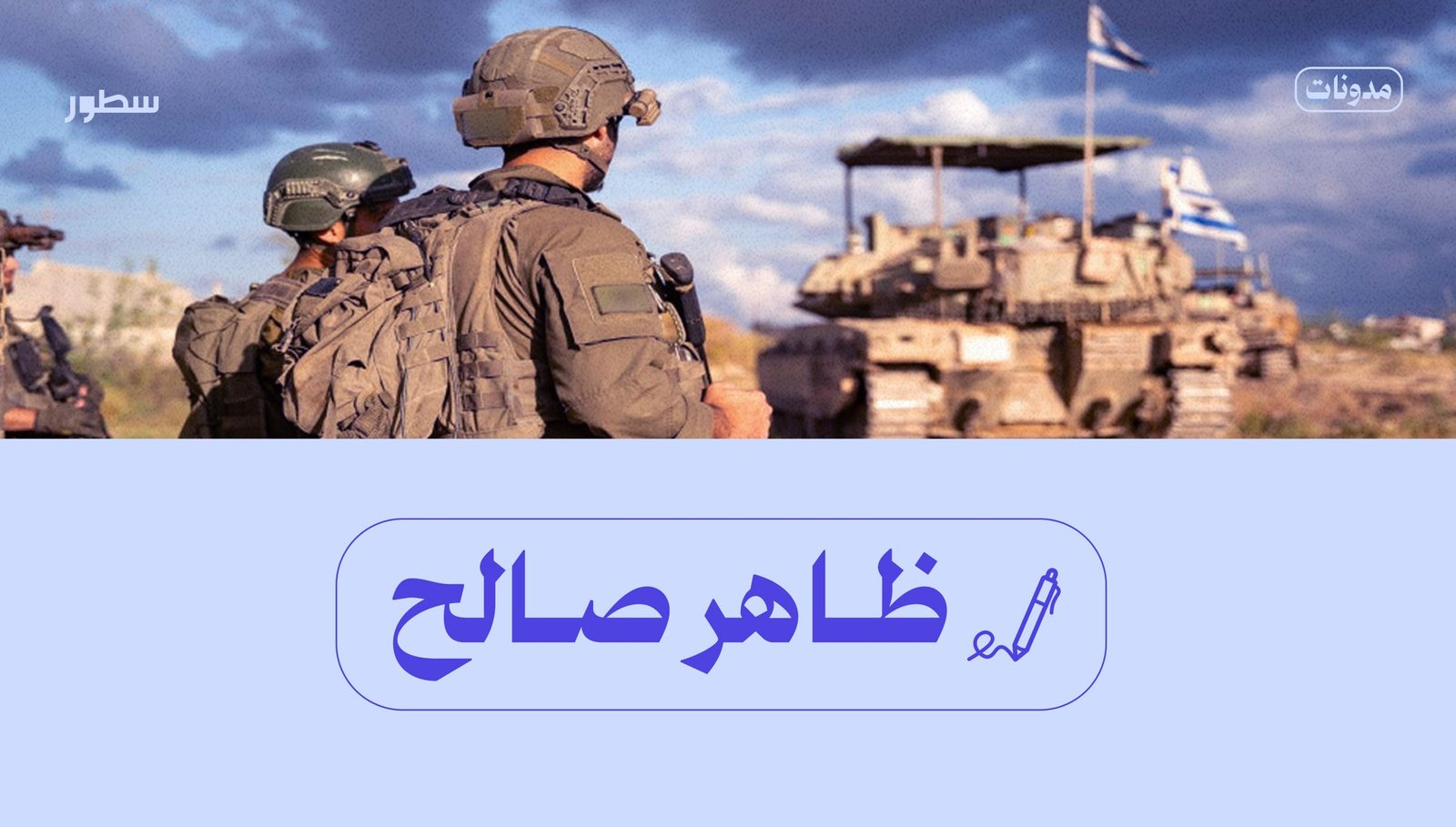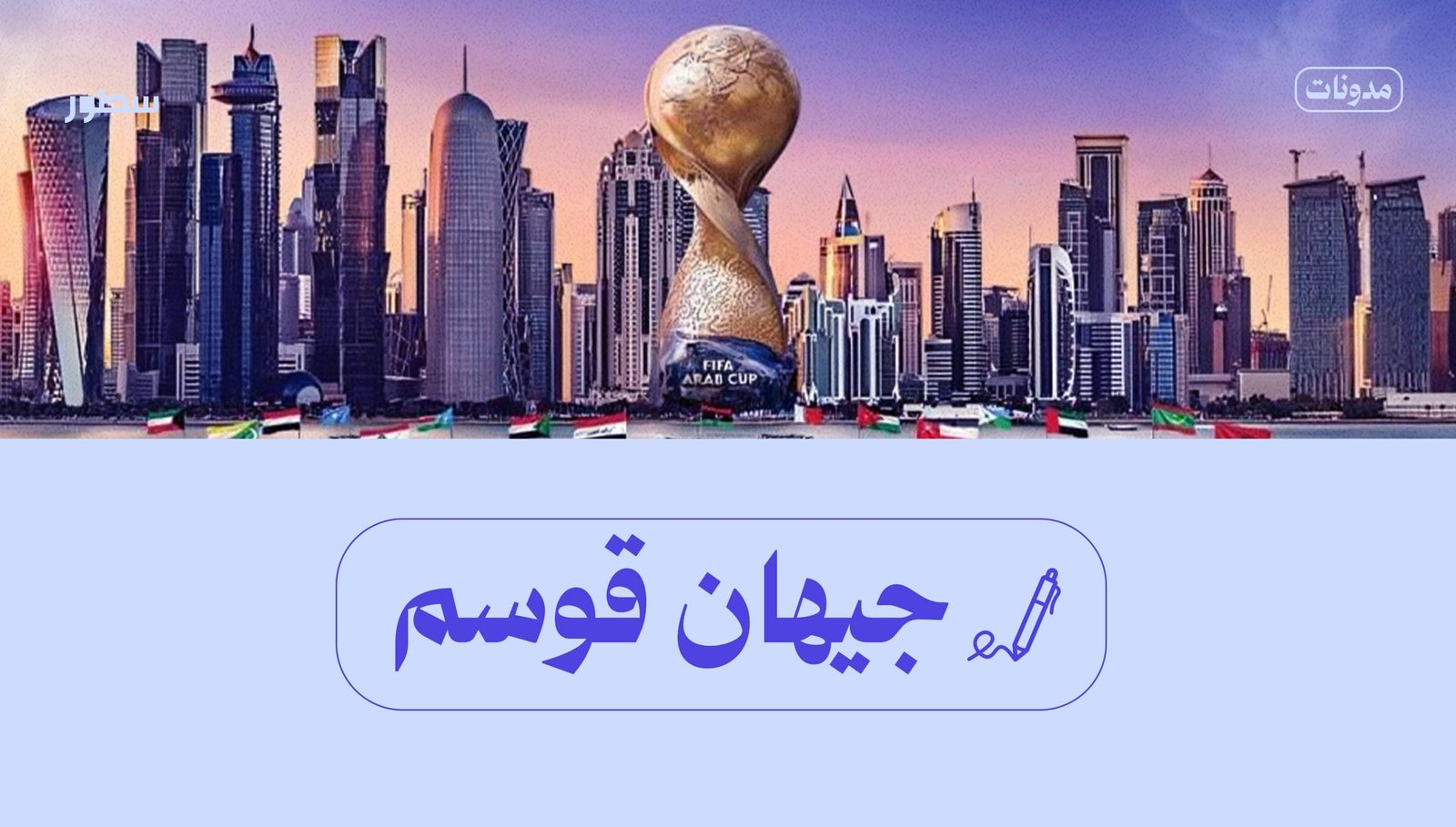مدونات
ثلاثية غرناطة وفلسطين!
ثلاثية غرناطة وفلسطين!
الكاتبة: إيمان فتحي
لا أعلم إن كانت هناك كلمات قادرة على التعبير عمّا شعرتُ به أثناء قراءتي لتلك الرواية. لا تربطني علاقة قوية برضوى عاشور وبأعمالها الأدبية، إذ لم أقرأ لها سوى رواية «فرج»، تلك الرواية التي لامستني بعمق. قرأتها دون أن أعرف اسم كاتبتها أو أيّ خلفيةٍ عنها، لكنّني، ومن بين سطورها، أدركت أنّ من كتبتها تحمل روحًا ثائرة، متمرّسة في فن الاعتراض. أيقنت حينها أنّ الكاتبة لا يمكن أن تكون سوى رضوى عاشور، تلك التي تمزج النضال بالكتابة، والاحتجاج بالأسلوب الهادئ العميق، وتجعل من الكلمة أداة مقاومة.
وتأكد حدسي تمامًا حين قرأتُ لاحقًّا كتابها الأخير «أثقل من رضوى»، الذي اختتمت به رحلتها العظيمة والمؤثرة، وكأنّها كانت تكتب سيرتها الأخيرة بوعيها الكامل بقرب الرحيل. كتاب لا يُظهر إلا امرأة من طرازٍ نادر، تقاوم المرض كما قاومت الفساد والإهمال في الحياة الجامعية، وتواجه الصعاب بإصرار، بينما تتحمل غياب زوجها وابنها وسفرهما المتواصل، وتعيش همّ الوطن كأنّه همّها الشخصي.
برغم الألم والجراح، لم يكن يشغلها إلا الاطمئنان على الميدان وعلى شباب الثورة، وحين عادت إلى مصر لم تتردد في النزول إلى ميدان التحرير، لتشارك بنفسها في ذلك الحدث التاريخي.
قوةٌ عهدتُها في هذه الكاتبة العظيمة، ومع ذلك، أشعر دائمًا أنّني لا أعرف عن “السيدة راء” إلا القليل، وأنّ كلّ عملٍ جديد أقرأه لها يكشف لي وجهًا جديدًا من عوالمها، حتى قررت أن أقرأ ما يصفه الكثيرون بأنّه أهمّ أعمالها: «ثلاثية غرناطة».
اكتشفتُ حينها أنّ رضوى عاشور تستحق أن تُلقّب بـ”رائدة السهل الممتنع”. تقرأها فتجد البساطة في الحوار واللغة، لكنّك تشعر في الوقت نفسه بعمقٍ فكري وأدبي نادر. فبينما يختلف القرّاء في تفضيلاتهم بين الفصحى والعامية، تقف رضوى في منتصف المسافة، تجمع بين صفاء اللغة ورهافة القرب من الناس، حتى يخيّل إليك أنّ كتابتها عامية مألوفة، لكنّها في الحقيقة فصحى رشيقة لا غبار عليها. ولهذا يتفق الجميع على فرادة أسلوبها.
أما «ثلاثية غرناطة»، فهي بحقّ رحلة عبر آلة الزمن. منذ الصفحة الأولى، تأخذ رضوى القارئ بيده إلى الأندلس؛ إلى تلك الجنة الخضراء التي كانت يومًا لنا. لم تجد الكاتبة أفضل من بيتٍ صغير في حيّ البيازين، بيتٍ تنبع منه أصالة التاريخ وعبق الذكرى، لتجعله محور حكايتها: بيت أبي جعفر الورّاق، وزوجته أم جعفر، وزوجة ابنه المتوفى أم حسن، والأحفاد سليمة وحسن.
تمتدّ أحداث الرواية عبر قرنٍ ونصف، ويتحوّل هذا البيت من موئل للسكينة إلى شاهد على الانكسار. تبدأ الحكاية بأخبار سيطرة الإسبان الوشيكة على الحيّ، ثمّ تتصاعد التوترات، ويقاوم الناس، لكن الاحتلال يفرض سلطته. يكبر الأحفاد، فتتزوج سليمة من سعد، وحسن من مريمة، وتشتدّ قبضة الإسبان، حتى يصدر المرسوم القاضي بتنصير جميع سكان المدينة، ومنع الأذان والصلاة، وحرق كلّ كتابٍ عربيّ، بما في ذلك القرآن الكريم.
وفي مشهدٍ بالغ القسوة، يُحرَق القرآن أمام أعين الناس، وأمام أعين أبي جعفر الورّاق الذي كان ينسخ الكتب بيده. لم يحتمل المشهد، فسقط ميتًا بين الجموع، عاجزًا عن رؤية دينه ولغته يُبادان، وكأنّه تمنّى الموت قبل أن يُجبر على حضور القدّاس بدل صلاة الجمعة. فتحوّل البيت الذي كان عامرًا بالحياة إلى بيتٍ للحزن والفقد.
أما سليمة، حفيدته، فقد تحققت فيها نبوءته بأنّها ستكون ذات شأن. أخفت الكتب العربية وبدأت رحلة علمٍ ومقاومةٍ في الخفاء. كانت تداوي المرضى وتعلّم الناس، حتى ذاع صيتها، فاتهمها الإسبان بأنّها “مسكونة بالشيطان”، وأُعدِمت أمام الناس، بعد أن رفضت الانصياع، تاركةً وراءها طفلتها عائشة التي تولّت تربيتها مريمة بكلِّ إخلاص.
ومع مرور الأجيال، صار بعض أهل البيازين يعلّمون أبناءهم العربية في السر، ويوصونهم بالحفاظ على دينهم وهويتهم، مثلما فعل حسن مع حفيده علي، بينما استسلم آخرون، وتوقّفوا عن ذكر الإسلام أو اللغة أمام أولادهم، فنشأت أجيالٌ لا تعرف من الإسلام سوى اسمه.
وفي الجانب الآخر، بقيت محاولات المقاومة قائمة، لكنّها فشلت مرارًا، حتى مات معظم أفراد العائلة، ولم يبقَ سوى علي، الذي شهد النهاية المأساوية حين فُرض الترحيل القسري. ماتت مريمة في الطريق، غير قادرة على فراق بيتها وأرضها، باكيةً حسرة القرون الضائعة.
تنقلنا رضوى ببراعةٍ بين الأماكن والأزمنة، فنشعر أنّ ما تصفه لا يخصُّ الأندلس وحدها، بل يشبه ملامحنا نحن؛ في مصر أو المغرب أو الشام. جعلت من غرناطة أقرب إلينا، كي لا نعتبرها تاريخًا بعيدًا، بل قطعة منّا ضاعت بتقصيرنا.
هي لم تكتب لتُبكينا على الماضي، بل لتذكّرنا بأنّ التاريخ يعيد نفسه حين نغفل.
وأنا — بعد أن أغلقت الكتاب — لم أملك إلا أن أقول: أخاف على فلسطين منّا…