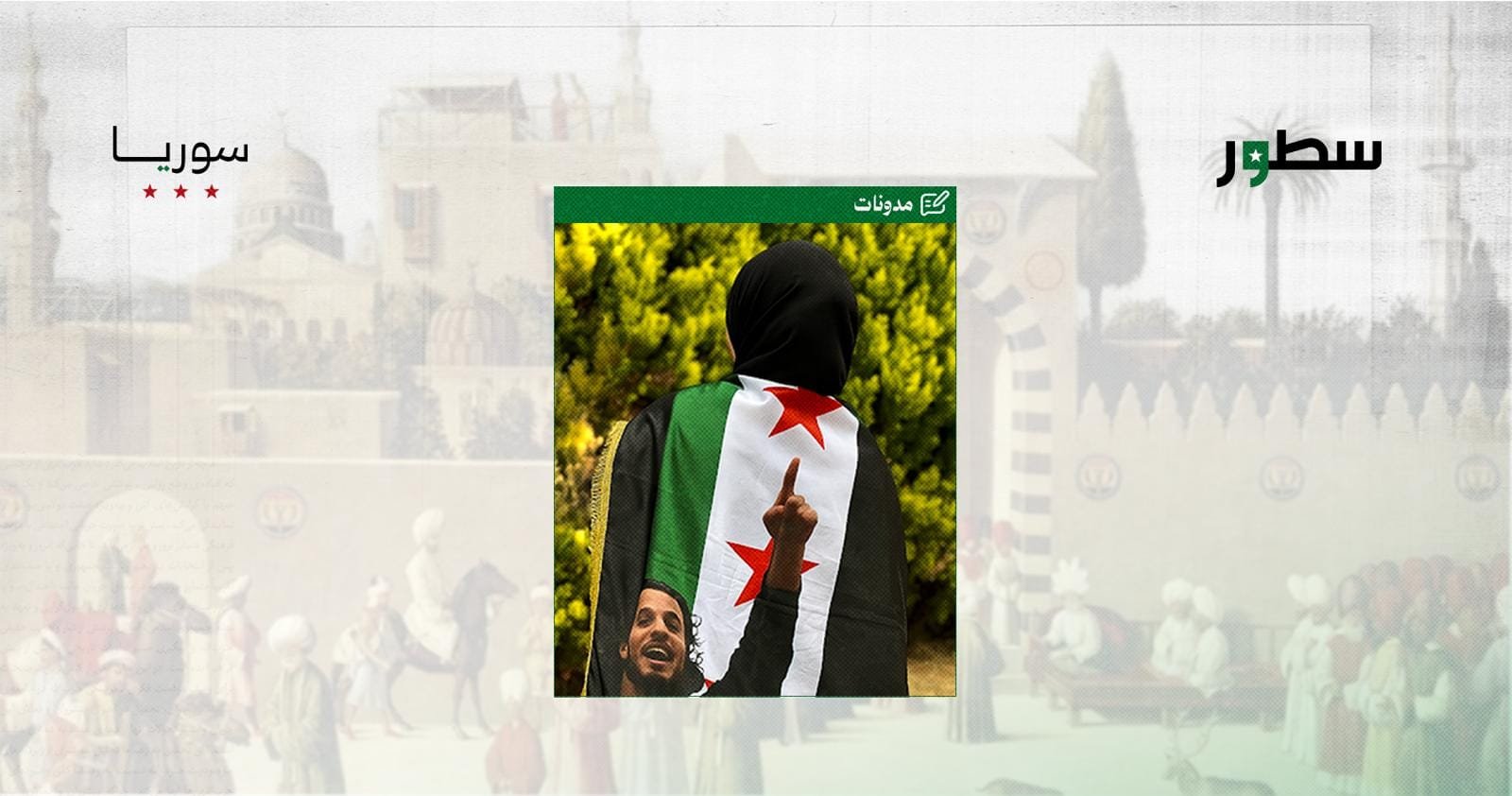مشاركات سوريا
صندوق التنمية السوري.. بين الإعمار وبناء الثقة
صندوق التنمية السوري.. بين الإعمار وبناء الثقة
تعتبر الصناديق التنموية من الأدوات المهمة التي تلجأ إليها الدول الخارجة من النزاعات أو الكوارث الكبرى بهدف تعبئة الموارد المالية وتنظيمها لتمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية المستدامة؛ حيث تكمن أهميتها في قدرتها على استقطاب التمويل الداخلي والخارجي، وتنسيق الأولويات الوطنية بعيداً عن الضغوط السياسية أو الديون الدولية مثل التجربة التركية التي بقيت عشرات السنوات رهينة هذه الديون، كما أن مسألة الاستدانة مسألة معقدة وربما لا تصلح في كثير من الأحيان بسبب الشروط التي يتم وضعها ضمن الوصفة الاقتصادية المقدمة مع الأموال الساخنة والتي تجبر الدول على اتباعها.
تبرز عدة تجارب دولية في تأسيس الصناديق، مثل تجربة صندوق أوغندا الذي ركز على التنمية بقيادة مجتمع شمالي أوغندا بعد الحرب، مع مشاركة محلية قوية في تحديد الأولويات. وتجربة هايتي بعد زلزال عام 2012 والتي قامت على تمويل جماعي لكنها واجهت تحديات بيروقراطية معقدة. والعراق الذي واجه ضعفاً في الشفافية وفقدان مبالغ ضخمة بسبب غياب الرقابة. وتجربة نيبال وكشمير التي مثلت تجربة تركز على المرونة وإعادة البناء بطريقة أكثر استدامة.
تأسيس الصندوق وأهدافه
يقف الاقتصاد السوري أمام مرحلة من أعقد المراحل في تاريخه الحديث؛ حيث يواجه دماراً واسعاً في البنية التحتية، وتراجعاً حاداً في الناتج المحلي، وضعفاً شديداً في القطاعات الإنتاجية الأساسية من جهة، وضعف التمويل الذي تحتاجه مهمة إعادة البناء المكلفة من جهة أخرى. لذلك منذ إعلان تشكيل الحكومة السورية صرح الكثير من المسؤولين السوريين مثل وزير المالية وحاكم مصرف سوريا المركزي بأن سوريا لن تلجأ للاستدانة وستعتمد على الموارد الداخلية في التنمية.
بناء على ذلك، أصدر الرئيس أحمد الشرع بتاريخ 9 تموز/ يوليو 2025 المرسوم رقم 112 القاضي بإنشاء “صندوق التنمية السوري” بهدف المساهمة في إعادة إعمار وترميم وتطوير البنى التحتية، التي تشمل جميع الخدمات والمرافق الداعمة للحياة اليومية للمواطنين، كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات والموانئ وشبكات الاتصالات وغيرها، عبر تمويل هذه المشاريع من خلال “القرض الحسن”. وبالفعل تم إطلاق الصندوق بتاريخ 4 أيلول/ سبتمبر عبر فعالية رسمية جمعت في أولى جلساتها أكثر من 60 مليون دولار.
الأهمية الاقتصادية للصندوق على المستوى المحلي
يعاني الاقتصاد السوري من فجوة تمويلية ضخمة ناجمة عن تراجع الإيرادات العامة من جهة، وضعف الاستثمارات الخاصة من جهة أخرى، فضلاً عن انخفاض تحويلات المغتربين وعدم كفايتها. من هنا، يمكن النظر إلى الصندوق على أنه آلية وطنية تسعى إلى تعبئة الموارد المحلية سواء عبر مساهمات حكومية ومساهمات القطاع الخاص ومدخرات المواطنين، أو عبر الموارد الدولي كالمنظمات، وتحويلها إلى استثمارات منتجة، هذا التحويل يقلل من الاعتماد على التمويل المشروط، ويعزز مناعة الاقتصاد تجاه الصدمات والضغوط السياسية.
عادة اقتصاديات ما بعد النزاع تحتاج إلى ما يسمى بـ”استثمارات القاعدة” (Base Investments)، أي تلك الاستثمارات التي تعيد بناء المقومات الأولية للنشاط الاقتصادي. على سبيل المثال، إعادة تأهيل شبكة الكهرباء لا يعتبر مجرد مشروع خدمي فحسب، بل هو شرط أساسي لإعادة تشغيل الورش والمصانع والمزارع، هنا يظهر دور الصندوق في تمويل هذه المشروعات الأساسية، ويؤدي إلى تقليص تكاليف الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية، ورفع الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج، وخلق فرص العمل، وخفض نسبة البطالة التي تشير التقديرات أنها وصلت إلى 80%.
بجانب ضخ الأموال في مشاريع إعادة الإعمار، خصوصاً تلك التي تعتمد على كثافة العمل مثل البناء والترميم وشبكات الطرق، بالتالي سيُحدث أثراً مضاعفاً (Multiplier Effect) في سوق العمل. فعلى سبيل المثال، مشروع ترميم شبكة مياه في محافظة ما لا يوفر عملاً للمهندسين والعمال فقط، بل يخلق طلباً إضافياً على مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، ما يعزز النشاط الاقتصادي المحلي وينعش الدورة الاقتصادية.
في هذا الإطار، يقول الدكتور في الاقتصاد ياسر الحسين “الأثر المباشر للصندوق يظهر في دعمه للقطاعات الإنتاجية، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد المحلي، وهذا يخلق فرص عمل جديدة، ويرفع مستوى الدخل الأسري، ويقلل الاعتماد على المساعدات الخارجية، كما أن ترميم وإعادة بناء المرافق الحيوية تساعد على إعادة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المجتمعات المحلية”.
يمكن أن يشكل الصندوق منصة بديلة لاستقطاب مدخرات المواطنين وتحويلها إلى استثمارات وطنية، بدلاً من بقائها مجمّدة في المنازل أو موجهة نحو المضاربة على الليرة والعقارات بسبب ضعف الثقة في الجهاز المصرفي، وبذلك يمكن إعادة تدوير السيولة داخل الاقتصاد الرسمي، ومنح المواطنين إحساساً بالشراكة في عملية الإعمار. وهذا أيضاً يساعد على الاستقرار النقدي، فإذا نجح الصندوق في امتصاص الكتلة النقدية الراكدة في السوق، فإن ذلك سيقلل من السيولة الفائضة التي تغذي التضخم والمضاربات.
يمكن توجيه التمويل نحو القطاعات الأساسية مثل الزراعة والتعليم والصحة، وتقليل التفاوتات الاجتماعية بالتالي تعزيز الأمن المجتمعي والاقتصادي. فمثلاً دعم قطاع الزراعة لا يقتصر على زيادة إنتاج الغذاء وخفض فاتورة الاستيراد فحسب، بل يساهم في تثبيت السكان في مناطقهم ويمنع موجات نزوح داخلية جديدة. أما الاستثمار في الصحة والتعليم، فيعيد بناء رأس المال البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي لأي نمو مستدام في البلاد.
أهمية الصندوق على المستوى الدولي
إحدى أبرز العقبات التي تواجه جهود إعادة الإعمار هي غياب إطار مؤسسي موحّد يدار عبره التمويل الدولي، ما جعل المشاريع تُطرح بشكل متفرق ومجزأ، فضعفت فعاليتها، بالتالي يوفر الصندوق قناة رسمية وشفافة للتعامل مع التمويل الخارجي، ما يبعث رسالة طمأنة إلى المانحين بأن هناك جهة مركزية قادرة على الإشراف والتنسيق ومراقبة تدفق الأموال. ولا يقتصر هذا الدور على تنظيم التمويل فحسب، بل يمتد ليشمل توحيد جهود المنظمات الدولية والإغاثية التي طالما عملت في سوريا بشكل متوازٍ ومنفصل، مما أدى إلى تداخل وتكرار في المشاريع وأحياناً تعارض في الأولويات، فتصبح هذه الجهود أكثر تكاملاً وانسجاماً؛ حيث تُوجّه نحو برامج وطنية محددة ذات أثر تنموي طويل الأمد. وهكذا، يساهم الصندوق في رفع كفاءة استخدام الموارد، وضمان استدامة الأثر التنموي، ويمنح المجتمع الدولي إطاراً رسمياً وفعّالاً للتعاون بعيداً عن العشوائية السابقة التي عانت سوريا منها في قضايا التمويل الدولي.
يضيف الحسين “يساهم الصندوق في عودة المهجرين داخلياً إلى بيوتهم قبل فصل الشتاء، ويبعث رسالة أن هناك جهة مؤسسية منظمة لإدارة الموارد المالية بعد سنوات من التشتت والفوضى، وهذا يعزز ثقة المستثمرين المحليين والمغتربين”.
يمكن أن يؤدي الصندوق دوراً في إعادة بناء الثقة الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي، فسوريا خلال سنوات الحرب فقدت جزءاً كبيراً من رصيد الثقة على المستوى الدولي بسبب سياسات نظام الأسد، بالتالي هناك دور مهم في عملية إعادة بناء هذه الثقة عبر تقارير عن المشاريع الممولة.
كما أنه قد يؤدي دوراً في استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الأجنبية، كما هو معلوم فإن رأس المال جبان وعادة يتجنب البيئات عالية المخاطر، لكن وجود إطار مؤسسي يشجع الصناديق السيادية العربية أو المستثمرين الأجانب على الدخول في مشاريع إعادة الإعمار. فمثلاً، يمكن أن يشكل الصندوق منصة للشراكات بين الحكومة السورية والقطاع الخاص العربي أو الأجنبي في مجالات الطاقة المتجددة، أو إعادة تأهيل الطرق، أو غيرها، وهو ما يفتح نوافذ جديدة للتعاون الاقتصادي الدولي.
يقول الدكتور الحسين في هذا الإطار “يمكن القول إن الصندوق لا يُعد مجرد آلية مالية لإدارة التبرعات، بل يمثل خطوة استراتيجية لإعادة بناء الثقة داخلياً وخارجياً، وتحويل الموارد لمشاريع إنتاجية وبنى تحتية تعيد الحياة للاقتصاد والمجتمع. نجاحه مرهون بمدى التزامه بالشفافية والحوكمة الرشيدة، وبقدرته على الجمع بين أولويات الداخل وتطلعات المانحين”.
بشكل عام، إن نجاح الصندوق مرهون بمدى الالتزام الفعلي بمبادئ الحوكمة والمساءلة، وبقدرته على توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية بعيداً عن الهدر أو المحسوبيات. فإذا ما تحقق ذلك، يمكن أن يتحول الصندوق إلى قاطرة للتنمية المستدامة وإلى أداة عملية لإعادة صياغة العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع، بما يجعل إعادة الإعمار فرصة لإطلاق دورة اقتصادية جديدة أكثر عدالة واستقراراً.