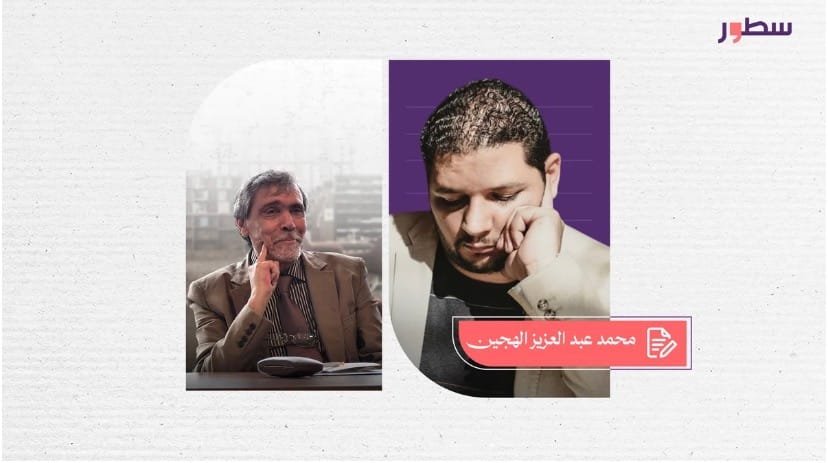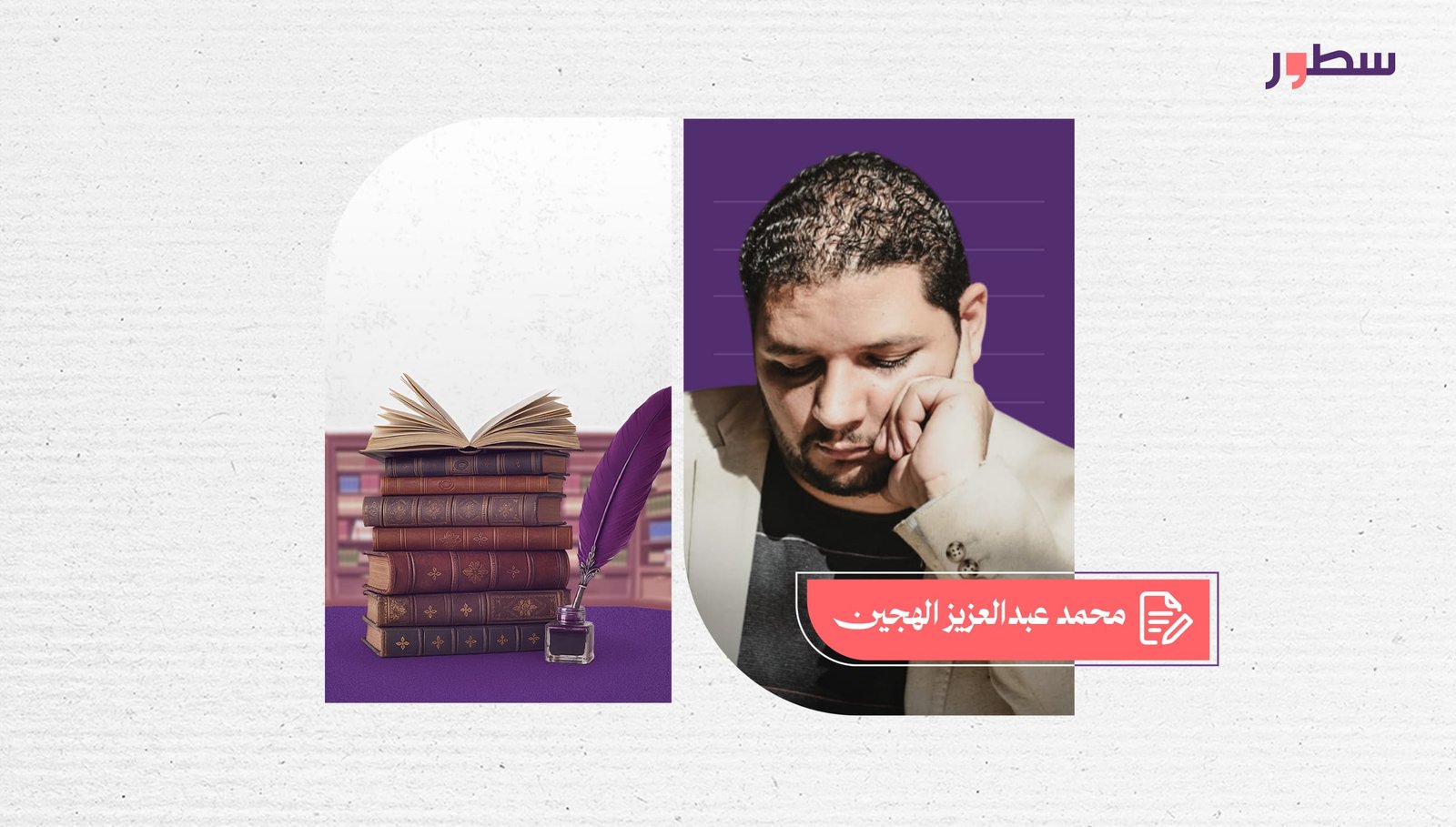أدب
إحسان عباس.. طفولة في فلسطين قبل النكبة الفلسطينية (1)
إحسان عباس.. طفولة في فلسطين قبل النكبة الفلسطينية (1)
عشت مع حياة الكاتب والمحقّق الكبير إحسان عباس الأيام الماضية وأنا أستكشف عوالمه الخاصة من حواراته التي جمعها يوسف بكار وصدرت عن المؤسّسة العربية للدراسات والنشر، وعُدت إلى الفصل الذي خصّصه الكاتب والناقد حسين محمد بافقيه عن المحقّق الكبير إحسان عباس في كتابه الممتع “عبروا النهر مرتين.. قراءات في السيرة الذاتية”، الذي أبحر بافقيه خلاله في عالم مذكرات إحسان “غربة الراعي”، وحلَّق في حياة إحسان عباس وحلّل سيرته الذاتية وأنصف تجربة حياته.
ثم رأيت معلومات وقصصًا مدهشة عن حياة إحسان عباس من حوار مميّز، وهو الحوار الذي أداراه الكاتب علي العميم معه ونشره في كتابه بعنوان “العلمانية والممانعة الإسلامية.. محاورات في النهضة والحداثة”. وعندما أثنيت على هذا الحوار تفاعل معي الصديق الكاتب هاني محمود وأرسل إليَّ كلمة الأستاذ عبد الله الهدلق عن هذا الحوار. قال الهدلق: “أفضل حوار اطّلعت عليه مع د. إحسان عباس هو ما ورد في آخر كتاب {العلمانية والممانعة الإسلاميّة}”، وأضاف: “أهمّ من سيرته {غربة الراعي}”. وعلَّقتُ على كلمة الهدلق بقولي: نكتشف كتبًا تكلَّم عنها الهدلق منذ سنوات، لكن المهم أن ذوقي قريب من الأستاذ الهدلق، وهو قارئٌ كبير كما يظهر في تعليقاته وكتبه.
حياة من الكفاح
أحكي لكم طرفًا من المعلومات التي وقفت عليها في هذا الحوار. كانت طفولة إحسان صعبة، وكافح من أجل التعليم. أرسل إليه والده ذات مرة جنيهًا إسترلينيًّا، وتسلَّم إحسان الجنيه ووضعه في جيبه، ووطَّن نفسه على أن يعيش من هذا الجنيه باقي العام، فعليه إذًا أن يقتصد، ويصرف منه في أضيق الحدود وأمسِّ الحاجات. كان إحسان وهو طفل يتعلم في المدرسة ويعيش يوميًّا بقرش، وأحيانًا بنصف قرش، يشتري رغيفًا مع جبنة أو حبة فاكهة، ويأكل منها طوال اليوم، وهكذا أمضى السنة الدراسية.
لديه بيت ينام فيه، لكن ليس لديه من يعتني به، فقد هربت الأسرة التي وضعه عندها والده، ولم يَعُد هناك أحد يجهّز له أكلًا. كانت تجربة قاسية ومرّة كما حكى عنها، وعلى الرغم من هذا الشظف والبؤس، لم يفكر إحسان يومًا في الرجوع إلى القرية، رغم استطاعته، فالحافلة التي تذهب إلى قريته قريبة منه، فلقد استقر في فكره منذ ذلك الوقت المبكر على أنَّ عودته إلى القرية لا تعني فشله وحسب، إنما إفشال أيّ طموحٍ لأبناء قريته في مواصلة تعليمهم، وسيكون إحسان إذا ما عاد إلى القرية مثالًا سيئًا، وسيشعرون بأنّه لا جدوى من مواصلة التعليم، لأنّ إحسان أول واحد فيهم يواصل تعليمه. لذلك كان الطفل بينه وبين نفسه يردّد وهو يمشي في الشوارع: “لن أعود مهما كلفني هذا من ثمن”.
كتابة الأحجبة بكلمات الأغاني
عاش بعد ذلك الطفل إحسان عباس في بيت رجلٍ يُدعى الشيخ أحمد السعدي، ويرتدي عمامة، كان أُميًّا لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا كان ينادى بـ”الشيخ”، لأنّه كان يكتب الأحجبة للمرضى الذين يقصدونه للاستشفاء، وكان هذا هو العمل الذي يتكسَّب منه.
أُنيط بإحسان كذلك المشاركة في كتابة الأحجبة، فالشيخ كما ذكرنا أُمّيٌّ لا يقرأ ولا يكتب، فكان إحسان يكتب بأحرفٍ مقطعةٍ السور القرآنيّة القصار، كسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، وكان الشيخ يعطيها لمرضاه. لكن إحسان كان يحسّ بتأثم دينيّ كبير، فيقول لنفسه: “هؤلاء الناس يرمون هذه الأوراق، المكتوب فيها كلام الله”. فقرّر ألّا يكتب على الأحجبة آيات قرآنيّة، لأنّ هذا في نظره حرام، وهو مذنب إن فعل ذلك، فصار حينما يذهب إلى قريته يستمع للأغاني الريفيّة ويحفظها عن ظهر قلب، ويبدأ في كتابتها على الأحجبة بدلًا من كتابة الآيات القرآنيّة، والشيخ لا يدري ماذا كان إحسان يعمل. لو عَلِمَ لطرده من البيت شرَّ طردة. كان هذا اجتهادًا من إحسان الصبي الصغير، الذي عزّ عليه في لحظة تديُّن خالصة أن تُكتب آياتٌ قرآنيّة على أحجبةٍ معرضة أن توضع في مكانٍ لا يليق بها.
طفولة بين حيفا وعكا
يتذكّر إحسان أُمَّه وكيف وقفت بصلابة، وكانت تنظر باتجاه غير اتجاهه، ثم حدجته بنظرةٍ صارمة شديدة حينما رأت أنّه ضعيف أمام هذا الفراق، وقرأ إحسان الطفل في عينيها كأنّها تقول له: “إلى أين أنت ذاهب؟! إن هي إلّا بضعة كيلومترات، وكلّها عدة أيام وشهور وتعود إلينا، فَلِمَ هذا التهالك وهذه الدموع التي تنفر من عينيك؟!”. يرى إحسان عباس وهو يستعيد ذكراها أن هذه النظرة الصارمة التي حدجته بها الوالدة هي التي وضعت فيه الصلابة، وأكسبته القوة والعناد، رحمها الله، لم يكن عندها سوى دعاء واحد لا يتغير، فكانت تقول له: “روح يا ابني، الله يحبب الناس فيك”.
عاش إحسان طفولته بين حيفا وعكا قبل حلول ظلام النكبة على أرض فلسطين، وحيفا لم يكن فيها صفّ «ثانٍ ثانويّ»، مما جعله يتردد على عكا يوميًّا بالقطار ليدرس فيها هذه المرحلة، وكان كلّ همه وهو في نهاية المرحلة الثانوية في عكا أن يكون ترتيبه إمّا الأول وإمّا الثاني، وذلك أنّ الكلية العربية بالقدس لا تختار طلابها إلّا من بين الأول والثاني من كلّ ثانوية.
سنوات الكلية العربية في القدس
ذات يومٍ جاءت إلى إحسان رسالة على قريته، وكان حجم الرسالة كبيرًا، ففتحها فإذا فيها قبول في الكلية العربية بالقدس. يتذكّر إحسان هذه الكلية التي لم تكُن ثانوية عليا وحسب، بل بوسعك أن تعتبرها جامعة، فالمواد التي تدرَّس فيها كانت حقيقةً في مستوى الجامعة، لذلك حينما درس في جامعة القاهرة خاب ظنّه في مستوى بعض الأساتذة ومستوى المناهج المقرّرة، لأنّه كان ينتظر أن ينتقل إلى مرحلةٍ علميّة أعلى من المرحلة التي أوصلته إياها هذه الكلية. ومن الشخصيات المهمة التي يذكرها بِوُدٍّ أستاذه سامح الخالدي، أستاذ علم النفس التربويّ، وهو من عائلة مقدسية معروفة (والد وليد الخالدي أستاذ العلوم السياسيّة، ووالد طريف الخالدي أستاذ فلسفة التاريخ).
نال إحسان من الكلية دبلومًا في التربية، وعُيِّن مدرسًا في ثانوية صفد. كانت سِنُّه في أثناء تخرجه في عام 1941 واحدًا وعشرين عامًا. درّس إحسان في ثانوية صفد خمس سنوات، وكان يدرّس مادتَي التاريخ واللغة الإنجليزيّة.
كان يروقه حينما كانوا في صفد منظر المرأة وهي تفتح ملاءتها لتُعيد ترتيبها من جديد إذا ما صادفَتْ رَجُلًا في الطريق، فكان إحسان الشاب يُفاجأ بمستوى جمالهن، فيقول لنفسه: “هل عندنا هذا القدر من الجمال الباهر؟!”. كان الشاب إحسان يذهب إلى البيت وهو مرتاح ومطمئن على أنّ الدنيا بخير، لأنّ رؤية الجمال تريحه.
زواج بقرار من الأب
وهذا يُحيلنا إلى قصة زواج إحسان عباس، ففي يوم من الأيام جاءه أبوه يزفّ إليه خبر خطبته لفتاة لا يعرفها، ولم يسبق له أن رآها، فقال لوالده: “يا أبي، ليس لي رغبة في الزواج الآن”، فأصرَّ على موقفه، فأبوه رَجُل ريفي لا يتقبل مثل هذا الاحتجاج، فما دام قد رأى أنّه يجب على ابنه أن يتزوج فما على الابن إلا أن يطيع ويذعن. والد إحسان -كما يحكي لنا- أكثر من كونه ريفيًّا، فهو أبويّ السلطة، كان عنده عُقدة تزويج الآخرين، فكان يزوّج أبناء العائلة، حتى من غير الرجوع إليهم أو استشارتهم، والعلّة في هذا أنّه كان يحبّ فتاة من قريةٍ أخرى غير قريته، فرفض جدّ إحسان أن يزوّجه بها، ثمّ تزوج والده أمَّ إحسان مُرغمًا. هذه القصة خلقت عنده مرارة خاصة، فحين أخفق في الزواج بمن يحبُّها، أراد أن يسوق أبناء العائلة إلى مصير الزواج دون أن يعطيهم حتى فرصة أن يختاروا. لا يُخفي إحسان أنّه مانَع بشدةٍ أن يتزوج، وكانت حُجته أنّه لا يعرف الفتاة التي خطبها له والده، قد تكون جميلة، وقد تكون مثقّفة، لكنه لا يعرفها، ولم يسمع حتى نغمة صوتها. وفي النهاية ضعُف إحسان أمام إلحاح والده، ووافق على الزواج، خصوصًا لمّا رأى والده يبكي. هذا ما كان من قصة زواجه، وهي كما ترى قصة زواج تقليديّة.
ثمّ تقدّم إحسان بطلب للبعثة، وجاءه الردّ بتخييره بين الذهاب إلى إنجلترا أو إلى مصر، فإن ذهب إلى إنجلترا فهذا يعني أنه سيدرس الأدب الإنجليزي، وإن ذهب إلى مصر فهذا يعني أنه سيدرس الأدب العربي، كما يحكي إحسان في حواره المطوّل مع الأستاذ علي العميم. اختار إحسان الذهاب إلى مصر، ولم يختَر الذهاب إلى إنجلترا لأنّه في ذلك الوقت كان قد تزوج وأصبح لديه طفلان، وزوجته لا تعرف اللغة الانجليزيّة، وخاف إذا ما ذهب إلى إنجلترا ألّا يتعلم طفلاه العربية.
لم يختَر إحسان عن وطنه فلسطين بديلًا، فقبل أن يذهب إلى مصر جاب فلسطين كلَّها، مما زاد تعلُّقه بها، فلم يَعُدِ الوطن قريته عين غزال وحسب، لكن الحياة تتطلب أن يكون أستاذًا ناجحًا، وإذا ما ظلَّ يبكي على ضياع الوطن فالوطن لن يرجع، وفي الوقت نفسه سيهمل الدرب الذي يجعل منه إنسانًا ناجحًا.
ظَلَّ الوطن في قلب إحسان لا يغيب، وبينه وبين نفسه يعيش كل الذكريات، لكنّه لا يحب أن يندب أمام الآخرين هذه المأساة، وفي نفس الوقت يحب أن يعرف أولاده أنّه صاحب قضية، وأنّ وطنه ضاع دون وجه حقّ، ضاع بسبب مؤامرة دوليّة عالميّة، وأنّ الفلّاح الفلسطيني الذي يمثّله أبوه لم يَبِع أرضه.
لم يستطِع إحسان عباس أن يكمل الإجابة، فلقد اختنق صوته بالبكاء، وطفرت عيناه بالدموع كما يوثّق علي العميم، واعتذر إحسان عن عدم مواصلة الحديث في هذه النقطة، وقال للعميم: “لا تؤاخذني يا بنيّ، فعلى الرغم من أني أبدو أستاذًا قاسيًا، فإنّي ضعيفٌ أمام ذكريات الوطن”. ولم يَرَه العميم على هذه الحالة العاطفيّة الشديدة إلّا حينما مرَّت به ذكريات وفاة والده، ولحظات فراقه الطويل عنه، فإنّه أيضًا لم يستطِع حبس دموعه.