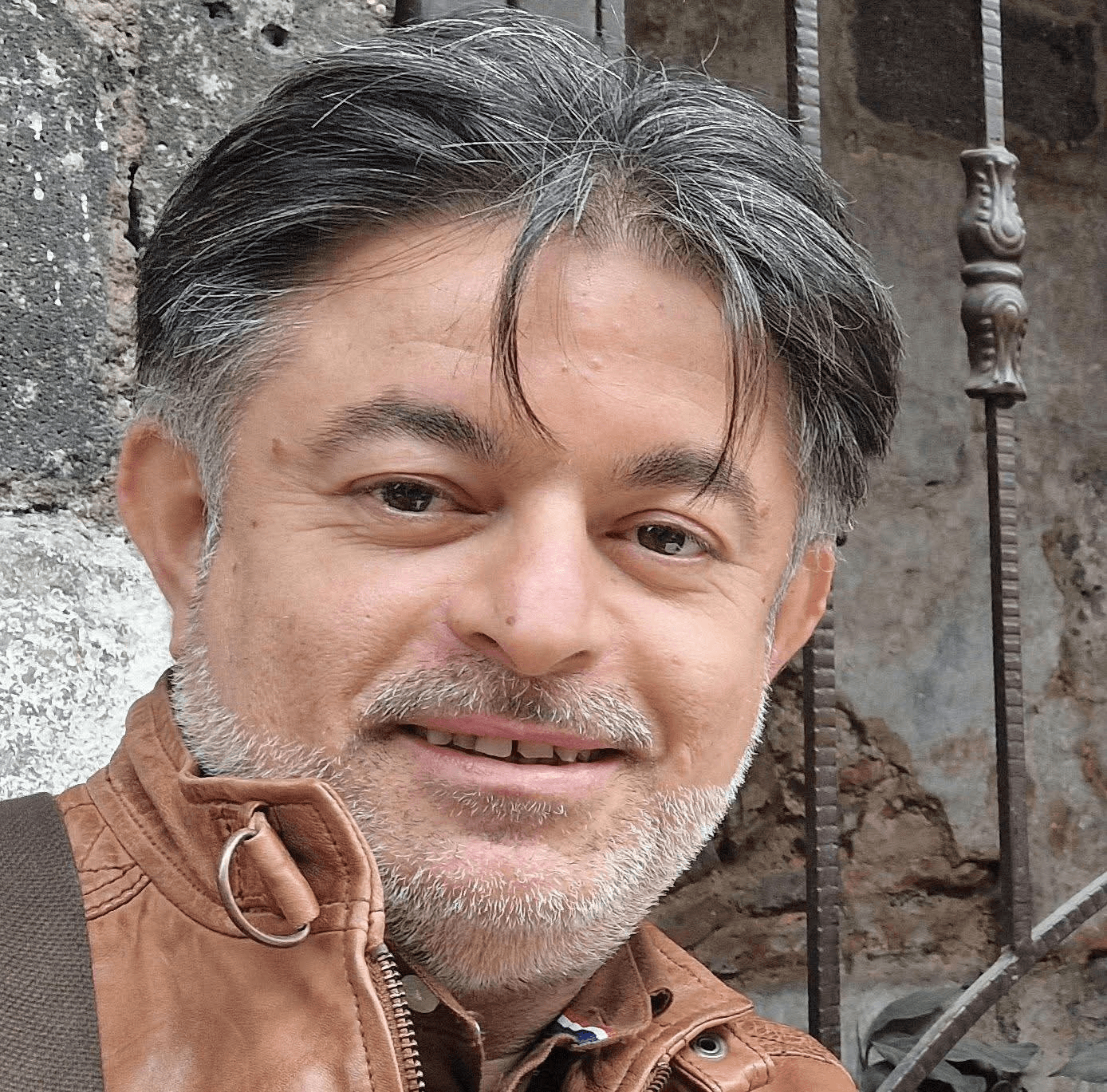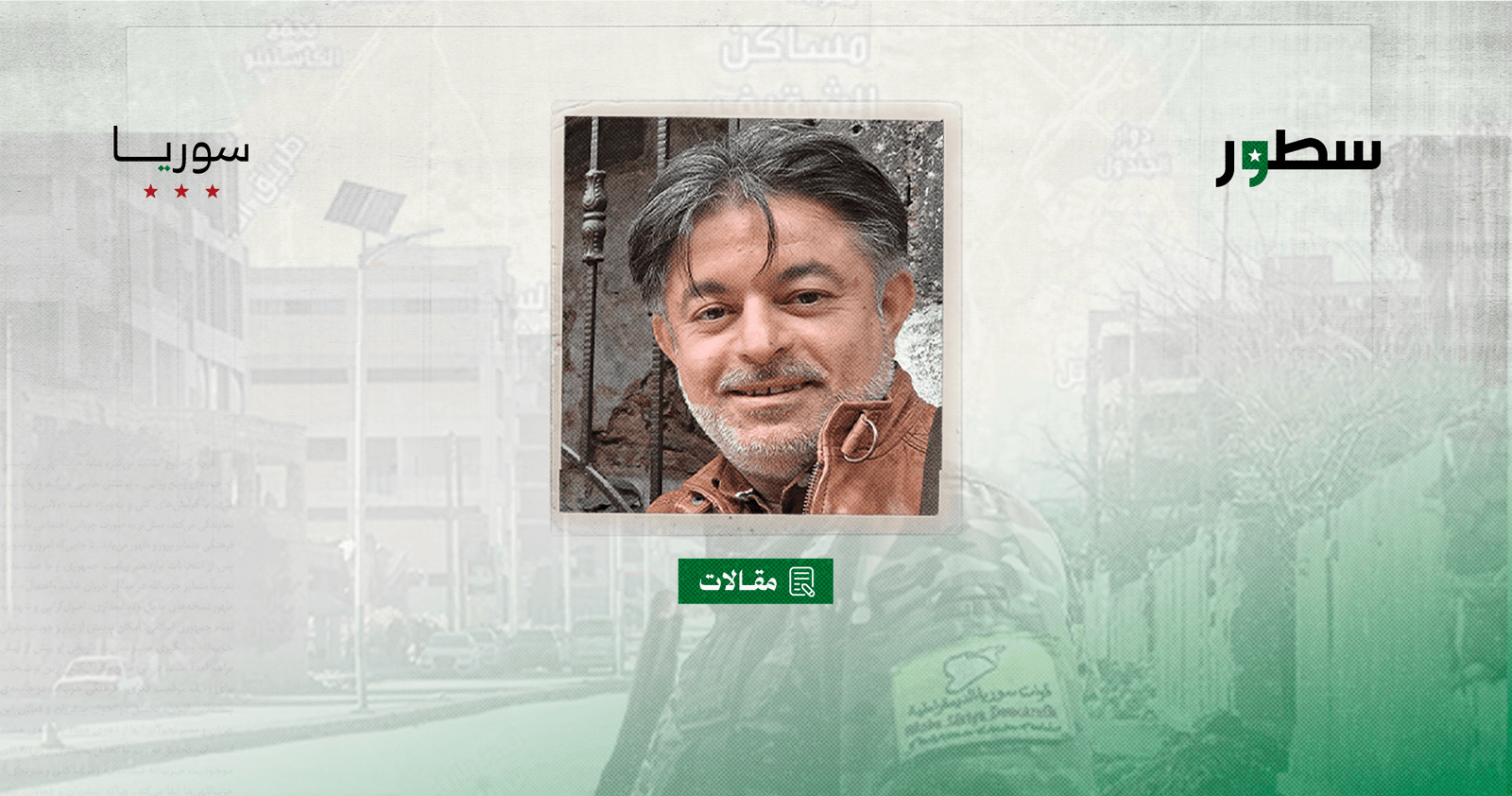مجتمع
الثورة السورية المستمرة والفرز الجديد: بين حلم لم يكتمل ومبررات مُعطّلة
الثورة السورية المستمرة والفرز الجديد: بين حلم لم يكتمل ومبررات مُعطّلة
في بدايات الثورة السورية، شهد المجتمع انقساماً عميقاً وصل إلى قلب الأسرة الواحدة. كان الفرز واضحاً بين من آمن بالثورة باعتبارها أداة للتغيير والحرية والكرامة، وبين من فضّل البقاء إلى جانب آلة القتل والاستبداد، ظناً منه أن الاستقرار الزائف، مهما كان مقنعاً، أفضل من الفوضى. هكذا انقسم الناس بين خيار الثورة وما حملته من أمل واعد، وخيار السلطة وما مثّلته من خوف وأمان هش.
14عاماً بين التضحيات والفرز الجديد
واليوم، وبعد 14 عاماً من التضحيات المكلفة والجسيمة، والشعارات الوطنية التي جمعت السوريين على اختلاف مكوناتهم وتوجهاتهم، وبعد تحولات السلطة في دمشق وتولي الحكومة المؤقتة حكم دمشق، يواجه المجتمع المؤيد للثورة فرزاً جديداً، هذه المرة داخل الصف الثوري نفسه. يرى البعض أن الثورة لم تنتهِ بعد، وأن المعركة لم تعد مقتصرة على إسقاط النظام البائد، بل امتدت لتشمل بناء وطن يتسع للجميع. يأتي ذلك عبر دعم الحكومة الجديدة وممارسة النقد البنّاء، سواء كان ليناً أو قاسياً، باعتباره حقاً طبيعياً وامتداداً للاستحقاق الثوري، وأداةً ضرورية لتصحيح وتوجيه المسار وضمان ألا تنحرف الثورة عن أهدافها الأساسية.
فالثورة، بعد كل هذه السنوات، ليست مجرد حدث تاريخي يُستذكر، بل مسؤولية مستمرة تتطلب يقظة شعبية، واستعداداً لتصحيح الأخطاء، وإعادة التوازن بين طموحات التغيير الواقعي والمخاطر الناجمة عن الانقسامات الداخلية، بحيث يتحوّل النقد إلى طاقة بنّاءة تحمي المكتسبات وتعيد الثقة، وتفتح الطريق نحو بناء دولة عادلة ومستقرة لجميع السوريين.
هؤلاء يؤكدون أن ثمرة التضحيات لا تُقطف إلا بترسيخ مبادئ المشاركة والمساءلة والرقابة الشعبية، وأن النقد ليس ترفاً، بل ضرورة لضمان ألا تتحول الثورة إلى سلطة جديدة مكرّسة.
الانقسامات حول ملفات مفصلية
في هذا السياق، يبرز الانقسام الحاصل ضمن الصف الثوري حول معالجة ملفات مفصلية وأساسية في القضية السورية، وعلى رأسها أحداث الساحل والسويداء، التي أثارت حساسية عالية بين مؤيد ورافض لما وقع فيها من انتهاكات.
فقد جاءت أحداث الساحل أولاً، حين توجه عدد كبير من عناصر قوى الأمن العام، والفزعات الشعبية لاستعادته من سيطرة فلول النظام السابق، وهو ما رافقته عمليات قتل وتجاوزات واسعة، ترقى لجرائم حرب، بحسب تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة.
ولم يكد الجدل حول هذه الوقائع يهدأ حتى جاءت أحداث السويداء لتزيد المشهد تعقيداً. فقد اضطرت الحكومة المؤقتة، في الشهر السابع من هذا العام، إلى إصدار بيان اعترفت فيه بوقوع “انتهاكات بالغة ومؤسفة” وصفتها بأنها “سلوكيات إجرامية وغير قانونية” لا يمكن تبريرها، متعهدة بمحاسبة جميع المتورطين.
وما زاد من حساسية الموقف أنّ بعض الأصوات في السويداء رفعت خطاباً انفصالياً، داعية إلى فصل المحافظة عن جغرافيتها السورية وعمقها المجتمعي. غير أنّ هذا الخطاب لا يمكن أن يبرّر بأي حال من الأحوال وصم جميع أبناء السويداء أو تحميلهم وزر هذه الدعوات، فالسويداء جزء أصيل من سوريا، وأهلها سوريون متجذّرون في تاريخها ووجدانها. وعلى رأس تلك الأصوات برز الشيخ الهجري الذي وجّه نداءً طالب فيه بدعم دولي لإقامة إقليم منفصل، لكن هذا الطرح الانفصالي قوبل برفض واسع من طيف كبير من السوريين الذين تمسّكوا بوحدة الأرض والشعب، ورفضوا الانجرار خلف مشاريع تقسيمية تزيد الجراح عمقاً.
من هنا تبرز الحاجة إلى أن يكون الخطاب الثوري أكثر عقلانية واتزاناً، منسجماً مع المبادئ الراسخة التي انطلقت منها الثورة: الحرية، الكرامة، والعدالة. وذلك عبر العمل على دعم جهود التقارب، والسعي لتقريب وجهات النظر، والدفع نحو الحوار والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من الانجرار إلى ردود الأفعال الانفعالية التي تعمّق الانقسام وتُبعد عن جوهر الثورة. ومن هنا أيضاً تتضح الحاجة، في مرحلة البناء، إلى الأصوات الأكثر انسجاماً مع الواقع السوري، وإلى الخطاب الوطني البنّاء الذي يحمي القيم الجامعة ويحافظ على النسيج الاجتماعي المتنوع، لا إلى الخطاب الهدّام الذي يزرع الانقسام ويعمّق الجراح.
تحديات الثورة: بين الفرز الجديد ومصير مكتسباتها
ورغم أن هذه الاعترافات وما رافقها من خطوات مؤسسية بدت وكأنها محاولة جادة للاقتراب من العدالة وإرساء بعض مظاهر الشفافية، فإنها لم تلقَ صدى واسعاً لدى جمهور السلطة الجديدة. فقد بدا جزء منه غير راضٍ عن طريقة اعتراف الحكومة المؤقتة، فيما اختار آخرون التساهل مع أخطائها وتجاوزاتها.
وتجلى ذلك في المزاج العام، وفي المزاودة أحياناً على السلطة ذاتها، واتهامها بالتساهل مع الطائفة الدرزية ككل. وهنا من المهم التوضيح أن هذه المواقف صدرت عن شريحة من الجمهور، وليست تعبيراً عن موقف عام موحد، وإن كانت قد أثرت على مناخ النقاش. كما لم يخلُ الأمر من نزعة لاتهام المجتمع السوري خارج المكوّن السني بالخيانة حتى يُثبت العكس.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، الاتهامات الموجَّهة للطائفة الدرزية، التي حمّلها بعض الأصوات وزر أعمال الشيخ الهجري وأتباعه. بدا كأن الطائفة كلها مطالَبة بتحمّل العار الذي ألحقه هؤلاء، من دون تمييز بين أفرادها وممارسات زعمائها أو الجماعات المنتمية إليها.
هنا يجدر القول إن الثورة لم تُختَزَل في إسقاط النظام وحده، ولم تُنجَز بعد كامل أهدافها كما يظن البعض. فحتى بعد سقوط النظام البائد، لم يتحقق جوهر الثورة بعد، وهو يكمن في مرحلة البناء المؤسسي وترسيخ سيادة القانون.
ومن هذا المنطلق، يتبيّن أن الحكومة المؤقتة، مهما بدت خطواتها جادّة، لن تتمكّن من تحقيق مساعيها في بناء الدولة ما لم تقترن جهودها بأهداف الثورة الجوهرية، ويواكبها ترسيخ ثقافة سياسية واجتماعية شاملة تحمي حقوق جميع المكوّنات وتكفل العدالة والمساواة. فمهما أبدت من استعداد، ستبقى محاولاتها محدودة الأثر من دون غطاء وطني جامع.
نحو عقد اجتماعي جديد
وتتمثل المرحلة الجوهرية للثورة في نبذ الطائفية وتجريم الخطاب الانقسامي، وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة، إلى جانب دعم مسار العدالة الانتقالية بوصفه إطاراً جامعاً لتحقيق الإنصاف، من خلال جبر الضرر المادي والمعنوي للضحايا، وضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وتحقيق المساواة أمام القانون. كل ذلك ينبغي أن يفضي إلى صياغة عقد اجتماعي جديد يكفل الحقوق والحريات لجميع السوريين.
فالثورة ليست حدثاً آنياً عابراً ينتهي بتغيير رأس السلطة، بل مساراً ممتداً يختبر قدرة السوريين على تحويل شعارات الحرية والكرامة إلى منظومة دستورية وقانونية تُترجَم إلى واقع ملموس، ويجعل العدالة والشفافية ركائز أساسية لأي بناء مستقبلي للمجتمع.
غير أن ما يعرقل هذا المسار ويهدد جوهره، هو بروز التيار الذي ما زال يراهن على خطاب الفرز الطائفي وإشعال فتيل الانقسامات. يرى هذا التيار في التهليل والتصعيد وسيلة لتحقيق ما يراه مصلحة للثورة والمجتمع. لكن هذا المنطق يعيد إنتاج الانقسامات التي خرج السوريون ضدها أصلاً، ويهدد بتحويل مسار الثورة من مشروع وطني جامع إلى صراع هويّاتي ضيق.
قراءة خالد أبو صلاح النقدية والاتجاهات المتباينة داخل الفرز الجديد
وفي خضم هذا الجدل الواسع، قدّم الناشط المعروف خالد أبو صلاح على صفحته الشخصية في فيسبوك، قراءة نقدية توضّح التباين داخل الصف الثوري، والمجتمع السوري عامة. إذ عرض أبو صلاح عدداً من التوجهات المتفاوتة في التعامل مع الوضع السوري، مشيراً إلى أن هذه الفئات مهما اختلفت دوافعها هي نتاج نصف قرن من الاستبداد والتصحّر السياسي، إضافة إلى مرحلة انتقالية مرتبكة لبلد خرج لتوه من أتون حرب طويلة.
وختم أبو صلاح منشوره بالقول إن الخلاص للسوريين لا يتحقق إلا بعقلية الدولة، لا بعقلية الفصائل أو السوق أو الترند؛ فمشروع وطني جامع يجب أن يشعر كل سوري بأن يده ليست أقصر من يد الآخر، ولا كرامته أقل وزناً. عندها فقط تتحول هذه التناقضات من عبء إلى طاقة بناء، ويصبح المستقبل مشروعاً مشتركاً، لا حلبة صراع جديدة.
بحيث يمكن قراءة الاتجاهات المتباينة كالآتي:
- مؤيد عاطفي للتغيير: يرى أن مجرد زوال النظام إنجاز كافٍ، ولا يكترث بما بعده. يعيش نشوة الانتصار أكثر مما يراقب الواقع أو يفكر في المستقبل.
- مبرر بحسن نية: يدعم الإدارة، ويخاف الانقسام أكثر مما يخاف الأخطاء. يرى في النقد تهديداً لوحدة الصف، فيغفر للإدارة كل عثراتها حفاظاً على “السفينة” من الغرق.
- داعم ناقد: يدعم الإدارة الجديدة، ويضع قدماً في صفها وقدماً على عتبة النقد. يرى في نجاحها طوق نجاة لمكتسبات الثورة، وفي فشلها بوابة للفوضى والمصير المجهول.
- المؤيد الأعمى: لا يرى في الإدارة إلا وجهاً مقدساً، ويشيطن من يختلف معها. تطبيله أعلى من طبول شبيحة الأمس، لكنه أشد ضرراً لأنه يعزل الإدارة عن الحقائق ويدفعها إلى الغرور.
- المراقب المحايد: يتابع الأحداث ببرود ولامبالاة، ولا يرهقه التفكير في المصير.
- المراقب الناقد: يقف خارج الاصطفافات بعقلية المراقب اليقظ، يدرس الأداء ويرصد التحولات، ويوجه نقده بموضوعية دون الانخراط في الصراعات.
- الرافض المطلق (أسير الامتيازات): يرى التغيير تهديداً وجودياً لمكانته السابقة، ويرفض الإدارة الجديدة جملة وتفصيلاً.
- المعارض الأيديولوجي: يرفض الإدارة لأنها لا تعكس مشروعه السياسي أو الفكري.
- المعارض غير الأيديولوجي: يعارض الإدارة الجديدة بسبب فقدان الثقة في قدرتها على إدارة البلاد، وليس لأسباب أيديولوجية.
- المؤيد المعارض: بدأ بدعم الإدارة الجديدة على أمل تأسيس مشروع وطني، لكنه تحوّل إلى معارض صريح بعد تراكم الأخطاء وفقدان الثقة.
- المتربص الانتهازي: يصطاد الأخطاء ويستثمرها لإثبات ذاته، فيخلط النقد بالمناكفة.
- المحبط المستسلم: فقد الأمل بكل إدارة أو مشروع، وينشر الإحباط من حوله.
- المستثمر البراغماتي: يرى المرحلة الجديدة فرصة لمكاسب شخصية، ويقف مع السلطة أو ضدها حسب مصالحه اليومية.
الثورة بين الفرص ومخاطر الفرز الجديد
بين هذه الخيارات المتباينة، يقف السوريون اليوم أمام سؤال مصيري: هل تكون الثورة بوابة لإعادة إنتاج الاستبداد والفرز الطائفي بوجوه جديدة، أم مشروعاً للحرية والكرامة لبناء عقد اجتماعي جديد يؤسس لدولة المواطنة والعدالة؟
إنّ الإجابة على هذا السؤال لا تحدّد فقط مستقبل السوريين، بل ترسم أيضاً ملامح معنى الثورة ذاتها: هل كانت مشروعاً للحرية والكرامة، أم محطة عابرة في سكة الصراع والانقسام؟
وأيّ من الخطابين قادر فعلاً على الإسهام في بناء سورية الجديدة، الوطن المتماسك والمستقر؟ هل سيكون ذلك عبر خطاب الانفصال الذي يفرّق ويعمّق الانقسامات، أم عبر الخطاب العقلاني البنّاء الذي يحمي القيم الوطنية، ويصون النسيج الاجتماعي المتنوّع، ويحوّل التناقضات إلى طاقة للبناء والمستقبل؟
فسوريا اليوم بحاجة ماسّة إلى أيّ الخطابين؟ وأيّهما ستراه الحكومة الجديدة بعينها، وتبني عليه مقاربتها لمستقبل البلاد؟