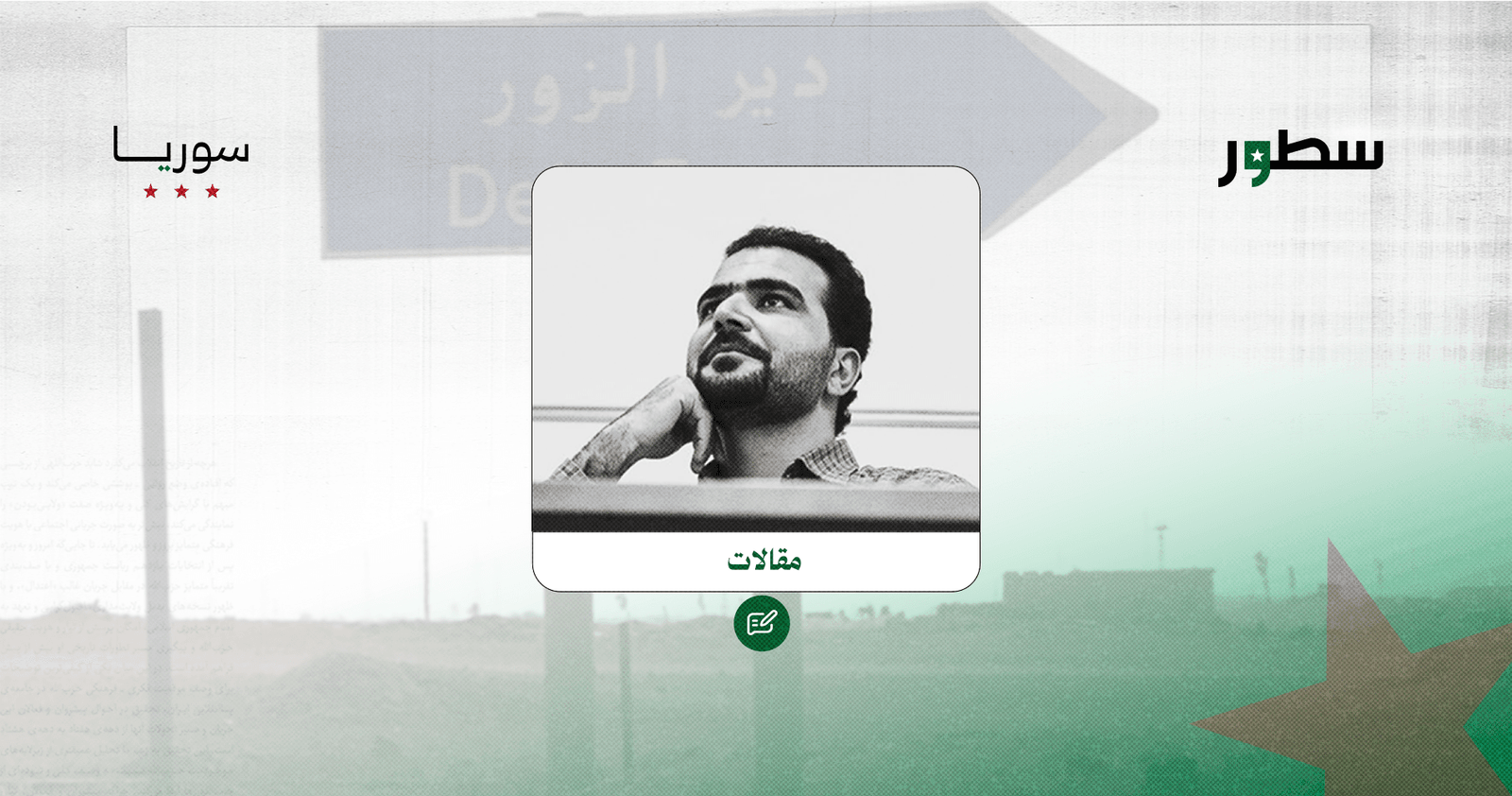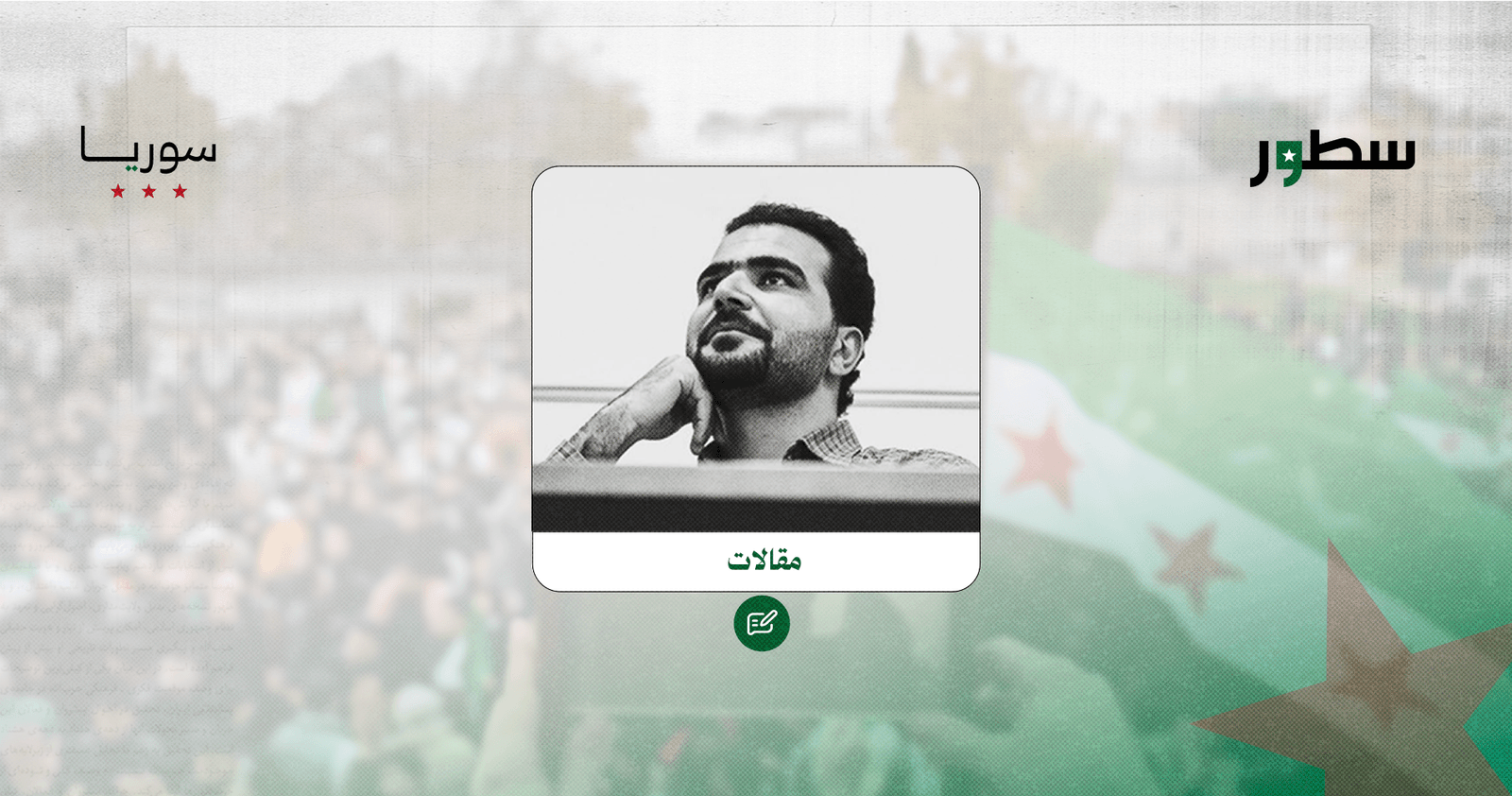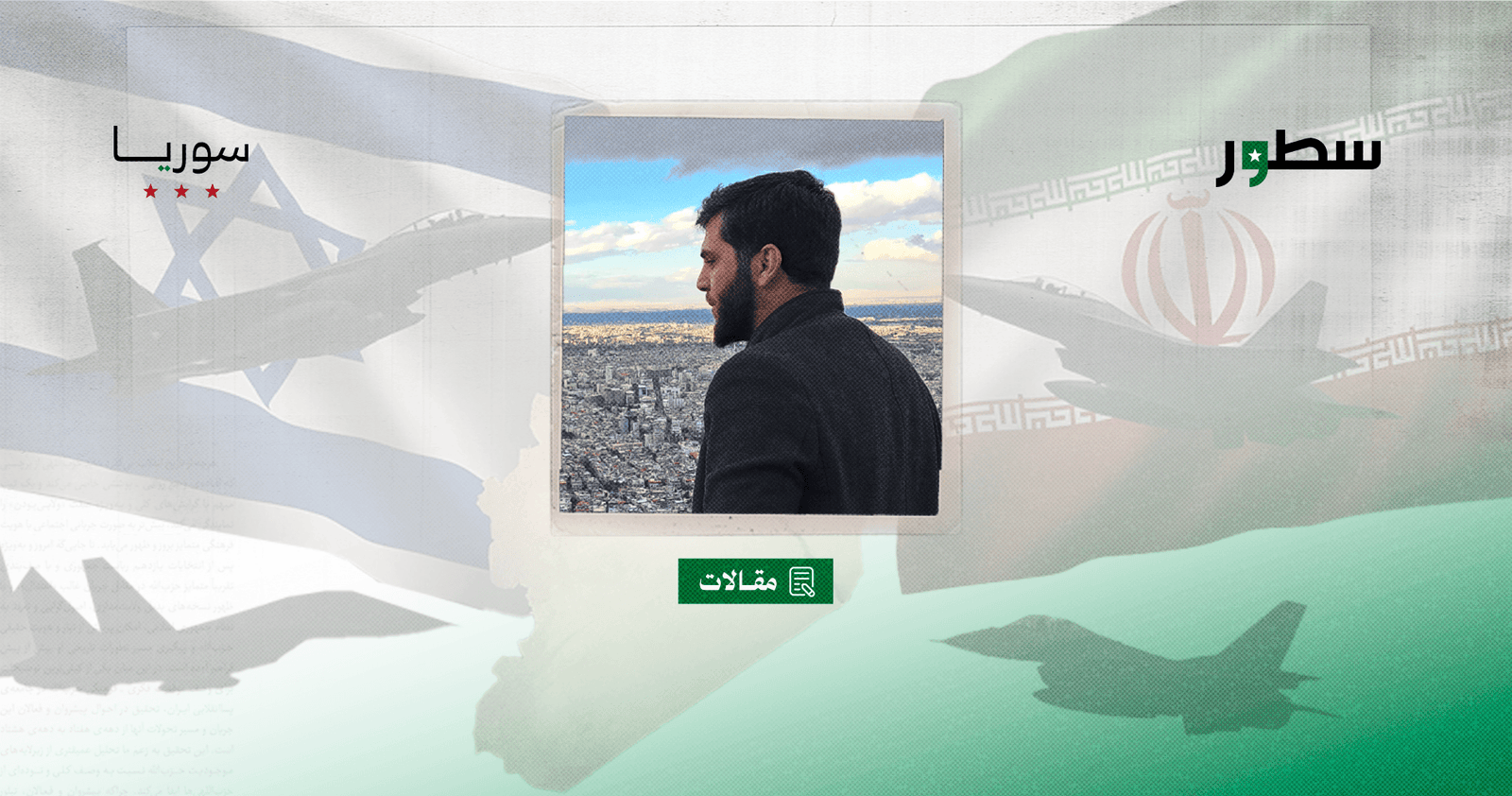مجتمع
في السكن الجامعي مجدداً: الطائفية، الدكتاتورية..والثورة.
في السكن الجامعي مجدداً: الطائفية، الدكتاتورية..والثورة.
في اليوم التالي لهروب الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في بداية العام 2011، عاد للسكن الجامعي أحد الطلاب الذين كانوا في زيارة لدى عائلته، وأخبرنا أن السوريين خارج السكن تغير لديهم شيء بعد هروب بن علي، فرحة وغبطة بادية في الوجوه، أو تعابير طافحة على محيا الناس تشي بالوجود من جديد، السعادة في وجوه الناس كما وصفها لنا كانت واضحة لا يتكلف الناس إخفاءها حتى، كنا شبه منقطعين آنذاك عن العالم الخارجي اهتمامنا منصب على التجهيز لامتحان نهاية الفصل الدراسي، لقد كنا نعيش في عالم سوري مصغر بكل تعقيداته عالم منعزل في وحدات السكن الجامعي الإسمنتية.
رغم تقشف هذا السكن من ناحية الراحة والخصوصية باعتباره سكناً عمومياً لم يمنع ذلك من وجود طبقية معينة يساعد على وجودها الفساد المالي في إدارة هذه الوحدات، قد تسمح 100 إلى 200 دولار أمريكي أو ما يعادلها في ذلك الوقت على شراء إيصالات طلاب وهميين، ما يسمح لك بالانفراد بغرفة خاصة بدون أن تُحشر مع 4 طلاب آخرين، ويزيد الوضع سوءاً والمخاوف تفاقماً إذا كانوا مجهوليين أو من محافظات أخرى، وهذه هي القضية الأكثر حساسية في السكن معرفة الآخر وتقبل الآخر.
الصور والفيديوهات المصورة القادمة من سوريا خلال أزمة السكن الطلابي في مدن دمشق وحمص وحلب خلال الفترة المنصرمة، أثارت لدي الرغبة في الكتابة عن مرحلة قصيرة من حياتي استمرت سنة واحدة تقريباً، ولكنها كانت فترة مفصلية في حياتي وفي تاريخ سوريا الحالية، خرجت في هذا العام من محافظة دير الزور للمرة الأولى في حياتي لأكتشف البلد وأهل البلد، مستغلاً دراستي الجامعية رغم اعتراض والدي على مغادرتي ديرالزور للدراسة في العاصمة دمشق، وفي ذات العام كان السوريون آنذاك يتجهزون بصمت لقفزة في المجهول.
التخوف من الآخر كان السمة البارزة للطلاب الذين لم يتجاوزوا 19 ربيعاً، في العمق كنت أشعر أن أحاديث المجتمعات المحلية عن الآخر تتسرب للأطفال الصغار من خلال نظرة نمطية عن الآخر المختلف، حكايات المجتمعات السورية التي تعكس نظرتها لبعضها البعض تعكس حالة الشك والتخوف، سمعت أحاديث من أوساط مختلفة سنة وأكراد ودروز وشركس وشوايا وحوارنة عن بعضهم البعض، التحسر على صدام حسين والتحذير من المشروع الإيراني في المنطقة، عشرات الألوف من الأكراد السوريين يعيشون بدون جنسية سورية يضطرون مرغمين على تبديل الأسماء الكردية لأطفالهم إلى أخرى عربية، الدروز لديهم أحاديث طويلة عن التعامل السني النمطي معهم وتلاعب نظام الأسد بهذه الثغرة الطائفية.
سرديات متباينة ووجهات نظر مختلفة تدور جميعها في سقف السكن الجامعي وتنتهي ما بين وحداته المتناثرة، فيما أعلم على الأقل، وكان الخوف من الوشاية حاضراً في أعماق النفوس وفي نظرات العيون والإيماءات التي تقطع الأحاديث أمام الغرباء، وتنبيهات أهالينا بالحذر من التفوه بكلام قد يغيبك خلف الشمس، على خيط رفيع وفي نطاق ضيق كانت تسري هذه النقاشات والأفكار بين الخوف والرغبة، رغبة اليافع أن يكون مسموعاً ومرئياً بأفكاره عن العالم، كان طلاب ذلك الزمن لديهم ترف الأحلام، فيما تبدو حتى الأحلام عصية على طلاب الجامعات في سوريا الحالية، بعد ما رأينا من خروجهم في طوابير من سكنهم.
كانت الصدمة الأولى لي هي امتناع زميلي في الغرفة التي أريد أن أنتقل منها عن الموافقة وكانت ضرورية لكي يتم الانتقال، وتعلل أن بهذا النقل ستكون هناك غالبية من مكون آخر وهو ما لن يسمح به، أخيراً وبعد أن انتقلت من الغرفة لغرفة أخرى تعايش مع أغلبية المكون الآخر، عندما ابتعدت عنهم تعرفت عليهم، كان صعباً ومجهداً لي أن أتكيف على التجاور مع شبان ليسوا من بيئتي، أنا الذي لم أخرج من ديرالزور مطلقاً قبل الدراسة الجامعية، وإن كان الفضول والاستكشاف يدفعني فإن الخوف من العواقب يمنعني، لا أخفي ذلك لم أكن أقل تحفظاً من ذلك الطالب الحوراني ولا أكثر انفتاحاً منه.
تحولات الطلاب من مؤيدين للسلطة للثورة كانت دراماتيكية، في بداية آذار/ مارس كان جزء جيد من الطلاب يعتبر أن الربيع العربي مؤامرة وكان من يعتقد بهذا الرأي يشكل جزءاً وازناً ومتزناً، ليس بالضرورة ذو صفة تشبيحية، بل كان يورد أسباباً منطقية في الدفاع عن وجهة نظره بخصوص الأمن والاستقرار وخصوصية البلد، وقد بقي جزء منهم على موقفه حتى بعد سنوات، كان الأكثر حكمة منهم والأكثر تحفظاً على المشاركة أو الإدلاء بأراء إشكالية قادراً على البقاء متزناً نوعاً ما، ومحافظاً على علاقاته الاجتماعية، فيما انتقل عدد من الذين كانوا يؤيدون النظام بشكل أعمى ومتعصب في لحظة مظاهرة أو انتهاك من قبل الأمن إلى أقصى يمين المعارضة، تفاعلات الحراك في السكن كانت عميقة ومؤثرة في شخصية وتكوين الطلاب اليافعين معنوياً ونفسياً، وربما تتمخض هذه التفاعلات إلى سمات معينة ثابتة ودائمة، وتصبح لديهم رؤية للبلد والحياة، قد يحملونها معهم مدى الحياة، بإمكاننا أن نتصور طالباً يفقد القدرة على إكمال دراسته بسبب وضع سياسي وطائفي معقد، فماذا ستكون أفكاره مشاعره تجاه بلده ومجتمعه لا سيما عندما يرى أن مستقبله القائم على فكرة الحصول على شهادة جامعية يتسرب من بين يديه.
كان هذا العام تتويجاً لأعوام إشكالية من سنوات حكم بشار الأسد، تلك السنة الدراسية اليتيمة في الجامعة منعت مجمل التحولات في سوريا في العامين 2010 و2011 من إتمامها، وقطعت السبيل لاستكمال دراستي الجامعية مرة واحدة حتى اللحظة، كنت قادراً على البقاء في دراستي الجامعية، لكن فضلت تركها، كانت السنة التي قضيتها في السكن الجامعي تُظهر إشكالاً جوهرياً وبنيوياً في المجتمع السوري، ينذر بسنوات عديدة من الدم.
تجمعات لطلاب في سكنهم الجامعي قبل عدة أشهر، يهتفون بالدفاع عن الإسلام والتوعد بالموت لمكونات سورية بعينها، كهرباء الاستعداء الطائفي حطت برحالها في مساكن الطلبة، يبدو أن هذه المساكن هي خط المواجهة الأولى مع أنفسنا كسوريين وملتقى تعارفنا، في حياة أي شاب سوري عاصر نظام الأسد هناك مؤسستان تعيدان تشكيل نظرته لسوريا وللسوريين الآخرين، الجيش وما تحمله الخدمة الإلزامية من معاشرة وتلاقٍ مع مكونات أخرى، والسكن الجامعي وما يترتب عليه من معرفة بالآخر المختلف، ربما تكون سلبية وربما تكون إيجابية حسب الشخص وطريقة تفكيره وحسب المقابل المختلف ومفاهيمه عن الحياة والمجتمع.
إننا الآن في العام 2010 تحديداً في الشهر التاسع، في دمشق وتحديداً في مبنى خاص بالمعسكرات الجامعية، إنها سنتي الأولى في جامعة دمشق في كلية الحقوق، لدي صعوبات في تقبل وضعي الجديد، أول مرة أخرج وأعيش خارج بيتنا الكائن في قرية صغيرة بريف ديرالزور، صور المباني الكثيرة والزحام والسرافيس الصغيرة في دمشق، كل ما حولي يتعبني الضوضاء الكثيفة والمرهقة في دمشق تجبرك على الشعور بالحنين إلى هدوء القرية ورتابة الحياة وبطء إيقاعها، وذات الأحداث اليومية التي تعيد إنتاج نفسها بانتظام.
المسؤول العسكري الذي يفترض أن يختم لنا نحن الطلبة على ورقة روتينية تتعلق بالمعسكر الجامعي، أنيق في بزته العسكرية مهندم الشعر وحليق الدقن، وكذلك يبدو ذو مزاج جيد للمزاح بدأ بإطلاق نكات على شاب تبين لي من خلال الحديث أنه من ريف ديرالزور الشرقي، “ليش أنتا هنا؟! لك جاي من ديرالزور لتدرس هون”، لا أدري لماذا لم أشعر انني أنا أيضاً معني بكلامه لم تضايقني سخريته اللاذعة ولا بعدها الطائفي الواضح ولم يخيفني ربما لأنه كان يرتدي لباسه العسكري الكامل، تشعر أنه رسمي ولا بد أن يتوقف عند حد معين، وربما بشاشته وبساطته الواضحة رغم سخريته وعنجهيته، وربما لأنني كنت غارقاً في ألمي الداخلي وفي غربتي بحيث أنني أتفق معه بالبقاء كل في مكانه.
على العكس منه كنت أخشى من أولئك المدنيين الغامضين، المحسوبين على نظام الأسد بصفات مختلفة، أعضاء اتحاد طلبة، الموظفين الذين يركبون سيارات عليها شعار العقاب الرسمي للدولة أو صورة الأسد أوكليهما، أو من يأخذون غرفاً مميزة في السكن الجامعي بحيث يجلسون على الشرفات وينظرون لبقية الطلاب شزراً.
سكن الطبالة البعيد أرسل إليه كل طلاب الحقوق من الشباب فيما بقيت البنات في سكن المزة القريب من الجامعة، تحتاج لواسطة أو لدفع مبلغ مالي محترم لتحصل على غرفة فيه أسوة بطلاب الطب وطب الأسنان والهندسات، سبب آخر لنكره هذه التخصصات التي لا ينفك السوريون على الافتتان بها وحس أبنائهم على الاجتهاد الدراسي القاسي ليحجزوا مكاناً على مقاعدها.
يضم السكن الجديد أكراداً ودروز وشوايا من المحافظات الشرقية وحمويين وطلاباً قادمين من أرياف حلب على الأقل هؤلاء من التقيت بهم، وعلى عادتي في التعرف على سمات أبناء العشائر في ريفنا بحيث أعمِل ذهني للتكهن لأي عشيرة ينتمي هذا أو ذاك، بدأت أستخدم هذه الموهبة الفريدة في التعرف على السوريين وعلى المجتمعات السورية أو ربما العشائر السورية، الشباب الأكراد يكثرون من استخدام المصففات المثبتة للشعر وغالباً ما يواظبون على حلق ذقونهم لدرجة تجعلك تعتقد أنهم يذهبون للحلاق يومياً، مشروب المتة كان علامة فارقة للتعرف على الدروز أو العلويين، حتى المنتمين للحزب القومي السوري كانوا مميزين بالنسبة لي تصفيفة الشعر والثياب والمشية شبه العسكرية، أما جماعتي فكنت أعرفهم بدون جهد يذكر، طلاب درعا كانوا إشكاليين بالتعرف عليهم لا شيء يربطهم بملامحهم وسلوكياتهم سوى لهجتهم المميزة.
يقول أحد الزملاء الذين أقطن معهم في نفس الغرفة “كيف تعرف الناس من وين جايبن بهذه السهولة؟” كنت أجيب بكل بساطة من ملابسهم وأنماط سلوكهم، بعد سنوات اكتشفت أنني مغرم بدون وعي بعلم الاجتماع بحيث أبحث عن أي تفصيل اجتماعي صغير حولي لأتفكر به، وذهني دائم الانشغال بمقارنات اجتماعية طبقية وطائفية عسى أن أجد نظرية اجتماعية تفسر لي الظواهر المستعصية.
التسكع في دمشق لم يكن يستهويني في الأشهر الأولى، كما يستهوي الطلاب الآخرين المسحورين بجمال المدينة، كنت أخرج معهم خشية أن أبقى وحدي وأستعجل بالعودة أثناء المشوار، في الأشهر الستة الأولى من إقامتي في المدينة كنت أعاني موجات حنين إلى الريف والقرية وإلى مظاهر الزراعة والعلاقات الاجتماعية الهادئة، الأنماط التي اعتدتها و اعتادتني، وفي أول مرة أعود فيها لديرالزور لاحظت للمرة أولى الرائحة المميزة التي يحملها (العجاج) وهي التسمية المحلية للعواصف الغبارية المعتادة في شرق سوريا، كما لاحظت أيضاً ضآلة مدينة ديرالزور وحجمها المتواضع أمام مدينة ضخمة كدمشق، بحيث يبدو استخدام النقل العام فيها نزهة أمام التنقل في دمشق باستخدام الوسيلة ذاتها.
انتقلت لأعيش في غرفة كل طلابها من ديرالزور، وكلهم طلاب في كلية الشريعة، وجود 5 طلاب أو 6 في فترة الامتحانات بما يشبه التكديس المتعمد، يجعل كتل السكن الجامعي الإسمنتية أشبه بالسجون المتناثرة، كان طلاب الشريعة قادمين من خلفيات غير متدينة بعضهم لم يحصل على معدل جيد لدخول كليات العلوم الإنسانية أو اللغة العربية، فيسارع لحجز مقعده في وظيفة التدريس عن طريق حصوله على شهادة بالشريعة الإسلامية، كل من كان معي كذلك لم يكونوا مختلفين في تدينهم أو نظرتهم للحياة بالمقارنة مع أي من أبناء جيلهم ومجتمعهم، لا مانع من وجود بعض النوادر والاستثناءات.
في إحدى المرات زارنا صديق لزميل لنا في السكن كان يدرس الشريعة في المعهد الأوزاعي، ملامح التمترس الطائفي كانت واضحة عنده، خصوصاً مع ذروة المشروع الإيراني في وقتها وقبيل الثورة بأشهر معدودة، كان يؤيد صدام حسين والمذهب السلفي بشدة، شديد العداء لإيران وحلفائها، بعد سنوات التقيت فيه في تركيا كان هارباً من داعش بعد أن حاول التنظيم أن يجبره على البيعة فضل الهرب على البقاء تحت رحمة التنظيم.
على عكس المروية التي يروج لها تيار كان موجوداً في زمن الأسدية وما زال يعيش جزء منه حتى اللحظة، تقول مرويته إن الشعب السوري كان متجانساً ومتعايشاً ولا يعرف الطائفية ولا التباينات الثقافية، في حين أن المجتمع السوري حينئذ كان يعيش في حالة تشبه كانتونات وغيتوهات اجتماعية وطائفية وطبقية لطيفة ومخففة الجرعة تحت مظلة القمع الأسدي، وتكون فجة وفاقعة عند الخروج من تحت هذه المظلة.