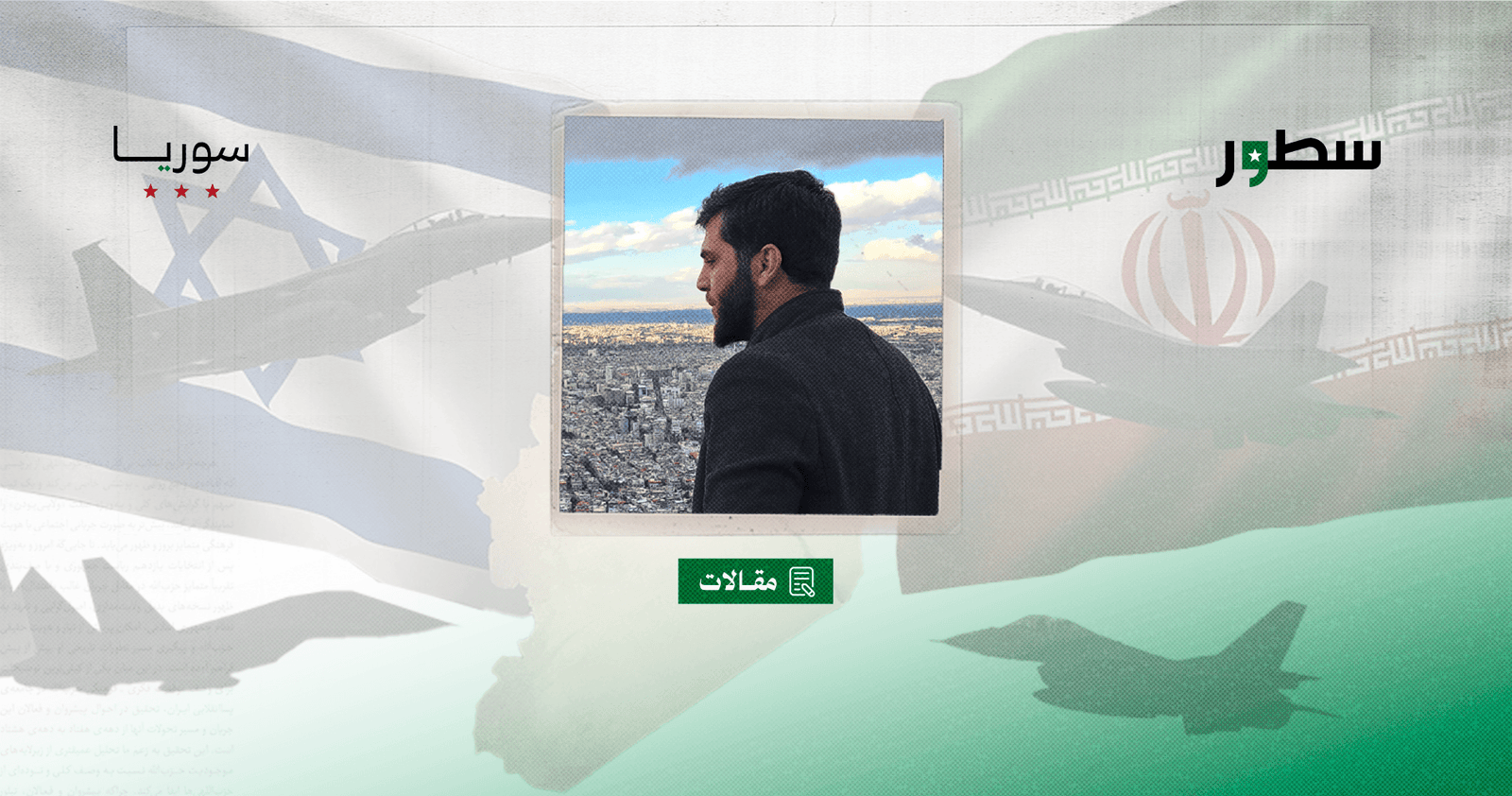سياسة
المشهد السوري خلال أسبوع: حراك دبلوماسي جديد بين موسكو وتل أبيب، ومعالجة جديدة لملفات الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي
المشهد السوري خلال أسبوع: حراك دبلوماسي جديد بين موسكو وتل أبيب، ومعالجة جديدة لملفات الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي
تموز/ يوليو 2025
في خضم تحولات جيوسياسية متسارعة، تشهد سوريا حراكاً دبلوماسياً وأمنياً غير مسبوق. زيارة وزير الخارجية أسعد الشيباني لموسكو ولقاؤه التاريخي بمسؤولين إسرائيليين في باريس يُشكلان محورين لاستراتيجية جديدة تهدف إلى موازنة العلاقات الدولية مع الحفاظ على السيادة، بينما تُواصل الحكومة السورية معالجة ملفات الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في مسارٍ شائك يعكس تعقيد مرحلة ما بعد النظام السابق.
الوضع السياسي: الدبلوماسية السورية بين موسكو وتل أبيب
- في أول زيارة بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، تمثل زيارة الشيباني لموسكو محاولةً لإعادة صياغة العلاقة مع روسيا بعد عقود من التبعية. الزيارة الروسية المفاجئة لموسكو حملت معها دلالات استراتيجية عميقة تتجاوز الشكل الدبلوماسي الروتيني خصوصاً مع تضمّن الوفد شخصيات محورية كوزير الدفاع مرهف أبو قصرة ورئيس الاستخبارات حسين السلامة، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، في خطوة تهدف إلى إعادة رسم العلاقة مع حليف النظام السابق على أسس جديدة توازن بين المصالح السورية والواقع الجيوسياسي. فروسيا ما تزال تمتلك حضوراً عسكرياً ملموساً عبر قواعد القامشلي حميميم وطرطوس، ما يفرض واقعاً لا يمكن تجاهله، بينما تسعى دمشق إلى تحقيق توازن دقيق مع الغرب وإلى مراجعة الاتفاقيات المجحفة التي وقعها النظام السابق مع السعي لشراكة استراتيجية جديدة تحت شعار “الاحترام والمصلحة المتبادلة”.
- رعى المبعوث الأمريكي توم براك اجتماعاً تاريخياً في باريس جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بوزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، في أول لقاء ثنائي رفيع المستوى بين البلدين منذ أكثر من ربع قرن، وكشفت مصادر دبلوماسية أن جوهر المحادثات السورية الإسرائيلية دار حول احتواء التصعيد الأمني الأخير في جنوب سوريا، خاصة في محافظة السويداء، وتناول الطرفان إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، مع مطالبة سورية صريحة بالانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط التي تقدمت إليها القوات الإسرائيلية مؤخراً. رغم أن اللقاء لم يسفر عن اتفاقات نهائية، إلا أنه حقق هدفه المباشر المتمثل في خفض التوتر وإعادة فتح قنوات التواصل، حيث اتفق الطرفان على عقد لقاءات مقبلة لتقييم خطوات تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري. يظل هذا اللقاء، رغم محدودية نتائجه الملموسة حتى الآن، خطوة دبلوماسية استثنائية في سياق العلاقات المعقدة بين دمشق وتل أبيب، تعكس رغبة أمريكية وأوروبية في احتواء التصعيد، واستعداداً سورياً للتواصل تحت ضغط الظروف الأمنية، وحاجة إسرائيلية لضمانات أمنية في الشمال في ظل استمرار حرب غزة.
- رغم تأكيد المبعوث الأمريكي “توم براك” أن التعامل مع الحكومة السورية الجديدة برئاسة الشرع هو “الخيار الوحيد” لتوحيد سوريا، تكشف السياسة الأمريكية عن تناقضات جوهرية” فمن جهة، تدعم واشنطن دمشق مشيدة بـ “كفاءتها” في أزمة السويداء واتفاق وقف إطلاق النار الأخير، لكنها تتغاضى عن العدوان الإسرائيلي الذي وصفته بـ “سوء الفهم”، دون خطوات أمريكية واضحة لكبح جماح تصرفات تل أبيب عن التدخل في الشأن المحلي السوري.
- من جهة أخرى، يتباطأ الضغط الأمريكي على قوات سوريا الديمقراطية (قسد) رغم الدعوة العلنية لدمجها في الحكومة المركزية، ووعود ترامب بنقل مسؤولية مكافحة الإرهاب لدمشق. يُضاف إلى ذلك “عقبات رفع العقوبات الذي يواجه انقساماً حاداً في الكونغرس. هذه السياسة المعلَّقة بين مصالح متضاربة وحلفاء متنازعين، تهدد بانهيار أي تقدم نحو الاستقرار، خاصة مع تصاعد التدخل الإسرائيلي وغياب آليات أمريكية حاسمة تجاه مشاريع التقسيم للأراضي السورية.
من ناحية أخرى شكل البيان المشترك بين دمشق وواشنطن وباريس -الصادر بعد اجتماعٍ في باريس- خطوة دبلوماسية تهدف إلى ترسيخ مسار الانتقال السياسي في سوريا، إلا أنه في الوقت ذاته يكشف عن فجوة بين مضامين البيان والخطوات الفعلية على الأرض، إذ اقتصر على خطوط عريضة دون معالجة التفاصيل الحرجة. فمن ناحية، ركز البيان على تعاون الأطراف في مكافحة الإرهاب ودعم مؤسسات الدولة، وحثّ المكونات السورية على حوارٍ لحلّ أزمتي قسد والسويداء، لكنه تجاوز التعقيدات الجوهرية: فـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) ترفض تسليم سلاحها، والتمرد المدعوم إسرائيلياً في السويداء ما زال يشكل تهديداً أمنياً، بينما تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية دون رادع.
الوضع الاجتماعي والمحلي: تعديل النظام الانتخابي ولجنة التحقيق في الساحل تنهي مهمتها
تسلم الرئيس السوري أحمد الشرع النسخة النهائية للنظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، الذي يحدد إجراءات الانتخابات المقررة بين 15-20 أيلول/ سبتمبر 2025، في خطوة تهدف لإضفاء الشرعية على المرحلة الانتقالية. وتضمن التعديلات رفع عدد المقاعد من 150 إلى 210 مقاعد (بناءً على إحصاء 2011)، مع تخصيص 20% للمرأة وتشجيع مشاركة الشباب، وإدراج آليات رقابة محلية ودولية لتعزيز الشفافية.
وقد شكلت إتاحة الرقابة الدولية نقطة محورية إيجابية، لتعزيز المصداقية، خاصة في أول اختبار تشريعي بعد سقوط النظام السابق. كما يُعد تخصيص الثلث المعين (70 مقعداً) لأصحاب الكفاءات الفنية محاولة لسد فجوات تمثيلية، مع ضمان تمثيل النازحين واللاجئين، وذلك رغم بعض الانتقادات التي وُجهت لآلية الانتخاب وتعيين الرئيس لثلث أعضاء المجلس بما يمنحه نفوذاً غير متناسب، كما لاقت عبارة “استبعاد من أيّد النظام السابق” معارضةً من بعض الناشطين وسط مخاوف من إمكانية استخدامها لاستبعاد معارضين، كما أثيرت تساؤلات أخرى حول آلية التصويت في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة (مثل مناطق “قسد” والسويداء)، والتي تفرض تحديات كبيرة أمام نجاح هذه الانتخابات.
تُمثّل نتائج التحقيق التي كشفتها اللجنة الوطنية السورية في أحداث الساحل 7-9 آذار/ مارس الفائت -والتي تضمّنت توثيق مقتل 1,426 شخصاً من قوى الأمن والجيش والمدنيين- سابقةً تاريخيةً عزّزت مصداقية الحكومة محلياً ودولياً بفضل تشكيلتها المهنية ومنهجيتها الشفافة والتي قدمت رواية مقبولة داخلياً وخارجياً أقرت بوجود انتهاكات جسيمة، ما نال إشادة عدد من الدول ومنظمات حقوق الإنسان. التقرير الذي قدم لائحة اتهام ضد 298 مشتبهاً بهم إلى النائب العام، وتوصيات شملت ملاحقة الفارين وإجراءات العدالة الانتقالية واجه مطالب حقوقية بمحاكمات علنية للجناة، وتعويضات مادية للضحايا، غير أن التحدي الأكبر يكمن في حماية هذه الخطوة غير المسبوقة من الضغوط السياسية، وترجمة التوصيات إلى إجراءات ملموسة كالملاحقات القضائية وجبر الضرر لتحقيق عدالة انتقالية حقيقية تكسب ثقة السوريين والعالم، وتُجنّب البلاد مخاطر التقسيم.
الوضع الأمني: ضربات استراتيجية ودعم تركي محدود
شهد الساحل السوري حملة أمنية متكاملة قادتها قيادة الأمن الداخلي في اللاذقية، تمكّنت خلالها من تفكيك شبكات مسلحة معقدة ترتبط عضوياً بفلول نظام الأسد والمتورطين في هجمات آذار/ مارس ضد الحواجز الأمنية والمواقع العسكرية. وبلغت الحملة ذروتها مع تفكيك ثلاث خلايا إرهابية خلال 24 ساعة، مما يعكس دقة التخطيط وفعالية التنفيذ وقدرة استباقية عالية في مواجهة التهديدات المُحدقة باستقرار المنطقة. وقد كشفت التحقيقات أن الخلايا المفككة كانت تعمل بتنسيق مباشر مع رموز النظام السابق، لا سيما ماهر الأسد (قائد الفرقة الرابعة السابق) وغياث دله وسهيل الحسن. والأخطر تلقي هذه الشبكات دعماً لوجستياً وعسكرياً من “حزب الله” اللبناني ومليشيات طائفية أخرى، مما حوّلها إلى أدوات تنفيذ لمشاريع إرهابية عابرة للحدود.
مثّلت هذه الضربات استجابةً عملية لتقرير “لجنة تقصي الحقائق الوطنية” الذي كشف تورط 265 متهماً في أحداث الساحل، ضمن تصعيد أمني ملموس في اللاذقية وجبلة تضمّن تعزيز الانتشار الأمني ونقاط التفتيش، كما شكّلت رداً حاسماً على المحاولات المنهجية لزعزعة استقرار الساحل السوري المنطقة الحيوية ذات التنوع الديموغرافي الحسّاس. ويُبرز نجاح العمليات تحولاً نوعياً في أداء الأجهزة الأمنية السورية الجديدة وقدرتها على ضرب شبكات متجذرة تمتد صلاتها للنظام السابق وحلفائه الإقليميين. لكن التحدي الأكبر يتمثل في قدرة هذه الأجهزة على تجفيف منابع التمويل والدعم الخارجي المستمر، ومواكبة تحوّل الشبكات لهياكل أكثر تخفياً، مع الحفاظ على التنسيق بين الجهد الأمني والمشروع السياسي الانتقالي.
يأتي طلب الحكومة السورية الرسمي من أنقرة لتعزيز قدراتها الدفاعية في سياق متشابك من التحديات الأمنية، أبرزها: الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي دمّرت نحو 80% من أصولها العسكرية الاستراتيجية، وتصاعد نشاط التنظيمات المتطرفة كـ “تنظيم الدولة”، والاضطرابات في السويداء. كما تشمل هذه التحديات الحاجةَ الملحّةَ لإعادة البناء العسكري وتغطية ثغرات التدريب والتسليح، خاصة في مجالات الدفاع الجوي والأنظمة الرادارية. من ناحية أخرى، تبرز دوافع جيوسياسية لأنقرة، تتمثل في ضرورة تمكين سوريا من بسط سيطرتها على مناطق الشمال الشرقي حيث تنشط “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتنظيمات متطرفة. ورغم الإعلان التركي عن استمرار تقديم “التدريب والاستشارات والدعم الفني”، يُتوقع أن يتركز الدعم على:
- أسلحة تقليدية خفيفة ومتوسطة.
- عربات مصفحة وتجهيزات ميدانية.
- تدريب الوحدات الأمنية.
بينما تبقى إمكانية توريد أنظمة دفاع جوي متطورة أو أسلحة ثقيلة محدودةً بسبب القيود الدولية والحسابات الإقليمية الدقيقة. وقد يُعزز هذا التعاون الاستقرارَ الأمني قصير المدى في جنوب سوريا، لكنه يحمل مخاطر تصعيد مع إسرائيل التي ترى في أي تعزيز للقدرات السورية تهديداً لمصالحها. من جانبها، ترى دمشق أن الهجمات الإسرائيلية تتطلب تسريع وتيرة تأطير التعاون الدفاعي مع تركيا.
السويداء: أزمة السويداء.. جذور غير محلولة
تعكس الهدنة الحالية في الجنوب السوري هشاشةَ معادلةٍ فرَضها الضغط العسكري الإسرائيلي، فلا تتعدى كونها وقف إطلاق نار مؤقت يفتقر إلى تحوّل استراتيجي في موازين القوى أو معالجة جذرية لأزمات السويداء المزمنة. هذه التهدئة ليست سوى محاولة لاحتواء أزمة قابلة للانفجار متى توافرت شروطها، إذ تمسكت الفصائل الدرزية الموالية للهجري وإسرائيل بجوهر سياستها الرامية إلى خلق جنوب ذي وضع خاص، يُدار أمنياً عبر تفاهمات خارجية تقيّد قدرة دمشق على فرض سلطتها الكاملة أو اتخاذ قرارات مستقلة بشأن حدودها.
هذا الواقع يدفع دمشق إلى مأزق تُختل فيه موازين القوى، وتضيق خياراتها لحماية السيادة، مما يخلق بيئة خصبة لموجات عنف جديدة تمنح إسرائيل ذريعة متجددة للتدخل تحت شعار “حماية الأقليات”. وهكذا يظل وقف إطلاق النار -رغم أهميته- إجراءً سطحيّاً يعيد الوضع إلى نقطة الصفر دون معالجة جذور الأزمة، خاصة بعدما كشفت الأحداث عن انقسامات مجتمعية كامنة تفجّرت إلى السطح، واستُغِلّت لأغراض سياسية.
من ناحية أخرى، حوّل التدخل الإسرائيلي في السويداء ودعوات التحالف معه إلى تغذية الخطاب التحريضي ضد الطائفة الدرزية، وعمّق انعدام الثقة بين شريحة واسعة من الدروز -خاصة مؤيدي الهجري- وبين مؤسسات الدولة. هذا الشرخ يُفاقم تآكل شرعية الحكومة، ويُظهر أن التهدئة الأمنية لم تُنتج مصالحة مجتمعية، بل رسّخت انفصاماً بين المجتمع والدولة رغم محاولات الأخيرة الحفاظ على وجودها الرمزي عبر المساعدات والقوافل الإنسانية كجسر تواصل مع المجتمع المحلي الدرزي.
التدخل الإسرائيلي: أبواب التفاهمات مفتوحة بعد أزمة السويداء
رغم حدّة الأزمة الناجمة عن أحداث السويداء الأخيرة، لم يُغلق الباب كليّاً أمام تفاهمات أوسع بين دمشق وتل أبيب، غير أن تحقيق ذلك يستوجب من الطرفين مراجعة تحركاتهما بعقلانية وحسابات متوازنة. فمن ناحيتها لا ترغب الحكومة السورية في التفريط بالمكاسب الإقليمية والدولية التي حققتها خلال فترة وجيزة، كما تدرك أن شرط الحصول على الدعم الدولي المنشود يكمن في تعزيز السلطة المركزية، وتجنب الصدام مع جيرانها -لا سيما إسرائيل- وتفادي الصراعات الطائفية التي تعيد إنتاج الحرب الأهلية.
من جهتها، تواجه إسرائيل حاجة ملحة لمراجعة ثغرات استراتيجيتها تجاه سوريا، إذ ما تزال تشكك في إمكانية تحوّل النظام السوري أو مرونته، كما لم تحسم موقفها من دعم نظام مركزي قوي في دمشق قادر على التعامل مع مصالحها. ورغم أن اجتماع باريس لم يُسفر سوى عن خفض التصعيد وإنهاء المواجهات المسلحة في السويداء تستمر اللقاءات الثنائية سعياً لاتفاق يمنع تصعيداً إقليمياً يتجاوز الحدود السورية.
تمثّل هذه الأزمة اختباراً مصيرياً يهدّد كيان سوريا برمته، إذ يتجاوز الصراعُ في الجنوب من صراع على السيادة إلى مشروع “ممر داود” التقسيمي ومحاولات خلق كيانات فدرالية في السويداء وشرق الفرات، مما دفع “قسد” للانحراف عن مسار اتفاق 10 آذار/ مارس، وسط ما يتردد من تحالفات ضمنية بين تل أبيب و”قسد”، تعززها تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بدعم الأكراد، ما يعطّل اندماجهم في الدولة السورية.
وفي الشمال، تراقب أنقرة تطورات التدخل الإسرائيلي بقلق عميق، إذ يهدد أي تقسيم في السويداء وحدة سوريا بأكملها. وقد تجسّد هذا الوعي في تعديل استراتيجي في خطوط أنقرة الحمراء من الانتقال من اعتبار شرق الفرات تهديداً للأمن القومي التركي، إلى تصنيف أي محاولة تقسيم لسوريا كخطر وجودي -بحسب تصريحات وزير خارجيتها هاكان فيدان- لكن رغم خطابها الحاد ظلّت تركيا خلال العدوان الإسرائيلي عاجزة عن التحرّك الفاعل دفاعاً عن حليفها السوري، مما يعكس تناقضاً صارخاً بين سياستها الخطابية وإمكاناتها الميدانية.
قسد: تعقيدات مفاوضات دمشق و”قسد”: بين شعارات الوحدة وعقبات الدمج
أثّرت أزمة السويداء مباشرةً على العلاقة المتوترة أصلاً بين الحكومة السورية و”قسد”، نتيجةً لمماطلة الأخيرة في تنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، وتصاعد الشكوك المتبادلة حول مستقبل الاندماج السياسي والأمني. وما تزال العقبات الرئيسية -أبرزها قضيتا دمج “قوات سوريا الديمقراطية” في الجيش السوري ونظام الحكم اللامركزي- تشكّل حاجزاً أمام التقدم، رغم إعلان الطرفين التزامهما بوحدة سوريا. وتكشف تصريحات “مظلوم عبدي” الترحيبية بالوساطة السعودية عن مناورة سياسية ذكية لتعزيز موقفه التفاوضي، خاصة مع تزايد المخاوف الكردية من التمدد التركي في شمال سوريا. وبينما يؤكد عبدي اتفاقه مع دمشق على مبدأ “جيش واحد وعلم واحد”، يصرّ على ضرورة “ضمانات دستورية” قبل الدمج، مما يعكس خشيةً من إفقاد الكيانات المحلية هويتها في ظل المركزية. كما أن سعي “قسد” لجَذب السعودية إلى طاولة المفاوضات -بدعوى قبولها كطرف محايد- يُعد محاولةً لخلق توازنٍ ضد النفوذ التركي المباشر، واستثمار التنافس الإقليمي لصالحها.
في المقابل، تمثل تصريحات المبعوث الأمريكي “توم براك” التي أشادت بـ”جيش واحد، حكومة واحدة، دولة واحدة” ترحيباً غربياً بتصريحات قسد لتسريع المفاوضات، لكن العقبات الجوهرية التي تعترض المسألة، إضافة إلى الوجود التركي في الشمال الذي يثير قلق الأكراد وهي ذات العوامل التي أفشلت مفاوضات باريس الماضية، ما ينذر بتحوّل المنطقة إلى بؤرة توتر قابلة للانفجار. وهكذا تُظهر عودة “قسد” لاتفاق 10 آذار مناورةً للبقاء أكثر من كونها تحولاً استراتيجياً، تقوم على محاولة استرضاء المجتمع الدولي بخطاب الوحدة لصد التهديد التركي، مع تمسّكها بالتمترس الميداني لتفادي ذوبان كيانها في مؤسسات الجيش السوري.
الوضع الاقتصادي: اقتصاد سوريا بين تعديل العقوبات والاستثمار السعودي
أقرّت لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جديد تحت عنوان “قانون محاسبة العقوبات على سوريا”، يستهدف تعديل “قانون قيصر” عبر آلية مشروطة تُرجئ إلغاء العقوبات إلى حين امتثال الحكومة السورية لمعايير حقوق الإنسان ومكافحة غسل الأموال لمدة عامين متتاليين، أو حتى نهاية 2029، مع تمديد فترات الإعفاء من العقوبات من 180 يوماً إلى عامين. ورغم اجتياز المشروع مرحلة اللجنة المالية، يبقى مصيره مرتبطاً بعقبات تشريعية لاحقة، تشمل مراجعته في لجنة الشؤون الخارجية والتصويت النهائي بالكونغرس، فضلاً عن معارضة قوية تستند إلى مخاوف من تقويض أدوات الضغط على دمشق.
كشف التصويت – 31 مؤيداً مقابل 23 معارضاً- عن انقسامٍ حادٍّ داخل أروقة الكونغرس بين فريقٌ يرى في الأحداث الميدانية الأخيرة بالسويداء دافعاً للحفاظ على العقوبات كأوراق ضغط، بينما يرفض فريق آخر المشروعَ جملةً لـ”عدم تماشيه مع الأجندة الأمريكية الحالية” التي أعلن عنها الرئيس ترامب بعد اجتماع الرياض. بشكل عام يُمثل التعديل تحولاً جزئياً في السياسة الأمريكية عبر ربط رفع العقوبات بجدول زمني صارم، لكنّ الانقسام السياسي الداخلي وتعقيدات المشهد السوري وتأثير جماعات الضغط السورية، تجعل تطبيقه رهن توازنات هشة داخل واشنطن أكثر من ارتباطه بالتطورات الميدانية بسوريا.
شهدت العاصمة السورية دمشق انعقاد المنتدى الاستثماري السعودي السوري الأول بحضور رسمي واقتصادي واسع، في خطوة تعكس تحولاً تدريجياً في العلاقات الثنائية ومسعىً لإعادة تطبيعها بعد سنوات من القطيعة، حيث شاركت أكثر من 20 جهة حكومية سعودية و100 شركة خاصة رائدة، وتوّجت الفعاليات بتوقيع 47 مذكرة تفاهم بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) تغطي قطاعات استراتيجية كالصناعة والطاقة والبنية التحتية والتقنية المالية. وتمثل هذه الاستثمارات محركاً محتملاً لتحفيز البيئة الاستثمارية في سوريا، وتعزيز الثقة الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي، مع توقعات بتوفير 50 ألف فرصة عمل، خاصة في مجالات حيوية كالطاقة والإسمنت التي تُعد ركائز لإعادة الإعمار وتحسين الخدمات المعيشية. غير أن هذه الآفاق تواجه تحديات جادة، أبرزها استمرار بعض العقوبات الدولية التي قد تعرقل تنفيذ المشاريع مستقبلاً، والحاجة الملحة لتسريع الإصلاحات التشريعية لضمان بيئة استثمارية جاذبة.