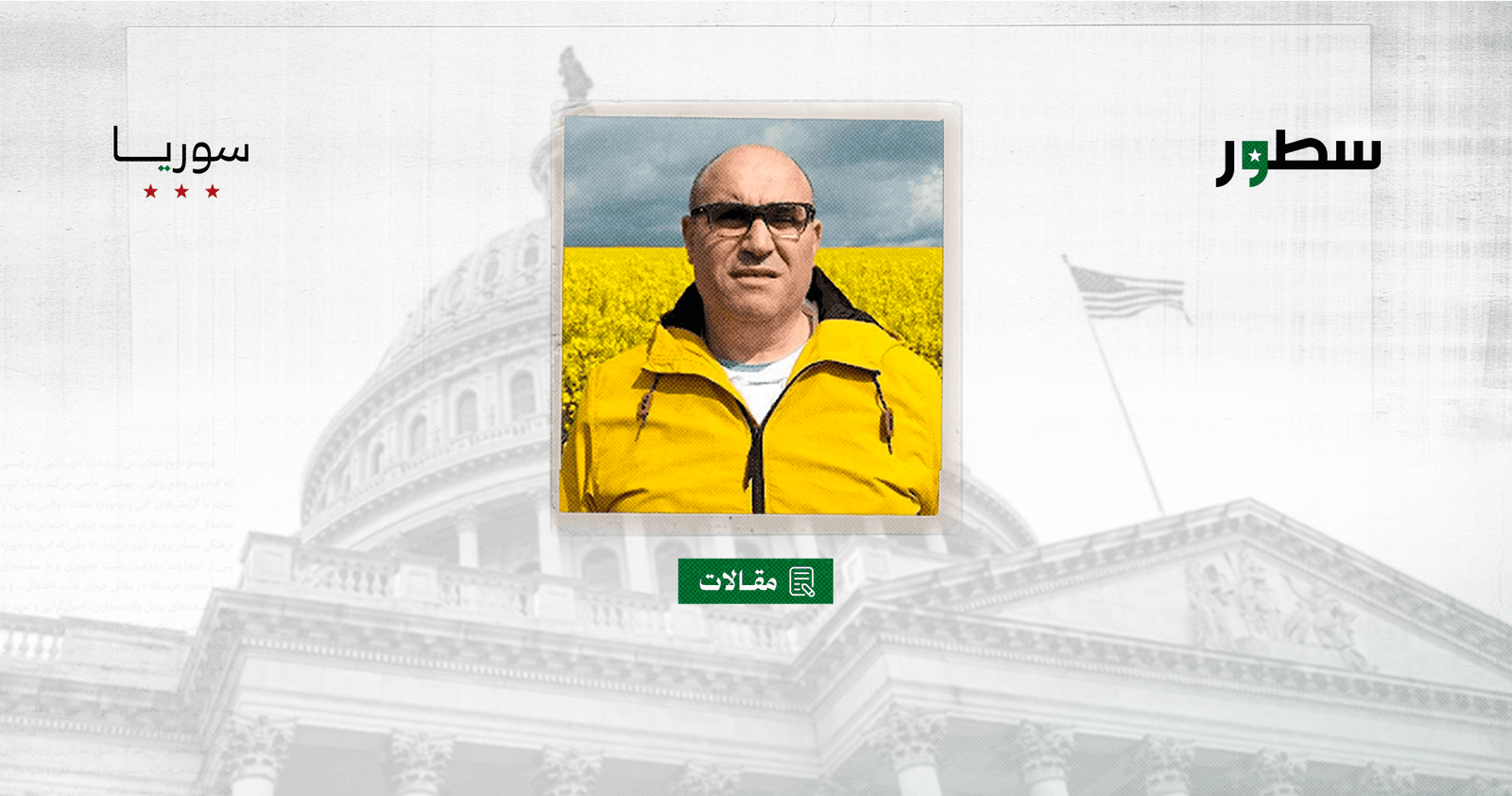سياسة
الكوميديان القاتل: بشار الأسد بين النكتة والجريمة
الكوميديان القاتل: بشار الأسد بين النكتة والجريمة
في سياق الإعداد لمادّة صحفية كنت أعمل عليها، التقيتُ بعدد من الأشخاص لإجراء مقابلات تهدف إلى إثراء المادة بشهادات حيّة. من بين هذه اللقاءات، ظلّت مقابلة واحدة عالقة في ذهني، لا لأنها حملت مفاجأة كبرى، بل لأنها كشفت لي مفارقة خطيرة اعتدنا تجاهلها. كانت الضيفة سيّدة في مطلع الستين من عمرها، سورية تقيم في المنفى منذ سنوات، بدت في بداية الحديث متماسكة، تتحدث بنبرة الواثقين رغم الألم الذي يسكن حديثها.
لكن ما أثار انتباهي حقاً، هو أنها كانت كلّما ذُكر اسم بشار الأسد، أو عُرضت صورته على الشاشة، تغصّ بصوتها، وتغالب دموعها. لم يكن ذلك ردّ فعلٍ عابراً، بل تكراراً لا إراديّاً لحزنٍ راسخ. سألتها بهدوء عن السبب، فأجابت بعد لحظة صمت: “أحد أولادي استشهد تحت القصف، والثاني استُشهد وهو يحاول إسعافه”. قالتها ببساطة تقطع أكثر مما تصرخ، ثم عادت إلى الصمت وكأنّ كل ما تبقّى في الكلام صار فائضاً عن الحاجة.
خرجت من تلك المقابلة مشحوناً بما هو أكبر من الحزن، كانت في ذهني فكرة واحدة تتضخّم: ماذا لو جلس أمام هذه السيدة شابٌ متهكم، وبدأ يروي نكتة عن بشار الأسد؟ كيف سيكون المشهد؟ هل سيكون مجرّد مزحة في سياق ساخر أم سيتحوّل إلى اصطدام عنيف بين ذاكرة تُنزف وذاكرة تستهين؟ في تلك اللحظة، أدركت أن هذا النوع من “السخرية” لم يعد أمراً بسيطاً، بل هو مسألة أخلاقية، وربما سياسية، تتطلب مساءلة جادّة: ماذا يعني أن نضحك من صورة القاتل؟ وهل الضحك في هذه الحالة مقاومة أم تواطؤٌ من نوعٍ آخر؟
السخرية سلاح مقاومة.. ولكن؟
لطالما اعتُبرت السخرية من أدوات مقاومة الاستبداد، في النظم القمعية، حيث تُخنق حرية التعبير، تصبح النكتة ملاذاً للبوح، وتتحوّل إلى صيغة رمزية للتمرّد. من النكت السياسية في الحقبة السوفيتية، إلى التهكّم على هتلر في أوساط اللاجئين اليهود، إلى رسومات “شارلي إيبدو” الساخرة من السلطة الدينية والسياسية، أدت السخرية دوراً بارزاً في تقويض الهالة الأسطورية التي تحيط بالحاكم، وكسر جدار الخوف حوله.
في السياق العربي، كان للتهكّم السياسي حضور لافت، لا سيما بعد ثورات الربيع العربي. انتشرت النكات والرسوم الكاريكاتيرية والمقاطع الساخرة من القذافي ومبارك وبن علي، ثم لاحقاً من الأسد والسيسي وغيرهم. وكان يُنظر إلى هذا التهكّم على أنه “تنفيس” ضروري لمجتمعات تعاني من القمع، وكأن الضحك، في غياب العدالة، هو أحد أشكال القصاص الرمزي.
لكنّ هذا “القصاص الرمزي” ليس دائماً بريئاً أو فعّالاً كما يبدو. فبحسب الباحثة “ليزا واكا”، في دراسة لها حول السخرية من الأنظمة التسلطية (Humor and Subversion under Authoritarianism, 2016)، فإن السخرية قد تؤدي أحياناً إلى نتائج عكسية، إذ تُعيد إنتاج صورة الطاغية في المخيال العام، وتحوّله من مصدر رعب إلى مادة هزلية، مما يقلّل من جدّية المطالبة بمحاسبته. وتضيف أن بعض الأنظمة نفسها تستثمر في إنتاج “نكات على الزعيم” لتخفيف الاحتقان وخلق صورة “الدكتاتور الأحمق” بدلاً من “الدكتاتور المجرم”.
في الحالة السورية، لا يمكن فصل السخرية عن الألم المتراكم. فالنكتة التي تتناول غباء الأسد أو غرابة صوته أو سذاجة خطاباته، لا تهاجم بنيته الأمنية، ولا تذكّر بمجازره، بل تفرّغ الوحش من وحشيته وتقدّمه كمهزلة. وهنا يكمن الخطر.
المفارقة المؤلمة أن النكتة حين لا يُحسن استثمار لحظتها قد تصبح نوعاً من التطبيع مع وجود الجلاد. نضحك، لا لأنه سقط من ذاكرتنا، بل لأنه ما يزال قائماً، ولأن ذاكرتنا أرهقها الجرح، فصارت تميل إلى التهكّم كآلية إنكار.
الدكتاتور الكاريكاتيري: حين تفقد الجريمة ملامحها
في الأنظمة الدكتاتورية، عادةً ما يبني الحاكم حول نفسه هالة من الخوف والهيبة، ويحرص على أن يُقدَّم في الإعلام الرسمي بصورة صارمة لا تتيح مجالاً للهزل. لكن المفارقة أن السخرية حين لا تُضبط بسياقها قد تساهم في ترميم صورة الطاغية بدلاً من تقويضها، بتحويله إلى شخصية كاريكاتيرية، فاقدة للرهبة، يسهل الضحك عليها، كما يسهل نسيان جرائمها.
بشار الأسد لم يكن استثناءً. فعلى مدار السنوات الماضية، غزت الإنترنت عشرات المقاطع والنكات التي تصفه بالغباء، أو تركّز على صوته، لغته الجافة، وظهوره الباهت. وقد ساعدت “ثقافة الميمز” (memes) على انتشار هذه الصورة الكاريكاتيرية، حيث بات يظهر في صيغ تهريجية، أحياناً إلى جانب شخصيات كرتونية أو رموز ثقافية هزلية. في الظاهر، قد يبدو هذا نوعاً من المقاومة الشعبية الساخرة. لكن على المدى الطويل، تنشأ مشكلة أعمق: إذ يفقد الجلاد ملامحه كجلاد، ويعاد تشكيله كـ”أضحوكة شعبية”.
في دراسة لجامعة بنسلفانيا حول أثر الصور الساخرة في تشكيل الوعي السياسي (2019)، وُجد أن التكرار الكثيف لصورة الزعيم المستبد في هيئة كاريكاتيرية يؤدي إلى نوع من “اعتياد” وجوده، بحيث تتلاشى حدّة الرغبة في تغييره أو محاسبته. الضحك المتكرر لا يحفّز الغضب، بل يُخدّره.
هذا التخفيف من وقع الجريمة عبر التهكّم لا يقتصر على المستوى الفردي. بل يمتد إلى الخطاب العام، في المنصات ووسائل الإعلام، حيث تغدو “مزحة عن الأسد” أكثر تداولاً من تقرير حقوقي، أو شهادة معتقل سابق، أو رواية أمّ شهيد. ومع الوقت، يصبح الأسد في الذاكرة العامة “الشخص الغبي الذي لم يفهم شعبه”، لا “المجرم الذي دمّر بلده وقتل نصف مليون إنسان”.
إن تحويل الدكتاتور إلى كاريكاتير ليس دائماً خطوة في طريق العدالة، بل قد يكون، أحياناً، طريقاً مختصراً نحو النسيان.
السخرية التي تهين الذاكرة: الضحايا خارج المشهد
الضحك، بطبيعته، لا يحتمل الجدية. فهو فعلٌ سريع، خفيف، يتجاوز التفاصيل الثقيلة كي يُنتج لحظةً من التسلية أو التهكّم. لكن ماذا لو كانت التفاصيل التي يُغفلها الضحك هي مجازر، وأقبية تعذيب، وآلاف الصور لجثث معتقلين أنهكهم الموت تحت التعذيب؟
في السياق السوري، لا يمكن الحديث عن بشار الأسد دون استحضار قائمة طويلة من الجرائم الموثّقة: من قصف المدنيين بالبراميل المتفجّرة، إلى استخدام السلاح الكيميائي، إلى مجازر جماعية في داريا والحولة والتريمسة والغوطة الشرقية، إلى عشرات آلاف المختفين قسراً، إلى صور “قيصر” التي كشفت للعالم شكل الجريمة حين تُترك لتتعفّن في الظلام.
حين تُروى نكتة عن غباء الأسد، أو عن طول قامته، أو عن طريقة نطقه، فإن الضحك الناتج عنها لا يمرّ فوق الجريمة، بل يمرّ على جثث أصحابها. يُعيد تشكيل الخطاب العام بحيث لا تكون الجريمة حاضرة، بل الغباء. لا القتل، بل السخرية من اللغة. لا المعتقلات، بل الميمز. ويصبح من السهل أن يشعر الضحايا أو من بقي منهم بأن معاناتهم صارت مادة للتنكيت، وأن أسماء أبنائهم التي غابت في المقابر الجماعية، لا تُستحضر إلا في الخلفية، بصمت.
أم الشهيد، التي تفقد وعيها كلما رأت صورة القاتل، لن تجد في النكتة تنفيساً، بل إهانة. والمعتقل السابق، الذي قضى سنوات تحت الأرض، لن يضحك حين يرى صورة سجّانه تُوزّع على وسائل التواصل كـ”نكتة الموسم”. ثمة ذاكرة تُهان لا لأنها تُنسى، بل لأنها تُروى بطريقة سطحية.
هذا لا يعني أن السخرية فعل مدان بالمطلق، لكننا بحاجة إلى مساءلة معيارها الأخلاقي: هل تهاجم البنية القمعية، أم تستخف بها؟ هل تحرّك الوعي، أم تروّضه؟ هل تسند الذاكرة، أم تزيّفها؟
في المجتمعات الخارجة من المجازر، تصبح طريقة السرد جزءاً من العدالة. والضحك، إن لم يكن موجّهاً ضد البنية الإجرامية نفسها، قد يتحوّل إلى أداة من أدوات محو أثر الجريمة، أو تسويتها مع النسيان.
ضحك لا يُسقط النظام: عن النكتة كتعويض وهمي
بعد سقوط النظام، استمرّ تداول النكات عن بشار الأسد كما لو أن شيئاً لم يتغير. عاد بعض الناشطين للمزاح حول “طريقة مشيه”، وسخر آخرون من خطبه القديمة، وامتلأت وسائل التواصل مجدداً بصور معدّلة ومقاطع تهكّمية. بدا المشهد وكأنّه احتفال متأخر، أو محاولة لتأكيد الانتصار بالضحك، لا بالمحاسبة. لكن هذا الضحك، في كثير من الأحيان، لم يوجَّه نحو تفكيك المنظومة، بل تحوّل إلى تعويض وهمي عن عدالة لم تتحقق.
يصف المفكر الألماني تيودور أدورنو في كتابه “جدلية سلبية” أن “الكوميديا الزائدة بعد الكارثة قد تصبح سلاحاً بيد النسيان، لا بيد الوعي”، إذ يفتح الضحك غير المنضبط الطريق لتحويل الجريمة إلى طُرفة، ويساهم في إعادة تطبيع الرموز المرتبطة بها. فحين نضحك كثيراً على الدكتاتور بعد سقوطه، من دون محاكمة، ولا مواجهة جماعية مع ما خلّفه، فإننا لا ننتصر عليه بقدر ما نُعيد إنتاج حضوره في صورة مخففة، سهلة الهضم، بل وقابلة للاستذكار الخفيف.
وهنا مكمن الخطر: حين يغيب الحساب، وتبقى النكتة، تصبح الأخيرة أداة ترويض لا تحرر، تخدير لا وعي لا يفتح جراحه، بل يغلفها بورق ضاحك. في دراسة نُشرت عام 2021 في مجلة Memory Studies، حذّر الباحث “ميشيل بوستيرو” من أن “الضحك الجماعي بعد سقوط النظم الاستبدادية، إذا لم يُرافقه مشروع عدالة انتقالية واضح، قد يؤدي إلى انفصال وجداني بين المجتمع وجرائمه التاريخية”.
في الحالة السورية، ومع انكشاف حجم الكارثة، ومع آلاف الشهادات والمقابر الجماعية التي ما تزال تُكتشف، تصبح السخرية غير المقنّنة شكلاً من أشكال الهروب الجماعي، لا من الجريمة، بل من مسؤولية سردها بصدق. وهي مسؤولية لا تخصّ الضحايا وحدهم، بل تخصّ من تبقّى ليكتب، ويوثّق، ويتذكّر.
لم يُسقط الضحكُ بشار الأسد، ولم يكن سبباً في زوال النظام. بل على العكس، لعلّه ساهم أحياناً في التخفيف من وقع الجريمة، وتقديم قاتل الشعب بصورة غير قاتلة. وإن لم نحسن إعادة ضبط خطابنا، فقد نكون ـ دون أن ندري ـ نضحك لا على الطاغية، بل على أنفسنا.
خاتمة
في طريق العودة من تلك المقابلة، ظلّت صورة السيدة في ذهني، بصمتها الذي كان أبلغ من أي تصريح. لم تكن بحاجة إلى تنديد، ولا إلى تحليل سياسي، كانت دموعها على ذكر اسم بشار الأسد كافية لتُذكّر بأن الجريمة ليست جزءاً من الماضي فحسب، بل من الذاكرة التي نقرّر كيف نرويها.
النكتة، في زمن ما بعد السقوط، لم تعد مجرّد وسيلة مقاومة. بل تحوّلت إلى اختبار أخلاقي: هل نضحك لأننا انتصرنا أم نضحك لأننا تعبنا من الحزن أم لأننا لا نعرف كيف نحكي ما حدث دون أن نُخفّف منه؟
في زمن العدالة المؤجّلة، تصبح الطريقة التي نتحدث بها عن الطغاة، جزءاً من سردية العدالة نفسها. أن نضحك على القاتل، لا يعني بالضرورة أننا حاكمناه. بل قد يعني، في بعض الأحيان، أننا أعدنا إنتاجه بصورة أكثر قبولاً، أكثر خفّة، أقل خطراً وأكثر قابلية للنسيان.
وإذا كان لا بد من ضحك، فلنضحك على أنفسنا، على هشاشة خطابنا، وعلى حاجتنا لأن نرتّب وجعنا في قوالب سهلة. أما القاتل، فلا يجوز أن يكون “نكتة الموسم”. لأن خلف صورته، ثمة أمٌّ تبكي كلما سمعت اسمه، وبلدٌ لا يزال ينفض غباره عن الركام.