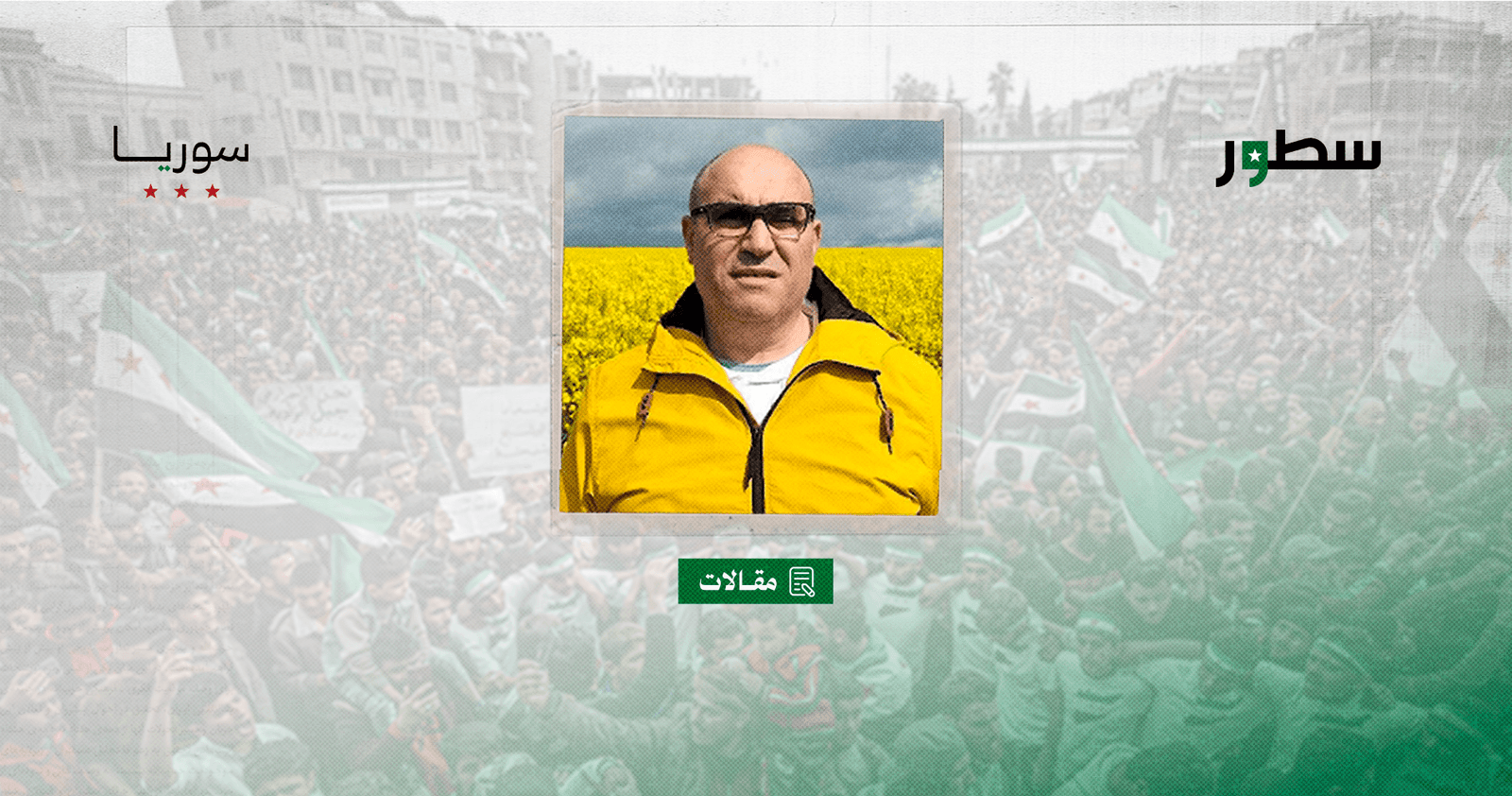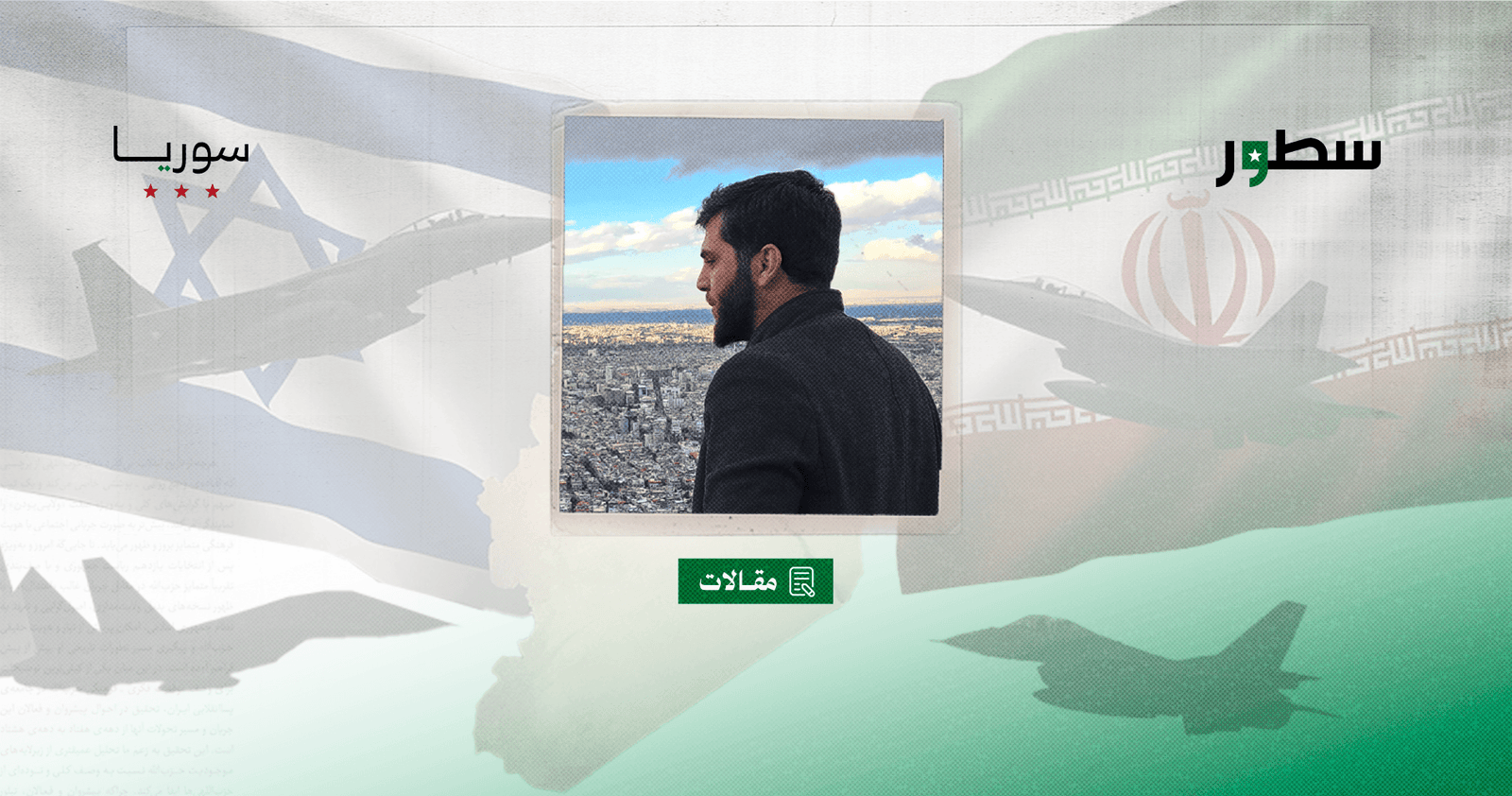سياسة
مآلات تصويت الكونغرس على مشروع قرار لا يجيز رفع العقوبات عن سوريا
مآلات تصويت الكونغرس على مشروع قرار لا يجيز رفع العقوبات عن سوريا
التصويت الذي جرى في الكونغرس الأمريكي بتاريخ 22 تموز/ يوليو الجاري بشأن المشروع المعروف بالرمز التشريعي (H.R.4427)
لا يشكّل قانوناً نافذاً بعد، بل يندرج ضمن مسار تشريعي طويل يتطلب المرور بمراحل متعددة تشمل لجان الاختصاص والتصويت في مجلسي الكونغرس، إضافة إلى مصادقة رئيس الدولة ترامب أو استخدامه لحق النقض.
المشروع يهدف لتعديل قانون قيصر للعقوبات من خلال إحكام الرقابة التشريعية على سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تجاه سوريا، وذلك في أعقاب القرار التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي برفع العقوبات المفروضة على سوريا في ظل نظام الأسد الهارب لموسكو.
هذا المشروع، وإن لم يُقر بعد، يكتسب أهمية سياسية ورمزية لكونه يأتي في لحظة انتقالية بدا أنها ستكون سهلة، لانتهاء مبررات القانون الأصلية التي تأسست على محاسبة سلطات الأسد المسؤولة عن انتهاكات مريعة موثقة حدثت بحق مدنيين سوريين.
يكتسب المشروع أيضاً بُعداً نوعياً يتمثل في الفقرة الثامنة التي تنقل جوهر العقوبات من إطارها العقابي التقليدي إلى مستوى مشروط بالأداء المؤسسي والأمني والاقتصادي للحكومة السورية المؤقتة، بما في ذلك التزامها الفعلي بمكافحة الأنشطة غير المشروعة، وعلى رأسها تجارة المخدرات.
يرى كاتب هذا النص أن التصويت، رغم ما يحمله من دلالات ضغط سياسي خارجي مرفوض، قد يشكّل فرصة مؤسساتية للحكومة الشرعية الناشئة من أجل مراجعة بنيتها الداخلية، وإعادة توجيه مقاربتها تجاه العدالة الانتقالية، وبناء منظومة قضائية مستقلة فعلياً عن سلطة القرار التنفيذي، تكفل المحاسبة وتضمن المساواة القانونية أمام جميع المواطنين دون تمييز مناطقي أو طائفي أو سياسي.
هذه اللحظة قد تكون مناسبة لكي تعيد السلطة المؤقتة في دمشق تثبيت سلوكها ككيان سيادي مسؤول أمام شعبها أولاً، ضمن حدود الدستور الوطني، وتحت أعين الرقابة الحقوقية الدولية، رغم يقيني المسبق أن ما يُعرف بالمجتمع الدولي ليس جهة حيادية أو قائمة على مرجعية أخلاقية مستقرة، بل هي منظومة سياسية تحكمها المصالح، وقد أظهرت خلال 14 عاماً من الثورة السورية، وعقود سبقتها، أنها تمارس معايير مزدوجة وغير متزنة في كثير من الملفات، وفي مقدمتها القضية السورية والفلسطينية وما يتعلق بها من قضايا المنطقة.
إن التصويت الأخير أشار بشكل غير مباشر إلى أن الشرعية الممنوحة من الخارج لا تمنح أي جهة، أياً كانت، الحق في استخدام العنف العشوائي أو تبرير انتهاك الحقوق تحت غطاء السيادة أو الخصوصيات الدينية أو الإثنية. هناك خرافة شعبية تقول إن امتلاك سلطة الحكم يعني امتلاك الحق في القمع والقهر، وهو افتراض باطل في القانون والعدالة ومبدأ الحوكمة الرشيدة. بالتالي فإن الشرعية الانتقالية لا تعني الإعفاء من المسؤولية أو التساهل في ضبط التعديات، بل تعني الالتزام المضاعف بتحقيق الانضباط المؤسسي والاحتكام إلى قضاء فعّال.
وفي هذا السياق، لا يمكن التغاضي عن حادثة مؤسفة تجسدت في استدعاء إحدى الجهات السورية لقوة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ ضربة عسكرية داخلية استهدفت مقر هيئة الأركان السورية، وهي واقعة تشكّل تصعيداً غير مسبوق في اختراق السيادة الوطنية والمحاسبة، واستمراراً لنهج اعتداءات الاحتلال التي بدأت منذ إلغاء اتفاقية روجرز السارية منذ 1974من طرف إسرائيل، وما تلاها من استمرارية احتلال نقاط جديدة والتمركز فيها بحجة الأمن الاستباقي، حصلت بعد هروب رأس النظام السابق إلى موسكو، وما تبعه من تدمير ممنهج لما تبقى من البنية التحتية للجيش السوري من قبل العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية.
هذه التطورات أيضاً سمحت بمراجعة مسؤولة من جميع الجهات والشخصيات التي دعمت خطاب السلام المجاني مع سلطة الاحتلال، وسوّقت له نظرياً أو سياسياً، ودفعت به للمجال العام باسم الواقعية أو المصلحة العليا، متذرعة بمواقف السلطة المؤقتة التي فسّر البعض تصريحاتها على أنها دعم لهذا التوجه. ذلك التذرع لم يعد مقبولاً، بل بات مكشوفاً ومثيراً للشفقة، خصوصاً في ضوء ما يتعرض له أهل غزة من عدوان مستمر في ظل صمت أو تواطؤ من دول الجوار والعالم.
السياسة الأمريكية، رغم انحيازها التاريخي للاحتلال الإسرائيلي، لا تكتفي في هذه المرحلة بإنتاج موجة مقترحة من العقوبات، بل تعيد تعريف حدود المشروعية السياسية للحكم في سوريا، وتضع السلطة الحالية أمام مسؤولية مزدوجة، هي تثبيت شرعيتها داخلياً، وتجنيبها التحول لأداة فئوية أو طائفية. ولأجل ذلك، ينبغي أن تكون العلاقة مع المكونات الاجتماعية مسألة داخلية خالصة، لا تتأثر بإرادة الخارج، ولا تتيح لأي طرف أن يتذرع بعجز المؤسسات ليستقوي بالخارج.
الموقف الأمريكي الحالي لا يمنح الثقة، لكنه يختبر مصداقية الأداء. لا يعفي من المسؤولية، لكنه يفتح ممراً ضيقاً للخروج من منطق الفصائلية والتشرذم الذي ما يزال يطغى على المشهد العسكري والمؤسسي. ذلك أن السلطة الشرعية المؤقتة، ورغم تماسكها الظاهري، لم تتمكن بعد من ضبط الفصائل على نحو قانوني علني، ولم تُعلن عن محاسبة واحدة ضد أي تشكيل ارتكب انتهاكات أو جرّ الدولة الناشئة إلى استحقاقات طائفية كانت في غنى عنها.
وفي هذه المرحلة الحساسة، ومع تزايد الاستقطابات والضغوط الاقتصادية والأمنية، تُختبر النوايا الحقيقية، وتسقط الأقنعة التي طالما احتمت بخطابات دينية أو وطنية، لم تُثبت نفسها حين استحقّت الفعل، فبقيت مجرد عبارات للاستهلاك النخبوي والتهرب من الواجبات.
ربما كان من الأفضل أن تكون هذه المراجعة ذاتية نابعة من إرادة داخلية، لكن الواقع يشير إلى أن حضور عامل خارجي حاسم، ولو كان غير نزيه مثل الموقف الأمريكي، قد يُجبر الفاعلين السياسيين والمؤسسين على مراجعة مساراتهم، والتفكير مجدداً في تأسيس منظومة عدالة ومؤسسات تتيح لكل الأطراف أن تتنافس وتختلف تحت سقف واحد، لا تحت رحمة الخارج، ولا تحت سطوة الإكراه بالسلاح.