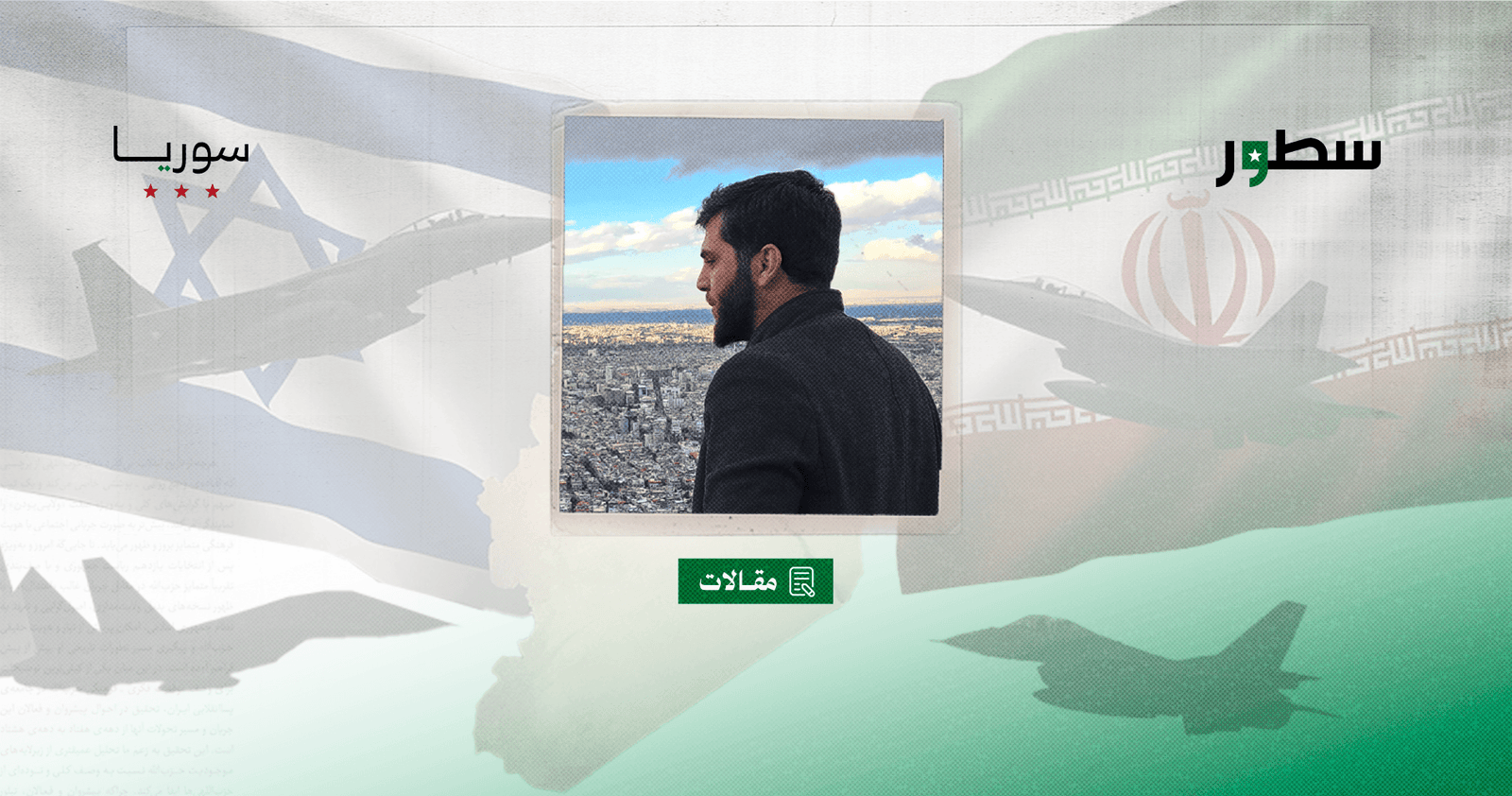مشاركات سوريا
يوميات الثورة والحصار 2.. حكاية بيتٍ ضاق بالعائلة واتسعت به الذاكرة
يوميات الثورة والحصار 2.. حكاية بيتٍ ضاق بالعائلة واتسعت به الذاكرة
بعد استشهاد جهاد، لم تعد الأرض كما كانت، ولا البيت الذي نأوي إليه عاد مألوفاً. ضاقت بنا الجدران، وضاقت الأرواح بما حملت من وجع الفقد، حتى غدا الليل ثقيلاً على قلب أبي وأمي، لا يعرفان للنوم سبيلاً. كان الحزن يتربّص بنا في الزوايا، ويهمس في عيوننا كلّما أطفأنا الضوء، وكلّما تظاهرنا أننا بخير.
قررنا الرحيل من ذلك المكان الذي بات يختنق بذكريات الشهيد، وعدنا إلى بيتنا الأول، إلى الحيّ الذي كان يوماً مأوى الطفولة والصخب والدفء. لم نكن نعلم أن العودة ستكون إلى حصار لا يرحم، وإلى مخيمٍ بدأت أطرافه تئنّ تحت وطأة القهر والعزلة، بعدما اشتدّ الخناق على الجنوب الدمشقي.
عند أول حاجز صادفناه، عرفنا أن الأمور تغيّرت، وأن الحصار ليس فقط بالجدران، بل بالوجوه والقرارات والمزاجيات. الحاجز يفتح ويُغلق كما يشاء عناصره، بلا نظام ولا مبرر، كأننا قطع شطرنج لا وزن لها. يُسمح لبعضهم بالمرور، ويُردّ آخرون دون سبب. لا مكان لنداء المرضى، ولا لدموع الأمهات، ولا حتى لبكاء طفل يتوق إلى علبة حليب.
أما من أراد الخروج من المخيم، فعليه أن يسلك الطريق الطويل الممتد من الحاجز إلى ساحة الريجة. طريق مكشوف، ينهكه الانتظار كما تنهكه الأقدام عدا عن طول الطريق من ببيلا إلى المخيم. ترى فيه كل صباح جموع الموظفين والطلبة، يحملون حقائبهم وأحلامهم ويصطفّون بصمت متعب على أمل أن يُسمح لهم بالعبور. وحين تميل الشمس إلى المغيب، يعودون مثقلين بحوائجهم، يجرّون تعب النهار خلفهم كظلٍ ثقيل.
ولأن الجوع لا ينتظر، كانت المساعدات تصل بعد مماطلة طويلة، وبعد أن تُنهب منها الحصة الكبرى على مرأى من الجميع. ما يصل إلى الداخل لا يكفي ربع الناس، فتتقاسم العائلات فتات الطحين، ويخبّئ الأطفال قطعة البسكويت ككنز لا يُقدّر بثمن.
لكننا تأقلمنا. ما دام البيت يضمّنا، وما دامت العائلة متماسكة، فكلّ شيء يُحتمل. لم يكن أحد يملك ترف التذمّر، ولا فسحةً للتململ. أصبحنا نُخطط حياتنا على إيقاع الحصار، نُوفّر الخبز كأننا نحفظ أرواحنا، ونقتسم الكهرباء ساعة كل يومين، بالكاد تكفي للغسيل مرة واحدة أو شحن البطاريات والهواتف المحمولة.
في الليالي، كانت الشمعة رفيقتنا الصامتة، تنثر ضوءاً شاحباً لكنه دافئ، وتجمعنا حولها، كما لو أنها ترفض أن تتركنا للظلمة وحدنا. كنّا نروي الحكايات، نضحك قليلاً، ونبكي كثيراً. كل لحظة تمرّ كانت درساً في الصبر، وكل يوم يُفتح فيه الحاجز يُعدّ نصراً صغيراً يُقاوم انكساراتنا.
الفرن الوحيد في الحيّ، بات نافذتنا إلى الحياة. يعمل بنصف طاقته، لكنه يمنحنا ما يكفي لنشعر أننا ما زلنا أحياء. نحمل الأرغفة الساخنة كمن يحمل شيئاً مقدساً، نُخبّئه عن أعين الجوع ونفوس الحاجة. والماء، تلك النعمة التي كانت تُهدر بسخاء، صارت تُحسب بالقطرات. نحملها في غالونات، ونحرص على كل رشفة منها كأنها تروي عطشاً عمره أعوام.
كانت الحياة تمضي ببطء، لكنها تمضي. نتعلّم كيف نعيش بموارد أقل، وبصبرٍ أكثر. كيف نُطوّع الألم ليصبح احتمالاً، وكيف نُبقي على جذوة الأمل وسط ركام الخوف. ورغم القهر، ورغم جدران الحصار، كان هناك شيء فينا يرفض الانكسار. شيء يُشبه روح جهاد التي لم تغب، بل بقيت معنا، تُضيء عتمتنا وتذكّرنا دوماً أن من يقدّم حياته في سبيل وطنه، لا يموت.
لكن حتى هذا التكيّف الهشّ لم يدم طويلاً. ففي أحد الأيام، ودون سابق إنذار، أُغلق الحاجز تماماً. لم يُفتح صباحاً كما جرت العادة، ولم يُسمح لأحد بالخروج أو الدخول. أصبحنا فجأة في سجنٍ كبير، نُطلّ من نوافذنا على فراغ الطريق، ونعدّ ساعات اليوم على أمل أن يُرفع الحاجز، عبثاً. انقطعت الأخبار، وتوقفت الحركة، وأُسدلت ستائر الحياة اليومية الثقيلة. صار الخروج حلماً مؤجلاً، والمساعدات الموعودة وهماً بعيداً، وكأنّ الجنوب الدمشقي شُطب من خارطة المدن الحيّة.
ومما زاد من صعوبة الحصار وشد من خناقه حولنا أنني بقيت مع أبي وأختي وحيدين في بيتنا منفانا عن العالم، حيث أُغلق الحاجز على إخوتي وأمي عند خروجهم للجامعة ولقاح أخي الصغير.
في لحظة، لم يعد الزمن يتحرك، ولم تعد الوجوه تُبدي أكثر من الصمت والترقّب. عاد الليل ليحكم قبضته، لا شمعة تُخفف ظلمته، ولا أمل يُبدّد ثقله. أُغلق الحاجز، لكن في قلوبنا ألف نافذة ظلّت مفتوحة، تهمس: لا حصار يدوم، ولا قيد يبقى، ما دامت في الصدور بقايا حياة.
اليوم، حين أستعيد تلك المرحلة، لا أراها مجرد سيرة من المعاناة، بل مرآة لصلابة شعب، وعائلة، وأمّ لم تفقد يقينها رغم أنين الليل. لقد ضاق بنا البيت يوماً، لكنه اتسع بالحب، بالصبر، وبذكرى من رحل ليُعلّمنا أن الحرية أثمن من الحياة ذاتها.