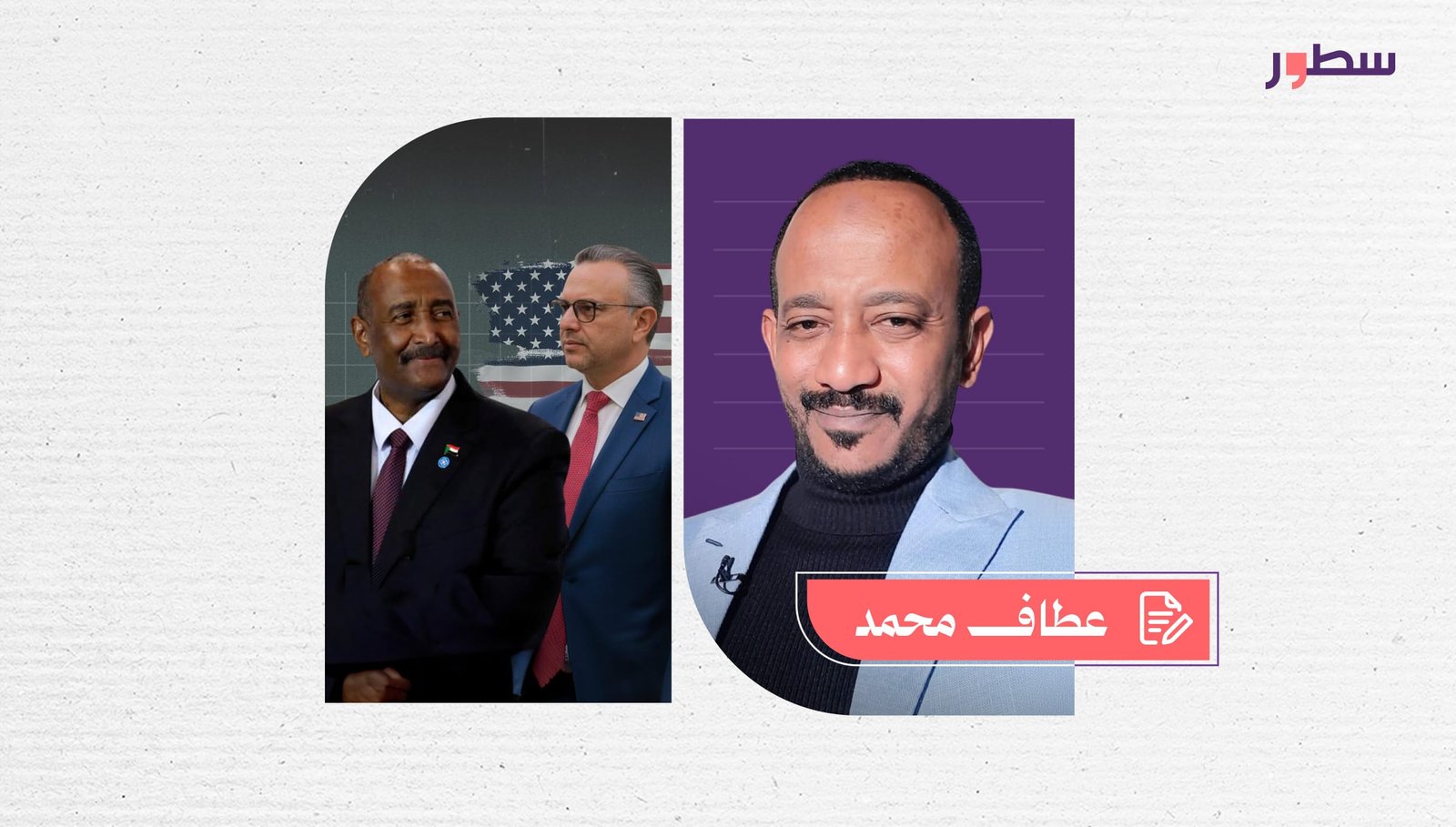سياسة
ذاكرة القارة الأفريقيّة في قبضة اللهب: إنقاذ مخطوطات تمبكتو من الإبادة!
ذاكرة القارة الأفريقيّة في قبضة اللهب: إنقاذ مخطوطات تمبكتو من الإبادة!
في عالمٍ تستعر فيه حروب على الذاكرة بقدر ما تستعر بالسلاح، تبرز قصة مدينة تمبكتو في مالي كواحدة من أعظم ملاحم الدّفاع عن التراث الإنسانيّ. فهنا، على تخوم الصحراء الكبرى، وقف أمناء المكتبات وعلماء المجتمع المحليّ في وجه من أرادوا طمس تاريخهم وهويتهم. إنَّها حكاية المخطوطات العتيقة التي كُتبت قبل قرون، وحُمِلت عبر القوافل والصحارى، لتغدو في القرن الحادي والعشرين هدفًا لقوى الظلام والتطرف.
كانت مدينة تمبكتو منذ قرون، العاصمة الثقافيّة لغرب إفريقيا وملتقى الحضارات بين شمال القارة وجنوبها. ويعود تأسيس المدينة إلى القرن الثاني عشر تقريبًا، لكنها بلغت شهرتها وذروة إشعاعها الفكريّ بدءًا من القرن الخامس عشر إبّان حكم إمبراطوريّة صنغاي. حينها ازدهرت المدارس والمكتبات، وتحول تجارة الكتب إلى نشاطٍ اقتصادي رائج يفوق قيمة سائر التّجارة؛ حتى أنّ الرحّالة الأندلسيّ الشهير حسن بن محمد الوزان (المعروف بـ ليون الإفريقي) أدهشه في أوائل القرن السادس عشر ما رآه في تمبكتو من قوافل العلماء واحتفاء أهلها بالكتب.
وقد سجّل في كتابه وصف إفريقيا أنّ المخطوطات الواردة من الشمال (بلاد البربر) تُباع في أسواق تمبكتو بأثمانٍ تفوق أيّ سلعة أخرى، ممّا يدل على مكانة المعرفة العالية في تلك الحضارة. وتؤكد وقائع أخرى من تاريخ المدينة هذا الشغف بالعلم، فمثلًا يروي تاريخ الفتّاش –وهو أحد مدوّنات تمبكتو الشهيرة– أن أحد ملوكها اشترى قاموسًا لغويًّا نادرًا بما يعادل ثمن فرسين، في مشهدٍ يعكس كيف كانت الكتب أثمن من الذهب في عيون أهل الصحراء. ثمّ شهدت تمبكتو خلال ازدهارها تجمع نخبة من العلماء والمتخصصين في شتّى العلوم. يذكر ليون الإفريقيّ أنّه وجد في تمبكتو قضاةً وفقهاء وأطباء وشعراء يقصدونها من كل حدب وصوب، وأنّ حاكمها كان يُجِلّ العلم والعلماء. وكانت جامعة سانكوري في تمبكتو منارةً علمية إسلامية يفد إليها الطلاب من أنحاء إفريقيا طلبًا للمعرفة. وتضمنت المناهج آنذاك علوم الفلك والرياضيات والكيمياء والموسيقى والفقه واللغة، وجرى نسخ الكتب والمخطوطات بأيدي نُسّاخ مهرة لبيعها وتبادلها، حتى أصبحت تمبكتو في المخيلة العالميّة رمزًا لمجد إفريقيا الضائع، حتى أنّ بعض الرّحالة الأوروبيين ظنّوها مدينة أسطوريّة في “طرف الدنيا”. لكن الوثائق التاريخية تؤكد واقعيتها المذهلة: مجتمع مدنيّ عماده المعرفة المكتوبة ومنابر علميّة سبقت عصرها.
المخطوطات الأفريقيّة: دليل مبكر على نضج حضاري
لم يبدأ اهتمام الباحثين المعاصرين بمخطوطات تمبكتو إلّا في القرن التاسع عشر، حين وصل المستكشف الألماني هاينريش بارت إلى مالي واطلع على مخطوطة تاريخ الفتّاش. شكّل نشر ترجمة هذه المخطوطة حدثًا مفصليًّا في فهم الغرب لأفريقيا، إذ كشفت فصولها عن تفاصيل التنظيم الاجتماعيّ والسياسيّ لتمبكتو في عصر ازدهارها. وتبيّن للمؤرخين أنّ هذه المدونات المحليّة دحَضَت الصورة النمطيّة الاستعماريّة عن مجتمع “بدائي” يفتقر إلى التدوين والنظام؛ فقد وجدت فيها نظريات في علاج الأمراض ووصفات صيدلانية، ورصد لحركات النجوم والظواهر الفلكيّة، وحتى سجلات محليّة للمعاملات التجاريّة والقضائيّة.
كما اكتُشفت لاحقًا وثيقة فريدة عُرفت باسم “ميثاق الماندي” أو “كوروكان فُوغا”، تُعدّ بمثابة الدستور الأول لإمبراطورية مالي، وقد وضعه الإمبراطور العظيم سوندياتا كيتا في القرن الثالث عشر. مثّلت هذه المخطوطة القانونية شاهدًا نادرًا على أنّ الأفارقة شرّعوا منذ ثمانية قرون قوانين متقدّمة لتنظيم الحكم وشؤون المجتمع، حيث اشتملت على مبادئ دقيقة في الإدارة الرشيدة، من بينها التأكيد على عدالة الحاكم وشفافيته، وتجريم النعرات القبليّة، إضافة إلى تنظيم مجلس شورى خاص بالإمبراطور يُحدّد صلاحياته، وينص على آليات واضحة لانتقال السلطة بسلاسة في حالات الشغور أو الوفاة. ويُعدّ ما ورد فيها من دقّة ووعي قانونيّ، في زمن سحيق كهذا، دليلًا قاطعًا على أنّ إفريقيا لم تكن يومًا خارج سياق تطور الفكر السياسيّ البشريّ، وإنْ تجاهل ذلك التأريخ الغربي طويلاً. وقد نالت هذه الوثيقة الاعتراف الدولي حين أُدرجت ضمن قائمة اليونسكو للتراث الإنسانيّ غير المادي سنة 2009، بوصفها من أقدم ما سُجّل في تاريخ الإنسانيّة من مواثيق تُعنى بحقوق الإنسان.
إلّا أنّ القيمة الأعمق لهذه المخطوطات لا تنحصر في مضامينها المعرفية في العلوم الطبيعيّة والإنسانيّة فحسب، بل تكمن كذلك في رمزيتها الوجدانيّة لدى الأفارقة المعاصرين؛ فهي تثبت بما لا يدع مجالًا للشك أنّ حضارة إفريقيا كانت حضارة مداد وورق، تمامًا كما كانت حضارة رواية ولسان. وعلى النقيض من الأسطورة الاستعماريّة التي سوّقت لفكرة أن الأفارقة “شعوب لا كتابة لها”، تأتي هذه النصوص الضاربة في القِدَم – والتي يعود أقدمها إلى القرن الثامن الميلادي– لتقلب تلك السرديّة وتعيد الاعتبار للتاريخ الإفريقيّ المكتوب. وتشير الدراسات الحديثة إلى وجود ما يقارب المليون مخطوطة إفريقية منتشرة بين نهر السنغال ورافد النيل، من بينها نحو 700 ألف مخطوطة محفوظة في مكتبات تمبكتو وحدها. وقد شهد علماء مرموقون –أمثال الدكتور هنري لويس غيتس– على هذا الإرث المذهل، حين وقفوا بأنفسهم على رفوف مكتباتٍ عائلية في قلب الصحراء، تكتنز مجلدات نادرة صمدت عبر قرون من التقلبات المناخيّة والتحوّلات السياسيّة، لتظل شاهدة على تميّز إفريقيا وإسهامها في التاريخ الكوني للمعرفة.
حراسة الذاكرة: من مقاومة النّهب إلى بعث المخطوط
لم يكن لبقاء مخطوطات تمبكتو على قيد الحياة أن يتحقّق لولا يقظة أهلها، الذين توارثوا حمايتها جيلًا بعد جيل، كأنّما يحملون أمانة الذاكرة في عروقهم. فمنذ أواخر القرن السادس عشر، والمدينة تتعرض لعواصف محنٍ متتاليةٍ، أوّلها الغزو المغربيّ عام 1591، الذي انتهى بأسر صفوة علمائها ونقل ذخائرها الفكريّة إلى مراكش. ومع تعاقب القرون، لم تهدأ التهديدات؛ إذ أتلف الجفاف والفيضانات عددًا من المجموعات، ثم جاء الاستعمار الأوروبيّ ليضرب ما تبقّى منها، لا من باب الجهل بقيمتها، بل إدراكًا تامًا لما تمثّله من سيادة معرفيّة.
تشير الروايات المحليّة إلى أنّ سلطات الاستعمار الفرنسيّ –خلال فترة احتلال مالي (1894–1960)– عمدت إلى مصادرة عدد كبير من المخطوطات، بل أقدمت على حرقها عمدًا لمحو ذاكرة المقاومة الثقافيّة. ففي عام 1913 تحديدًا، حاول ضابط فرنسيّ إحراق مكتبة أهليّة تحتضن ما لا يقل عن ثلاثين ألف مخطوطة، إلّا أنّ الأهالي هبّوا لحمايتها، ونجحوا في تهريب غالبية محتوياتها، وأخفوها في صناديق خشبية دُفنت تحت رمال الصحراء بعيدًا عن أنظار العسكر. ولم تكن تلك الحادثة الوحيدة؛ بل أضحت الخبرة المتوارثة في الإخفاء والتحصين ركنًا من ثقافة المدينة. فنتيجةً لهذه الصدمات التاريخيّة، آثر كثير من السكان إبقاء مخطوطاتهم في مكتباتٍ عائليّة خاصة – قُدّر عددها بين 60 و80 مكتبة– موزعة على أحياء المدينة وأطرافها، بدلًا من تسليمها إلى مؤسسات رسميّة قد تعجز عن حمايتها. هذا الحذر، وإن بدا مفرطًا، كان تعبيرًا عن ذاكرة جمعية مُثقلة بأهوال السلب، وفطرة شعبٍ خَبِرَ أنّ المستعمر لا يسعى فقط للسيطرة، بل لمحو الذاكرة ذاتها.
وبعد نيل الاستقلال عام 1960، نشأت مؤسسات وطنيّة لرعاية التراث، من أبرزها “معهد أحمد بابا للمخطوطات”، الذي جمع ما يقرب من 30 ألف مخطوطة في مقره الرسميّ، في محاولة لترميم ما اندثر، وتأريخ ما تبقى. لكن المأساة الكبرى لم تأتِ من زمن الاستعمار، بل من الداخل، حين اجتاحت جماعات متطرفة – تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلاميّ– شمال مالي عام 2012، واستولت على تمبكتو لعدة أشهر، معلنة عزمها القضاء على كل ما لا يوافق أيديولوجيتها، بدءًا من المزارات الصوفيّة وانتهاءً بالمكتبات. لم تتوانَ تلك الجماعات عن تنفيذ تهديداتها، إذ أحرقت عدة مراكز للمخطوطات، من بينها مبنى تابع لمعهد أحمد بابا، وعبثت بكنوز معرفيّة لا تقدّر بثمن. تشير التقديرات إلى أنّ قرابة 40% من المخطوطات تعرّضت للحرق أو التلف. مشاهد النار تلتهم الرفوف كانت بمثابة اغتيال معنويّ لذاكرة شعب بأكمله، وصرخة دامية في وجه العالم المتفرّج.
لكن وسط هذا الدمار، برز بصيص رجاء: فقد أظهر سكان تمبكتو – مرةً أخرى– معدنهم الأصيل، حين نفّذوا عملية تهريب معقّدة لإنقاذ ما تبقّى. وبفضل جهود منسّقة بين الأهالي وخبراء محليين، تبيّن لاحقًا أنّ نحو 90% من المجموعات قد تم تهريبها إلى أماكن آمنة قبل أن تصل إليها أيدي المتطرفين.
ومع تحرير المدينة أوائل 2013، أُعيد إحياء الأمل، لكن المعركة الحقيقية بدأت حينها؛ إذ لم تعد القضية إنقاذ الأوراق فقط، بل إثبات أنّ هذه المخطوطات هي شاهد حضاري على انخراط الأفارقة في مسيرة الإنسانيّة الكبرى. فهي لا تمثّل مجرد نصوص عتيقة، بل وثائق شاهدة على عقولٍ أفريقيّة خطّت باللغات العربيّة والسونغيّة والتماشيقيّة والبامباريّة.
وكما حذّر الفيلسوف المارتينيكيّ فرانز فانون، فإنّ أخطر أدوات الاستعمار لم تكن المدافع فقط، بل محاولته إقناع الشعوب المستعمَرة بأنّهم بلا ماضٍ ولا ذاكرة. ولهذا، فإنّ إعادة الاعتبار لهذه المخطوطات هو فعل مقاومة فكريّة بامتياز، يُعيد للأفارقة صوتهم المدوَّن.
وانطلاقًا من هذا الوعي، تزايدت الدعوات في السنوات الأخيرة إلى ضرورة إطلاق مشروع ثقافيّ قارّي شامل، يتجاوز حدود مالي، نحو ترميم وحفظ آلاف المخطوطات المنتشرة في القارة، وتأسيس مراكز تدريب محليّة لعلم الكوديكولوجيا، وتوسيع رقعة الرقمنة كي تصبح هذه الكنوز في متناول أي طالب أو باحث. بل إنّ لهذا الحراك بُعدًا أنثروبولوجيًّا عميقًا، يكشف من خلال دراسة المخطوطات بنية المجتمعات الإفريقية، ويفكّك الصورة النمطيّة التي اختزلت القارة في الأمّية والشفاهيّة. إن وثائق مثل “ميثاق الماندي” لا تسجل فقط مبادئ الحكم الرشيد في القرن الثالث عشر، بل ترسم ملامح فهم إفريقيّ مبكر للعقد الاجتماعيّ، وتكشف رسائل العلماء الأفارقة مع أقرانهم في فاس والقاهرة عن وجود شبكة علميّة عابرة للحدود، لا تقل شأنًا عن مثيلاتها في أوروبا أو آسيا.
ولعل ما يعكس الاعتراف الدولي المتأخر بقيمة هذا الإرث، هو دخول مكتبات كبرى في شراكات لحفظه، من مكتبة القرآن بالشارقة، إلى مكتبة الكونغرس والمكتبة البريطانيّة، بل حتى مكتبة الفاتيكان ذات الرمزيّة المسيحيّة العريقة، التي استضافت علماء مالي، وقدّمت دورات تدريبيّة، وساهمت في رقمنة بعض النصوص، في مبادرة لحوارٍ حضاري بين الضفتين.
ختامًا، تأتي ملحمة تمبكتو لتذكرنا بأنّ الهوية الإنسانيّة هي حصيلة ما تراكمه الذاكرة من معرفة وإبداع. وإذا كان ثمّة درس نأخذه من يوم الكتاب العالمي، فهو أنّ الكتاب قد يكون أحيانًا أشدّ قوة من المدفع، وأنّ حفظ التراث هو في جوهره دفاع عن الإنسانيّة المشتركة في وجه كل من يسعى لتفريقها أو تدمير منجزاتها. ستبقى مخطوطات تمبكتو، بما نجا منها وما فُقد، شاهدًا على أنّ حضارة إفريقيا لم تنطفئ يومًا، وأنّ أبناءها قادرون على حماية شعلتها المُتّقدة وإضاءتها للأجيال القادمة بالرغم من كلّ الصعاب.