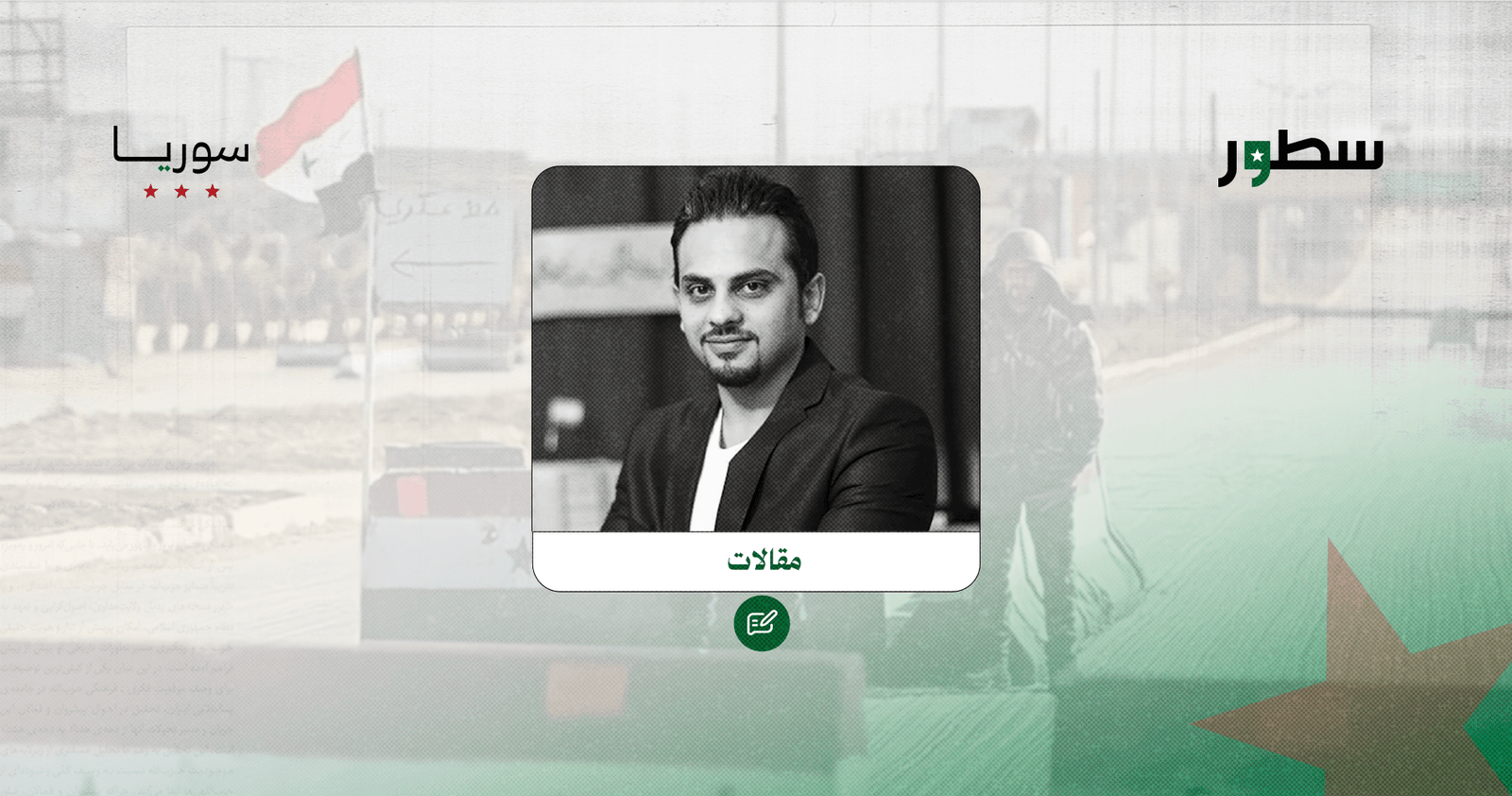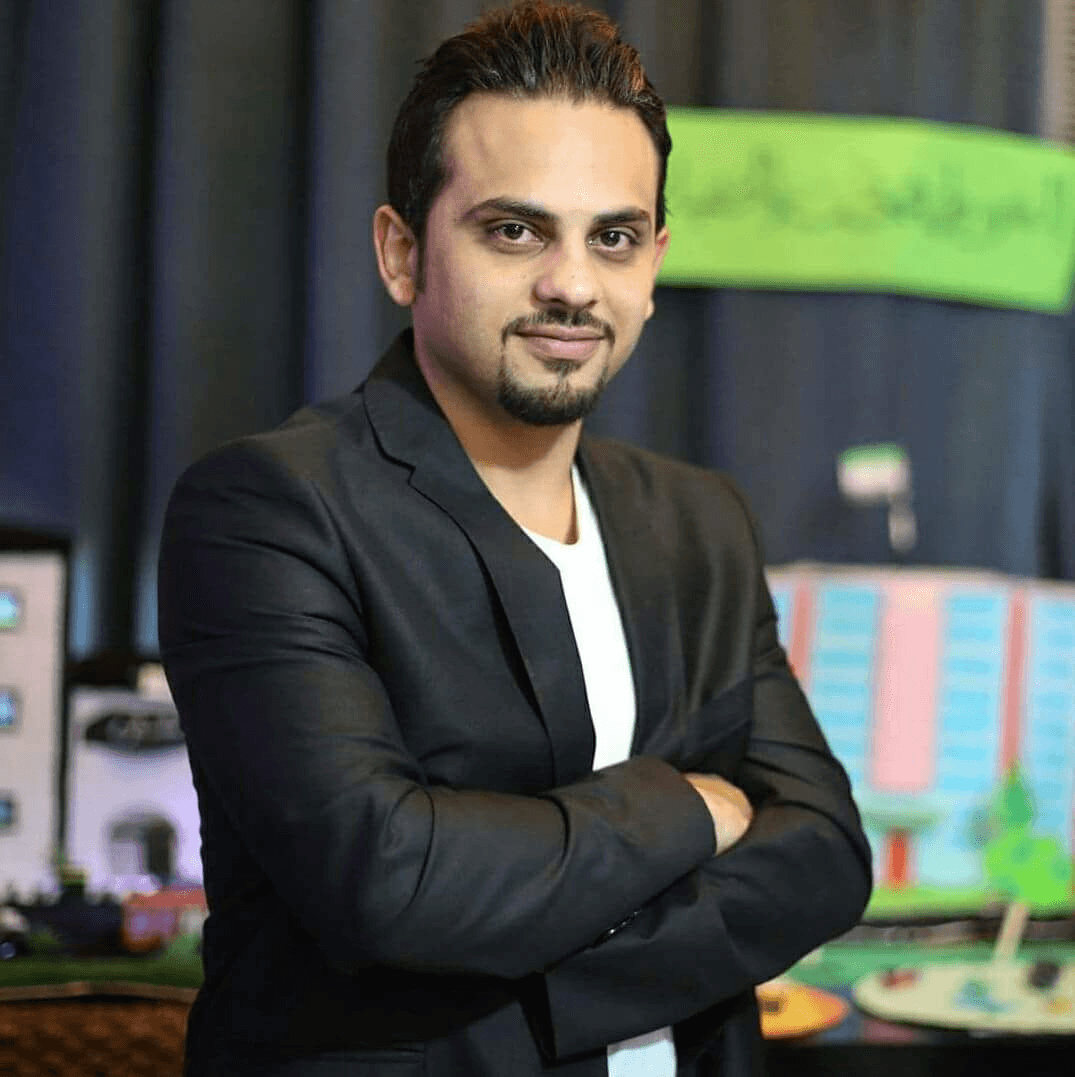سياسة
السويداء بين فخ الخصوصية ومشروع الوصاية: هل نهوض العشائر إعلان وفاة لحلم إسرائيل في الجنوب؟
السويداء بين فخ الخصوصية ومشروع الوصاية: هل نهوض العشائر إعلان وفاة لحلم إسرائيل في الجنوب؟
على الحدّ الفاصل بين ساحة الأمويين التي اهتزّت تحت صواريخ العدو الإسرائيلي الغاشم، وجبل العرب الذي ارتجّ تحت أقدام العشائر السورية الزاحفة من كل اتجاه، تعيش سوريا لحظاتٍ فارقة حقيقية لتُختبر معاني الوطنية والانتماء فيها، بعد أن حررت نفسها من كابوس نظام الأسد البائد نهاية عام 2024.
في الجنوب، حيث محافظة السويداء التي لطالما تمايزت بمواقفها الخاصة، لم يعد المشهد يحمل فقط ملامح الخصوصية أو الحياد، بل بات البعض فيه يجرّ المحافظة نحو المشروع الإسرائيلي مباشرة، عبر أذرع محلية يتقدّمها “شيخ العقل” حكمت الهجري، الذي لم يتوانَ عن استدعاء تل أبيب بشكل فجّ وعلني، في لحظة ظنّ فيها أن إسرائيل قادرة على تأمين حصانة لطائفته أو جماعته إن صحّ التعبير، ولو كان ذلك على حساب الوطن كله.
هذا التحوّل لم يكن وليد لحظة، بل هو نتيجة تراكمات امتدت لسنوات، حيث عجزت الدولة السورية الجديدة، بعد سقوط الأسد، عن إقناع جماعات مسلّحة خارجة عن القانون في السويداء بالاندماج مجددًا في مشروع الدولة، رغم كل المحاولات والمفاوضات، وبينما كان الشيخ سلطان البلعوس ومشايخ العقل الوطنيين يدعون لعودة الدوائر الرسمية وقوات الشرطة ووزارة الداخلية، كانت جماعة الهجري تمضي في طريق التفلّت والانفصال، إلى أن جاء مشهد الصدمة، اقتتال داخلي دموي مع عشائر البدو، ثم تصدٍ عنيف لقوات فض النزاع الحكومية، ليظهر للجميع من الذي يخشى عودة الدولة، ومن الذي يعمل ضد وحدة البلاد.
لكن ما هو أخطر من الاقتتال، هو أن يفتح هذا التيار الباب أمام تدخل إسرائيل المباشر، في سابقة لم تشهدها أي منطقة سورية منذ بداية الثورة، ليس من باب العدوان فحسب، بل من باب “الوصاية”، القصف الإسرائيلي لمبنى هيئة الأركان في دمشق لم يكن فقط رسالة عسكرية، بل كان إعلانًا عن غاية إسرائيلية في احتضان مشروع الانفصال داخل السويداء، بعد طرد الهجري وجماعته، وفشل مشروعهم.
ووسط اتفاق دولي وإقليمي رعته تل أبيب وواشنطن وتركيا وبعض الدول العربية تم التوصل إلى هدنة تنسحب فيها الدولة من السويداء، وهو ما اعتبره السوريون طعنةً في السيادة، وفرصة جديدة لعودة القتلة ليكملوا مذابحهم بحق العشائر البدوية الذين يسكنون جبل العرب قبل الدروز أنفسهم، لكن الحدث لم ينتهِ هنا، بل امتد المشهد إلى ما يشبه “الصحوة العربية”، حين لبّت قبائل سوريا نداءات الحرائر والأرامل والناجين من مذابح الهجري، فخرجت عشرات آلاف من العشائر، كالسيل الجارف نحو السويداء، لا لتفتح جبهة طائفية كما يحاول البعض الترويج بل لتقول: لن نسمح لدولة الاحتلال بأن تجد لها موطئ قدم على ترابنا.
وفي خضّم هذه الأحداث، تُطرح أسئلة مهمة جداً حول ما يجري في السويداء، فهل هو لحظة تمرّد عابرة أم بداية جديدة لمشروع تقسيمي قد تم رسمه في غرف تل أبيب؟، وهل حقاً أصبح بعض السوريين جاهزين لتتنازل عن الهوية مقابل حماية مزعومة من عدوٍ غاشم على مرّ التاريخ والعدو لا يحترم حتى عملائه؟ وهل الدولة السورية الجديدة الوطنية ما زالت قادرة على استعادة سيادتها بلا تواطؤ دولي؟
من الخصوصية إلى الوصاية
عندما يرفع مكوّن محلي في دولة ما راية “الخصوصية” فذلك أمر قابل للنقاش، لكن حين تتحوّل هذه الخصوصية إلى أداة لرفض الدولة، وذريعة لاستدعاء الوصاية الأجنبية، تصبح المسألة خطرًا وطنيًا، لا مجرّد رأي أو اجتهاد سياسي، السويداء التي كانت لعقود تُقدّم نفسها كمنطقة مستقلة المزاج والقرار، تشهد اليوم منعطفًا بالغ الخطورة، فبعض الفاعلين فيها لم يكتفوا بعدم الاندماج في الدولة الجديدة، بل سعوا، عن سابق قصد، إلى إنتاج شكل بديل من “الانتماء”، يضع الهويّة السورية على الرف، ويضع يدًا في يد كيان غاصب، يعتدي على الأرض والإنسان والمصير، وإن ما يجري في الجنوب السوري ليس تمرّدًا محليًا ولا احتجاجًا مدنيًا، بل محاولة مكتملة الأركان لفرض واقع انفصالي، تُحرّكه إسرائيل بوضوح، وتُشرعنه أدوات محلية باعت هويتها لقاء وهم الحماية أو النفوذ أو الاستثناء، وهذه ليست خيانة عابرة، بل مشروع خبيث يستخدم اللامركزية ذريعة للانفصال، والحياد غطاءً للتعاون مع العدو.
الواضح اليوم، أنّ المشروع الإسرائيلي لا يريد من السويداء الأمن أو السلام، بل يريد ثغرة جديدة في الجغرافيا السورية، يُكرّس عبرها مفهوم “الدويلات”، ويعيد إنتاج نظرية الشرق الأوسط المجزأ والضعيف، حيث لا دولة قوية، ولا جيش واحد، ولا قرار سيادي موحد، وما ممر “داوود” وخرائط الفيدراليات المقنّعة، إلا دلائل حيّة على الطموح الإسرائيلي الساعي لشقّ الجسد السوري من الداخل، بعد أن فشل في إخضاعه من الخارج، وإن أخطر ما في المشهد، ليس تواطؤ جماعات مسلّحة أو تحالفات طارئة، بل محاولة إعطاء كل هذا طابعًا “اجتماعيًا” و”هوياتيًا”، كأنّ سوريا لا تسع الجميع، وكأنّ المشروع الوطني الجديد لا يعترف بالتنوع، وهذا كذب فجّ يتجاهل أن الدولة الجديدة ما بعد الأسد تضم كل المكونات، وتستمد شرعيتها من فكرة التعدد والعدالة والتمثيل، فلم تعد المسألة محصورة في الجنوب، بل باتت اختبارًا حقيقيًا لبوصلة الانتماء: هل السويداء جزء من سوريا فعلاً أم أنها على وشك أن تتحوّل إلى قاعدة أمامية لإسرائيل تحت عنوان “الخصوصية الروحية”؟ وهل نترك هذا الباب مفتوحًا، أم نغلقه بقوة، قبل أن تتحوّل السويداء إلى نموذج يُعمَّم في شمال سوريا وشرقه وغربه؟
العشائر والكرامة الوطنية
في وجه الفوضى التي أطلقتها جماعة الهجري ومَن وراءها، لم يكن الردّ بالعنف الطائفي، ولا بدعوات الانتقام، بل بحضور وطني جامع قادته العشائر السورية من مختلف المحافظات، هذه العشائر التي تنتمي لأعرق البيئات العربية في سوريا، لم تتحرك من منطلق طائفي، بل من واجب أخلاقي ووطني صريح: الدفاع عن أهلهم في الجنوب، ورفض تحويل السويداء إلى معبر للاحتلال أو مرتع للفوضى.
العشائر لم تأتِ لتنتقم، بل لتدافع عن عشائر البدو في السويداء الذين تعرضوا بعد خروج الدولة بضغط حكومي لأبشع المجازر، وهذه رسالة يجب أن تُقرأ بوضوح: أن الكرامة السورية اليوم لا تُعبّر عنها المليشيات، بل أبناء الأرض أنفسهم، من بدو وحضر، من سنّة ودروز، من كل مكوّن سوري يرى في سوريا وطنًا لا مزرعةً ولا مقاطعة، وفي قلب هذا المشهد، لا يمكن تجاهل الدور المشرف للدروز الوطنيين، وعلى رأسهم الشيخ سلطان البلعوس، الذي رفض منذ البداية منطق الانفصال، وتمسّك بدور السويداء كمكوّن أصيل في الدولة السورية الجديدة، لا كجيب خارجي مرتهن للمخابرات الإسرائيلية.
إن اللحظة اليوم تتطلب أكثر من الحسم العسكري؛ تتطلب خطابًا وطنيًا واضحًا، يفرّق بين مَن خان الوطن وبين من ما زال يقاتل من أجله، بين الدروز السوريين الشرفاء، وبين مَن جعل من الجبل جسراً لتل أبيب، فالانتماء الحقيقي يُقاس اليوم بالموقف لا بالكلام، ومن لا يرى في وحدة سوريا قضيةً لا تقبل النقاش، فهو خارج المشروع الوطني، مهما لبس من عباءات.
ما جرى في السويداء ليس حدثًا عابرًا، بل جرس إنذار لمستقبل وطن بأكمله، فحين تُستبدل بالهوية الوطنية الوصاية، وتُستدعى إسرائيل بدلاً من الدولة، نكون أمام لحظة فارقة: إما أن ننهض للدفاع عن ما تبقّى من سوريا، أو نتركها تُنهَش باسم “الخصوصيات” و”الضمانات الدولية”، فليس كل من في السويداء خائنًا، كما أن العشائر ليسوا غزاة، بين هؤلاء وأولئك، ما زالت الروح السورية تنبض، تنتصر حين تلتقي على المبدأ: أن لا كيان أكبر من الوطن، ولا سلاح أقدس من سلاح الدولة، ولا دم أوجب من دم الأبرياء.
من سلطان البلعوس إلى شيوخ العشائر، ومن أهالي الجنوب إلى عشائر الشمال والشرق، هناك خيط رفيع يشدّ الجميع: خيط اسمه الانتماء، ما لم يتمسك السوريون اليوم بهذا الخيط، فستتوزع البلاد على خرائط الاحتلال ومشاريع التقسيم، لن تُبنى سوريا من جديد بإقصاء مكوّن أو بترهيب آخر، بل بتوحيد الصف، وكشف الخونة، ومحاسبة كل من فتح الباب لإسرائيل، سواء برفع السلاح أو برفع الهاتف، فسوريا لا تُقسَم، ولا تُستبدَل، ولا تُؤجَّر.. سوريا لن تكون إلّا واحدة.