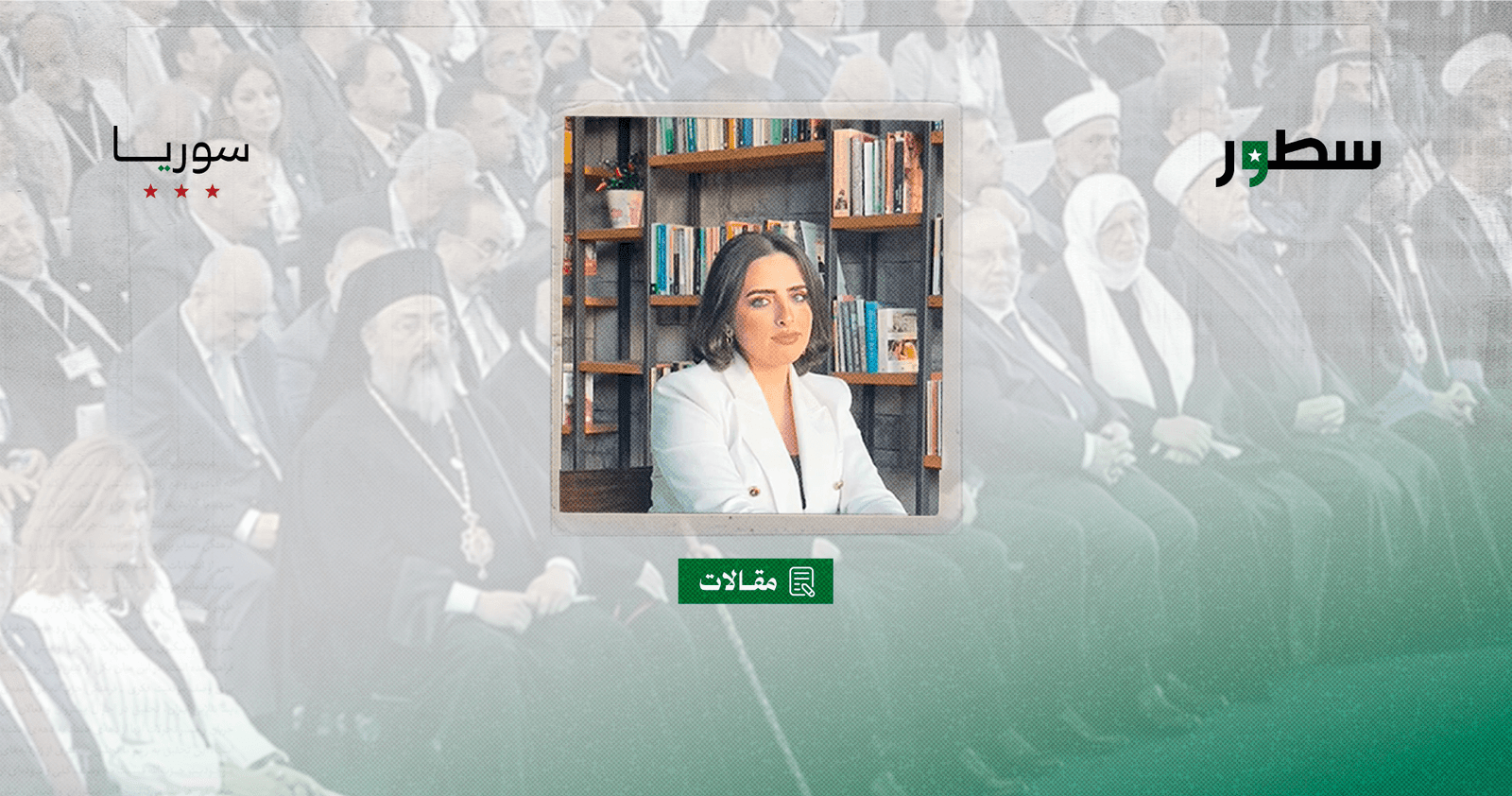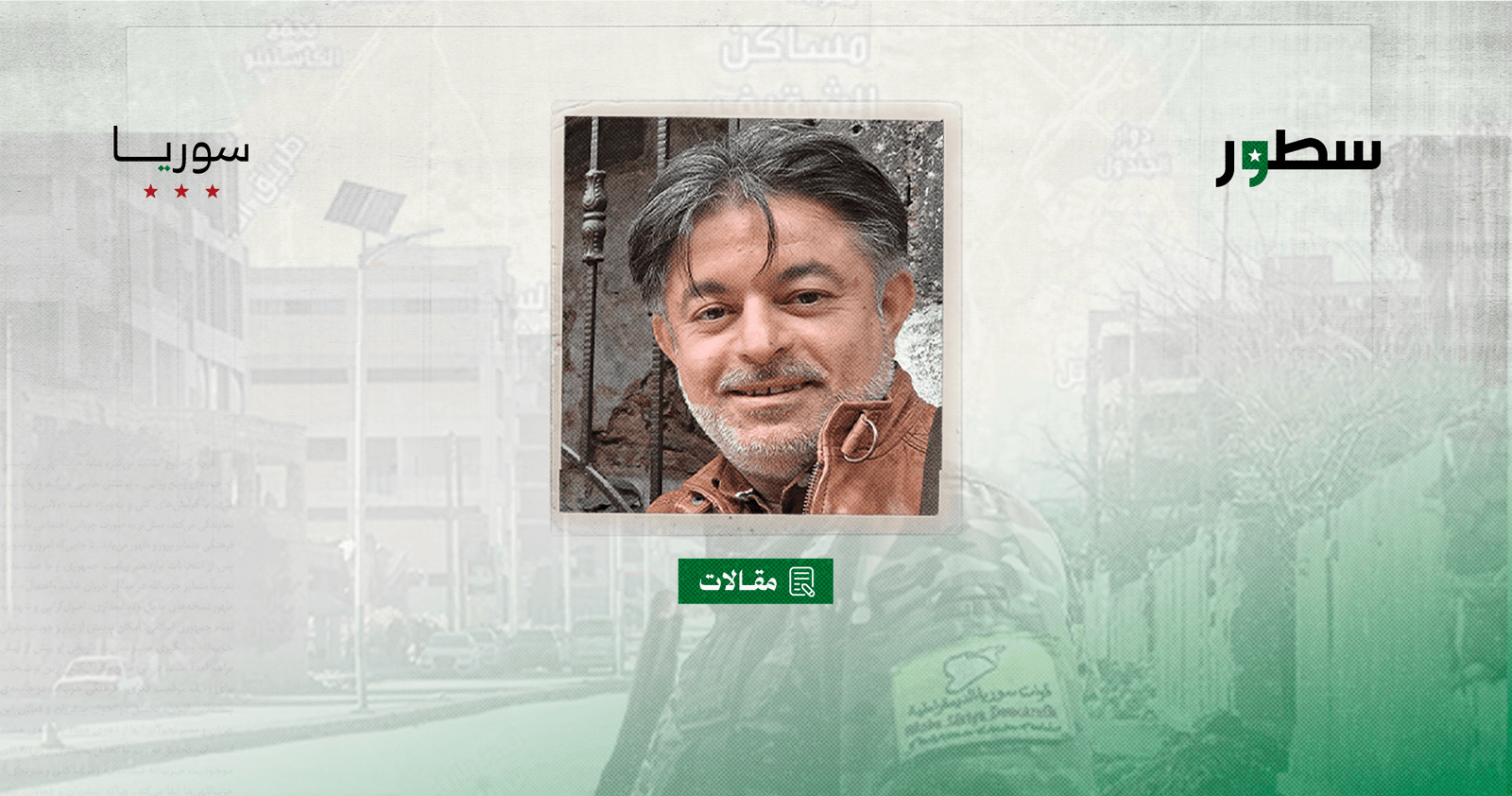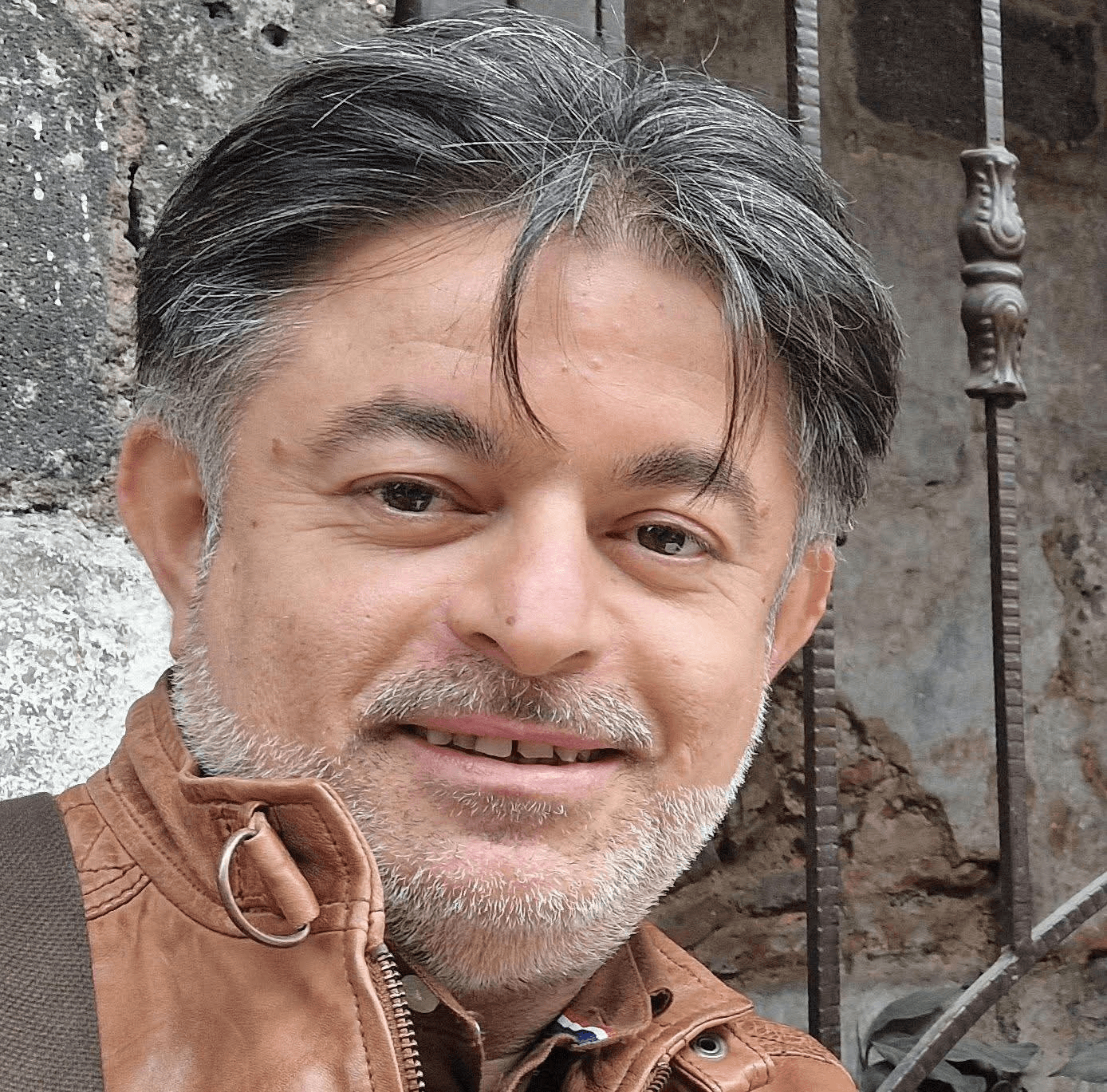مجتمع
من الإقطاع إلى الطائفية فالانقسام الطبقي: المجتمع السوري بين الشرخ التاريخي وتحديات العدالة
من الإقطاع إلى الطائفية فالانقسام الطبقي: المجتمع السوري بين الشرخ التاريخي وتحديات العدالة
– أحمد الياماني
من الإقطاع إلى الطائفية فالانقسام الطبقي: جذور الشرخ السوري الممتد
منذ أن نالت سوريا استقلالها عن الاحتلال الفرنسي عام 1946، دخلت البلاد في مرحلة حاسمة من إعادة تشكيل هويتها الوطنية وبناء مؤسسات الدولة الحديثة. غير أن هذه المحاولة اصطدمت بجدار من التفاوت الاجتماعي العميق، حيث استمر نفوذ الإقطاع في التحكم بمصير مئات الآلاف من الفلاحين، الذين كانوا مجرد عمال في أراضٍ لا يملكون منها سوى تعبهم وعرقهم.
لم يكن الصراع في سوريا مجرد تنازع سياسي بين نخب العاصمة وكتل المعارضة، بل كان في جوهره صراعاً طبقياً بنيوياً، تجذّر في التربة الاجتماعية لعقود طويلة. فقد عاشت غالبية القرى السورية تحت رحمة الإقطاع، الذي شكّل امتداداً للنظام العثماني، وتحوّل لاحقاً إلى قوة سياسية واقتصادية نافذة حالت دون أي توزيع عادل للثروة أو فرص التعليم والخدمات.
ومع دخول الجيش إلى الحياة السياسية عقب سلسلة من الانقلابات، وخاصة بعد صعود حزب البعث إلى السلطة عام 1963، بدأ مشهد آخر من الهيمنة يتشكل؛ هذه المرة بوجه قومي وشعارات اشتراكية، لكنها سرعان ما تحولت إلى أداة لضبط المجتمع وتفتيت هياكله الطبقية السابقة، ليس من أجل العدالة، بل من أجل السيطرة المطلقة. وسرعان ما استُبدل تحالف الإقطاعيين بتحالف جديد من كبار الضباط ورجال الأمن والمقربين من مراكز القرار، ليُعاد إنتاج الفوقية الطبقية بشكل مختلف وأكثر قسوة.
ومع اندلاع الثورة الشعبية عام 2011، التي رفعت شعارات “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية”، ظهرت التصدعات الاجتماعية على السطح بشكل عنيف. لم تكن الأزمة مجرد تمرّد سياسي، بل انفجار احتقان اجتماعي عميق الجذور، كشف مدى هشاشة الروابط بين أبناء المدينة والريف، بين الطبقات الاجتماعية، بين النخبة الحاكمة وعموم الشعب.
بين الإقطاع والفلاحين: عدالة مفقودة بين قوت الأرض وموازين السلطة
عبر التاريخ السوري الحديث، كان الريف -وما يزال- مرآة لواقع البلاد العميق، حيث تتلاقى مشكلات الفقر والتهميش والسيطرة المركزية. في خمسينيات القرن الماضي، كانت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية مملوكة لعائلات إقطاعية قليلة، تحتكر الأرض والغلال، وتفرض شروط العمل والعيش على الفلاحين. هؤلاء الفلاحون، الذين كانوا يحرثون الأرض ويزرعونها ويسقونها بدمهم وعرقهم، لم يمتلكوا منها شيئاً، سوى الوجع والتعب والانتظار.
برز في هذا السياق اسم أكرم الحوراني، ابن حماة، كأحد أبرز وجوه الحركة الاجتماعية المناهضة للإقطاع. كان خطابه راديكالياً، منحازاً بشكل كامل للفلاحين، وساهم في سنّ قوانين الإصلاح الزراعي التي أعادت توزيع الأراضي على من يزرعها لا من يملكها على الورق. لكن الواقع لم يكن بهذه البساطة. فرغم النية الثورية، طُبق الكثير من هذه القوانين بعشوائية، وجاء بنتائج عكسية.
أراضٍ مثل “أصفر ونجار” التي كانت تنتج آلاف الأطنان من الحبوب، ومؤسسات صناعية مثل الشركة الخماسية، التي كانت من أهم أركان الاقتصاد الوطني، جرى تأميمها أو تفكيكها، ما أدى إلى انهيار خطوط إنتاج وطنية، كان يمكن إصلاحها وتطويرها بدل تحطيمها. وهكذا، تحوّل الإصلاح الزراعي من فرصة لتحقيق العدالة إلى سلاح أدى أحياناً إلى ضرب الاقتصاد الوطني وتفريغ الريف من قدرته الإنتاجية المستدامة.
من صراع طبقي إلى شرخ طائفي: حين يستبدل العدل بالولاء
في المراحل التالية، لم تعالج السلطة تلك الفجوة بين المدينة والريف، بل أعادت إنتاجها ضمن بنية أمنية وطائفية. فبعد صعود البعث ثم نظام الأسد الأب، تحولت الدولة من مشروع قومي جماعي إلى جهاز سلطوي يتحكم بكل مفاصل المجتمع، ويمنح الامتيازات بناءً على الولاء لا الكفاءة.
استُخدم الريف مخزوناً بشرياً للجيش وأجهزة الأمن، بينما حُصر القرار السياسي والاقتصادي في نخبة ضيقة من أبناء المدن الكبرى الموالين للنظام. ولكن المأساة الحقيقية تمثلت في أن السلطة، التي رفعت شعارات “العدالة الاشتراكية”، قتلت الريف حرفياً؛ من خلال الإهمال والتجويع حيناً، أو بالقصف والتهجير حين قرر بعض أبنائه التمرد على الظلم.
في هذا السياق، لم يعد الصراع في سوريا صراعاً طبقياً فقط، بل تحوّل إلى شرخ طائفي خطير، استثمر فيه النظام بمهارة عبر زرع الشكوك بين الطوائف والمذاهب، ما أدى إلى تفكك النسيج الوطني، وتحوّل المجتمع إلى جزر معزولة تتصارع على الفُتات بدل أن تبني مشروعاً وطنياً جامعاً.
الثورة، والقضاء على الطبقة الوسطى
الثورة السورية لم تكن لحظة تمرّد عابرة، بل كانت لحظة انكشاف تاريخي. انكشاف لنظام لا يحتمل النقد، ولمجتمع لم يعُد قادراً على الصبر، ولطبقة وسطى كانت عماد الاستقرار، فانهارت أمام نيران الحرب وتضخم الفساد.
هذه الطبقة، التي كانت تضم المعلمين، والأطباء، والموظفين، وأصحاب المحلات الصغيرة، وجدت نفسها فجأة بلا عمل، بلا دخل، بلا أمان. وبينما كان أبناء هذه الطبقة يُقتلون على الجبهات أو يُهجرون من بيوتهم، كانت طبقة جديدة تُولد في الظلام: طبقة من أثرياء الحرب، تجار المازوت والخبز والسلاح، الذين صنعوا ثرواتهم من معاناة الناس.
إلى جانب ذلك، جاءت العقوبات الاقتصادية -رغم شرعيتها الأخلاقية في استهداف النظام- لتُضيف طبقة جديدة من الألم، خاصة على من لم يعد يملك شيئاً أصلاً. انهار سعر الليرة، تضاعفت الأسعار، وسُحق المواطن بين نار الداخل وحصار الخارج. وهكذا، محيت الطبقة الوسطى، لا بسبب الحرب فقط، بل بسبب اللاعدالة في نتائج الحرب.
نظرة فوقية أم وعي طبقي؟ كيف شوه النظام العلاقة بين المدينة والريف؟
إحدى أخطر الظواهر الاجتماعية التي تكرّست خلال العقود الماضية، هي نتيجة مباشرة لسياسات النظام نفسه، الذي عمّق الفجوة بين المدينة والريف من خلال تهميش المناطق الريفية وحرمانها من البنية التحتية الأساسية كالمشافي والمواصلات والخدمات، مقابل تركيز كل شيء في مراكز المدن. كما ساهم النظام عبر الإعلام والتعليم الرسمي في بناء صورة ذهنية داخل بعض أبناء المدن بأنهم يمتلكون المعرفة والامتيازات، بينما يُنظر إلى أبناء الريف باعتبارهم أقل تحضراً أو أقل قدرة. ومن هنا، نشأ تفاوت شعوري واجتماعي حاد، ينعكس بوضوح حين يُرشّح أحد أبناء الريف أو المدينة لمنصب سياسي، فتتفجر التوترات والشكوك المتبادلة، نتيجة تراكمات لم تُعالج.
وهنا تكمن خطورة أن يتحول الانقسام الطبقي إلى حالة عنف ثقافي دائم، يحول دون بناء وطن جامع.
ومسؤولية السلطة اليوم معالجة هذه الظواهر بعمق، بحيث لا يكون هناك شرخ طائفي، ولا طبقي، ولا اجتماعي، لأن ابن المدينة هو نفسه ابن الريف، وكلٌّ منهما يُكمل الآخر. وقد نجحت دول مثل رواندا بعد الإبادة الجماعية، أو ألمانيا بعد الحرب، في رأب الانقسام الأهلي، عبر برامج مصالحة وطنية وتعليم مدني ونهوض اقتصادي. سوريا ليست استثناء، لكن نجاحها يحتاج إلى شجاعة سياسية وإرادة حقيقية.
سبل المعالجة: خارطة طريق لوطن جامع
- بناء عدالة اجتماعية مرنة: لم تعد الشعارات تكفي. نحتاج إلى منظومة اقتصادية تؤمن بحق كل مواطن في العمل والمأوى والتعليم، دون قمع روح المبادرة أو احتكار السوق.
- إحياء الطبقة الوسطى: وهي ركيزة أي مجتمع متماسك. يجب دعم المشاريع الصغيرة، وتحفيز التعليم، وتخفيف الضرائب عن أصحاب الدخل المحدود.
- إصلاح قوانين الأراضي: فلا الفلاح يجب أن يكون تابعاً، ولا صاحب الأرض يجب أن يكون سلطاناً. الملكية يجب أن تُربط بالإنتاج، لا بالميراث السياسي.
- تمثيل سياسي متوازن: يضمن أن يكون ابن الريف في قلب القرار، لا على هامشه، بعيداً عن منطق المحاصصة الطائفية.
- ثورة ثقافية عبر الإعلام والتعليم: تعيد الاعتبار لقيمة العمل والكرامة، وتكسر الصورة النمطية التي رسخها النظام.
- نموذج تعليمي جديد: يزرع في الأجيال القادمة قيم المواطنة، ويُعلي من شأن العمل، ويكرّس الاحترام المتبادل بين الطوائف والمناطق والطبقات.
الخاتمة: سوريا القادمة ليست مستحيلة
إن المجتمع السوري اليوم يقف على مفترق طرق حاسم، لا يحتمل المزيد من التأجيل أو الهروب إلى الأمام. إما أن يُعيد إنتاج شرخٍ جديد يُضاف إلى تراكمات الأمس، شرخٍ يغذّيه الغبن التاريخي والتفاوت الاجتماعي والتفكك الطائفي، أو أن يتجه بشجاعة نحو إعادة صياغة ذاته، على أسس جديدة من المواطنة والعدالة، حيث لا فضل لعاصمة على ريف، ولا لطائفة على أخرى، ولا لطبقة على غيرها، إلا بما تقدمه للوطن من خدمة وشرف.
هذا الخيار، وإن بدا صعباً، إلا أنه ليس مستحيلاً. لقد مرت مجتمعات كثيرة عبر العالم بتجارب أكثر قسوة: رواندا خرجت من مذابح عرقية، وجنوب أفريقيا من نظام فصل عنصري، وألمانيا من دمار شامل بعد حرب عالمية. لكنها، عبر الاعتراف، والمحاسبة، والمصالحة، استطاعت أن تبني مستقبلاً لا يشبه ماضيها، وأن تجعل من جراحها جسوراً، لا حدوداً.
فما دامت هناك ذاكرة حية تحفظ الحقيقة، وأقلام تكتب بلا خوف، وأصوات تنادي بالكرامة لا بالانتقام، فإن الأمل لا يُمحى. الطريق إلى سوريا جديدة لا يبدأ من شعار سياسي أو وعود انتخابية، بل من الوعي الجمعي بأن الوطن لا يُبنى بالولاء، بل بالانتماء، ولا يُحمى بالقمع، بل بالعدالة.
علينا أن نُعيد للإنسان السوري ثقته بذاته، بوطنه، وبمستقبله. أن يشعر ابن الريف أنه ليس مواطناً من الدرجة الثانية، وأن يدرك ابن المدينة أن نجاته لا تكتمل دون العدالة لغيره. أن نؤمن بأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وأن الاختلاف ليس تهديداً بل ثراء.
سوريا القادمة ليست خيالاً، بل مشروعاً يمكن أن نبدأ به اليوم، هنا، بالكلمة، بالاعتراف، بالحوار، بالحب، وبالجرأة على أن نكون صادقين مع أنفسنا أولاً، ومع تاريخنا، ثم مع بعضنا البعض، وإن لم نفعل، فإن التاريخ سيكتب أن جيلاً كاملاً رأى الشرخ، وصمت. أما إن فعلنا، فسيكتب أن جيلاً منكوباً، مجروحاً، مهدداً، نهض من بين الرماد، وصاغ من وجعه وطناً أجمل.