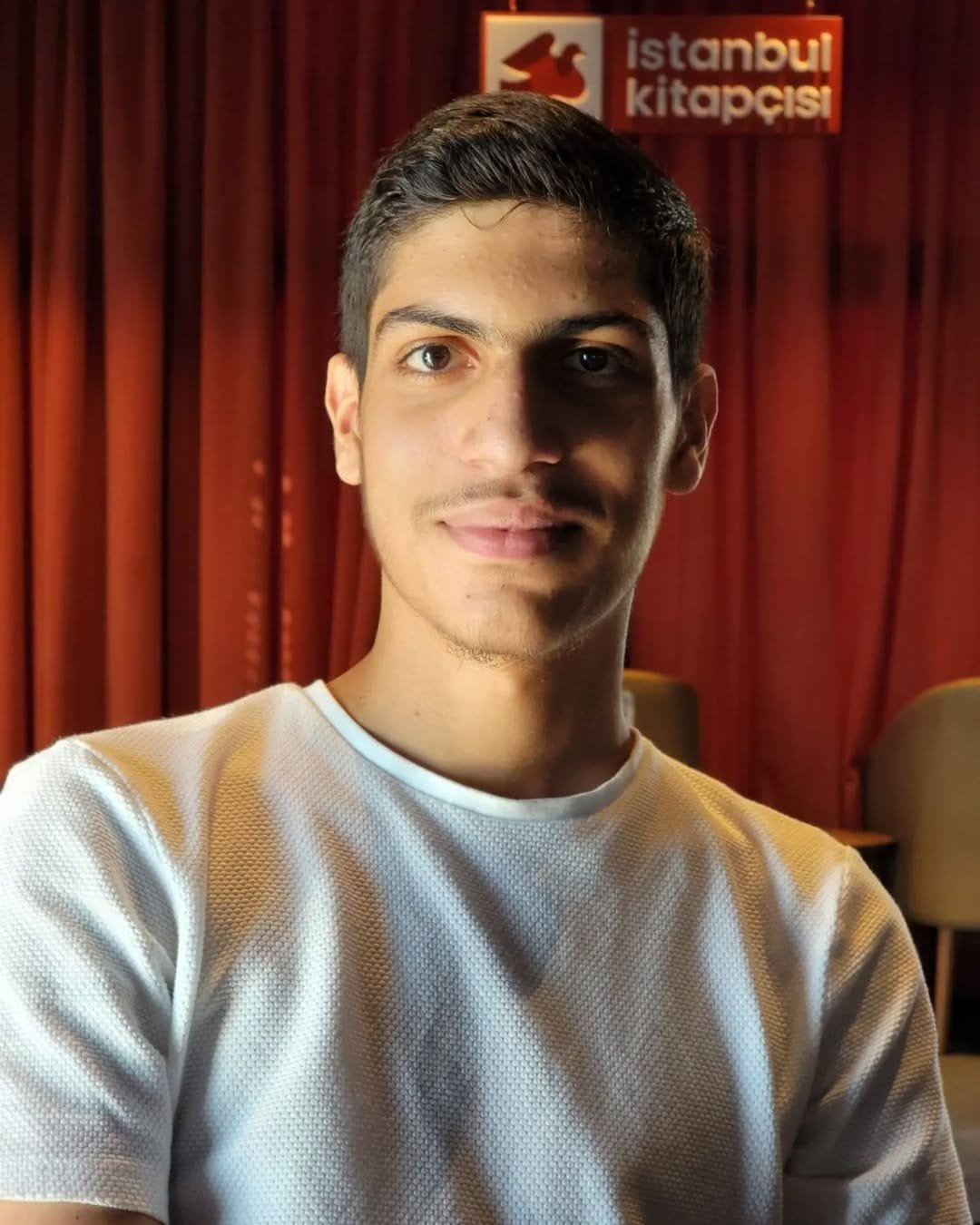مجتمع
من يحمل الماء؟ عن الناشط السوري بين الفعل والضجيج
من يحمل الماء؟ عن الناشط السوري بين الفعل والضجيج
قبل أيام من كتابة هذا المقال، ظهر فيديو لناشط سوري يقف أمام عدسات الكاميرا، يبتسم بثقة، ويشرح “كيف ساعد في إخماد حرائق الساحل”، بينما في الخلفية كان المشهد فارغاً من أيّ نار أو حركة. على الطرف الآخر من البلدة، كان متطوعون مجهولون يتسلّقون التلال ويكافحون بوسائل بدائية لإيقاف اللهب.
في المشهد السوري المتكرّر، لا تكشف الكارثة فقط عن حجم الخراب، بل تكشف أيضاً عن موقع الكاميرا: من يحملها، ولأي غرض تُستخدم.
لم يعد مفهوم “الناشط” في سوريا مرادفاً بالضرورة للفعل، ولا شاهداً على الجرح. في أحيان كثيرة، صار أقرب إلى هوية إعلامية، أو فرصة رمزية للظهور في زمن أصبح التفاعل فيه هو المعيار الوحيد للوجود. ومع أن هذا التحوّل لا يمحو كل الأشكال الأصيلة من النشاط، إلا أنه يفرض مساءلة ضرورية حول الفرق بين من يعمل بصمت، ومن يعمل أمام الجمهور.
هذا المقال لا يهاجم “الناشطين”، بل يسائل بنية الخطاب ومكان الصورة. يسأل عن الفعل، عن الحضور، وعن الفرق الجوهري بين من يحمل الماء، ومن يصنع الضجيج حوله.
الناشط: صورة الثورة التي بهتت
حين اندلعت الثورة السورية عام 2011، لم يكن مصطلح “ناشط” يحمل بريقاً. كان أقرب إلى تهمة منه إلى صفة، فالناشط آنذاك هو من ينقل الأخبار من الميدان، يوثّق ما يجري، يصرخ في المظاهرات، يُطارَد أمنياً، ويُعتقل أو يُقتل أو يُنفى. كان “الناشط” في المعنى الأصلي للكلمة: ناشطاً بالفعل.
كان من السهل أن تتعرّف عليه من دون أن تراه. يكفي أن تتابع صفحات التنسيقيات، أو أن تسمع باسم جديد يُعتقل كل يوم، أو تُشاهد مقاطع مصوّرة له في قلب الأحداث، لا على حافتها. الناشط في ذلك الزمن لم يكن نجماً، بل كان غالباً شهيداً محتملاً. ولم يكن مفهوم “المحتوى” قد دخل بعد إلى الحقل الثوري، فالحدث كان محتوى بذاته.
لكن مع تحوّل الثورة إلى أزمة مفتوحة، وبدء المنظمات غير الحكومية عملها في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، دخل مفهوم “الناشط المدني” إلى المشهد. بدأت المراكز تُفتح، المشاريع تُموّل، و”ورشات التمكين” تُقام. ومعها، بدأت صورة الناشط تتغيّر. صار مطلوباً منه أن يكون حاضراً، متحدثاً، جيد الخطاب، ومقنعاً للممول. شيئاً فشيئاً، لم يعد العمل الميداني شرطاً، بل أصبح الأداء والتمثيل ضروريَّين.
تقول الباحثة “سيريل هيلرز” في ورقتها حول “المنظمات والسلطة في سوريا” إن كثيراً من مفاهيم العمل المدني أُسقطت على السياق السوري دون مراعاة طبيعة الصراع، مما خلق فجوة بين الاحتياج الفعلي والشكل التمويلي للعمل. هذه الفجوة أنتجت نمطاً جديداً من “النشطاء”: أكثر تدريباً على العرض، وأقل تفاعلاً مع الأرض.
وهكذا، تسرّب “الاحتراف” من بوابة الخطاب لا الفعل. صار الناشط يجيد الحكي، يعرف كيف يُصاغ البيان، وكيف تُحرّر قصته الشخصية لتُروى في مؤتمر دولي. ولم يكن هذا بذاته خطأ. لكنه، حين ابتعد عن الجذر، صار نسخة مشوّهة من الأصل: صورة بلا حرارة، كلام بلا مخاطرة، و”نشاط” بلا أثر.
كيف تغيّرت صورة الناشط السوري من “فتى الميدان” إلى “صاحب الستوري”؟
خلال العقد الماضي، لم تكن كلمة “ناشط” في السياق السوري تشير إلى صفة مهنية أو تصنيف شكلي، بل كانت عنواناً لموقعٍ أخلاقي سياسي اجتماعي. الناشط كان هو من يخرج من بيته ليحمل لافتة، أو يصوّر مظاهرة، أو يوصل مساعدات لأهل الحيّ المحاصر، كان الكلمة التي تخرج إلى العلن حين يهمس الجميع، وكان العين التي توثق حين تُطفأ الكاميرات.
لكنّ هذه الصورة، التي تشكّلت من رحم الثورة والميدان، لم تبقَ على حالها. فمع تطوّر المشهد، وانزياح الصراع من الشارع إلى الشبكة، بدأ يتغيّر شكل الناشط وأدواته، وأحياناً مبرّر وجوده نفسه. صار “الظهور” أهم من “الحضور”، وصار “نقل الحدث” يتحوّل إلى “صناعة محتوى”. وبهذا، لم يعد الناشط دائماً هو من يُخاطر، بل من يُوثّق، وربما من يُعيد إنتاج الخطر كصورة لا كممارسة.
التحوّل لم يكن فجائياً، بل مرّ بمراحل متدرجة. في البداية، أدت وسائل التواصل دوراً إنقاذياً، نقلت مجازر واعتقالات لم يكن يمكن معرفتها لولا الفيديوهات التي نشرها ناشطون ميدانيون. لكن هذه الوسائط نفسها، مع الوقت، أعادت تشكيل “الناشط” بوصفه مرئيّاً أكثر من كونه فاعلاً. فقد صار يُنتظر منه ألا يفعل فقط، بل أن يوثّق فعله، ويصمّمه، ويعدّل عليه ليصبح قابلاً للمشاركة.
ولأن التمويل، والتمثيل، وحتى فرص النجاة صارت مرتبطة بمدى “فاعلية الخطاب الإعلامي”، تسلّل تدريجياً منطق “البزنس” إلى العمل العام، وبدأت تنشأ قوالب نمطية للناشط “المثالي”: منسّق، لبق، كثير الظهور، قليل الجدل، يحرص على “المحتوى الآمن” الذي لا يزعج الجهات المانحة ولا يغضب المتابعين.
بذلك، انزلقت صورة الناشط من حامل للوجع إلى ناقلٍ له، ومن ناقلٍ إلى معلّق عليه، ومن معلّق إلى صانع صورة عن نفسه وهو “يتعاطف”. هذه الانزياحات لا تُدين كل من نشط بعد 2015 أو من لجأ إلى وسائل التواصل، لكنها تُحيلنا إلى سؤال مهم: هل ما زال الناشط يعبّر عن الناس؟ أم عن صورته لدى الناس؟
الكارثة فرصة للتصوير
في مشهد الحرائق الأخيرة التي اجتاحت مناطق واسعة من غابات سوريا، ظهر نوعان من الناشطين: أولئك الذين حملوا الماء واندفعوا لإطفاء النار، وأولئك الذين حملوا هواتفهم واندفعوا لتوثيق أنفسهم وهم “ينظرون إلى النار”. كلاهما حضر، لكن أحدهما كان حضوره فعلاً، والآخر كان حضوراً في الـ”ستوري”.
في وسائل التواصل، ضجّت الصفحات بصور شباب يبتسمون أمام ألسنة اللهب، يرفعون شعارات عن التضامن مع الطبيعة، أو يُطلقون بثاً مباشراً بعنوان “في قلب الحدث”، ثم يغادرون الموقع دون أن يمدّوا خرطوماً أو يحملوا دلواً. هذا لا يعني أن التوثيق جريمة، بل إن تصوير الكارثة قد يكون ضرورة. لكن حين يُختزل الوجود في “إثبات الحضور الرقمي”، دون أي أثر حقيقي على الأرض، تصبح الكارثة مادّة للاستعراض، لا مساحة للتكافل.
هذه الظاهرة ليست حكراً على الحريق الأخير، بل تتكرر مع كل مأساة: في الزلازل، في حملات التبرع، في قوافل الشتاء. هناك من يحضر ليخدم، وهناك من يحضر ليُرى. من يقدّم المساعدة بهدوء، ومن يصوّر توزيع البطانيات كما لو أنه إعلان. هذا النوع من الناشطين ليس ضارّاً فقط لأنه لا يُساهم فعلياً، بل لأنه يُربك المشهد الأخلاقي العام. إذ يُشوّش على الفعل الحقيقي، ويغمره بضجيج الحضور الزائف.
في هذا السياق، تظهر مفارقة قاتلة: باتت بعض الكوارث عند البعض فرصة لتعزيز “البراند الشخصي”، وليس لحمل العبء، صار التفاعل مع الألم مشروطاً بمدى قابليته للمشاركة، وصار بعض الناشطين يشبهون نجوم التواصل أكثر من أبناء البيئة التي تحترق أو تغرق أو تتجمد. يُعدّون مشاركاتهم بعناية، يختارون زوايا التصوير، يكتبون جملاً مشوّقة، ثم ينصرفون.
المشكلة الأكبر ليست فقط في هؤلاء، بل في المناخ الذي سمح بتحوّل العمل العام إلى مسابقة ظهور. في عالمٍ تُقاس فيه القيمة بعدد المتابعين، تصبح النار خلفية، ويصبح “الإطفاء الحقيقي” هو تسويق الذات.
تشويه الوعي: حين يفقد الناشط معناه
حين يصبح الناشط مرئيّاً أكثر مما هو فاعل، فإن المجتمع لا يخسر فقط أداءً على الأرض، بل يخسر نموذجاً كان يوماً ما بوصلته الأخلاقية. فالناشط في أصل الكلمة هو من يُبادر، يفتح الطريق، يدفع الثمن الأول، ويكون صوته سابقاً لصوت القطيع. لكنه مع الزمن، ومع تحوّل الخطاب إلى استعراض صار أحياناً ظلّاً باهتاً لما كان، أو صورة مُلمّعة لشيء لم يكن أصلاً.
هذا التحوّل لم يكن نتيجة سوء نية بالضرورة. في عالم يتهاوى فيه العمل الجماعي، ويتراجع فيه الفعل السياسي لصالح الأداء الفردي، يبدو “الناشط الجديد” ابناً شرعياً لهذا العصر: سريع، لامع، قابل للاستهلاك. لكنه بذلك يفقد شيئاً جوهرياً: المعنى.
المعنى لا يُصنع بالتصفيق، ولا بعدد المتابعين، ولا بتفاعل الجمهور. المعنى يُصنع حين يكون فعل الناشط متناسقاً مع قِيَمه، ومع ذاكرة مجتمعه، ومع موقعه الأخلاقي في لحظة الخطر. وبهذا، فإن أخطر ما تخلّفه ظاهرة “الناشط الموسمي” ليس التشتت أو الفراغ، بل إضعاف الحسّ العام، وتفريغ كلمة “ناشط” من محتواها الحقيقي.
في دراسة نُشرت بمجلة Global Media Journal عام 2022، بعنوان Activism, Optics, and the Crisis of Credibility in the Digital Age، تشير الباحثة ناديا صايغ إلى أن “كثرة الظهور الإعلامي للناشطين دون إنجاز ملموس يؤدّي إلى تآكل ثقة الجمهور بالعمل المدني ككل، ويخلق مناخاً من الريبة والسخرية”. وهي ريبة مبررة أحياناً، لأن المشهد بات مشوّشاً: من يذهب ليساعد ومن يذهب ليُصوَّر يقفان أحياناً في الإطار ذاته، دون تمييز.
هذه الضبابية لا تؤذي الناشط الحقيقي فقط، بل تدفع الناس إلى الانكفاء، إلى السخرية من العمل العام، إلى الإحساس بأن كل من يتكلم لا يفعل، وكل من يظهر لا يساهم، في حين أن الحقيقة أعقد بكثير.
من يحمل الماء؟
في لحظة الحريق، لا يعود السؤال عن عدد الصور المنشورة، ولا عن عدد المتابعين على “إنستغرام”، بل عن الشيء الأبسط والأكثر وضوحاً: من حمل الماء؟ من هرع ليطفئ النار لا ليظهر قربها؟ من انشغل بالفعل أكثر مما انشغل بروايته؟
ليس الغرض من هذا المقال تسفيه الناشطين، ولا تحويل الفعل العام إلى اختبار قاسٍ لا ينجو منه أحد. بل الغرض أن نُعيد المعنى إلى مكانه، أن نفرّق بين الضجيج والفعل، بين من يشعل الكاميرا ومن يُطفئ النار. فالناشط، في لحظات الكارثة، لا يُعرّف بخطابه، بل بخطواته. لا بما ينشر، بل بما ينجز.
في المشهد السوري، ومع عمق الجراح، نحن في أمسّ الحاجة إلى استعادة صورة “الناشط الحقيقي” ذاك الذي ينتمي لمجتمعه لا لكاميرته، ويعرف أن التضامن يبدأ بالركض إلى موقع الحريق، لا إلى زاوية التصوير.
وإن كان لا بدّ من “صورة” تُنشر، فلتكن صورة اليد التي امتدّت لتساعد، لا اليد التي رفعت الهاتف.