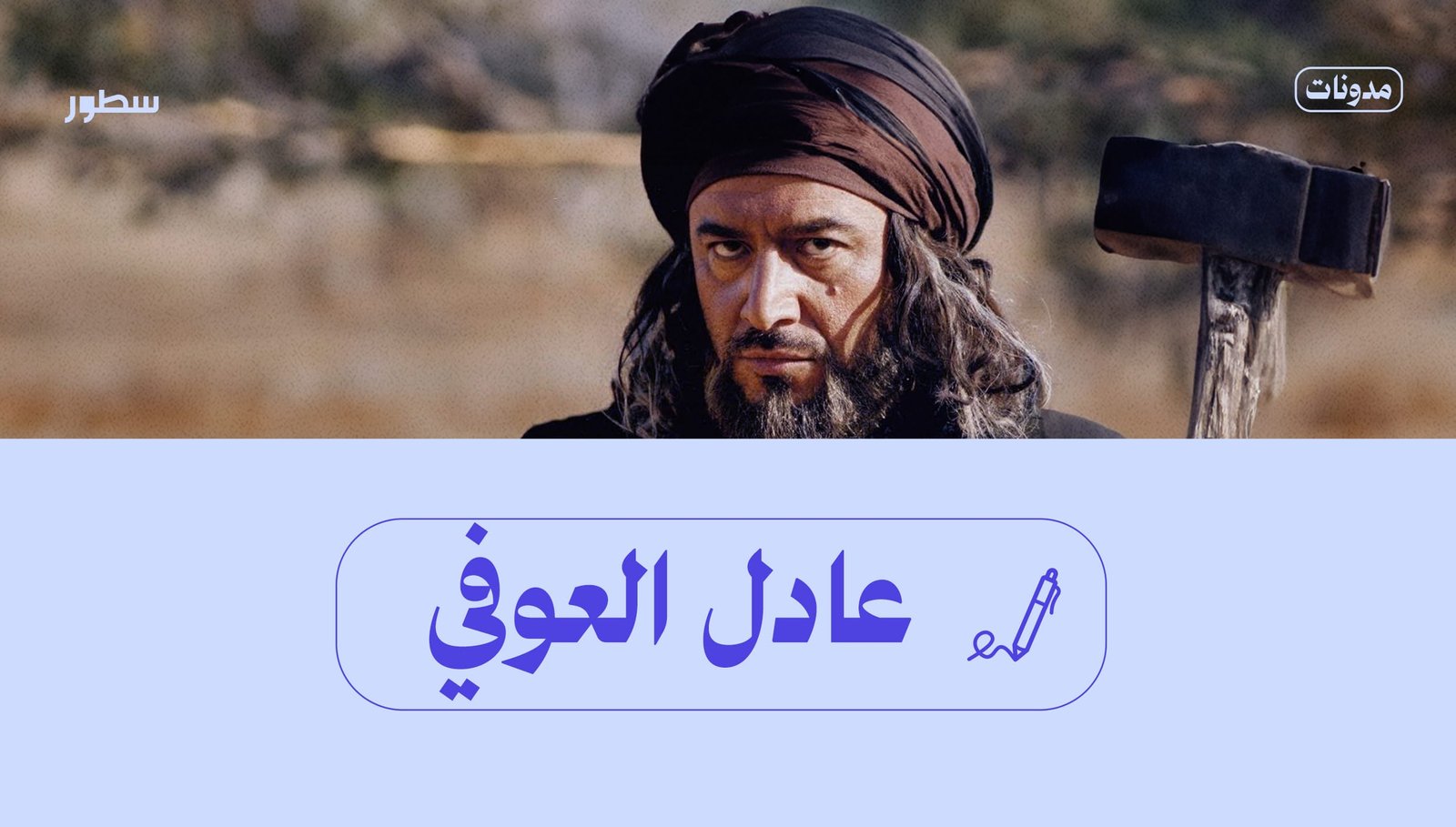مدونات
الكاتب وأزمة الأماكن: في حاجة للإقامات الأدبية!
الكاتب وأزمة الأماكن: في حاجة للإقامات الأدبية!
للكاتبة: فاطمة الزهراء حبـيدة
الحديث عن الكتابة، لا يمكن أن يكتمل دون التطرق للظروف المحيطة بها، والأماكن المناسبة التي تمد الكاتب بشرارة الإلهام، إذ تختلف الظروف بين من يحب الهدوء في الأماكن الفارغة بألوان هادئة وبين من يفضل الأماكن المكتظة وبألوان مبهجة، وهذا التباين في طقوس الكتابة يجعل لكل كاتب مكانًا مميزًا يستلهم منه ليبدع في إنتاج النصوص الأدبية.
وعندما نتحدث عن المكان لا يجب أن نتغاضى عمّا يُعرَف بـ”طاقة المكان” أو “الفانغ شوي feng shui” الذي يعبر عن العلاقة بين ما يحتويه المكان وتأثيره على مشاعر وإنتاجية المرء، ويتأسس “feng shui” على أنّ كل الأشياء المحيطة بنا تحمل طاقة تأثير سواء بالإيجاب أو السلب، فاختيار مكان الكتابة ليس بالأمر الهيّن، فقد يُهدِر الكاتب الكثير من الوقت والفرص، في سبيل البحث عن مكان يُحفّز احتياجاته الفكرية، لأن الكتابة ليست عملية ميكانيكية، بل نتاج لتفاعلات مشاعرية كذلك، ومن هنا يبرز الاهتمام بالإقامات الأدبية ودورها في توفير جو ملائم للمهتمين بالكتابة؛ لخلق بيئة مشحونة بالالتزام، تحفّز على الإبداع، وتُجنب الاحتباس الأدبي الإبداعي، وتعزله في فضاء خاص، بعيدًا عن انشغالات الحياة الاعتيادية التي تكون مليئة بالتكرار والرتابة.
تعمل الإقامات الأدبية على تشجيع الكاتب على الاستمرارية، فالكثير من الأفكار الإبداعية تبقى حبيسة الذهن بسبب التأجيل، أو بحجة غياب الدعم، أو نظرًا لظروف العمل التي قد لا ترتبط بالكتابة الأدبية، مما يزيد من صعوبة إخراج عمل إبداعي في ظرف زمني محدد، ونظرًا لأهمية المكان، فكيف يدبر الكتاب حاجتهم للإقامات الأدبية في ظل ندرة هذا النوع من الإقامات، وكيف يمكنهم التوفيق بين حاجتهم لها والالتزامات الحياتية؟ وهل ساهم هذا النقص في ابتكار بدائل عن الإقامات الأدبية؟
أولا: الكاتب والإقامات الأدبية بين التحديات الحياتية والتمويلية
اهتمت دول كثيرة بالإقامات الأدبية، منها فرنسا، أمريكا…، وعلى المستوى العربي انطلقت بعض التجارب في كل من مصر والمغرب. أمّا بخصوص المملكة السعودية فقد أنشأت ما يسمى بـ”معتزلة الكتابة”، وهو برنامج أطلقته وزارة الثقافة السعودية من تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة، بهدف خلق فضاء يُلهم الكتاب.
تُحيط بهذه الإقامات تحديات كثيرة، فعلى مستوى الكاتب المستفيد، قد لا تُمكن ظروف العمل والالتزامات المهنية من ترك الوظيفة لمدة معينة بغاية التفرغ للإبداع الأدبي، وحتى إنّ طبيعة بعض الوظائف ترتبط بمهام متكررة وروتينية، ممّا قد ينتقل صداه للأعمال الأدبية وينعكس سلبًا عليها، إذ لم يُحسن الكاتب الفصل بين مجال عمله وشغفه بالكتابة، وهذه المسألة آثارها نجيب محفوظ متحدثًا عن الوقت التي تأخذه وظيفته من حيز الكتابة قائلا: “فمن المستحيل أن يتفرغ الأديب في مصر، ولو كنا مثل أوروبا، وصدر لي كتاب متميز لتغيرت حياتي، وكنت استقلت من الوظيفة وتفرغت للأدب“، لكن يبدو أنّ هذه المعادلة صعبة التحقق، وذلك راجع لعدة أسباب أهمها تموقع فعل الكتابة داخل المجتمع والأوساط المهنية، فلا زال يُنظَر للكتابة على أنّها مسألة ترفيهية، وأنها مجرد عمل إضافي متجاهلين أن الكتابة في الوقت الحالي هي بمثابة “قوة ناعمة” تؤثر على المجتمع بمختلف أجياله، وعلى أكثر المجالات حساسية كالسياسة مثلًا.
تتميما للإشكالات التي يعاني منها الكُتاب، لا يجب أن نتغاضى عن مقاربة النوع، أي عندما يتعلق الأمر بكاتبة (امرأة)، بالنظر للتحديات الحياتية الملقاة عليها، كالالتزامات تجاه البيت، الأبناء، والزوج، فيصعب كثيرًا التوفيق بينهما وإيجاد الوقت الكافي للتفرغ للكتابة، خصوصًا إذا كانت البيئة العائلية، والمجتمع المحيط بها لا يقدّر ذلك، علمًا أنّ للمرأة دور محوري في التنبيه للقضايا المتصلة بحقوق المرأة، والإشكالات التي تعانيها داخل المجتمع.
إلى جانب التحديات الحياتية المتصلة بالكاتب(ة)، تبرز تحديات أخرى مرتبطة بطبيعة التمويل الذي تتلقاه الإقامات الأدبية أي الجهة الممولة، إذ تلعب دورًا مهمًا في تحديد عدد الكُتاب المُفترَض استقطابهم، ومدة الإقامة، ومدى تنوع المجالات والثقافات، وأهمية الشركاء في توسيع انتشار هذا النوع من الإقامات، ويندرج ضمنها: دور النشر، الجمعيات المهتمة بالقراءة والكتابة، ومبادرات فردية ومؤسسية، ومنظمات دولية، فكل هذه الجهات تساهم في إشاعة ثقافة الإقامات الأدبية، ولو بشكل مؤقت. إذ دائما ما يقف التمويل عائقًا أمام استمرار الإقامات الأدبية نظرًا للتكاليف التي تتطلبها. كما تنكب وزارات الثقافة في بعض الدول-خصوصا العربية- على تمويل عدة فعاليات فنية، على حساب فعاليات الكتابة والتأليف، مما يطرح قلة التوازن في التمويل، ومع وجود هذه العراقيل كان لا بد للكُتاب أن يبحثوا عن وجهة بديلة للبحث عن جنّتهم الإبداعية المفقودة.
ثانيا: البدائل المؤقتة للإقامات الأدبية: المقاهي الأدبية: ازدواجية الكتابة ومتعة النقاش
إن الدول التي تشهد قلة الإقامات الأدبية، غالبا ما يتطوع الأفراد للبحث عن بدائل، ولو أنها لا ترقى للامتيازات المتوفرة بالإقامات الأدبية، لكنها الحل الأنسب والأكثر قابلية للتطبيق ومنها: المقاهي الأدبية.
ارتكزت المقاهي الأدبية في بدايتها، لتكون بمثابة محتضن للنقاشات السياسية، إذ “ارتبط المقهى قديما باجتماعات الأحزاب الساخطة على الحكومات، وفضاء للحوار السياسي، وهو ما أدى بتشارلز الثاني في ديسمبر 1675 لقمع المقاهي، أما روجر نورث الموالي للحاكم آنذاك، اعتبر أن “الفتنة والخيانة، والإلحاد والبدعة تُدرَّس علنًا في المقاهي” لكن مع ذلك فشل تشارلز في قمع المقاهي، واستمرت كفضاء للنقاش السياسي؛ لتطور وظيفتها فيما بعد إلى المستوى الادبي (1).
تعزز دور المقاهي الأدبية مع بداية عصر التنوير خصوصًا مع الثورة الفرنسية، وتعود أصل نشأتها في فرنسا، وكان أشهرها آنذاك “مقهى لو بروكوب، ومقهى فلور، ومقهى دو ماجوت”، وعرفت كذلك إيطاليا بمقهى caffé florian venezia الذي يُعَدُّ من أقدم المقاهي الأدبية في العالم(2).
ومن هنا يظهر البعد التاريخي للمقاهي الأدبية، إذ تعد البيت الحاضن للكُتاب، نستحضر في هذه الحالة الأديب نجيب محفوظ، الذي ارتبطت أعماله كثيرا بحضوره في المقاهي، وتحدث عن هذا الارتباط الروحي بينه وبين المقاهي، في كتاب لجمال الغيطاني بعنوان “نجيب محفوظ يتذكر”: “المقهى يلعب دورًا كبيرًا في رواياتي، وقبل ذلك في حياتنا كلنا، لم يكن هناك نوادٍ، المقهى محور الصداقة”.
خصص الكثير من الكتاب مؤلفاتهم للحديث عن دور المقاهي الأدبية، منها كتاب لرشيد الذوادي المعنون بـ “مقاهي الأدباء في الوطن العربي” الذي عرج على مختلف الدول العربية التي عرفت ظاهرة المقاهي الأدبية في كل من تونس، المغرب، مصر، العراق…، مما يوحي أننا لسنا أمام مكان لرشف القهوة، والأحاديث الجانبية، بل في مكان ذو بعد تاريخي ألهم الكُتاب، وأنار بصيرتهم الإبداعية.
يُبرز الكاتب رشيد الذوادي هذا الدور قائلا: “المقهى الأدبي وعلى امتداد أجيال، عاش مع القضايا العربية، وعكس العصر، وفيه وُضِعت بعض الخطوط من حضارتنا وأفضى الأدباء فيه بآرائهم في الكثير من القضايا والمشكلات”.
يمكن القول أن المقاهي الأدبية تمثل دلالة تاريخية في مجال الأدب، والنقاش الثقافي، غير أن هذه الرمزية، تراجعت مؤخرًا، بعد حضور هاجس الربح، وجشع المقاهي، التي أصبحت ترفض حتى إدخال الكتب، أو الحاسوب المحمول، تجنبا لاستغراق وقت أطول داخل المقهى ممّا يفوت عليها أرباح زبائن آخرين، ليبرز الحل حينها في اللجوء للمكتبات والفضاءات المؤسساتية.
وفي ظل رحلة البحث عن المكان المناسب والملهم، يصبح الكاتب الذي يحمل مشروعًا فكريًّا وأدبيًّا يسعى لإنتاجه كمن يحمل كرة النار، يجوب بها كل الأماكن بغاية إتمامها، ناهيك عن التحديات الحياتية (العائلية، المهنية) التي يجب أن ينتشل نفسه منها، فربما نحن بحاجة اليوم وأكثر من أي وقت مضى للالتفات لهذا النوع من المبادرات، وتشجيع وزارات الثقافة في البلدان المغاربية بالخصوص، على خلق مثل هذه الفضاءات لتعيد للكاتب وهجه داخل المجتمع، فالحديث عن تراجع جودة الكتابة، والإنتاجات الفكرية، ليست مسؤولية الكاتب وحده-وإن كان يتحمل النسبة الأكبر-بل هي مسؤولية مشتركة ومجتمعية.
إذن، لا يمكن الارتقاء بالمشهد الثقافي دون خلق المحيط المناسب، وفضاءات تكون بمثابة بيئة حاضنة للكتاب لتبادل خبراتهم، وتجاربهم والاستفادة من أخطائهم كذلك، فالكتابة مهما كان مجالها أو موضوعها، تبقى في غاية الأهمية، وليست مجرد ترف أو أمر هامشي، أو فعلًا موسميًا كما يُشاع، بل يجب أن يُصبح روتينًا يوميًا، مما يقتضي توفير الأماكن اللازمة والتي تليق بمكانة الكُتاب في المجتمع.
(1): the coffeehouse culture, british literature wiki, https://2u.pw/t5y75Ym5
(2): the history of the literary café, ponte Vecchio, https://2u.pw/aIZD99GK