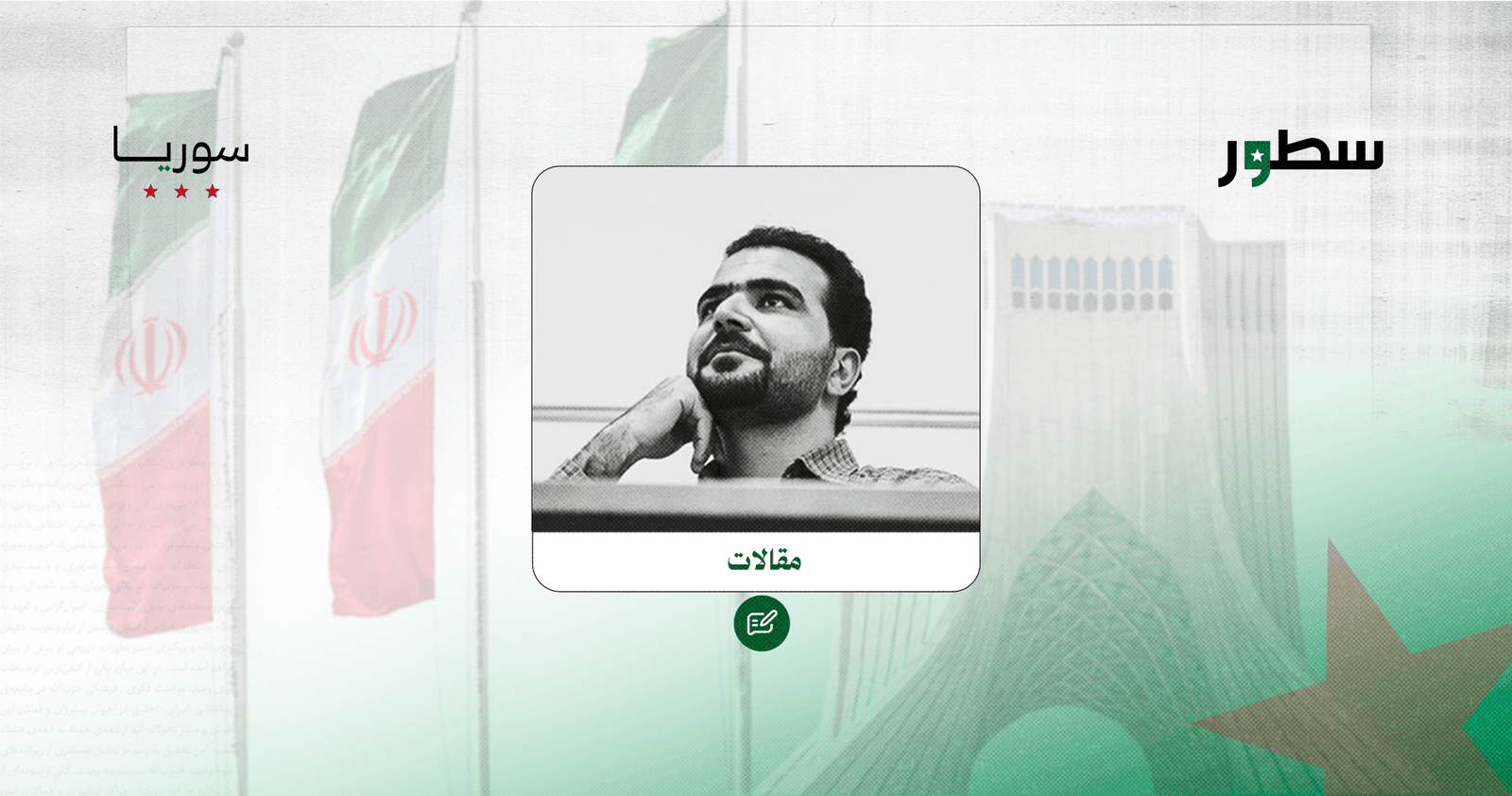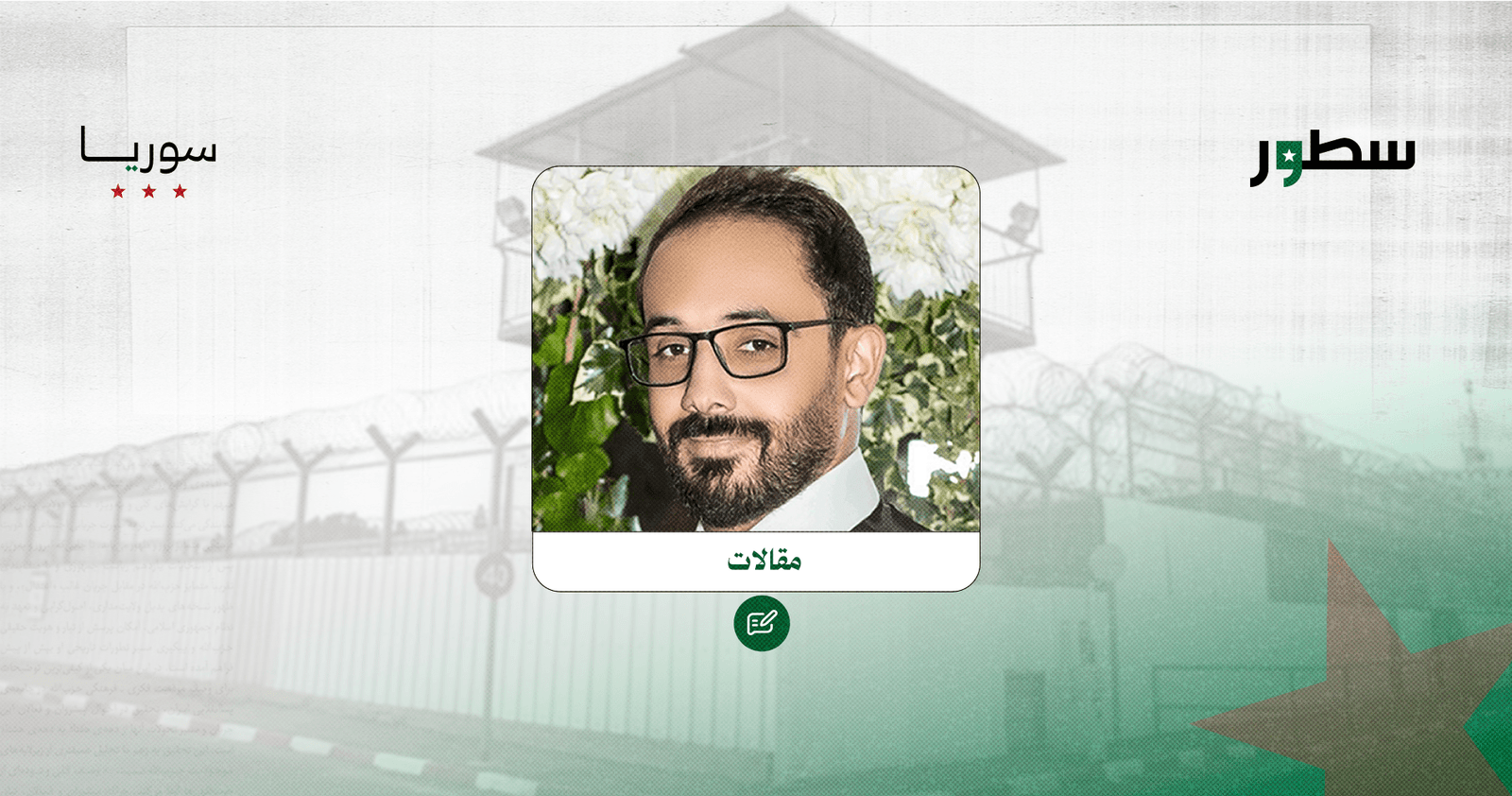سياسة
سوريا واتفاقيات أبراهام: تحوّل استراتيجي أم تسوية اضطرارية؟
سوريا واتفاقيات أبراهام: تحوّل استراتيجي أم تسوية اضطرارية؟
في السياسة كما في الجغرافيا، ثمّة لحظات تعيد تعريف الموقع والدور، وسوريا التي اعتادت أن تقف على خطوط النار في الصراع العربي الإسرائيلي، تجد نفسها اليوم أمام مفترق غير مسبوق، فالانضمام المحتمل إلى “اتفاقيات أبراهام”، التي كانت يوماً من المحرّمات السياسية، بات مطروحاً على طاولة البحث الجدي، لا بوصفه خياراً سيادياً حرّاً فقط، بل جزءاً من ترتيبات إقليمية أوسع تعيد رسم ملامح الشرق الأوسط.
على مدى عقود، صدّرت دمشق خطاب المقاومة والممانعة، وقدّمت نفسها قلعة رافضة لأي تسوية تُفرّط بالجولان أو بفلسطين، لكن سلسلة التحولات التي عاشتها سوريا داخلياً وخارجياً، من حرب شاملة إلى عزلة خانقة، ليطفو على السطح سؤال محوري، هل تتحوّل سوريا إلى حلقة جديدة في سلسلة التطبيع العربي الإسرائيلي، وإن حصل، فهل هو تحول استراتيجي مدروس أم مجرد تسوية اضطرارية لفتح أبواب الدعم والشرعية؟
في هذا المقال، نحاول قراءة هذا التحوّل من زواياه المختلفة، وتسليط الضوء على الخلفية والدوافع والتحديات المستقبلية.
لماذا يظهر ملف التطبيع الآن؟
منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، صدرت سوريا نفسها على أنها أحد أركان محور”الممانعة”، وواصل المخلوع رفع شعارات العداء لإسرائيل، حتى في ذروة الحرب والانقسام الداخلي، لكن التبدلات المتسارعة التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في أعقاب انهيار النظام السابق، فتحت الباب أمام تحولات جوهرية في السياسات الخارجية، وعلى رأسها العلاقة مع إسرائيل.
تعود اتفاقيات أبراهام إلى آب/ أغسطس 2020 حين أعلنت الإمارات اتفاق تطبيع مع إسرائيل، تبعتها البحرين والمغرب والسودان، ضمن مشروع طرحته إدارة ترامب تحت شعار “السلام مقابل المصالح”، وقد رُوّج لهذه الاتفاقيات كأداة لإعادة هيكلة العلاقات العربية الإسرائيلية، بعيداً عن منطق الأرض مقابل السلام.
توقيت طرح انضمام سوريا اليوم لا يمكن فصله عن 3 دوافع رئيسية أولاً، رغبة الإدارة الانتقالية في تثبيت شرعيتها الدولية، وثانياً، حاجة إدارة ترامب الثانية إلى تسجيل اختراق جديد في الشرق الأوسط، وثالثاً، سعي إسرائيل إلى توسيع شبكة حلفائها الإقليميين لمواجهة التمدد الإيراني جنوب سوريا ولبنان، وفي هذا السياق، يبدو التطبيع بالنسبة لدمشق خياراً اضطرارياً لا مفر منه، لا سيما في ظل اشتراطات المانحين لإعادة الإعمار، وتحولات المزاج الإقليمي حيال الدولة السورية.
ولا يمكن عزل هذا التوقيت عن السياق الجيوسياسي الأوسع، حيث تتحرك القوى الدولية والإقليمية لرسم مستقبل سوريا بعد الحرب، فبينما تحاول واشنطن تقليص نفوذ طهران، تسعى إسرائيل لتأمين حدودها، وفي هذا المناخ، تتحول اتفاقيات أبراهام من مجرد خيار دبلوماسي إلى أداة في سباق النفوذ.
كما أن تحرّك دمشق تجاه هذا المسار لا يعكس بالضرورة قناعة أيديولوجية بقدر ما يعكس واقعاً ضاغطاً، فالدولة الخارجة من الحرب تواجه شروطاً واضحة من شركاء دوليين وإقليميين، لا دعم ولا إعادة إعمار دون إعادة تموضع سياسي، ومن هنا، يأتي طرح التطبيع جزءاً من صفقة اضطرارية أكثر منه قراراً سيادياً نابعاً من الداخل.
طموح أمريكي أم حاجة سورية؟
التحركات السورية تجاه “اتفاقيات أبراهام” لا تعبّر بالضرورة عن انقلاب في الموقف الأيديولوجي، بل تكشف عن محاولة للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي عبر بوابة دولية تضمن الاعتراف والدعم، فالإدارة الانتقالية، التي تسعى إلى إعادة تدوير النظام ضمن شكل جديد، ترى في هذا المسار فرصة لتخفيف العزلة واستئناف العلاقات الخارجية، دون الحاجة إلى تنازلات داخلية كبرى.
من جهة أخرى، تنظر واشنطن إلى الملف السوري باعتباره ورقة جيوسياسية يمكن توظيفها ضمن مشروع إقليمي أوسع، فمع تراجع نفوذ بعض حلفائها التقليديين، ترى في دمشق الجديدة فرصة لتعديل التوازنات الإقليمية عبر إخراج سوريا من تحت المظلة الإيرانية وإعادة إدماجها في النظام العربي الموالي للغرب.
وفي هذا السياق، أُشير إلى زيارة الحاخام الأمريكي أبراهام كوبر إلى دمشق في حزيران/ يونيو 2025، كمحاولة مدعومة من البيت الأبيض لفتح قنوات تواصل مباشرة مع القيادة السورية الجديدة، وتهيئة الأرضية السياسية والرمزية لمسار تطبيعي محتمل.
إذن، تتحرك واشنطن بدافع من حسابات استراتيجية، وتتحرك دمشق من موقع الحاجة، وبين الدافع والموقع، تنشأ معادلة هشّة تفرض على الطرفين أن يحسبا كل خطوة وفق توازن دقيق بين الطموح والضغط.
الملفات العالقة: الجولان، اللاجئون، وإعادة الإعمار
يشكل ملف الجولان المحتل اختباراً فعلياً لأي مسار تطبيع محتمل بين سوريا وإسرائيل، فبينما تعتبر تل أبيب أن قرار ضم الجولان منذ عام 1981 حُسم بدعم من إدارة ترامب في 2019، تُشير مؤشرات سياسية أولية إلى أن دمشق الجديدة قد تضع هذا الملف في صلب أي تفاوض مقبل، خصوصاً أن السيادة عليه تُمثّل رمزاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه بسهولة، وقد تداولت بعض الدوائر الغربية تسريبات عن مقترحات تتعلق بترتيبات إدارية أو شراكات استثمارية في الجولان، دون المساس بالوضع القانوني، وهي طروحات ما تزال تواجه تحفظاً واسعاً داخل مؤسسات الدولة السورية.
أما ملف اللاجئين، فهو أعقد مما يبدو على السطح، فدول الجوار، خصوصاً تركيا ولبنان، تضغط باتجاه العودة الطوعية، بينما ترى دمشق أن هذه الورقة يمكن استخدامها لتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية، كما أن تقارير إعلامية تحدثت عن مقترحات أوروبية بتمويل مشاريع إعادة إعمار مقابل الإشراف الأممي على عودة اللاجئين، وهو ما يفتح الباب على نقاش طويل حول السيادة والرقابة الدولية.
ويبرز ملف إعادة الإعمار بوصفه الحافز الأكبر، فدمشق التي تعاني من اقتصاد منهك تدرك أن بوابة المساعدات الدولية تمرّ عبر قرارات سياسية، في هذا السياق، تروّج بعض العواصم العربية والغربية لفكرة “التطبيع مقابل الإعمار”، أي أن توقيع الاتفاق سيؤدي إلى تدفق الدعم المالي، سواء من صناديق خليجية أو عبر مؤسسات دولية، لكن هذه المعادلة تواجه رفضاً ضمنياً من بعض القوى السياسية السورية، التي ترى أن الاستثمار لا يمكن أن يكون مشروطًا بتنازلات استراتيجية.
بالتالي، لا يمكن اختزال هذه الملفات باعتبارها تفاصيل فنية فهي تمثل جوهر الصراع، وتحدد ما إذا كان اتفاق أبراهام المقبل مع دمشق مجرد عنوان دبلوماسي، أم بداية تسوية أوسع تُراعي المصالح الوطنية.
أما ملف اللاجئين، فهو أكثر تعقيدًا من مجرد أرقام، إذ يتداخل مع الحسابات الديموغرافية والسياسية والأمنية، في حين تضغط دول الجوار من أجل عودة طوعية، ترى دمشق في هذه الورقة عنصر قوة تفاوضي يمكن استخدامه لتحصيل مكاسب في ملفات أخرى، خصوصًا مع الطروحات الأوروبية التي تربط العودة بتمويل مشروط وإشراف دولي.
إعادة الإعمار بدورها تمثل العنوان الاقتصادي الأبرز، إذ تراهن دمشق على أن فتح بوابة التطبيع سيؤدي إلى تدفق المساعدات من دول الخليج والمؤسسات المالية، لكن ذلك يتطلب ضمانات سياسية ودبلوماسية، وهو ما يجعل التطبيع جزءًا من صفقة أوسع تتعدى الشق الدبلوماسي لتطال جوهر السيادة الوطنية.
الداخل السوري: بين الانقسام والصمت الحذر
رغم أهمية الملف، تلتزم الدولة السورية الرسمية بصمت ملحوظ تجاه التطبيع، ما يوحي بأن النقاش ما يزال محتدمًا داخل أروقة القرار. فالتركيبة الحالية تجمع بين تيارات تكنوقراطية تدفع نحو الانفتاح الاقتصادي، وأخرى قومية تقليدية ترى في إسرائيل تهديداً وجودياً، ما يخلق حالة من التوازن الحرج تمنع الحسم.
على المستوى الشعبي، لا يبدو الموقف موحداً أيضاً، فبينما تُحافظ شرائح واسعة على موقف رافض للتطبيع انطلاقًا من الذاكرة القومية والسياسية، تظهر أصوات جديدة، خصوصاً من الأجيال الشابة، ترى في الخروج من العزلة أولوية تتقدّم على المواقف المبدئية، ما يعكس تبدّلاً تدريجياً في المزاج العام، وإن لم يتحول بعد إلى رأي عام ضاغط.
هذه التركيبة الداخلية المعقدة تجعل أي خطوة رسمية نحو اتفاقيات أبراهام مشروطة بإجماع داخلي هش، أو على الأقل بسردية وطنية قادرة على تبرير التحول دون كسر الرموز أو فقدان الهيبة السياسية.
هل ما يُعرض شراكة متكافئة أم صفقة مشروطة؟
رغم الطابع الدبلوماسي المُعلن لاتفاقيات أبراهام، لا تبدو الصيغة التي تُعرض على سوريا أقرب إلى شراكة متكافئة بقدر ما توحي بأنها صفقة ذات شروط مسبقة، ترتبط بإعادة التموضع السياسي، والابتعاد عن طهران، والقبول بترتيبات أمنية جديدة في الجنوب السوري.
هذه المعادلة تُثير تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت دمشق تفاوض على موقعها ضمن الإقليم، أم تُجبر على التنازل مقابل البقاء، فالتطبيع، إن تم، لن يكون مجرد تغيير في الخطاب، بل إعادة صياغة لدور سوريا الإقليمي ولموقعها التاريخي في الصراع العربي الإسرائيلي.
بين الفرصة والضغط، تحتاج دمشق إلى حسابات دقيقة، لأن ما يُعرض قد يحمل وعوداً بإعادة الإعمار ورفع العزلة، لكنه في المقابل قد يتطلب أثماناً سياسية لا يمكن استردادها لاحقاً، كالتخلي عن ملفات بحجم الجولان واللاجئين، أو القبول بسياسات إقليمية تُملى من الخارج.
تجد سوريا نفسها اليوم أمام مفترق حساس، حيث لم تعد السياسة الخارجية امتدادًا للأيديولوجيا، بل باتت امتدادًا لحسابات النجاة من الحصار والانهيار، اتفاقيات أبراهام تمثل بهذا المعنى فرصة مزدوجة، إما نافذة للاندماج في النظام الإقليمي بشروط جديدة، أو مصيدة تتطلب تنازلات جوهرية في ملفات استراتيجية.
هل تتحرك دمشق من موقع الفاعل، أم تجد نفسها تُدفع نحو خيارات مرسومة سلفاً؟ وهل تملك القرار الكامل، أم أن بوصلة المرحلة الانتقالية ستُحدَّد وفق موازين قوى خارجية؟ تلك الأسئلة ستبقى مفتوحة حتى تتضح معالم المسار، لكن الأكيد أن ما يُعرض اليوم ليس مجرد اتفاق تطبيع، بل اختبار لحدود السيادة وإعادة تعريف للدولة.