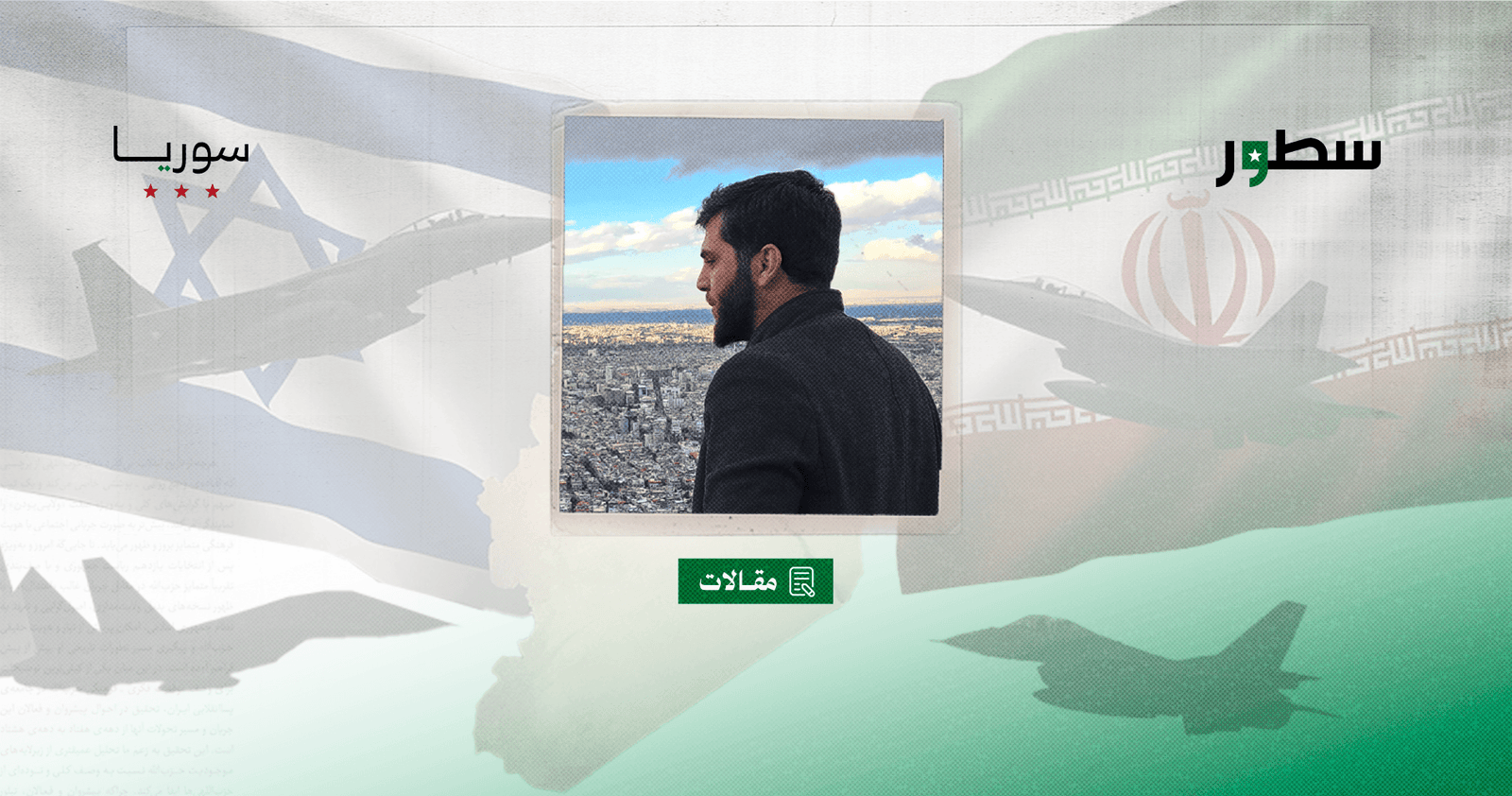أدب
بنّان طنطاوي: بين الشام وآخن.. سقطت الفكرة شهيدة
بنّان طنطاوي: بين الشام وآخن.. سقطت الفكرة شهيدة
وُلدت بنّان طنطاوي في دمشق، في 23 أيار/ مايو 1943، لأبٍ هو أحد أبرز علماء وأدباء الشام في القرن العشرين: الشيخ علي طنطاوي، الرجل الذي عاش حراً ومات حراً، وعلّم أبناءه وبناته أن يكونوا مثله. لم يُربِّها على حفظ القصائد والنصوص فحسب، بل غرس فيها وعياً سياسياً مبكراً، لا يعرف المداهنة ولا يقبل المساومة.
وقد شاء الله أن تكون شريكة حياة أحدِ رموز التيار الإسلامي في سوريا، خطيب الجامع الأموي، وقائد جماعة الإخوان المسلمين آنذاك: عصام العطار، ليجتمع فيها إرث الشام من جهة والدها، وهمّها السياسي من جهة زوجها، في مشهدٍ نادرٍ يجمعُ بين العلم والوعي، والتقوى والموقف.
لكن، كما الكثير من أبناء الشام، كان لا بد أن تدفع الثمن باكراً.
البعث.. والمنفى الطويل
في 8 آذار/ مارس 1963، وقع الانقلاب البعثي الذي غيّر وجه سوريا إلى الأبد، واستهلّ مرحلةً من القمع المنظَّم والاستبداد المؤدلَج. كان الرحيلُ لزاماً على من يعارض، فغادر عصام العطار دمشق برفقة زوجته بنّان وابنتهما هادية، التي لم تتجاوز السنوات الثلاثة بعد.
تنقلوا بين عدة دول، ثم استقر بهم المقام في مدينة آخن بألمانيا، ظناً منهم أنها ستكون ملاذاً آمناً. ليبدأ عصام العطار هناك عمله السياسي والإعلامي، محاولاً إيصال الصوت السوري الحر إلى المنصات الغربية والعربية؛ والقديم والمتجدد في هذه القصة: أنَّ صوت أحرار المنافي لا يعجب الطغاة ولا يغري أسماعهم الثقيلة، ويذكرهم أن الفكرة لم تمت بعد.
الدم في قلب أوروبا
في صباح الثلاثاء، 17 آذار/ مارس 1981، هاتفَ الشيخ علي طنطاوي من السعودية ابنته بنّان. كانت نبرة صوته مختلفة؛ فقد علم غالباً من دوائر سعودية رسمية أن حافظ الأسد يُخطط لاغتيال صهره. قال لها بقلق: “أرجوكم توخّوا الحذر، لا تفتحوا الباب لغرباء…”
ابتسمت ابنته وقالت مطمئنة: “لا تقلق، نحن حذرون جدا. الباب لا يُفتح إلا من الداخل، ولا أفتحه لغير من أعرفهم”. وأنهيا المكالمة بالدعاء.
بعد أقل من ساعة، دقّ الجرس سمعت بنّان صوت جارتها الألمانية التي تسكن في المبنى نفسه، فتحت الباب، فاندفع 3 رجال مسلحين إلى الداخل. كانوا قد أجبروا الجارة على قرع الجرس تحت تهديد السلاح.
في لحظات قليلة، أطلق المهاجمون 5 رصاصات على بنّان، ثم داس أحدهم صدرها ليتأكد من موتها، هكذا ببساطة، قرر نظام الأسد أن يقتل امرأة في منفاها، أمام ابنتها، بعيداً عن بلادها، بدمٍ بارد.
الوداع الذي لم يكتمل
رحلت بنّان طنطاوي عن عمر 38 عاماً، لكن الجرح الذي خلّفته كان أوسع من عمرها بكثير. فقدت دمشق ابنتها، فقدت آخن سكينتها، وفقد الشيخ علي طنطاوي جزءاً من روحه.
حين بلغه الخبر من وزارة الخارجية السعودية، لم يستطع الحديث، ويُقال إنه لم يذكر اسمها لسنوات، من شدة الألم.
أما عصام العطار، الذي خسر شريكة روحه، فقد آثر ألا يتزوج بعدها، وكان كلما قرأ المرثية التي كتبها في وداعها، انهمرت دموعه من جديد، وكأن الزمن لم يمر قط…
بَنانُ لَقَدْ طالَ الفِراقُ وَأوْحَشَتْ
دُروبي وَلكِنّي الْمُهَنَّدُ ماضِيا
تَسيلُ حُروفي إذْ أناجيكِ رِقَّةً
وَيَنْزِفُ قَلْبي أدْمُعاً وَقَوافِيا
وَلُقْياكِ في عَدْنٍ عَزائِيَ والرَّجا
فَلا خَيَّبَ الرَّحْمنُ مِنّي رَجائِيا
وَرَحْمَةُ رَبّي عُدَّتي وَمَفازَتي
وَدارُ التي أحْبَبْتُ – لا شَكَّ – دارِيا
لكن للظلم نهاية وللدم صوت لا يموت
مرّت الأعوام كما تمرّ الجنازات ثقيلة موجعة. لكن للألم ذاكرة، وللدم صوتٌ لا يخرس.. مات القاتل. وماتت صورته، وماتت دولته التي كانت تمشي على جماجم السوريين. سقط نظام الأسد الذي قتلها.
سقطت الجدران التي كانت تمنع الحكايات. وعادت الشام تُغنّي، وتبكي، وتحتفل بمن ماتوا من أجلها.
عادت الحرية إلى جسدٍ أُنهك طويلاً. وفي مقبرة آخن، تبتسم بنّان من تحت التراب، كما لو أنها تقول: “كنتُ أعلم أن الحرية ستعود.. وأن الرصاصة لا تقتل وطناً.”