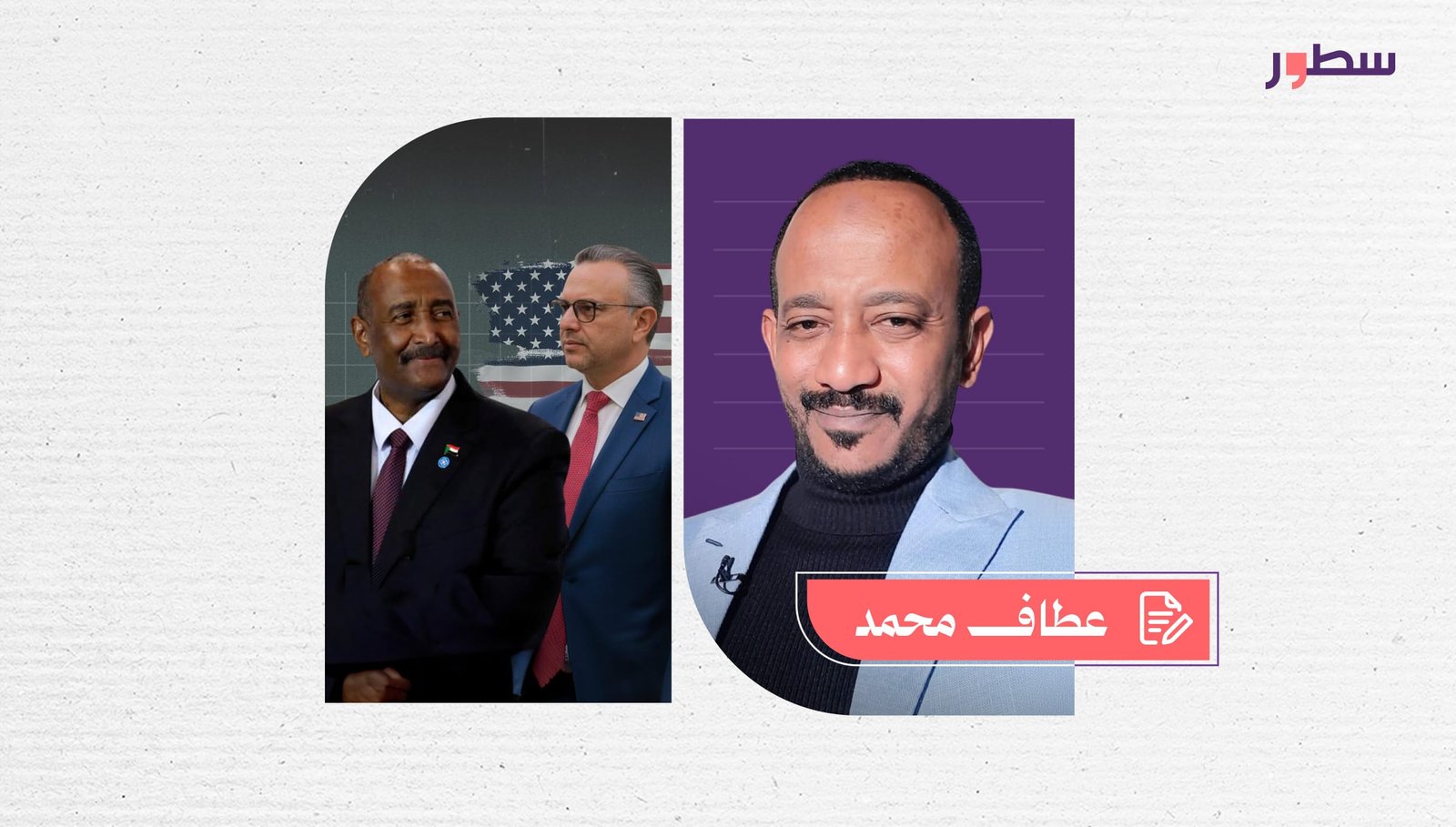سياسة
ضريح توماس سانكارا: استعادة الذاكرة الأفريقية وسط أطلال الخيانة والتبعية
ضريح توماس سانكارا: استعادة الذاكرة الأفريقية وسط أطلال الخيانة والتبعية
في قلب واغادوغو، حيث كانت الدولة البوركينابية تُدار لعقود بعقلٍ مستعار وإرادةٍ خائفة، أزاحت حكومة الكابتن إبراهيم تراوري الستار عن ضريح توماس سانكارا. الرئيس الأسبق للبلاد والذي اغتيل قبل ما يقارب أربعين عامًا في انقلاب مدعوم فرنسيًا، ودفن في زاوية مُهمَلة بلا شاهد ولا سياق. وهكذا اليوم، يُستعاد رماده ببرجٍ من الطين الأفريقي، في لحظة تحمل في ظاهرها تكريمًا لبطل، وفي باطنها صراعًا مع التاريخ نفسه.
وفي الافتتاحية كان واضحًا أن الضريح ليس معلمًا معماريًا يُضاف إلى جغرافيا المدينة، بل تدخلٌ مباشر في معركة الرواية. هو فعلٌ سياسي بامتياز، يُعيد توزيع رمزية القوة، ويحرّك المياه الراكدة في ذاكرة قارة بكاملها لم تتعافَ بعد من عطب الاستعمار، ولا من التبعية المعاصرة المقنّعة.
حين تكون الذاكرة أداة مقاومة
النظر في ضريح سانكارا – في تقديري- لا يمكن أن يكون معزولًا عن علم النفس السياسي. الشعوب التي قُتلت رموزها، أو شُوِّهت سيرتهم، هي شعوب مجروحة الهوية. والاستعمار الأوروبي، كما يشير فرانز فانون، لم يقتصر على نهب الموارد، بل عمِل أيضًا على إعادة تشكيل ذاكرة الشعوب المهزومة. حيث خضعت الذاكرة الجمعية حينها لعمليات تبييض ممنهج، فتحوّل المقاوم إلى فوضوي، والعميل إلى مؤسس للدولة الحديثة.
وسانكارا – في هذا السياق – تجاوز مجرّد رئيس قُتل، ليتحول إلى رمزٍ لمشروع سياسي مختلف، يُجسّد فكرة السيادة، لا بوصفها خطابًا مجردًا، بل ممارسة اقتصادية واجتماعية وثقافية. ولهذا بالتحديد، لم يُقتل لأنه فشل، بل لأنه بدأ ينجح. وحين أُعيد رفاتُه اليوم إلى موضعٍ مركزي في المدينة، فإن العملية لا تتعلّق فقط بتكريمه، بل بتثبيت ذاكرته كـ”مُحرّض مستمر” على مساءلة ما جرى، وما لم يجرِ بعد.
إذن ما فعله النظام البوركينابي الحالي بقيادة النقيب تراوري، في لحظة سياسية حسّاسة، هو قلبٌ لأدوار رمزية دامت لعقود. فحين يُزال اسم “شارل ديغول” عن أحد شوارع العاصمة ليُستبدل بـ”جادة سانكارا”، فالمقصود ليس فقط استعادة اسم، بل إزاحة صورة ذهنية كاملة لعلاقة مختلّة بين المستعمِر والمستعمَر.
ففي فرنسا مثلاً، يُقدّم شارل ديغول على أنه “محرّر الأمة” وقائد الكرامة الفرنسية، لكن في أفريقيا، هو أحد رموز استدامة السيطرة ما بعد الاستعمار بل ومجرم حرب في دولة مثل الجزائر. والإشكال لا يكمن في وجود رموز فرنسية، بل في غياب ما يعادلها أفريقيًا. هنا تظهر المفارقة: الدول الأوروبية امتلكت رفاهية إعادة تدوير رموزها حتى غدت بعض التماثيل تُقرأ كأيقونات قومية، فيما بقيت أفريقيا تسكن هوامش التاريخ، إما برموز مجهولة، أو بوجوه رسمها الاستعمار لها. وهنا يأتي ضريح سانكارا ليرفض هذا التوازن المختل. فالعبرة ليست بتقليد الغرب في تقديس الرموز، بل بتحدي الوعي المزيف الذي يقيس البطولة على معيار الاعتراف الأوروبي.
غياب الرموز القومية في أفريقيا جنوب الصحراء تحت وطأة الاستعمار:
عانى كثير من دول أفريقيا جنوب الصحراء من ندرة الرموز القومية الجامعة نتيجة عقود من الاستعمار الأوروبي الذي سعى لطمس الرموز الثورية المحلية أو تهميشها. فقد اتبعت القوى الاستعمارية سياسة ممنهجة لنزع الشرعية عن أبطال المقاومة الأفارقة، إما عبر تصفيتهم جسديًا (كما حدث مع لومومبا في الكونغو وعبد القادر في الجزائر وغيرهما)، أو من خلال تشويه صورتهم ووضع أسماء المستعمرين ورموزهم محلهم في الفضاء العام.
وورثت الدول الإفريقية المستقلة حديثًا هذه المشكلة: إذ أن الحدود المصطنعة التي رسمها الاستعمار غالبًا ما جمعت جماعات إثنية وثقافية مختلفة تحت دولة واحدة دون سردية تاريخية موحّدة أو أبطال وطنيين مجمع عليهم. في ظل هذه الظروف، كان من السهل أن تستمر هيمنة الرموز الاستعمارية حتى بعد الاستقلال، سواء في أسماء المدن والشوارع والمؤسسات، أو حتى في المناهج التعليمية التي مجّدت تاريخ أوروبا على حساب تاريخ أفريقيا. على سبيل المثال، ظلت شوارع عديدة في عواصم أفريقيا تحمل أسماء قادة استعماريين (كشارل ديغول في واغادوغو وداكار، وليوبولد الثاني في كنشاسا سابقًا، إلخ) لعقود بعد الاستقلال.
هذا الأمر يعني ضمنيًا أن الذاكرة الجمعية لتلك الشعوب بُنيت حول رواية يكتبها المنتصر الأبيض، فيما جرى تهميش رموز النضال المحلية. وكانت النتيجة فراغًا رمزيا أو ارتباكًا في الهوية الوطنية، ملأته أحيانًا شخصيات سلطوية بعد الاستقلال حاولت فرض نفسها كأبطال، لكنها غالبًا ما فشلت في الارتقاء لمكانة الرموز التاريخية الحقيقية.
ولهذا نرى العديد من الدول الأفريقية لا تحتفي بقادة استقلالها بنفس القوة التي تحتفي فيها أمم أخرى برواد نهضتها، إما بسبب أن أولئك القادة تم اغتيالهم (كما في حالة سانكارا ولومومبا وسيلفانوس أوليمبيو في توغو وغيرهم)، أو بسبب انقلابهم إلى ديكتاتوريين شوهوا صورتهم (كما في حالة العديد من “الأباء المؤسسين” الذين أساءوا استخدام السلطة بعد الاستقلال).
وفي أفريقيا، حيث اعتمدت حركات المقاومة كثيرًا على الزعماء التقليديين أو القادة الروحيين المحليين، قام الاستعمار بتصفية هؤلاء أو استبدالهم بعملاء موالين له. ولهذا دخلت معظم الدول الإفريقية مرحلة الاستقلال وهي تفتقر إلى بانثيون (مجمع) من الرموز الوطنية المتوافق على قدسيتها شعبيا. حتى المناهج المدرسية التي وضعها الاستعمار لم تتحدث عن أبطال أفارقة إلا نادرًا، بل ركّزت على “مزايا الاستعمار في تمدين أفريقيا”، في حين صوّرت المقاومين كخارجين عن القانون. هذا الإرث الثقيل جعل الأجيال اللاحقة لا تعرف الكثير عن رموزها التحررية، وفاقد الشيء لا يعطيه في مجال بناء الهوية الوطنية. لكن ابتداءً من مطلع الألفية الجديدة، ومع ظهور جيل جديد من الشباب الأفارقة الواعين بماضيهم، بدأت حركة مراجعة واسعة لإرث الاستعمار ورموزه.
وشهدت مدن أفريقية عديدة حملات لإزالة أسماء المستعمرين واستبدالها بأسماء الأبطال المحليين. حصل ذلك في دكار -عاصمة السنغال- حين تمت إعادة تسمية شارع شارل ديغول باسم مناضل سنغالي، كما حدث الأمر ذاته في واغادوغو 2023 كما أسلفنا. هذه الجهود هي بمثابة محاولة متأخرة لسد النقص في الرموز القومية وإعادة الاعتبار للتاريخ الوطني. ومن شأن ضريح سانكارا في بوركينا فاسو أن يكون نموذجًا ملهمًا لدول أخرى في المنطقة لإحياء رموزها الثورية. فها هو شعب بوركينا، بعد سنوات من هيمنة رواية بليز كومباوري – الرجل الذي اغتال سانكارا لصالح فرنسا- رواية همّشت سانكارا وصادرت إرثه، يفرض تكريم بطله الوطني أخيرًا. وهذا التكريم الشعبي والرسمي قد يشجع شعوبًا أخرى على المطالبة بمواقع لذاكرة أبطالها المهملين وإعادة كتابة تاريخها بمنظورها الذاتي.
الضريح كفعل تأسيسي… لا تخليد فقط
ينجرف البعض إلى اعتبار ما حصل نوعًا من “ردّ الاعتبار العاطفي”، أو حتى محاولة سياسية من تراوري لبناء شعبية ظرفية عبر تمجيد سلفه. غير أن هذا التوصيف يغفل جوهر المسألة: نحن أمام فعل تأسيسي يُقارب ما يسمّيه المفكر والمؤرخ الأمريكي-الإيرلندي وأحد منظري الدراسات القومية والهوية الوطنية، بندكت أندرسون “إعادة تخييل الأمة”. بمعنى أن الضريح هنا ليس نهاية سردية، بل بدايتها. هو صياغة لنسخة بديلة من الهوية الوطنية، لا تُبنى على التعايش مع الخضوع، بل على افتكاك الرواية واستعادتها من غاصبيها.
ولقد كانت الدولة البوركينابية – كحال كثير من الدول الإفريقية – أسيرة رواية رسمها الغير: كتبها المستعمر، وراجعها التابع، ودرّسها المتردد. اليوم، يأتي الضريح كمحاولة لاقتطاع سرديّ جديد، يربط الجيل الحالي بجذوره الثورية، لا بوثائق البيروقراطية الدولية. ومن هنا اعتبر هذا الحدث لحظة نموذجية يمكن أن تعيد تشكيل وعيٍ جماعي أوسع. وإذا كان لفرنسا شارل ديغول وإن كان مجرم حرب، ولأمريكا جورج واشنطن، وللصين ماو تسي دونغ، فأفريقيا بحاجة لأن تقول: لدينا أيضًا من لم يخضع، من لم يساوم، من لم يُفرّط في الكرامة باسم الواقعية السياسية.
وفي الختام، غنّي عن الذكر هنا أن ما يُميّز هذا الحدث هو أنه تخطّى الحدود الوطنية لبوركينا فاسو. في حفل الافتتاح، حضرت وفود من دول مجاورة، وتم التصريح بأن سانكارا “رمز أفريقي”، لا فقط بوركينابي. فأعادتْ هذه اللغة للأذهان مشروع القومية الأفريقية الذي روّج له الزعيم الغاني السابق، كوامي نكروما، سيلاسي، وعبد الناصر في الخمسينات، لكنه سرعان ما انكسر أمام صعود الأنظمة الوطنية القطرية. وهنا يتساءل البعض، هل نحن أمام عودة خجولة لذاك الحلم؟ أم أن سانكارا سيبقى رمزًا تتقاذفه الخطابات دون أن يتحوّل إلى مرجعية حقيقية لوحدة سياسية قارية؟
في رأيي لا يزال الجواب مفتوحًا، لكن الضريح ذاته يقدّم احتمالًا جادًا لتجذير نوعٍ من الهوية الأفريقية البديلة: ليست الهوية التي تُفرض من الاتحاد الأوروبي عبر برامج “التنمية”، ولا التي تُهندس في مكاتب البنك الدولي، بل هوية تُكتب من تحت، من ذاكرة المقاومة، من مشروع سياسي لم يُستكمل بعد. وطبعًا، ليس المطلوب اليوم تمجيد سانكارا بوصفه شخصية بلا أخطاء. التفكير الرمزي السليم لا يقوم على تأليه الأفراد، بل على مساءلتهم، على تحويل تجاربهم إلى أدوات لفهم الذات الجماعية. في هذا الإطار، لا ينبغي أن يُقرأ الضريح كتثبيت لنموذج سلطوي جديد يتلبّس صورة سانكارا، بل كمحرّك لعقل نقدي يُطالب باستكمال الطريق، لا الاكتفاء بتكراره.