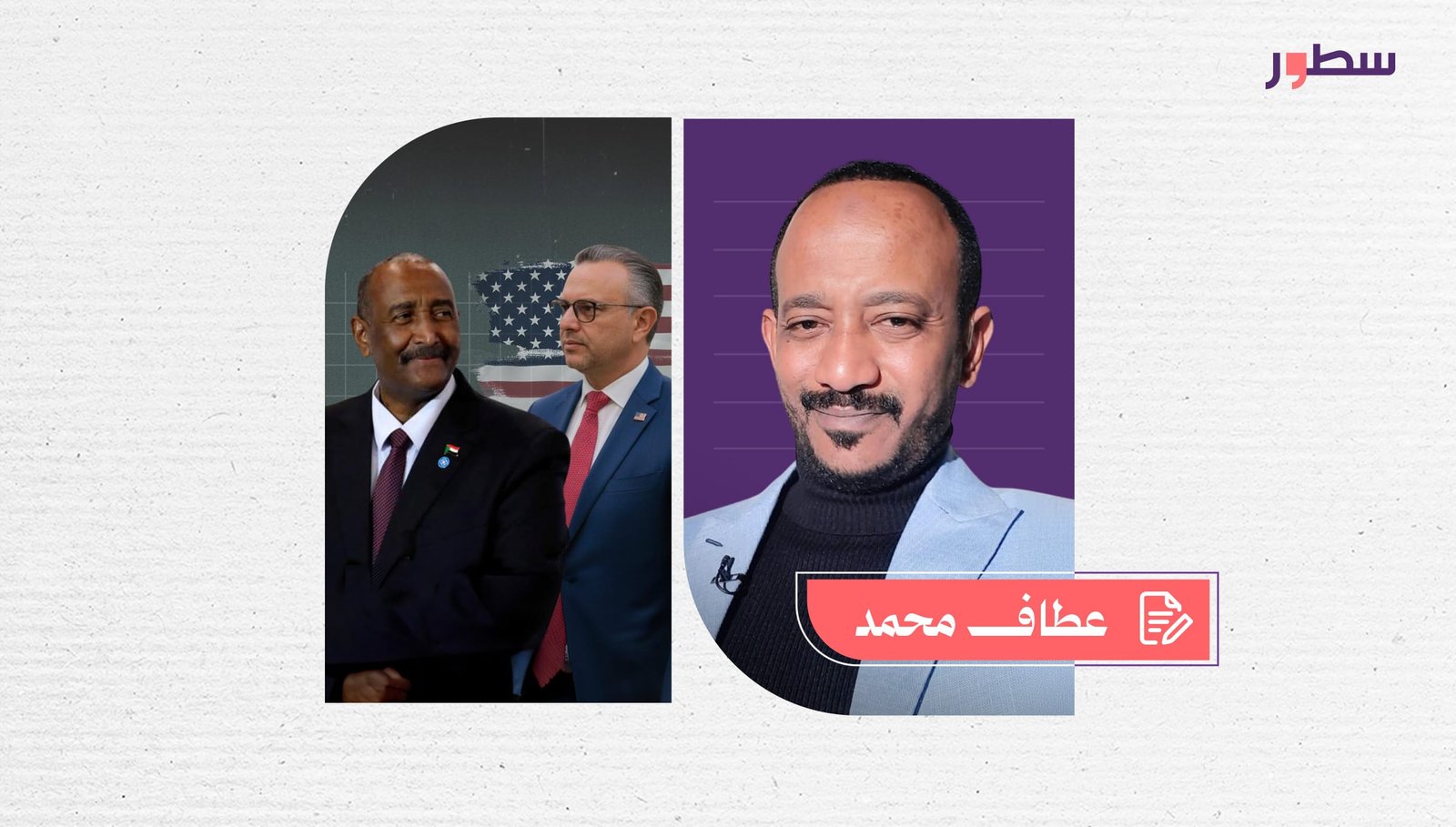سياسة
ثورة لغوية في الساحل: النيجر تُعلن الهوسا لسانًا وطنيًا وتُقصي الفرنسية!
ثورة لغوية في الساحل: النيجر تُعلن الهوسا لسانًا وطنيًا وتُقصي الفرنسية!
في خطوةٍ تُعد الأولى من نوعها في القارة الأفريقية، أعلنت جمهورية النيجر في الحادي والثلاثين من مارس 2025، اعتماد لغة الهوسا لغة وطنية رسمية، بينما خُفّض تصنيف اللغتين الفرنسية والإنجليزية إلى لغتي عمل فقط، وفقًا لما ورد في الميثاق الدستوري الجديد الذي نُشر في الجريدة الرسمية. خطوةٌ لا تُقرأ بمعزل عن السياق الجيو-لغوي الأوسع، بل تتجاوز حدود النيجر لتفتح بابًا واسعًا لإعادة تعريف هوية الدولة ما بعد الكولونيالية.
إذ تُعدّ الهوسا واحدة من أكثر اللغات انتشارًا في أفريقيا جنوب الصحراء، بقاعدة متحدثين تتراوح بين 80 و85 مليونًا كلغة أولى أو ثانية، فيما تصل التقديرات الشاملة لمستخدميها إلى نحو 150 مليونًا، إذا أُخذت في الحسبان باعتبارها لغة تواصل مشترك في الإقليم. ففي نيجيريا وحدها، يبلغ عدد المتحدثين نحو 54.7 مليون شخص، أما في النيجر، فتُعد الهوسا اللغة الأوسع انتشارًا، لا سيّما في أقاليم زيندر ومارادي وطاوة. كما تتواجد مجتمعات ناطقة بها في الكاميرون وغانا وبنين وتشاد والسودان، فضلاً عن الشتات الهوساوي في السعودية والمملكة المتحدة وأمريكا الشمالية.
وهذه الخطوة الجريئة التي اتخذتها النيجر، جاءت بعد شهرٍ واحد فقط من انسحابها الرسمي من المنظمة الدولية للفرنكوفونية، تلك الذراع الثقافية الناعمة التي طالما استخدمتها باريس لتعميق حضورها اللغوي والسياسي في مستعمراتها السابقة، تحت غطاء “التنوع الثقافي”.
من التبعية اللغوية إلى استعادة اللسان الوطني
دخل الاستعمار الفرنسي إلى النيجر في أواخر القرن التاسع عشر، لكنه لم يُعلن سيطرته الكاملة إلا عام 1922، حين أصبحت النيجر رسميًا إقليمًا تابعًا للاتحاد الفرنسي. جاء ذلك بعد سلسلة من الحملات العسكرية وفرض الحماية، بدأت منذ عام 1898، وانتهت بتكريس الوجود الفرنسي الذي استمر حتى الثالث من أغسطس 1960، تاريخ إعلان الاستقلال الرسمي. لكن اللغة، كأداة استعمارية خفية، استمرت بعد الاستقلال في حكم البلاد من خلف الستار.
وقبل أن تطأ أقدام الجنرال فوشير أرض النيجر، لم تكن البلاد تملك لغة وطنية جامعة، لكنها كانت تزخر بثروة لغوية تعددية، تعكس ثراءها الثقافي وتعددها العرقي. فالهوسا كانت، ولا تزال، أكثر اللغات نفوذًا، خاصة في الجنوب الشرقي، حيث شكّلت لغة السوق، والدين، والعلاقات العابرة للحدود. أما الزَرْما-السونغاي فكانت حاضرة بقوة في غرب البلاد وجنوبها الغربي، وتُعد اليوم أكثر اللغات المحلية تداولًا في العاصمة نيامي، بوصفها امتدادًا حضاريًا لإمبراطورية السونغاي القديمة.
في الشمال، حافظ الطوارق على لغتهم التِّمَجَق، لغة الشعر والهوية، المكتوبة بحروف التيفيناغ الأمازيغية، فيما سادت الفولانية بين المجتمعات الرعوية والبدوية، خاصة في شرق النيجر ووسطها، باعتبارها لغة عبور وتعايش بين القبائل المتنقلة. وكذلك اللغة العربية في القبائل العربية المتواجدة في البلاد، بجانب التبو وغيرها.
مع بسط فرنسا نفوذها على النيجر، لم يكن الاستعمار محصورًا في السياسة والاقتصاد، بل تعدّى ذلك إلى غزو لغوي وثقافي. فُرضت الفرنسية كلغة الإدارة، والمحاكم، والتعليم، وتمّت تنحية اللغات الأصلية من الفضاء الرسمي، لصالح نخبة ناطقة بلغة المستعمر. تمّ تجريف الهوية اللسانية للبلاد، عبر سياسة “الفرنسة الثقافية”، التي جعلت من إتقان الفرنسية مدخلًا للترقي الاجتماعي والمكانة.
ومع ذلك، لم تستطع فرنسا اقتلاع اللغات الأصلية من وجدان الناس. فقد ظلت حيّة في الأسواق، والمدارس القرآنية، والحكايات الشفهية، وفي الروح اليومية للناس. قاومت الهوسا والزرما والتماشق والفولانية وغيرها، الموت البطيء الذي أراده لها المستعمر، وأبقت جذورها في عمق التربة النيجرية.
الهوسا: من الألِف إلى الأجاوي… لسانيات ذات شخصية مستقلة
الهوسا ليست لغة وطن، بل وطن للغة. لتجاوز عدد متحدثيها الإجمالي 150 مليونًا. وهي لغة تواصل رئيسية في أكثر من 12 دولة أفريقية شعبيًا. حيث تنتشر الهوسا كلغة تواصل مشتركة في نيجيريا، النيجر، وامتدادًا إلى غانا، الكاميرون، بوركينا فاسو، مالي، بنين، توغو، وتشاد، فضلًا عن انتشارها في الشتات بين مهاجري الحج والعمالة في السعودية، واللاجئين في السودان، والجاليات الثقافية في بريطانيا. وفي النيجر تحديدًا، تُعد الهوسا لغة رسمية إلى جانب الفرنسية، ما يعكس متانتها ومكانتها السياسية. كما تمتلك الهوسا تراثًا كتابيًا غنيًا، سواء بخط الأجاوي العربي أو بالحرف اللاتيني، تُقدّر نصوصه المكتوبة بملايين الوثائق، في وقتٍ يشهد فيه المجال الرقمي والتقني دعمًا متصاعدًا، وإنْ ظلّ محدودًا حتى الآن. إنها لغة عريقة تزداد حضورًا في الفضاء الجيو-لغوي لغرب أفريقيا.
وبخلاف كثير من اللغات الأفريقية التي حوصرت بين الشفاه والمشافهة، امتلكت الهوسا تقليدًا كتابيًا ضاربًا في القدم، بدأ بخط الأجاوي العربي منذ القرن السابع عشر، حيث استخدمت الكتابة أساسًا في الشؤون الدينية والفقهية، ثم انتقلت للخط اللاتيني في ظل الاستعمار البريطاني. وتشير التقديرات اللسانية إلى وجود أكثر من ألفي كلمة عربية دخيلة في مفرداتها، نتيجة تفاعل تاريخي عميق مع الثقافة الإسلامية. اليوم، يُقدّر عدد النصوص الإلكترونية المكتوبة بها بأكثر من 10 ملايين صفحة، مما يجعلها من أكثر اللغات إنتاجًا أدبيًا في أفريقيا جنوب الصحراء.
وتتميز الهوسا ببنية صرفية معقدة قائمة على الجذور، وبنظام صرفي تحليلي. تمتلك نظامًا نغميًا (tonal) حيث تُغيّر النغمة معنى الكلمة، ونظامًا صرفيًا غنيًا في تصريف الأفعال، وجمع الأسماء، وتعدد الضمائر. أما بنيتها النحوية فتُتيح توليد المعاني بأقل عدد من الكلمات، ما يجعلها مرنة في الخطاب السياسي والديني، ومحببة في الأدب الشفهي والمسرح الشعبي.
كما ذكرنا، لم تكن الهوسا في منأى عن التفاعل اللغوي. فقد تأثرت بالعربية بشكل واضح، لا سيما في المفردات ذات الطابع الديني والإداري (hukumci، الحكم alkalami القلم، والعديد غيرها)، ثم بالإنجليزية زمن الاحتلال البريطاني كـ (mota – سيارة)، كما أثرت بدورها في اللغات المحيطة مثل الفولانية والكنورية، فضلًا عن تأثيرها على اللهجات المحلية المنتشرة في الحواضر الكبرى.
واليوم، تحتل الهوسا موقعًا بارزًا في الإعلام الإذاعي والمرئي، خصوصًا من خلال منصات عالمية مثل BBC Hausa، ( بي بي سي بلغة الهوسا) ووسائل الإعلام في نيجيريا والنيجر. كما أصبحت اللغة تُستخدم في الترجمة للمؤسسات الدولية، وتخترق تدريجيًا مجال الذكاء الاصطناعي. كما تُعد لغة رئيسية في السينما النيجيرية الشمالية “كانيوود”، وتُوظف في الحملات السياسية والخطب الدينية باعتبارها اللسان الأقرب للوجدان الشعبي.
الفرص والتحديات المحتملة
على المستوى الاجتماعي والتنموي، يُتوقع أن يُسهِم القرار في تحسين نسب التعلّم والإلمام بالقراءة والكتابة، خاصةً في المناطق الريفية، حيث تشكّل الهوسا اللغة الأم الغالبة. كما أن استخدامها في الإدارة والتعليم سيُقرب الدولة من مواطنيها، ويفتح الأبواب نحو ترسيخ مفهوم المواطنة اللغوية.
اقتصاديًا، يُعزز اعتماد الهوسا موقع النيجر في المنظومة التجارية لغرب أفريقيا، حيث تُعد اللغة وسيلة رئيسية في الأسواق والمعابر الحدودية، ما يُمهّد لتكامل اقتصادي أكبر بين بلدان الساحل. أما ثقافيًا، فإن دعم الإعلام والتعليم والإنتاج الفني باللغة الهوسا سيوفر فضاءً للتعبير الثقافي الأصيل، ويُعيد تشكيل المشهد الهوياتي بعيدًا عن وصاية المركز الاستعماري القديم.
غير أن هذا التحول الجذري لا يخلو من تحديات. فالنيجر بلدٌ متعدد الأعراق واللغات، ويضم أكثر من عشر لغات وطنية كما أشرنا إليه، ما قد يثير تساؤلات حول العدالة اللغوية والتوازن الداخلي. كما أن الخطوة تتطلب استثمارات ضخمة في المناهج التعليمية والتكوين الإداري، ناهيك عن تأثيرها المحتمل على علاقات النيجر بالدول الفرنكوفونية والمؤسسات الدولية المرتبطة بها.
ختامًا، النيجر، بموقفها هذا، لا تكتفي بمجرد التحرر من اللغة الفرنسية تدريجيًا، بل تفتح أبواب التاريخ على مصراعيه، لتُعلن – وبلا مواربة – أنّ زمن التبعية اللغوية قد ولى، وأنّ لغة الهوسا التي كتمها الاستعمار، ودفنها تحت رماد البيروقراطية الكولونيالية، قد عادت رسميًا لتُصبح لغةً وطنيةً لبلادها. والمفارقة أن نيجيريا، الدولة الأكبر من حيث عدد الناطقين بالهوسا، لم تُقدم بعد على خطوة مماثلة، ما يجعل من النيجر أول دولة في العالم تعترف بهذه اللغة رسميًا في دستورها، بعد قرون من التهميش والتغريب. في النهاية، يُعد قرار النيجر ترجمةً عملية لمبدأ السيادة الثقافية واللغوية، ورسالة مفادها أن أفريقيا قادرة على النهوض بلغاتها الأم، واستعادة صوتها في وجه نظم الهيمنة الثقافية. وقد تكون النيجر بهذا القرار قد أطلقت شرارة لثورة لغوية كامنة في عمق القارة.