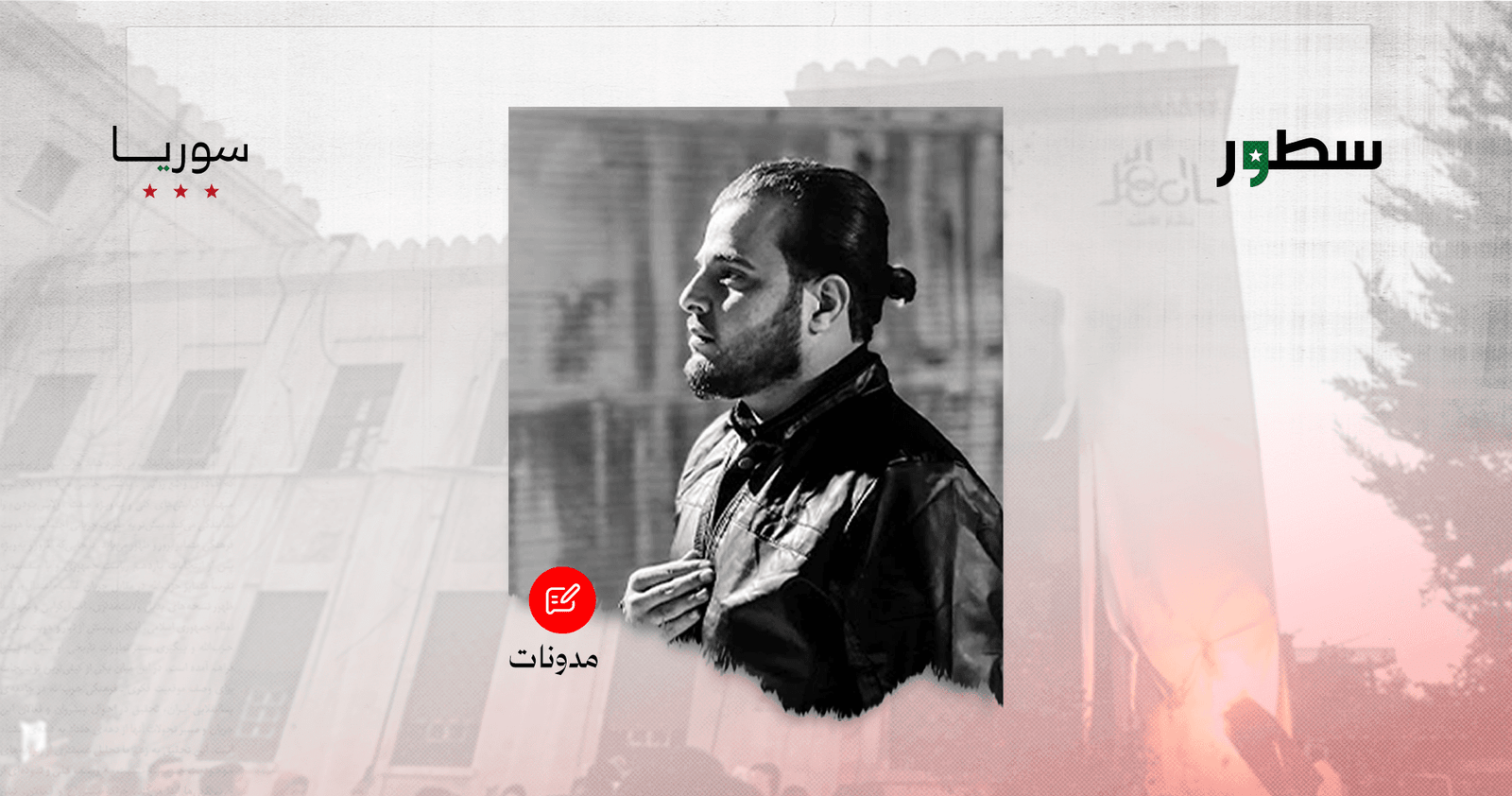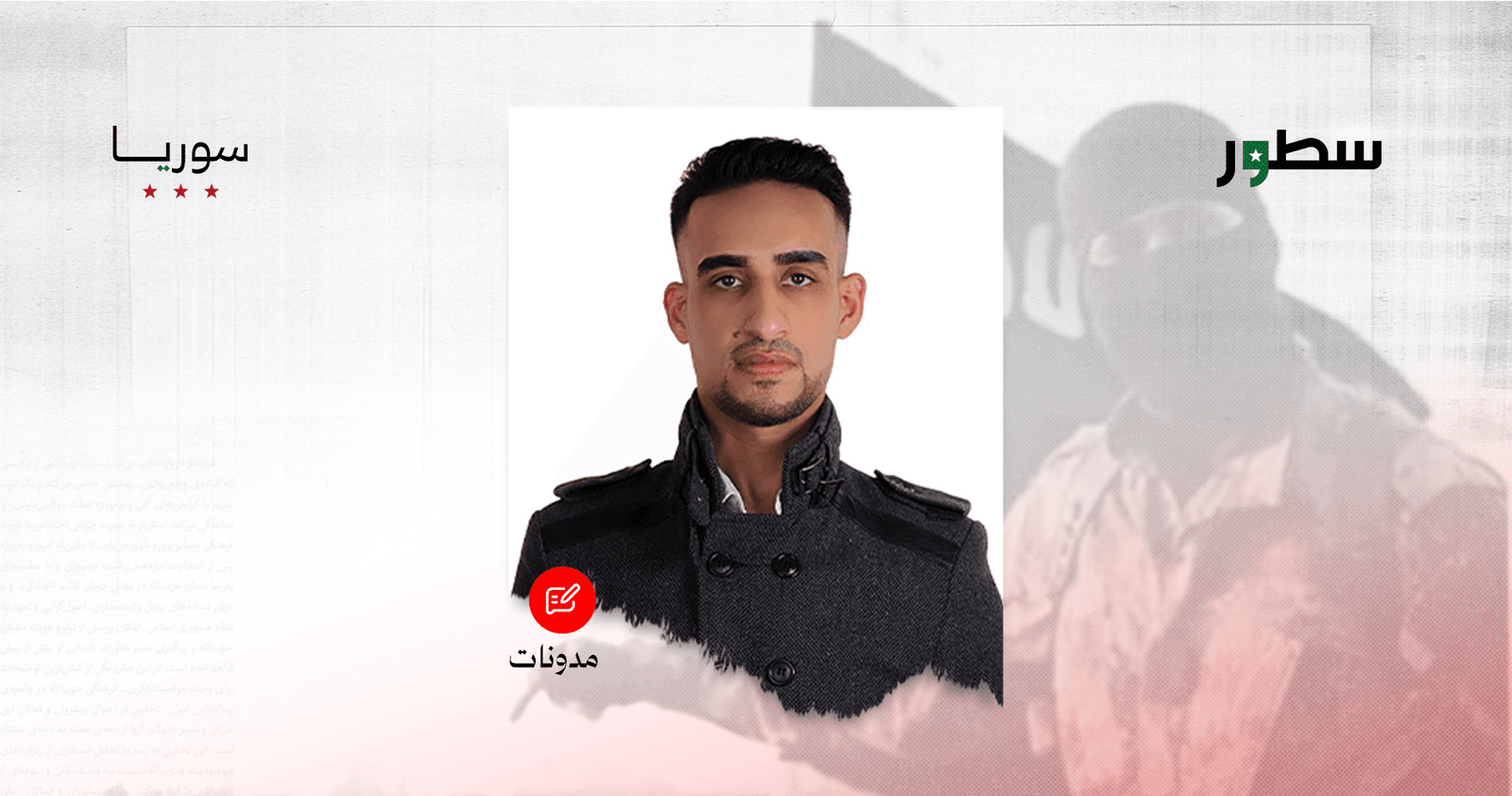مقالات سوريا
“سوريٌّ مقتولاً” و”سنيٌّ قاتلاً”: عن بنى تعمية سياسية في سوريا
“سوريٌّ مقتولاً” و”سنيٌّ قاتلاً”: عن بنى تعمية سياسية في سوريا
زيد محمد
بعد التمرد الذي شنته نواة الدولة الأسدية المكسورة والمهزومة، والتي خلعت ثوبها الرسمي وانحلت في البيئات الأهلية السورية، فيما انحل جل نواتها في البيئة الأهلية العلوية، طفى على السطح نقاش يتعلق بالعنف الهوياتي، وهو العنف الذي يستهدف إنسانا ما بناء على طبيعته، بعكس العنف السياسي الذي يستهدف الإنسان بناء على فعله. النقاش، بطبيعة الحال، ليس طارئا على القضية السورية، لا خلال سني الثورة ولا خلال ٥٤ عاما من الحكم السلالي الأسدي، ويدرج أن يعود إلى الواجهة بين الحين والآخر بتشنج مفهوم الجذور؛ خاصة إذا أُخذ بعين الاعتبار تجذر الطائفية في النواة الأمنية-العسكرية الأسدية، وما أنتجت من أجهزة تطييف للفضاء العام، وما أطلقت من آليات عنف وتمييز طائفي لم تلبث إلا أن تحولت لفوقية وإخضاع سياسي وهوياتي على أهبة الاستعداد لارتكاب المذبحة، وصارت وحربي إبادة مكتملتي الأركان تفجرت إحداهما في نهاية العقد الأسدي الأول والثانية إبان انطلاق الثورة السورية.
ثلاث بنى تَعْمَويَّة
تعرضت حرب الإبادة التي شنت على “العرب-السنة” في سوريا لإنكار ممنهج يمكن القول بمروره تحت ثلاثة عناوين رئيسية: خطاب الحرب على الإرهاب، وخطاب التلاحم الوطني السطحي، والخطاب الصوابي للمنظمات غير الحكومية (NGOs). من نافل القول إن ما يتقدم ليس حصرا للأسباب، بل تبيانا لأطر رئيسية ساهمت في التعمية وتعميم الإنكار، والتي لا تندرج من حيث الأصل والجذر ضمن أدوات الدولة الأسدية أو روسيا أو إيران وإن تقاطعت معها.
أولا، الحرب على الإرهاب. شنت الإمبراطورية الغربية، بمركزها في واشنطن، ما سمته بالحرب على الإرهاب مطلع الألفية الراهنة. الإرهابي، في هذه السردية التي تحركت وراءها الأساطيل، هم العرب السنة على وجه العموم والجهاديين منهم على وجه الخصوص. أتت هذه الحرب لتبني على الإرث الكولونيالي الغربي وما يتولد عنه من عنصرية ضد العرب من جهة، والغزو الإستيطاني-الإحلالي في فلسطين، حيث يشكل كيان إسرائيل رأس حربة الغرب في أرض العرب، من جهة أخرى. تعاونت جل الأنظمة الرسمية العربية، بشكل وثيق ومباشر، مع السيد الأمريكي منتظمة في صفوف حربه على الإرهاب، ولم يكن نظام الأسد استثناء في هذا الصدد؛ ومع اندلاع الثورة السورية أعلن الأسد بدوره الحرب على الإرهاب في سوريا. والحال أن هذه الحرب لم تقرأ في مجمل المستويات كحرب لها بعد إبادة هوياتية لأنها شُنت من المركز الإمبراطوري الغربي الذي شكَّل النظام الدولي ويتحكم بمفاصل المؤسسات “الدولية” ويهيمن بشدة على فضاءاتها كما يمتلك أدواته من مؤسسات قضائية وتعليمية وإعلامية وبحثية بالغة السطوة والسيط وغير ذلك، وبالتبعية فإن هذه المؤسسات ستلتزم بإنكار البعد الإبادي الهوياتي لهذه الحرب وكل الحروب المنضوية تحت لوائها، كحرب بشار الأسد على الإرهاب؛ والتي “أُتبعت” بحرب إبادة أمريكية-روسية-إيرانية على ذات الإرهاب.
ثانيا، التلاحم الوطني السطحي. إذا كان تطييف المجتمع السوري هو إحدى الركائز الأساسية لاستدامة الدولة الأسدية، فالوجه الآخر لهذه الاستدامة هي إنكار البنية الطائفية والتطييفية للدولة الأسدية من جهة والتوتر الطائفي الاجتماعي الناتج عنها من جهة أخرى. وبين التطييف وإنكار البنية الطائفية، ولد أو تعزز تناول سوري ثقافي وسياسي يقفز فوق الأسئلة المتعلقة بالطائفية في سوريا، وبمعزل عما إذا كان القفز إنكارا عن قناعة أو نتاج رثاثة أدوات تفكيرية أو مجاملات اجتماعية ونخبوية أو هروبا من أعين المخابرات أو غيره، فقط أعيد إنتاجه في المجتمع وأوساطه الثقافية وما يتولد عنه من عمل سياسي كقناعة راسخة. وهذه القناعة أعادت إنتاج نفسها ضمن قطاعات، اتسعت أو انحسرت على اختلاف المرحلة، بين الثوار. وليس أدل عليها حالة إصرار غير هين على أن الدولة الأسدية تتعمد بث مقاطع التعذيب والإذلال للضحايا العرب-السنة، وذلك لإشعال “الصراع الطائفي” و”الحرب الأهلية”، وليس في كل ذلك إلا نفي للبنية الطائفية والتطييفية للدولة الأسدية؛ وهو صوت لم يخفت رغم وجود كل الدلائل التي تشير لعكس ذلك.
ثالثا، المنظمات غير الحكومية (NGOs). مع انطلاق الثورة السورية بدأ الثوار بمحاولات لتجميع بعضهم البعض في تنسيقيات سرية -بطبيعة الحال- تهدف إلى العمل على إسقاط النظام. ومع التحولات الجذرية التي طرأت على المشهد السوري وتبلور الصراع، بدأت قطاعات من هذه التجمعات بالانشغال بالعمل الإغاثي والخدمي والحقوقي وغيره، فيما ولدت مجموعات أخرى ذات طابع شبيه في تلك المرحلة. فقد قسم من هذه التجمعات استقلاليته في وضع رؤاه وبرامجه، قبل أن تتم عملية لا يتسع المجال لشرحها حولت عموم هذه التجمعات لمؤسسات وظيفية في قطيعة مع المجتمع السوري وسياقه؛ فصارت مؤسسات تخدم برامج الممولين الغربيين بعمومهم، في مختلف طيف العمل المدني، كالعمل التعليمي أو الخدمي أو الحقوقي أو الإعلامي الخ. أدت هذه البنية إلى هيمنة الخطاب الذي يدور في الفلك الأمريكي خصوصا والغربي عموما على فضاءات العمل المدني المنظماتي السوري، والتي تتقاطع في المفاصل مع خطاب الحرب على الإرهاب حاملة مفاعيله.
ساهمت البنى آنفة الذكر بشكل فعال، في فضاءات العمل الإعلامي والحقوقي والثقافي وغيرها، بالتعمية عن الوجه الهوياتي لحرب الإبادة التي شنتها الدولة الأسدية في سوريا وإنكارها المفصلي.
العربي السني: بين سوري مقتول أو سني قاتل
لم تكد الأنباء تتوارد عن حدوث تمرد في الساحل وإعلان النفير العام لمواجهته حتى تضافرت أقاويل مؤسسات ومنظمات إعلامية وحقوقية مناهضة للدولة الأسدية على تصوير ما يحدث في الساحل على أنه حملة إبادة تشنها مجموعات مسلحة سنية ضد العلويين في الساحل. وبمعزل عن الغوص في تحليل وتفكيك ما حدث، وأخذا بعين الاعتبار وقوع جرائم بحق أبرياء في الساحل، وهو ما ساهم بإصدار أمر من القيادة السورية بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، فإن هذه اللغة وهذا المنظار، تسمية ضحية ومعتدٍ بمنبتهما الاجتماعي، قد غُيِّبت بشكل مفصلي وواسع من ذات الشخصيات والمؤسسات عن تناول حرب الإبادة الأسدية بمرتكبيها وضحاياها.
ما هو السياق الذي غُيب بشكل مستمر؟ باقتضاب، فقد استبيحت نساء سوريا من البيئات الاجتماعية العربية السنية استباحة تحمل هوية علوية وشيعية، سلخت جلود رجال هذه البيئات، دمرت قراهم ومدنهم، هجروا، دنست مجالسهم، واستهدفت هويتهم. حدث ذلك بإطار استئصالي هوياتي؛ “أجنبي”، أي أنه لا يرتبط بالآخر ولو كان جاره، وإبادي، فيما “يفيض” عما “يكفي” من الإبادة لـ”إخضاع الآخر”. حدث ذلك ضمن ما يكفي من التأسيس الفكري لارتكاب القتل المرتاح من أي سؤال للضمير؛ وعادي، إذ أنه يستطيع العيش حياة يومية عادية، يقتل ويشرب عصيرا باردا، يغتصب ويستمتع بالموسيقى. وفي البيئتين الاجتماعيتين، الشيعية والعلوية، غالبية بين من تورط ودعم واحتفى وسرق واستفاد وتستر وأنكر ولم يكترث وغيره.
باختزال ضروري، فإن الصورة التي رسمتها الشخصيات والمؤسسات الواقعة في الفضاء المذكور على النحو التالي: حين يُقتل المسيحي يقال إن مسيحياً قتل لأنه مسيحي، وحين يقتل كردي يقال إن كردياً قتل لأنه كردي، وحين يقتل علوي يقال إن علوياً قتل لأنه علوي، أما حين يقتل عربي-سني فيقال إن سورياً قتل لسبب سياسي.
هذا مسلك غير كريم وتزييفي. هذا مسلك قوى طائفية، وتطييفية.
أوركسترا الجذور
يستدعي النظر في مسألة الإنكار التفكير: كيف تضافرت بنى فاعلة محلية وإقليمية ودولية في إطلاق ديناميات متناغمة في تشكيل فضاءات رسم الصورة، على الرغم مما يبدو بين الفاعلين في هذه البنى من تباين وتفاوت واختلاف وتنازع وتناقض؟ يقترح كاتب هذه السطور سن اصطلاح “أوركسترا الجذور”: فالتشارك في الجذور لا بد أن يطلق ديناميات مشتركة للفاعلين بمعزل عما يبدو على السطح من تناقض؛ وهذا فيه من تضافر ما يتولد عن جذور الفاعلين أكثر بكثير من تنسيق الفاعلين أنفسهم، بل إن الثاني هامشي في وجود الأول. فمن وجد نفسه دون عمد بين الفاعلين وجب عليه سؤال نفسه عن جذوره ومسائلتها؛ كيف حدث هذا؟ وكيف يُقطع معه؟
لا بد للعدالة من يد تضرب بالسيف وأخرى تكتب بالحقيقة. وهذا لازم لذاته. وهو، من باب آخر، لا يضمن سلامة سوريا، لكن لا سلامة لسوريا دونه.