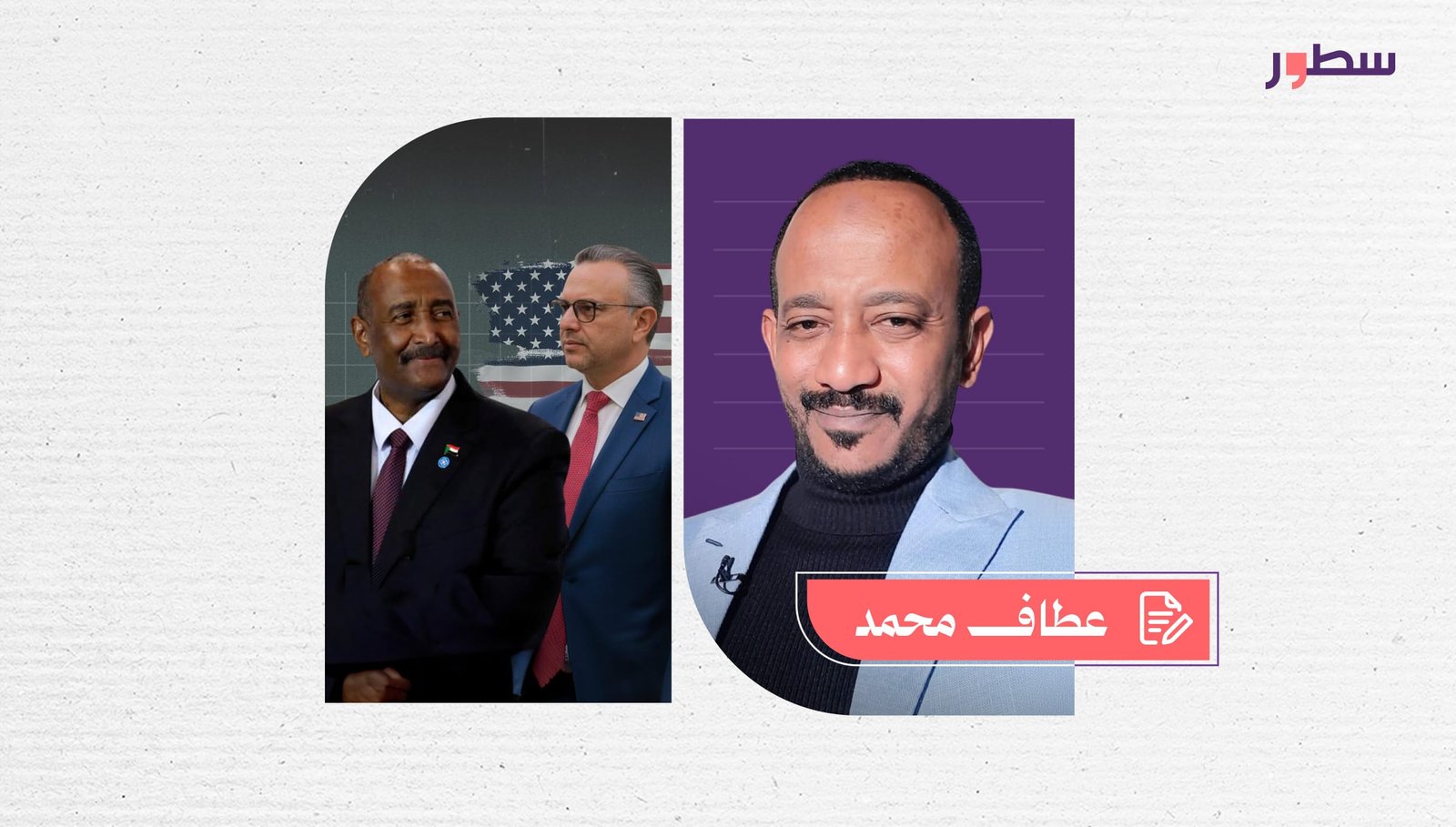سياسة
الرأسمالية الوطنية: أين أخطأ وأصاب طلعت حرب؟ (٣) الانحيازات الطبقية
الرأسمالية الوطنية: أين أخطأ وأصاب طلعت حرب؟ (٣) الانحيازات الطبقية
لمن يبقى فائض القيمة؟ لمن يذهب ما يحققه الاستثمار من ربح؟ الفارق بين ميزان المدفوعات والإيرادات؟ الربح الصافي – هل يذهب كله لصاحب رأس المال؟ من ثم تتضاعف ثروته من صافي الربح أو بالأحرى من فائض القيمة؟ هل للعامل والموظف في هذا المشروع جزٌء ولو ضئيل من رأس المال؟ بالتالي من فائض القيمة؟ وهل هؤلاء العمال ممثلون في مجالس الإدارة أو في نسب الأسهم أو المجالس التنفيذية أو ممثلين بنقابة تؤثر في قرارات أي من تلك المجالس والإدارات؟ هل للمواطن الحق في قبول أو رفض – ممثلا في نوابه مثلا أو نقاباته أو حزبه السياسي أو أي كيانات معبرة أخرى – أوجه صرف الموازنة العامة؟ أو في ترتيب أولويات الموافقة على ذلك المشروع على حساب آخر؟
لو جاءت الإجابة بلا على كل ما سبق فالمشروع أو المؤسسة أو الدولة رأسمالية طبقية..
مقدمةٌ مؤلمةٌ لكني أعلم أننا ولو لم نَبُحْ، فكل حضورٍ لنا في مصر بات إدراكا مكتملا لحقيقة أننا مواطنون كالضيوف غيرِ المرحب بهم، أو أننا أتينا في وقت غير مناسب. في المقال السابق أشرت إلى المنافسة المجحفة بحق القطاع العام مع الخاص على نفس الموارد إذا جاءت من الموازنة العامة؛ أولا لأنهما لا يخضعان لنفس الشرائح الضريبية بسبب تسهيلات مقدمة لجذب الاستثمار خصوصا الأجنبي، وأقساها وهي الأكثر شيوعا ”العمالة الرخيصة“. مهنيا سأكتب العمالة منخفضة الأجر. إنتاج القطاع العام يقدم للشعب إما سلعا أو خدمات مدعمة بموارد من الموازنة العامة. أما المشروعات الاستثمارية أو الخدمية العملاقة فتوفر الخدمات أو السلع (السياحة – الترفيه – الخدمات التسويقية – العقارات – التجمعات السكنية المسماة ”الفقاعة“ للطبقة فوق المتوسطة).
هذا الفارق الذي اتسع شيئا فشيئا مع بداية عصر الانفتاح مرورا بسياسة خصخصة القطاع العام وحتى اللحظة شديدة السوء الآن لتفريط من لا يملك لمن لا يستحق؛ ممتلكات الدولة والشعب التي تباع للإمارات تحت رايات التطبيع دون مناقصات، لأنها خرجت بالتأكيد عن بيروقراطية الدولة المصرية بمعناها المفهوم، بحجة ”تشجيع الاستثمار“ و ”التنمية“ بينما لا نرى مشروعا على قنوات البروباجندا الرسمية يروج للتنمية المستدامة أو استيعاب خريجي الجامعات الحكومية أو لاستعانة بالخبراء من أبناء الطبقة الكادحة أو حتى التعامل بأقل خشونة مع أي بادئة لإضراب من أي كوادر عمالية في مواقع حساسة بين القطاعين العام والخاص عالقة منذ بدء تصفية مصانع وشركات القطاع العام، ومراكمة فائض القيمة مثل وبريات سمنود أو أسمنت الإسكندرية أو الغزل والنسج بالمحلة الكبرى، وقد كانت بصيص النور الذي مهد لسنوات لانتفاضة ٢٥ يناير ٢٠١١.
ثلاث إضرابات مهدت لانتفاضة يناير
في كتابه ”عمال على طريق يناير“ يشير الأستاذ الصحفي هشام فؤاد إلى ثلاث حركات نضالية للعمال المصريين في شركات أسسها رأس المال الوطني بالمعنيين الحرفي والرمزي، مهدت الطريق للخامس والعشرين من يناير؛ الأولى عمال المحلة الكبرى للغزل والنسج من أجل أجر عادل (قطاع عام)، الثانية كانت نضال موظفي الضرائب العقارية من أجل تأسيس نقابة مستقلة في معركة مريرة لمحاولة النقابات استعادة مكاسبها الضئيلة لاسترداد نقابات فاعلة أمام البيروقراطية الإدارية الباتة في الحدود الدنيا والقصوى للأجور، وأخيرا نضال عمال طنطا للكتان ضد السياسيات الليبرالية الجديدة، والتي انتهت بالمطالبة القضائية بالعودة تحت مظلة شركات القطاع العام.
اخترت هذه النماذج للأستاذ هشام فؤاد أولا لأنها خير دليل على ما أحاول تأطيره في هذا المقال، أسباب تأزم رأس المال الوطني المصري (قطاع عام أو خاص استثماري أو أجنبي) مع العمال، سواء العمالة المنتظمة أو تلك غير المنتظمة التي قد تعمل باليومية من دون أي حقوق. دورة رأس المال الوطني يُفترض أن تعود بالربح على رأس المال والخدمات للمواطن أو بالتنمية المستدامة التي يستفيد منها المواطن و الدولة معا في دورة رأس المال التالية أو ما بعدها وهكذا.
إفقار منهجي للطبقات الكادحة
في الوضع الراهن الاحتكار للمؤسسة العسكرية وشركائها غير المصريين تسبب في التالي: ١. خلق احتكارا كبيرا بالتأكيد يخلق احتكارات صغيرة تخدم موارده ومشروعاته التي ينفرد بها في دولة بحجم مصر. ٢. أضعف القوة الشرائية لضعف العملة المحلية وغياب التنافس بسبب احتكار جهة وحيدة بالاستثمار (خاصة في ظل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وحلفائها المطبعين الناجح من عام ونيف). ٣. أضعف العملات المحلية وقد يحرر سعر الصرف تماما (تعويم كامل) سيقضي تقريبا على القدرة الشرائية للاحتياجات الأولية للمواطن وسيذهب بصراع الطبقات إلى سياسة حافة الهاوية. ٤. إضعاف التنمية المحلية وإفقار متعمد للطبقات الكادحة لتشجيع استثمار جديد. كل ذلك يرسم طريقا رأيناه كثيرا للأسف يفضي إلى نموذج ”دولة غنية بشعب فقير جدا“. كل ذلك طبعا يعود بالصراع الطبقي الحتمي إلى الإمبريالية الأمريكية وهيمنتها وحلفائها في المنطقة والحرب الباردة المتهيئة على ذلك، خاصة مع إعادة ترتيب الشرق الأوسط الآن سياسيا وعسكريا.
هل كان طلعت باشا حرب رأسماليا طبقيا؟
افتتح طلعت حرب بنك مصر سنة ١٩٢٠ برؤوس أموال مصرية. أن يحدث ذلك بنية استقلال المصريين بمشروعات تمول من الأعيان والوجهاء ورجال الصناعة تحت ظل الاحتلال البريطاني الثقيل شيء رائع في حد ذاته. العثرة كانت في تأثير رؤوس الأموال الأجنبية في البورصة المصرية وهيمنة المستعمر البريطاني على بورصة وصناعة القطن التي كانت مصر فيها الرقم الأوحد في جودته لعشرات السنوات تصل للمئتين. حرب كان يهدف حرب فيها لتحقيق استقلال اقتصادي كامل.
السؤال هل يتم ذلك برأس مال وطني صرف حتى تحت الاحتلال بأياد عاملة مصرية؟ بأي نية؟ رفعة العامل المصري أم إرجاء ترقيته لأولوية حساب رأس المال والمشروع؟
كتب مصطفى بسيوني عما سماه ”الوجه الآخر للرأسمالية الوطنية.. طلعت حرب والعمال“ في كتاب ماذا جرى لمشروع طلعت حرب؟ اتخذ الزميل الباحث دراسة حالة هي تجربة شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى لكونها إحدى كبريات إنجازات حرب وأزيد أنها إحدى أقوى الريادات النقابية والاحتجاجية في مصر في زمن حرب وفيما بعد. أظن أن الأذى طال عمال المحلة للغزل والنسج لسببين أحدهما لا علاقة له بطلعت حرب. أولهما وهو ما أتفق فيه مع الزميل الأستاذ مصطفى بسيوني، النمط الذي تخلقه الرأسماليات الكبرى بحكم التركيبة بابتلاع الحرف الصغيرة وحاضناتها الاجتماعية بداية ثم ”نشأة مجتمعات تقوم على نمط جديد من العلاقات الاجتماعية تتمحور حول العمل المأجور لسكان هذه المجتمعات مع الرأسمالية الكبيرة”.
اللافت أن التكتلات العمالية ومطالباتها بحقوقها نشأت قبل مشروع حرب بحوالي خمس وعشرين سنة أو أكثر قبل نهاية القرن التاسع عشر، لكنها كانت تقاوم رأسمالية المحتل خاصة في صناعة القطن والسجائر وقصب السكر في وجهي بحري وقبلي في مصر، أو ضد اضطهاد الطبقة التي لم تكن أقل سوءا من إنكار حقوق العامل كشريك في فائض القيمة أو حتى يُعترف له بأي حقوق لا نقول حتى امتيازات. المعضلة كانت في مشروع يُنشأ أساسا لكسر نمطية الهيمنة المستعمرة لكن بنفس الطبقة المخملية التي لا ترى العامل، ولم يثبت لنا أن خطط طلعت حرب كان من بينها تمييز العامل أو أن حقوقه كانت جزءا من المشروع الوطني.
لذا أجد أن مشروع الرأسمالية الوطنية لم يتخلص من متلازمة الثروة وتهميش الطبقات الكادحة، من ثم لربما كان أمينا في تسمية نفسه بالرأسمالية الوطنية. الشاهد: عدد النقابات العمالية كما رصد مصطفى بسيوني في عام افتتاح بنك مصر ١٩٢٠ ثلاثٌ وأربعون نقابة، ١٩ منها في الإسكندرية، وستٌ في الأقاليم.
الغزل والنسج بالمحلة والرأسمالية الوطنية
أبدى طلعت باشا حرب في خطبه إعجابه بمدينة المحلة الكبرى كقلعة صناعية يمكن الانطلاق منها تأسيسا للمشروع الصناعي برؤوس الأموال المصرية، رصد الباحث مصطفى بسيوني في خطابات طلعت حرب أن عديد العمال في المحلة آنذاك بلغ ١٠٤٥٨ عاملا، من بينهم ٣١٦٧ أي ٣١٪ عامل نسج. كما رصد برنامج لجنة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية وهي التمثيل الرسمي لمشروع طلعت حرب على أرض الواقع بخلاف بنك مصر. السبب في الترحيب بالبدء بالمحلة غير وافر الإنتاج وجودة المنتج (القطن) بل اعتباره فائق الجودة على الرغم من احتكار بريطانيا تقريبا وعدد من كبار رجال الصناعة آنذاك لبورصته كان بوضوح ”العمالة الرخيصة“؛ هكذا بلا مواربة.
فكانت البداية شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة، وعلى الرغم من استبسال النقابات الناشئة في تحسين أوضاع العمال، تخلفت شركة مصر للغزل والنسج عن أي مكتسبات لعمالها والحجة كانت حاضرة دوما: المشروع الوطني قبل كل شيء. الأجر، وهو أبسط الحقوق الأصيلة للعامل كان أقل من معظم شركات النسج الأخرى ولربما رأى فيه عمال الشركة ومعظمهم من الأرياف القريبة من مدينة المحلة الكبرى انتظاما واستقرارا لعملهم يغنيهم عن الاستبداد الكامل من قبل رؤوس الأموال الأخرى، خصوصا مع بلوغ الحركة الوطنية ضد الاستعمار أوجها في هذه الفترة ودور الحركة العمالية الأصيل في القضية الوطنية المصرية في كل الحقب.
أنهي هذا المقال بإضرابين نجحا في ظل مشروع الرأسمالية الوطنية ضمن نضالات كثيرة رصدها مصطفى بسيوني. إضراب عام ١٩٣٨ احتجاجا على طول نوبة العمل التي دفعت العمال للنزول قبل مطلع الفجر والعودة بعد العشاء وكان شعارها ”عايزين نشوف الشمس“ ونجح الإضراب فعلا في تخفيض ساعات العمل إلى عشر ساعات يوميا وإلزام كل عامل بماكينتين فقط بدلا من أربع ماكينات! والثاني كان إضراب ١٩٤٧ في شركة مصر للغزل والنسج نواة مشروع الرأسمالية الوطنية الصناعية، وكان احتجاجا على انخفاض الأجر عن سوق العمل بعد محاولات كثيرة للإضراب والنجاح في ارتفاعات ضئيلة جدا في الأجر وتعويض ”الرأسمالية الوطنية“ في مقابل ذلك بزيادة لا معقولة في ساعات العمل. المؤسف في هذا الإضراب أنه هوجم بقوة ضخمة من الأمن وجرى فضه بالقوة. قٌتل في فض الإضراب بالعنف أربعة عمال وإصابة ٢٧٠ واعتقال ٦٠ من بينهم ٣٧ عاملا والبقية من أهالي الحي!
أخيرا أرى أن محاولة دولة يوليو بعد تدشين بنك مصر سنة ١٩٢٠ بأكثر من ثلاثين سنة وأكثر لم تكسب الكثير من مغازلتها للمشروع أو محاولة التقرب منه لأن أدبياته وأدبيات دولة يوليو متنافرة وجوبا إلا ربما في الحس الوطني بخلق مشروع صناعي وتحقيق استقلال ذاتي عن المحتل والإمبريالية. البعض سيقول إن ذلك مهم جدا ولب المسألة. صحيح ولكن ينبغي أن نسأل لماذا تلجأ دولة يوليو التي كانت ملئ السماء والأرض لمحاولة التقرب (بالاسم حتى) لمشروع طلعت حرب؟ السؤال تقريري بالمناسبة. دولة يوليو نجحت نجاحا كاسحا في مخاطبة الطبقات الكادحة، لكن دولة يوليو أعدمت في أيامها الأول عاملين أقدما على الإضراب.
أرد حضراتكم إلى أصل المسألة والخط الرابط بين المقالات الثلاث – الرأسمالية الوطنية: فخ النقد والوقوع تحت براثن الاستدانة، ثم أولويات المشروع وأين منها التنمية التي ترتقي بالمواطن صاحب رأس المال أو المشارك فيه بالموازنة العامة، وأخيرا كيف تتعامل الرأسمالية الوطنية من شريكها الرئيسي؛ العمال؛ ولمن يذهب فائض القيمة وحقوق اجتماعية لم تكن أبدا منة أو فضلا.