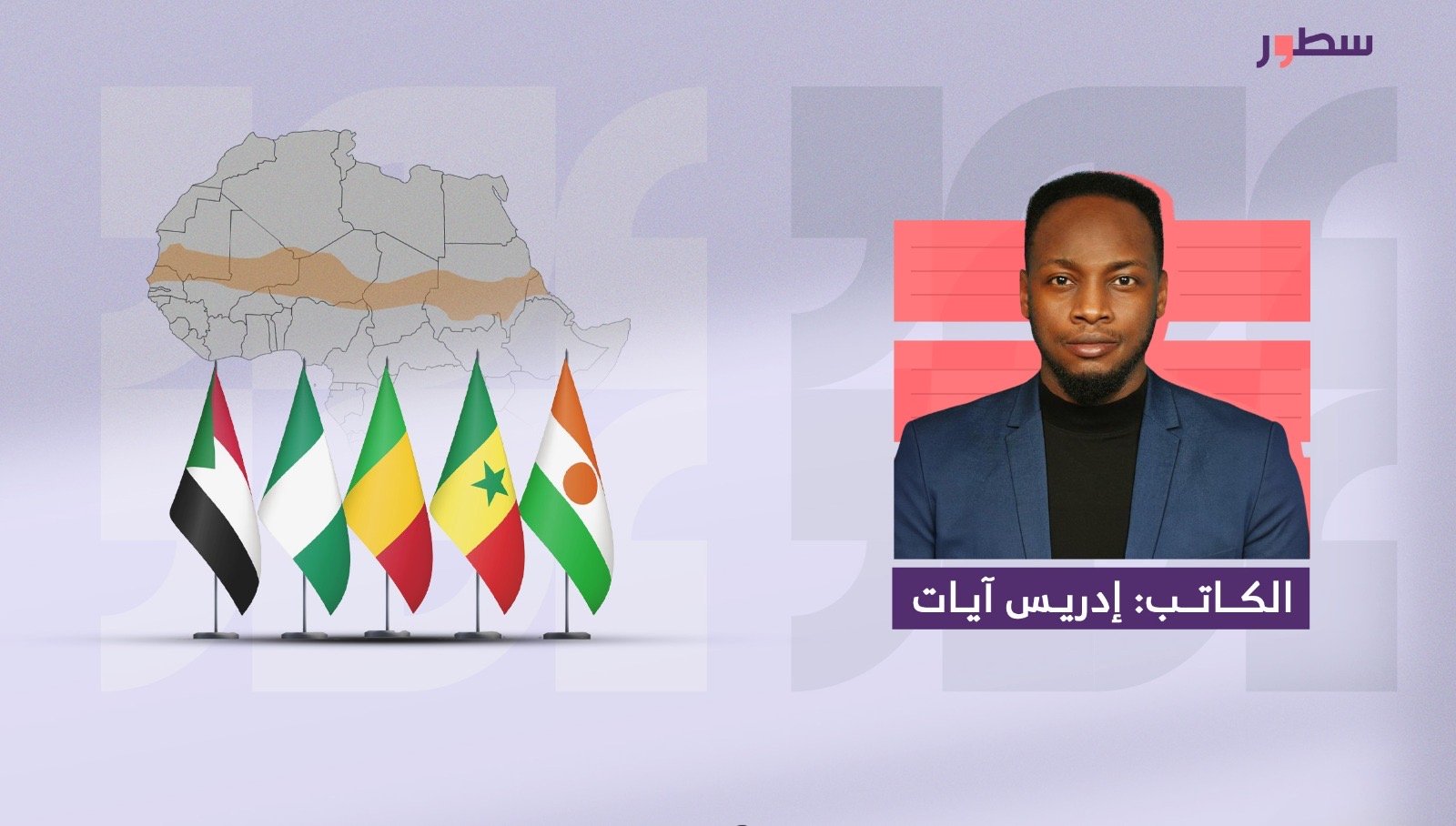سياسة
القمة الصينية الأفريقية: لماذا نجحت السعودية وأخفقت القيادة الأفريقية؟
القمة الصينية الأفريقية: لماذا نجحت السعودية وأخفقت القيادة الأفريقية؟
تنطلق اليوم، الأربعاء، فعاليات القمة الصينية الأفريقية التي تستمر من الرابع حتى السادس من سبتمبر. في هذا السياق، كشف تحليل حديث أجراه مركز سياسات التنمية العالمية في جامعة بوسطن أن حجم القروض التي منحتها الصين للحكومات الأفريقية بلغ 4.61 مليار دولار في عام 2023. هذا الرقم، على الرغم من تحسنه مقارنةً بالعام السابق، يظل متواضعًا بالنظر إلى الذروة التي بلغتها الاستثمارات الصينية في العام 2016 بقيمة 28 مليار دولار.
يطرح هذا التراجع سؤالاً حاسمًا: لماذا خفّتْ الصين من حماسها تجاه أفريقيا؟ ومن جانب آخر، أبرزت بيانات جديدة لعام 2024 نشاطًا استثماريًا ملفتًا من الجانب السعودي مع الصين، حيث وقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي ست مذكرات تفاهم بقيمة تصل إلى 187.5 مليار ريال (50 مليار دولار) مع عدد من المؤسسات المالية الصينية الكبرى بما في ذلك البنك الزراعي الصيني (ABC)، بنك الصين (BoC)، بنك التعمير الصيني (CCB)، شركة الصين لتأمين الصادرات والائتمان (SINOSURE)، بنك التصدير والاستيراد الصيني (CEXIM)، والبنك الصناعي والتجاري الصيني (ICBC). هذا التحرك السعودي الكبير يعكس استراتيجية استثمارية ذكية قد تقدم دروسًا قيمة لأفريقيا.
وبالعودة إلى القمة الصينية الأفريقية، يظل السؤال المحوري: هل يمكن لأفريقيا أن تحذو حذو السعودية في استقطاب استثمارات صينية جديدة؟ بدايةً، هذه المقالة جزء من سلسلة تبحث في الأخطاء الاستراتيجية التي يرتكبها القادة الأفارقة، وهي أخطاء إن لم يتم تداركها بحكمة وبصيرة ستُعيق فرص القارة لعقودٍ عامًا قادمة.
إحدى المشكلات الجوهرية التي تعترض عمق العلاقات بين الصين وأفريقيا تكمن في نظرة المثقفين والساسة الأفارقة، التي غالبًا ما تُشوه بمفاهيم مستوردة من الغرب، ويُسارعون إلى التماهي مع تصورات “السيد الأبيض” دون تمحيص أو تساؤل حول ما إذا كانت هذه التصورات تخدم مصالحهم أم تعمل ضدها. يتخذ هؤلاء الساسيون من العدسات الغربية منطلقًا لهم، وتُغذى بشكل كبير من الدعاية الغربية، التي تنشغل ببث روايات تعزز من النزعة العنصرية ضد الصين. ومن هنا، يبرز تحديًا كبيرًا يواجه القادة الأفارقة: الحاجة إلى تطوير استقلالية فكرية تسمح لهم برسم مساراتهم التنموية بناءً على واقعهم ومصالحهم الخاصة.
مع ضرورة التنويه، أن هذه السلسلة من المقالات لا تروم تبييض صفحة الصين أو تصويرها كمنارة للخير مقابل الدول الغربية، فالمعادلات الدولية لا تخضع لتقسيم بسيط بين الخير والشر. بدلاً من ذلك، تهدف المقالة إلى استعراض المشهد من منظور جيو-اقتصادي، مُظهرين كيف تتبع الدول استراتيجيات تهدف إلى تعظيم منافعها الاقتصادية في العلاقات الدولية، متجاهلةً الأحكام التي قد يصدرها الآخرون عنها. فالدول لا تُقيّم علاقاتها الخارجية من خلال النظارة الأخلاقية بقدر ما تُركز على المصالح والفرص. هذه النظرة الواقعية، التي تتجاوز العواطف والمثاليات، تُمكّن الدول من نسج شبكات تعاون تحتكم للمنطق الاقتصادي والاستراتيجي، بعيداً عن العبارات المنمقة والشعارات الرنانة.
في القرن الماضي، بينما كانت الدول الغربية تصف أفريقيا بقارة “ميؤوس منها”، انفتحت الصين نحوها برؤية استراتيجية اقتصادية تتمثل بتوفير بنية تحتية لها في كافة المجالات بما تفيد مشاريع الصين والدول الأفريقية، وفي الوقت الذي كان فيه الغرب يتوقع فشل الصين ويشكك في قدرتها على فهم تعقيدات القارة، كانت بكين تضع خطوات واثقة على أرض الواقع.
ومع مرور عقد من الزمان، ومع تحقيق الصين لإنجازات هائلة في بناء البنى التحتية عبر القارة الأفريقية، حيث برزت شبكات طرق متطورة، ومطارات على المستوى، واستثمارات قيمة في قطاعات الصحة والطاقة، سرعان ما غيرت الدول الغربية لهجتها. فقد بدأ الإعلام الغربي بترديد عبارات كـ”الاستعمار الصيني الجديد” و”فخ الديون الصينية”، مستهدفة بذلك النخب الأفريقية التي تفتقد إلى الحصانة الثقافية اللازمة للتنقل في الغابة العالمية القاسية.
وقبل أن نخوض في أعماق هذا التحليل الاقتصادي، يجدر بي التأكيد على أن مفهوم “فخ الديون الصينية” في أفريقيا لا يمثل واقعًا ملموسًا. ربما يبدو هذا الكلام صادمًا، لكني أعد بتقديم الأدلة التي تدعم هذا الطرح في المقالات القادمة. في هذا السياق تبرز كينيا كمثال بارز. هذه الدولة، التي يمجدها الغرب كإحدى معاقل الديمقراطية والتقدم في القارة الأفريقية، ما يغيب عن كثير من الأحاديث عنها هو كيف أسهمت الصين، في صياغة ملامح البنية التحتية الكينية المعاصرة، مستفيدةً بشكل كبير من التمويل الصيني. فالعلاقة بين كينيا والصين تعكس تعقيد العلاقات الدولية حيث شكلتْ الدعاية الغربية ضغطًا متزايدًا على كينيا لإعادة النظر في شراكاتها مع الصين.
مع تزامن انعقاد القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في بكين هذا العام، أصدرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية تقريرًا لها بعنوان: FOCAC: Ruto’s pro‑West policy faces test in Beijing as Kenya seeks to woo China.
الترجمة: منتدى التعاون الصيني الأفريقي: سياسة روتو المؤيدة للغرب تواجه اختبارًا في بكين وسط مساعي كينيا لجذب الصين. وفي مقدمة التقرير جاء ما يلي: مع انطلاق الدورة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) في بكين هذا الأربعاء، تظهر كينيا مترددة بين تبني سياسة “التوجه نحو الغرب” الجديدة والإبقاء على علاقة التعاون المستمرة منذ عقدين مع الصين. كينيا، التي طالما استفادت من علاقات اقتصادية متينة مع الصين بدأت منذ عام 2002، تواجه اليوم تغيرًا محوريًا في سياستها الخارجية مع تولي ويليام روتو الرئاسة في سبتمبر 2022، خلفًا لأوهورو كينياتا.
ما لم يذكره تقرير “جون أفريك” هو الحكاية الكاملة، وهنا سنسردها لكم!
تبدأ القصة، بينما كانت أجواء المنافسة الانتخابية تتوتر في كينيا مع خواتيم عام 2022، تبنى وليام روتو المرشح للرئاسة -وقتئذٍ- منهجًا هجوميًا، متعهدًا بإخراج ما وصفهم بـ”اللادينيين الصينيين” من كينيا، لفتح الباب أمام حلفاء الغرب. وفي سبتمبر 2022، أدى السيد روتو، المولود في عام 1966، اليمين الدستورية كرئيس لكينيا، متوليًا الرئاسة في سن الخامسة والخمسين كخامس رئيس للبلاد منذ استقلالها في عام 1963.
ولأن حملته ركزت بشكل كبير على معاداة الوجود الصيني، تلا ذلك هجرة الصينيين ورؤوس أموالهم، مما أطلق العنان لأزمة اقتصادية حادة. وجد روتو نفسه، على إثر ذلك، مضطرًا للاستدانة من واشنطن بفائدة قدرها 7%، معدل أعلى بكثير من الـ2% التي كانت تعرضها الصين. ولم يكتف بذلك، بل لجأ أيضًا إلى صندوق النقد الدولي الذي فرض شروطًا قاسية، بما في ذلك رفع الضرائب على السلع والخدمات، مما أثار استياءً شعبيًا ملموسًا.
لتقدير الأحداث التي أعقبت نهاية العام 2022 بصورة موضوعية، يجب استعادة تقرير صادر عن وكالة فرانس برس يعود للثاني والعشرين من أغسطس/آب 2013، والذي نُشر تحت عنوان “بعد تجاهل الغرب، كينيا تلتفت نحو الصين”. في تلك الفترة، وجد الرئيس الكيني آنذاك، أوهورو كينياتا، الذي كان يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، نفسه مُهمَشًا من الغرب، مما دفعه لتعزيز العلاقات مع الشرق، لا سيما الصين، خلال أول زيارة دولية له بعد انتخابه في مارس من نفس العام.
في نهاية زيارته الملفتة إلى الصين، والتي جاءت في ظل التجاهل الغربي والضغوط الدولية، تلقى كينياتا دعمًا ماليًا قدره خمس مليارات دولار من الصين، وهو ما كان جزءًا من سعي كينيا لتحقيق رؤيتها التنموية لعام 2030. ولم تقتصر الشراكات الكينية الصينية على تطوير البنية التحتية فحسب، بل تعدتها إلى خطط لإنشاء غرفة مقاصة لليوان في نيروبي، رغبةً منها لتقليل اعتمادها المالي على الغرب، وبالأخص على بنك إنجلترا.
من الجدير بالذكر أن العقود الموقعة مع الصين كانت تحمل طابعًا سريًا، وتم تنظيمها كعقود مصرفية حكومية لا تظهر ضمن الديون الرسمية للبلاد، مما يجنبها التأثير على التصنيف الائتماني للدولة وشروط الاقتراض من هيئات مالية دولية مثل البنك وصندوق النقد الدوليَين.
في ظل هذه التحولات، وبعد تسع سنوات من تلك الزيارة، ركز وليام روتو، خلال حملته الانتخابية، التزامه بالكشف عن تفاصيل العقود المبرمة مع الصين، مشددًا على ضرورة التحقيق في أي خفايا محتملة قد تضر بمصالح كينيا. بينما الاتفاقيات، التي أُبرمت في ظروف استثنائية، كانت تهدف بالأساس إلى حماية السيادة الكينية في مواجهة ما يُمكن وصفه بالافتراس المالي الغربي، في وقت كانت فيه القيادات الكينية تواجه الهجوم الغربي.
ومع وصول روتو وانسحاب كينيا من تحالفها مع الصين ورحيل الشركات الصينية برؤوس أموالها، تحولت كينيا إلى بؤرة لأزمة اقتصادية حادة، إذ شهد الشلن الكيني انخفاضًا بنسبة 22% مقابل الدولار منذ عام 2022. ترتب على هذا ارتفاع حاد في أسعار السلع الغذائية والطاقة وتكاليف النقل، ما أدى إلى تفاقم صعوبات الحياة اليومية للمواطن الكيني العادي، في ظل تناقص ملحوظ في دخله.
وفي الخامس والعشرين من يونيو 2024، اندلعت احتجاجات عنيفة في أرجاء نيروبي رداً على مشروع قانون مالي لعام 2024 يهدف إلى جمع ضرائب إضافية تقدر بـ 2.7 مليار دولار للتخفيف من حدة العجز المالي الكبير الذي يستهلك 37% من الإيرادات السنوية في دفعات الفوائد فقط، في ظل ديون وطنية تبلغ 82 مليار دولار.
طالب المتظاهرون الكينيون الحكومة بالتراجع الكامل عن هذا المشروع المالي، معبرين عن مخاوفهم من أن الزيادات الضريبية ستزيد من معاناتهم، فيما شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة زيادة الإيرادات لخفض العجز. إلا أن النخبة السياسية الكينية أظهرت تصميمًا على تنفيذ توجيهات الصندوق، مما يضع عبء الديون الهائل على عاتق المواطنين.
أسفرت الاضطرابات -حينها- عن مقتل ما لا يقل عن خمسين شخصًا وإصابة المئات. وفي تطور مثير، اقتحم المتظاهرون البرلمان وأضرموا النار في جزء منه بعد أن وافق النواب على مشروع قانون التقشف، الذي كان بانتظار توقيع الرئيس ويليام روتو. وقد أدت الاحتجاجات إلى شل حركة النقل وإغلاق الشركات الكبرى في نيروبي ومدن رئيسية أخرى، حيث أصبح “روتو يجب أن يرحل” شعارًا مركزيًا في هتافات المحتجين، فيما عُرف بأسوأ أزمة في تاريخ البلاد الحديث.
واليوم، بينما تتعثر المؤسسات الغربية في تلبية تطلعات الاستثمار الكيني، يعود الرئيس وليام روتو إلى بكين في القمة الصينية الأفريقية، محاولاً إعادة الصين إلى الساحة الكينية، متجاهلاً جميع إهاناته السابقة للصين وتقاليدها، ما يشير إلى عمق الأزمة الفكرية والثقافية لدى القيادات الأفريقية التي تربت في أحضان المؤسسات الغربية ولم تطور الوعي اللازم لحماية مصالحها، منجرفًا وراء دعايات مضللة تتحدث عن “الاستعمار الصيني الجديد”.
يجدر بالسياسي أن يطرح الأسئلة التي يغفل عنها العامة. إذْ ما يحكم العالم اليوم ليس مبادئ الديمقراطية أو السياسة، بل هي الرأسمالية المالية، وهي الصورة الأخيرة للامبريالية. إذا كانت أفريقيا قد فاتها قطار الاستقلال الحقيقي ولا تزال ترزح تحت وطأة الفقر والتبعية، فإنها بأمس الحاجة إلى قادة جدد؛ أذكى، أكثر ثقافة وأقل عاطفية لمواجهة التحديات المعقدة.
عندما تقول أوروبا إن الصين تمثل استعمارًا جديدًا لأفريقيا، ينبغي أن يتساءل لماذا هذا الادعاء بالذات؟ إن الحد الأدنى من الذكاء كان سيقود إلى التساؤل هل الغرض هو التقليل من شأن أكبر مأساة في قارتنا: العبودية والاستعمار الغربيَيْن. إذْ من مصلحة الأوروبيين أن يقولوا إن الصين سوف تستعمر أفريقيا، وهذا يسمح لهم، على أقل تقدير، بالتقليل من شأن كل أعمال العنف وجرائمهم الاستعمارية ضد أفريقيا. إذا كان التوجه الصيني نحو أفريقيا “استعمارًا” فمن واجب الذاكرة أن نسأل أنفسنا ما إذا كانت الصين تستعد لقطع أذرع الأفارقة الذين لم يصلوا إلى حصة إنتاجية من الكاكاو أو القطن أو المطاط؟ كما دأب عليه الاستعمار الأوروبي.
وهل تستعد الصين لاستبدال اللغات الأفريقية بالصينية؟ وإجبار الزعماء الأفارقة على أن يصبحوا المروجين الرئيسيين للغة الصينية، كما أجبرتهم فرنسا على القيام بذلك من أجل الفرانكفونية؟ وهل تستعد الصين لاستبدال العملات الأفريقية بعُملاتها، كما هو الحال في المستعمرات الفرنسية؟ هذه التساؤلات هي ما ينبغي أن يشغل بال السياسيين الأفارقة بدلاً من الانسياق وراء الدعايات الغربية.
بينما ثمة أسئلة أساسية لا يطرحها أحدٌ مثلا: لماذا لا يستهدف الساسة الأفارقة، العقود التي تشمل 90% من التعدين في الكاميرون مع فرنسا التي تقدم فقط 8% من الإيرادات للكاميرون، بينما تقدم الصين 50%. كيف يُمكن تجاهل هذه الحقيقة وعدم استنكار الفوائد الهزيلة التي تقدمها فرنسا بينما تُعرض الصين كالشرير في المعادلة؟ إن النموذج الكيني هذا موجود في كل أقطار أفريقيا.
الخاتمة الجزئية: في ظل المشهد العالمي الراهن، حيث يبدو الغرب معتلًا بأزماته المالية وعاجزًا عن الاستجابة لاحتياجات الاستثمار في البلدان النامية، برزت دولة كالمملكة العربية السعودية كمثال للنضج الاقتصادي. تحت قيادات واعية، تمكنت من تحويل مسارها نحو الشركاء الأكثر فعالية في الاقتصاد العالمي، وفي هذا السياق، كانت الصين خيارًا استراتيجيًا لا مثيل له.
ففي تحدٍ صريح للضغوط الغربية، لم تخضع السعودية -في هذا الإطار بالتحديد- للإملاءات الخارجية بل ذهبت إلى حد التفاوض من موقع قوة في أسعار البترول إبان الأزمة، مؤكدةً على سيادتها الاقتصادية. ولعل انضمامها لمجموعة بريكس كان تأكيدًا على هذا المسار الجديد، حيث تجاهلت المملكة الدعاية الغربية المعادية للصين ورسخت علاقة متينة مع بكين تجلتْ في اتفاقيات تجارية تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.
إن السخرية من “فخ الديون الصينية” غابت تمامًا عندما تعلق الأمر بالسعودية، لأن القادة هنالك لا يأبهون بذلك. وفي خطوة رمزية لتعميق الروابط، أدرجت السعودية هذا الأسبوع اللغة الصينية كلغة تدريس ثالثة، بعد العربية والانجليزية، واستقبلتْ مئات المعلمين الصينيين، في خطوة نحو تعزيز التفاهم المتبادل والتبادل الثقافي، ولم تُعر اهتمامًا لما يُقال عن “الاستعمار الصيني الجديد”.
هذا التحول السعودي يُبرز النظرة لقيادتها التي ترى أن النظام العالمي يمر بمرحلة تحول، وأن الانفتاح على الصين ليس مجرد تكتيك اقتصادي، بل استراتيجية بقاء في عالم متغير. وبهذا، تتجنب السعودية الوقوع في فخ الاعتماد الأحادي على الغرب، الذي طالما استغل الدول النامية في سعيه لتأمين مصالحه الخاصة، وتظهر كنموذج للسياسة الخارجية التي تضع مصالح الوطن فوق الالتزامات الدولية المفروضة، وتتجنب الأخطاء الاستراتيجية التي يرتكبها القادة الأفارقة، والتي يجب على الجيل الصاعد من السياسيين الأفريقيين تجنبها لتفادي استمرار دورة الفشل واليأس.