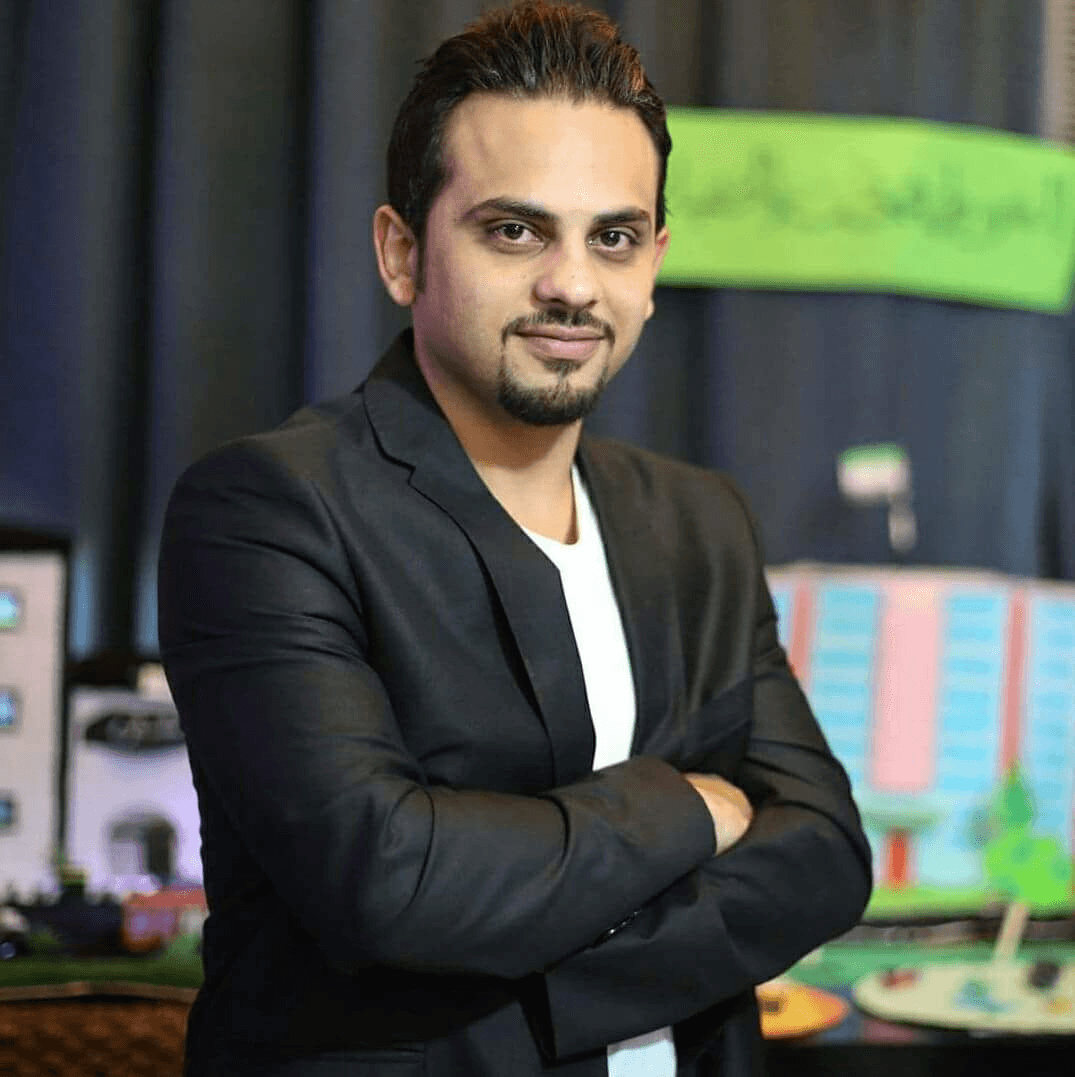سياسة
نحن وقسد والمعركة الأخلاقية
نحن وقسد والمعركة الأخلاقية
في كل صراعٍ مسلّح، ثمة معركتان تسيران بالتوازي: واحدة تُخاض على الأرض، وأخرى تُخاض في الوعي. الأولى قد تُحسم بسرعة أو تطول، وقد تُقاس بخسائر وأرقام، أما الثانية فهي الأبطأ والأخطر، لأنها لا تنتهي مع توقف النار، بل تبدأ بعدها. ما يرافق المواجهات الأخيرة من جدلٍ محتدم لا يبدو، في جوهره، مرتبطاً بتفاصيل الميدان بقدر ما هو انعكاس لمعركة أخلاقية مفتوحة، تتجاوز الحدث نفسه، وتمسّ الطريقة التي نرى بها أنفسنا والآخرين في لحظات التوتر القصوى.
عندما نقول “نحن” في هذا السياق، فنحن لا نشير إلى طرفٍ عسكري ولا إلى جمهورٍ سياسي محدد، بل إلى موقع أخلاقي تشكّل حول رفض الانتهاك بوصفه سلوكاً لا يُقبل مهما تغيّرت الذرائع. “نحن” الذين انطلقنا من فكرة أن معركتنا لم تكن مع أشخاص أو جماعات بقدر ما كانت مع منطقٍ كامل، يجعل القوة معيار الحق، ويحوّل الإنسان إلى تفصيل قابل للتجاوز. من هذا المنطلق، يصبح النقاش حول “قسد” نقاشاً يتجاوزها كقوة أمر واقع، ليطالنا نحن في صميم خطابنا ومعاييرنا.
من المهم التمييز بين طبيعة الحدث الميداني وطبيعة السجال الذي أعقبه. فالمعركة نفسها أُديرت، وفق ما ظهر في مجرياتها العامة، بقدرٍ من الانضباط والسعي الواضح لتقليل الكلفة البشرية، مع حرصٍ على تأمين المدنيين وتحييدهم قدر الإمكان عن مسار الاشتباك. هذا الجانب لا يُستخدم بوصفه شهادة براءة مطلقة، ولا مادة للاحتفاء، بل باعتباره مؤشراً على أن إدارة القوة يمكن أن تخضع لمنطق ضبط الضرر لا لمنطق الاستعراض. غير أن المفارقة المؤلمة أن هذا الأداء الميداني، مهما كان محسوباً، كاد يُفرَّغ من معناه الأخلاقي تحت ضغط الخطاب التحريضي اللاحق، الذي اندفع نحو التبرير والتشفّي بدل البناء على ما يمكن اعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح.
ومن هنا، يصبح من الضروري التذكير بأن الجدل الأخلاقي لا ينشأ في فراغ . فـ”قسد” تمتلك سجلاً طويلاً من الانتهاكات في مناطق سيطرتها، وهو سجل معروف، موثّق، ومثار جدل منذ سنوات. الإشارة إلى هذا السجل ليست تبريراً لأي خطاب تحريضي ضدها، لكنها ضرورية لفهم طبيعة المشاعر التي تحرّك جمهوراً واسعاً يرى فيها قوة مارست القمع، وفرضت الأمر الواقع، وانتهكت حقوقاً أساسية. غير أن الخطورة تبدأ حين يتحوّل هذا الغضب، المشروع في كثير من أسبابه، إلى استعداد لتطبيع أي سلوك نقيض، أو لتبرير أفعال لا تقل إشكالية من حيث المبدأ.
المعركة الأخلاقية هنا لا تُقاس بميزان التعاطف أو الكراهية، بل بميزان الاتساق. فرفض انتهاكات “قسد” لا يكتمل أخلاقياً إن لم يُقابل برفضٍ مبدئي لأي انتهاك مضاد، حتى لو كان رمزياً، وحتى لو لم يرقَ إلى مستوى الجريمة الممنهجة. الأخلاق، في هذا المعنى، لا تعمل بمنطق التراكم العددي، بل بمنطق الخطوط الحمراء: ما الذي نقبله، وما الذي نرفضه، ولماذا.
من هنا تبرز أهمية حادثة رمي الجثة التي جرى تداولها على نطاق واسع. قيل إن الجثة تعود لجندية من “قسد”، وقيل إنها كانت مشاركة في القتال، وربما كانت كذلك. لكن كل هذه التفاصيل، مهما بدت مثيرة للجدل، لا تمسّ جوهر السؤال الأخلاقي. الجثة، أيّاً كانت هوية صاحبها، لها حرمة. التمثيل بالجثث، أو التعامل معها بوصفها أداة إذلال أو رسالة سياسية، فعل مرفوض من حيث المبدأ. ليس لأن الطرف الآخر بريء، ولا لأن تاريخه نظيف، بل لأن القبول بهذا الفعل ينسف الأساس الذي ادّعينا أنه يميّزنا.
الأكثر إشكالية من الفعل نفسه كان ما تلاه من محاولات تبرير أو تهوين. هنا يتبدّى الخلل بوضوح. حين يصبح النقاش دفاعاً عن الفعل بدل مساءلته، وحين تُستدعى سيرة الضحية لتخفيف وطأة ما جرى لها بعد موتها، نكون قد دخلنا منطقة رمادية خطيرة، حيث تُعلّق القيم عند أول احتكاك حقيقي مع مشاعر الغضب أو الشماتة. هذا الانزلاق لا يحدث فجأة، بل يبدأ بخطوات صغيرة، لغوية في ظاهرها، لكنها عميقة الأثر.
في المقابل، لا يمكن تجاهل أن جمهور “قسد” هو الآخر انخرط في خطاب تعبوي حاد، يرى في أي نقد استهدافاً وجودياً، ويخلط بين المساءلة الأخلاقية والتحريض السياسي. هذا الانغلاق المتبادل حوّل النقاش إلى ساحة صدام رمزي، لا مكان فيها للتفكير الهادئ أو للتفريق بين الفعل والخطاب، وبين الإدانة المبدئية والاصطفاف العدائي. هكذا، تحوّلت المعركة الأخلاقية إلى مادة للاستقطاب، بدل أن تكون فرصة للمراجعة.
المسألة، في جوهرها، ليست من هو الأكثر انتهاكاً، ولا من يملك سجلاً أسوأ، بل أيّ منطق نريد أن يحكم الفضاء العام. هل نريد منطقاً يرى في الأخلاق أداة ظرفية، تُستدعى حين تخدم موقفنا وتُهمَل حين تعاكسه؟ أم نريد منطقاً أكثر صعوبة، يفرض علينا إدانة ما نرفضه حتى حين يصدر عن “اللحظة المناسبة” أو “الطرف غير المحبوب”؟
الانتصار في المعركة الأخلاقية لا يعني تبييض صفحة أحد، ولا إنكار واقع الصراع وتعقيداته، بل يعني الحفاظ على حدّ أدنى من الاتساق، يمنع العنف من التحوّل إلى لغة طبيعية، والمهانة من أن تصبح تفصيلاً مقبولاً. هذا الانتصار، وإن بدا أقلّ صخباً من الانتصار العسكري، هو الذي ينعكس لاحقاً على شكل الدولة، وعلى علاقة السلطة بالمجتمع.
في النهاية، ليست المسألة مسألة “قسد” وحدها، ولا مسألة معركة بعينها، بل مسألة وعيٍ عام يُعاد تشكيله تحت الضغط. إما أن ننجح في الحفاظ على المعركة الأخلاقية بوصفها مرجعاً لا يخضع للمساومة، أو أن نقبل، بصمت أو بتبرير، بأن تتحوّل الأخلاق إلى طرفٍ آخر في الصراع، يُهزم كل مرة بحجة أن الوقت غير مناسب. وفي بلدٍ أنهكته الانتهاكات، قد يكون هذا الخيار هو الفارق الحقيقي بين قطيعة مع الماضي، أو إعادة إنتاجه بلغة جديدة.