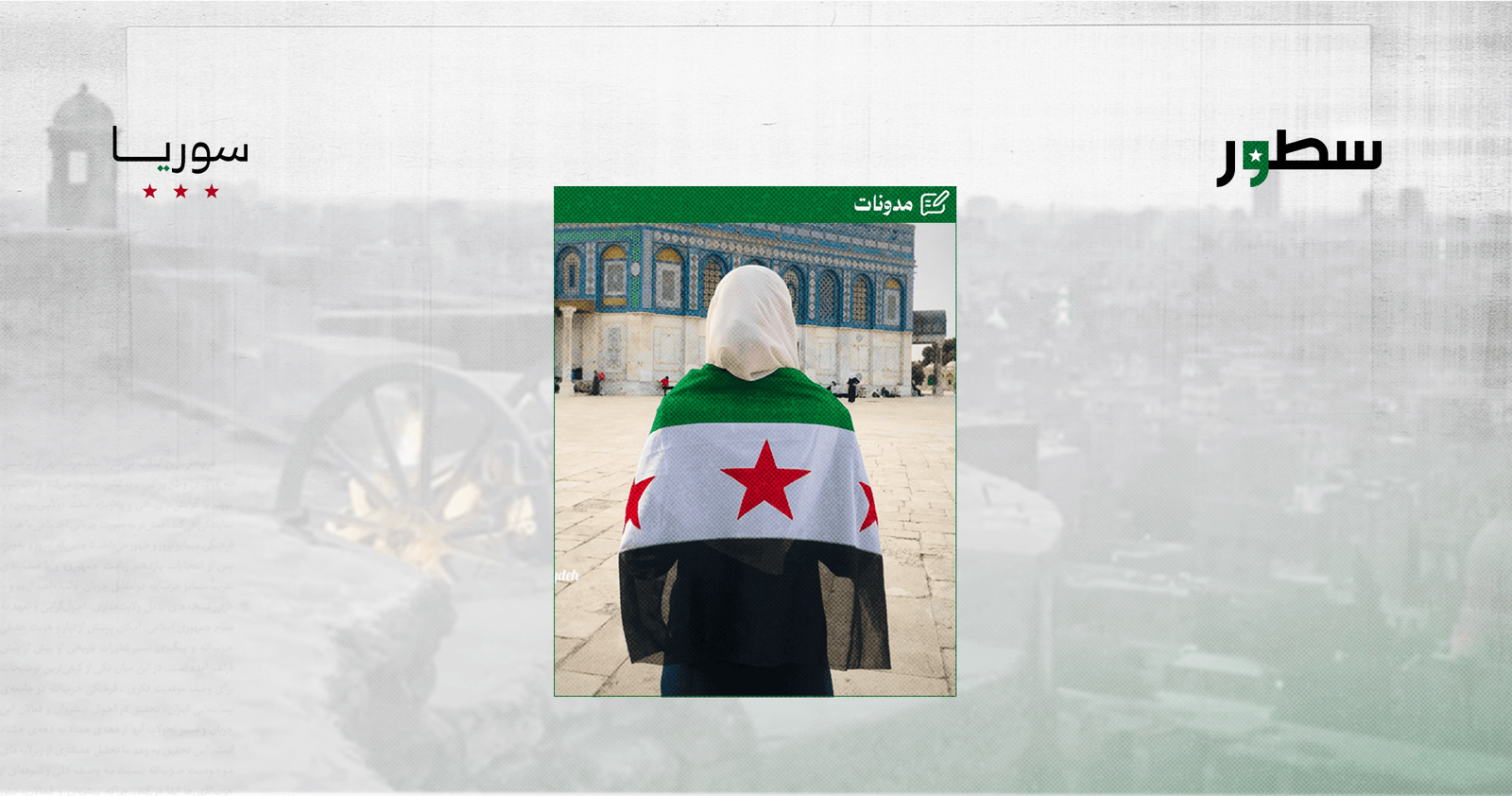مدونات
أبو يزن الشامي.. عالم لم يساوم على ضميره
أبو يزن الشامي.. عالم لم يساوم على ضميره
علي البرغوث
في زحمة الأسماء التي مرّت على الثورة السورية، يبقى اسم أبو يزن الشامي محفوراً في ذاكرة من عرفوه، لا لأنّه كان قائداً عسكرياً فحسب، بل لأنّه كان مشروعاً فكرياً وروحياً متكاملاً، جمع بين العلم والعمل، بين الحرف والبندقية، بين الورع والجرأة.
البدايات: من دمشق إلى ساحات الوعي.
وُلد محمد الشامي، المعروف بلقب “أبو يزن الشامي”، في العاصمة دمشق عام 1986، ونشأ في حي دمشقي محافظ، حيث كانت رائحة الكتب تفوح من زوايا بيته، وكان والده حريصًا على تربيته تربية دينية متوازنة. منذ صغره، أبدى نبوغاً لافتاً، فكان من المتفوقين دراسياً، لكنّه اختار طريقاً غير مألوف حين قرر دراسة الشريعة الإسلامية، رغم أنّ عائلته كانت تفضل له مساراً أكاديمياً مختلفاً.
في كلية الشريعة بجامعة دمشق، لم يكن طالباً عادياً. كان شغوفاً بالفقه، مولعاً بالقراءة، ينهل من كتب التراث كما ينهل من الفكر المعاصر. لم يكن يكتفي بالمقررات الجامعية، بل كان يتردد على حلقات العلم في المساجد، ويتتلمذ على يد علماء كبار، أبرزهم الشيخ كريم راجح، شيخ قراء الشام، الذي ترك في نفسه أثراً عميقاً.
الوعي المبكر والقلق من الصمت.
كان أبو يزن يرى أنّ العلم لا يكتمل إلا إذا اقترن بالمسؤولية الأخلاقية. ولم يكن مرتاحاً لحالة الجمود التي يعيشها كثير من العلماء، وكان كثيراً ما يعود من حلقات العلم حزيناً، متألماً من صمت العلماء عن الظلم، ومن تبريراتهم للواقع. كان يقول لأصدقائه: “العلم الذي لا يحرك صاحبه لنصرة المظلوم، هو علم ناقص، بل قد يكون وبالاً عليه”.
الاعتقال: حين يصبح الفكر تهمة.
في عام 2010، وقبل اندلاع الثورة بعام، تمّ اعتقاله من قبل فرع فلسطين، أحد أكثر الأفرع الأمنية رعباً في سوريا. كانت التهمة: “السلفية الجهادية”، وهي تهمة جاهزة لكلّ من يجرؤ على التفكير بصوتٍ عالٍ. قضى عدة أشهر في المعتقل، ذاق فيها مرارة القهر، لكنّه خرج أكثر إصراراً على أن يكون للعلم دور في التغيير.
من المنفى إلى الثورة.
بعد خروجه من السجن، غادر إلى الإمارات، وهناك أسس مع مجموعةٍ من رفاقه “مجلس الإفتاء”، الذي كان يتلقى الأسئلة من الداخل السوري ويجيب عنها، في محاولة لمد الثوار بالوعي الشرعي. كان يؤمن أنّ الثورة ليست فقط صراعاً على الأرض، بل معركة على العقول والقلوب.
العودة إلى الميدان: حين يصبح العالم مقاتلاً.
لم يرض أبو يزن أن يبقى بعيداً عن الميدان. عاد إلى سوريا، وانضم إلى صفوف الثوار، وتحديداً في الغوطة الشرقية. لم يكن مجرّد مقاتل، بل كان قائداً يحمل رؤية، ومجاهداً يحمل كتاباً وسلاحاً. كان يحرص على أن تكون كتائبه منضبطة أخلاقياً، وكان يرفض أيّ تجاوزات، حتى لو صدرت من أقرب الناس إليه. وكان يقول: “الثورة التي لا تحترم الإنسان، لا تستحق أن تُنتصر.”
العريس الشهيد
في عام 2014، عقد قرانه على فتاة من الغوطة، وكان يحلم بحياةٍ بسيطة، مليئة بالعلم والعمل. لكن القدر لم يمهله طويلاً. ففي التاسع من أيلول من العام نفسه، ارتقى شهيداً في إحدى المعارك، بعد أن أصيب بقذيفةٍ خلال اشتباك مع قوات النظام. رحل وهو في أوج عطائه، تاركاً خلفه زوجةً لم تكتمل فرحتها، وأمًّا مكلومة، وأمةً فقدت أحد أنبل أبنائها.
إرثه: ما بعد الغياب
لم يكن أبو يزن نجماً إعلامياً، ولم يسع إلى الشهرة، لكنّه ترك أثراً عميقاً في كلّ من عرفه. رفاقه يروون عنه مواقف لا تنسى: كيف كان يواسي الجرحى، ويقضي الليل في قراءة كتب الفقه، ويحرص على صلاة الجماعة حتى في أشد لحظات القصف. كان يؤمن أنّ الثورة امتحان أخلاقي قبل أن تكون معركة سياسية.
لماذا لا يُنسى؟
لأنّنا في زمن اختلطت فيه الأصوات، وبات من الصعب التمييز بين من يقاتل من أجل الكرامة، ومن يقاتل من أجل السلطة، يبقى أبو يزن الشامي شاهداً على أنّ الثورة كانت، في جوهرها، صرخة ضمير. كان نموذجاً لما يمكن أن يكون عليه الإنسان حين يتسلح بالعلم، ويتزين بالأخلاق، ويختار أن يدفع ثمن مواقفه مهما كان باهظاً.
رحم الله أبا يزن الشامي، وجعل ذكراه حيّة في قلوب الأحرار، وهو الذي علّمنا أنّ الكلمة الصادقة قد تكون أثقل من الرصاص، وأنّ العالم إذا حمل السلاح دفاعاً عن الحقّ، صار سلاحه أنبل من كلّ سلاح.