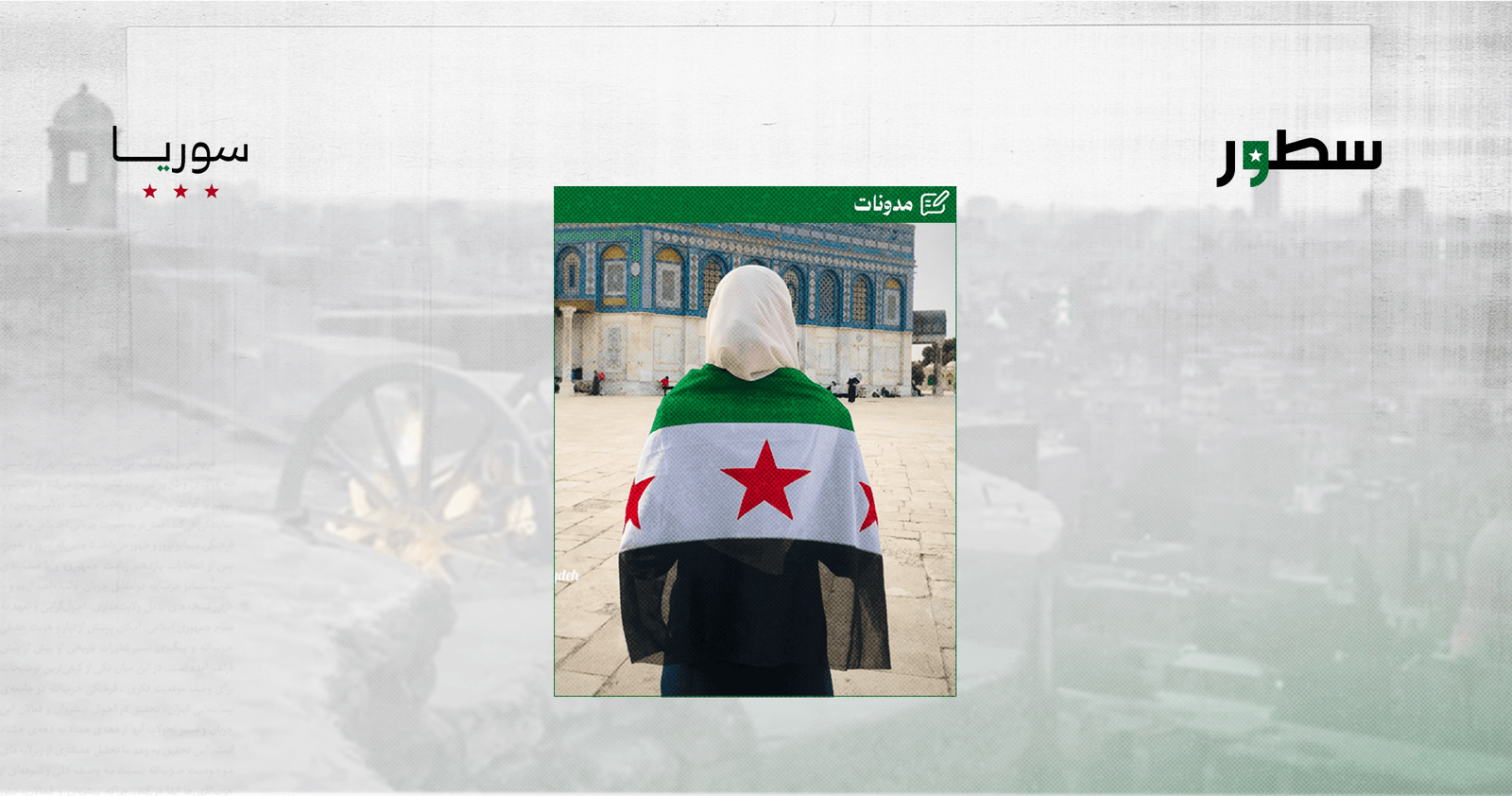سياسة
الشيخ مقصود والأشرفية ورقتا ضغط
الشيخ مقصود والأشرفية ورقتا ضغط
لا يمكن اعتبار ما شهده حيّا الشيخ مقصود والأشرفية مجرد توتّر عابر في حيّين حلبيَّين؛ فهما في الواقع ورقتان سياسيتان بالغتا الحساسية، لطالما لجأت “قسد” إلى توظيفهما كلما وجدت نفسها في مأزقٍ سياسي أو رغبت في إعادة خلط الأوراق، إذ إنّ السيطرة عليهما والتمسّك بهما تمنحها أداة ضغط أمنية وسياسية في آنٍ واحد.
وعندما تختار “قسد” إعادة إشعال التوتر والتصعيد فيهما، فإنّ ذلك لا يأتي بمعزلٍ عن السياق السياسي الأوسع، ولا عن اقتراب انتهاء مهلة اتفاق 10 آذار/ مارس، ولا عن التوقيت المتزامن مع زيارة وفد تركي رفيع المستوى ضمّ وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم كالن. زيارة لم تكن بروتوكولية بقدر ما حملت رسائل سياسية مباشرة، عبّر عنها فيدان بوضوح حين قال: “من المهم ألا تظلّ قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة الأكراد، عقبة أمام وحدة سوريا”، مضيفاً أنّ “قوات سوريا الديمقراطية لا يبدو أنّ لديها نية حقيقية للمضي قدماً في عملية الاندماج”.
في هذا السياق، يغدو التصعيد في الشيخ مقصود والأشرفية رسالة سياسية متعددة الاتجاهات، تتجاوز بُعدها المحلي، وتدخل مباشرةً في صلب الترتيبات الأمنية والسياسية في الشمال السوري، حيث تتقاطع حسابات اللاعبين الدوليين، وفي مقدمتهم تركيا، مع معادلات النفوذ والضغط وإدارة الوقت.
ولم يبقَ هذا التصعيد في إطار الرسائل السياسية فحسب، بل وجد ترجمته الميدانية في 22 ديسمبر/ كانون الأول، حين اندلعت اشتباكات في محيط الحيّين بين عناصر من قوات “قسد” وقوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية المنتشرة على الحواجز المحيطة. ولم تقتصر المواجهات على نقاط الاشتباك المباشر، إذ طال رصاص القنص محيط دوّار الليرمون ومنطقة الشيحان، ووصلت قذائف الهاون إلى أحياء السريان والجميلية داخل مدينة حلب.
وأسفرت الاشتباكات عن مقتل مدنيين وإصابة آخرين، بحسب قناة الإخبارية السورية، جراء نيران مصدرها مواقع “قسد”. كما أُصيب عنصران، أحدهما من وزارة الداخلية والآخر من الجيش السوري، إضافة إلى عددٍ من عناصر الدفاع المدني، وفق بيان وزارة الداخلية، في حين أفاد مستشفى الرازي في حلب باستقباله 4 إصابات نتيجة نيران مصدرها عناصر “قسد”.
في المقابل، سارع المركز الإعلامي التابع لقوات سوريا الديمقراطية إلى نفي الاتهامات الموجّهة إليه، معتبراً أنّ ما جرى في حلب “نتاج مباشر لأفعال الفصائل التابعة لحكومة دمشق”. وقال في بيان إنّ “الفصائل تستخدم الدبابات والمدفعية ضد الأحياء السكنية في حلب”، نافياً بشكلٍ قاطع استهداف قواته لأحياء المدينة. كما أكد في نص البيان، أنّ “قواتنا كانت قد سلّمت مواقعها لقوى الأمن الداخلي (الأسايش) وفق اتفاق 1 نيسان”، محمّلاً الحكومة السورية الانتقالية مسؤولية ما وصفه بـ”الفشل في وقف الاستفزازات المتكررة ومحاصرة حيي الشيخ مقصود والأشرفية خلال الأشهر الأربعة الماضية”.
وأضاف البيان أنّ التصعيد الأخير، ولا سيّما “نشر الدبابات والمدفعية وقصف الأحياء السكنية في الشيخ مقصود والأشرفية”، يشكّل “تصعيداً خطيراً يهدّد حياة المدنيين والاستقرار الإقليمي”، متهماً تلك الفصائل بإطلاق الصواريخ من “مساراتٍ عسكرية واضحة في غرب وشمال حلب” باتجاه أحياء المدينة، بهدف تقويض الأمن والتحريض على الاضطرابات.
غير أنّ هذا الخطاب، في جوهره، لا يبدّد الأسئلة الأساسية حول توقيت التصعيد وحدوده، ولا ينجح في فصله عن السياق السياسي الذي يُعاد فيه توظيف الحيّين كورقة ضغط في لحظةٍ تفاوضية شديدة الحساسية. فالمسألة تتجاوز تبادل الاتهامات إلى نمطٍ متكرر من إدارة الصراع عبر التوتر الميداني كلّما اقترب استحقاق سياسي أو ضاق هامش المناورة.
ويُذكر أنّ الحيّين يخضعان لاتفاق أُبرم في أبريل/ نيسان 2025 بين الحكومة السورية و”قسد”، بهدف تعزيز السلم الأهلي والتعايش المشترك وتنظيم الوضعين الإداري والأمني فيهما، وينصّ على اعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية جزءاً إدارياً من مدينة حلب. غير أنّ ما جرى يعكس فجوة واضحة بين نصوص الاتفاق ومسار تنفيذه على الأرض، ويؤكد هشاشة الالتزامات حين تتحوّل الوقائع الميدانية إلى أداة ضغطٍ سياسية، ويُدفع المدنيون مرة أخرى ثمن صراعات تُدار فوق رؤوسهم.
ولم يمرّ هذا الحدث من دون أن يترك أثره في الساحة السورية، ولا سيّما مع اقتراب انتهاء مهلة اتفاق 10 آذار، الذي أُبرم في دمشق بين الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية السيد أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية السيد مظلوم عبدي. فقد أعاد التصعيد فتح باب واسع من الانقسام والتباين في آراء المهتمين بالشأن العام، وخصوصاً في أوساط النخب السياسية والإعلامية.
في هذا النقاش، يذهب فريق إلى التعويل على سياسة الصبر التي تنتهجها الحكومة السورية، وعلى تقاطع المصالح الإقليمية التي تدفع، حتى اللحظة، باتجاه إبقاء مسار الحوار مفتوحاً إلى أبعد مدى ممكن. ويستند هذا الرأي إلى قراءةٍ ترى أنّ الحكومة، وهي في مرحلة تثبيت الحكم وإعادة ترتيب بنيتها الأمنية والسياسية، لا تبدو معنية بخوض حرب شاملة أو الانجرار إلى انفجار واسع قد يرهق بنيتها الوليدة ويستنزف قدرتها على إدارة ملفات أكثر تعقيداً.
في المقابل، يبرز تيار أكثر تشككاً يرى أنّ سياسة الصبر قد تتحوّل إلى عبءٍ سياسي متراكم، ولا سيّما في ظل ضغط تركي واضح يرفض أيّ كيان مسلح على حدوده الجنوبية يشكّل تهديداً مباشراً لأمنه القومي، إلى جانب ضغط داخلي متزايد يتهم الحكومة بالتراخي والتماهي، وبإهمال ملفّ الجزيرة السورية، وترك “قسد” تمضي في ممارسات وانتهاكات جسيمة تطال شريحة واسعة من المواطنين السوريين في المنطقة، مستفيدة حتى الآن من دعم الشريك الأمريكي الذي يتيح لها التحكم بوتيرة التصعيد أو خفضها كلّما شعرت بالضغط السياسي.
وبين هذين الاتجاهين، تبدو الحكومة السورية وهي تحاول الموازنة بين كلفة الصدام وكلفة الانتظار في معادلة دقيقة وحساسة، حيث لا يُقرأ ضبط النفس دائماً بوصفه خياراً استراتيجياً، ولا يُنظر إلى التصعيد باعتباره حلاً مضمون النتائج. وفي ظل هذا التوازن المربك، يتحوّل اتفاق 10 آذار من أداةٍ يُفترض أن تفتح باب الحل إلى عبءٍ يثقل كاهل حكومة انتقالية تواجه ملفات أخطأت في تقديرها وما يزال بعضها معلّقاً، مثل السويداء، التي لا تقل أهمية أو كلفة. وقد اعترفت الحكومة بالانتهاكات التي وقعت، وهي ذاتها الملفات التي استندت إليها “قسد” تارة لرفع سقف مطالبها في مفاوضاتها مع دمشق، وتارة أخرى للتلويح بعصا التصعيد كلّما انحسر هامش المناورة السياسية، ما يجعل الاتفاق اختباراً حقيقياً لقدرة الدولة على ضبط التوازن بين التحديات المحلية وإدارة الضغوط الإقليمية في آنٍ واحد.
وفي هذا المناخ المأزوم، يطفو على السطح اتجاه ثالث يذهب إلى أبعد من ذلك، داعياً الحكومة السورية إلى إعلان النفير العام واستدعاء الفزعات العشائرية لمواجهة عسكرية شاملة مع “قسد”، باعتبارها -وفق هذا الرأي- الطريق الأقصر لحسم الملف، وإنهاء حالة المراوحة السياسية. غير أنّ هذا الطرح، على ما يحمله من نزعة حاسمة، ينطوي على مخاطر عالية قد تُربك المشهد العام أكثر ممّا تحسمه؛ إذ يتجاهل هشاشة البنية العسكرية والأمنية للحكومة الانتقالية، ويغفل كلفة الانخراط في صراعٍ مفتوح متعدد المستويات، لا يقتصر على الداخل السوري فحسب، بل يمتد إلى توازنات إقليمية ودولية معقّدة، في ظل وجود أمريكي مباشر، ودور تركي فاعل، وتشابك مصالح القوى الدولية.
كما أنّ الانزلاق إلى مثل هذه الدعوات لمواجهة شاملة من شأنه أن يفتح الباب أمام فوضى أثبتت التجربة كيف أدت دوراً سلبياً في تقويض الدولة كمؤسسة وإرباك سلطتها، وقد يجرّ البلاد إلى دوّامة انتهاكات ومجازر تضع الحكومة في فخٍ جديد، لا تصنعه قوى معادية هذه المرة، بل تُنتجه خيارات مرتجلة بأيدٍ محلية. وهو ما يعيد إنتاج مناخ الصراع المسلح على حساب أيّ مسار سياسي أو تفاوضي، فضلاً عن الكلفة الإنسانية التي ستقع مجدداً على عاتق المدنيين في مناطق التماس. وفي هذا السياق، تبدو هذه الدعوات، مهما بدت حادّة أو جذّابة لبعض الرأي العام الغاضب، أقرب إلى تعبير عن انسداد أفق سياسي ومأزق استراتيجي، أكثر من كونها خياراً واقعياً قابلاً للتنفيذ دون أثمان باهظة قد تتجاوز قدرة الدولة والمجتمع على الاحتمال.