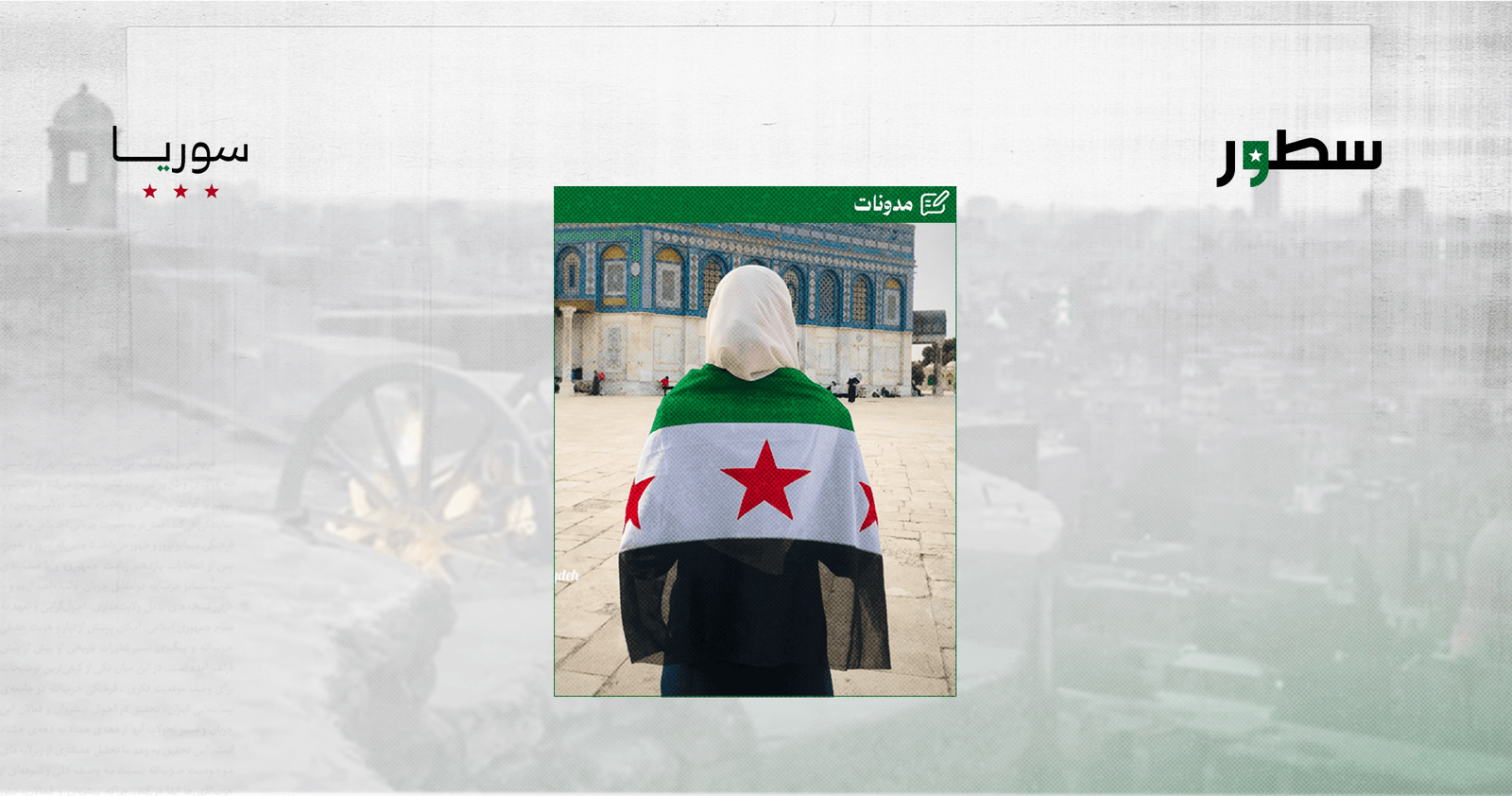مدونات
الجنوب السوري بين السيادة والردع
الجنوب السوري بين السيادة والردع
محمد السطم
منذ سقوط نظام الأسد ودخول سوريا مرحلة سياسية جديدة، تبنّت دمشق مقاربة مختلفة تجاه محيطها الإقليمي تقوم على تهدئة التوترات وطيّ صفحة الصدامات، مؤكدة أنّها لا تسعى إلى تشكيل أيّ تهديدٍ بما في ذلك تجاه إسرائيل، وأنّ استقرار الجبهة الجنوبية شرط لإعادة بناء الدولة.
لكن إسرائيل اتخذت مساراً مغايراً؛ إذ استهدفت مقدرات الجيش السوري ليلة سقوط النظام، واستمرت في التوغلات التي تجاوزت ما نصّ عليه اتفاق فصل القوات لعام 1974، وصولاً إلى فرض واقع ميداني جديد. وبينما تطالب دمشق بالعودة إلى خطوط ما قبل سقوط النظام وإحياء ترتيبات 1974 كأساسٍ لأيّ تفاهم أمني، ترفض تل أبيب ذلك رغم جهود الوساطة الأمريكية.
وهكذا تتسع الهوّة بين رؤيتي الطرفين، ما يجعل فرص التفاهم تتراجع يوماً بعد يوم ويطرح تساؤلاً حول الأسباب العميقة وراء تعثر المسار وما إذا كانت المشكلة في شروط التفاوض أم في الحسابات الاستراتيجية لكل طرف.
حسابات أمنية لا تلتقي
تعود أزمة التفاهمات بين الجانبين إلى اختلاف جوهري في تقدير المخاطر وتحديد أولويات الأمن القومي. فإسرائيل تنظر إلى الجنوب السوري باعتباره بوابة حساسة لجبهتها الشمالية، وتتعامل بعقلية “التحوّط الدائم” التي تعزّزت بعد أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، معتبرة أنّ أيّ سلطة في دمشق مهما بدت معتدلة قد تعيد إنتاج سياسات مختلفة مستقبلاً، ما يجعلها تفضّل تثبيت واقع ميداني جديد يمنحها عمقاً أمنياً بدل العودة إلى حدود تراها مكشوفة.
في المقابل، تركّز دمشق الجديدة على إعادة بناء الدولة وتثبيت السيادة، وترى أنّ تجاوز خطوط 1974 يمثّل إخلالاً بمرجعية قانونية حافظت لعقود على هدوء الجبهة، وأنّ القبول بالواقع الجديد يعني تحويل أيّ تفاهمات مستقبلية إلى معادلة قوة لا إلى التزامات متبادلة.
وبهذا التباين العميق في تقدير المخاطر وأولويات الأمن، يصبح تعثر المسار نتيجة طبيعية، وتتقدّم مجموعة من العوامل المحدّدة التي تفسّر اتساع الهوّة بين الطرفين:
انعدام الثقة بين الطرفين
مثّل انعدام الثقة أحد العوامل الأكثر تأثيراً في تعثّر التفاهمات بين دمشق وتل أبيب. فرغم إعلان السلطة السورية الجديدة أنّها لا تسعى إلى تهديد إسرائيل ولا إلى تغيير قواعد الاشتباك، ترى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنّ هذه التطمينات غير كافية، لأنّها صادرة عن سلطةٍ ما زالت في طور إعادة بناء الدولة، ولم تتضح بعد ملامح استراتيجيتها طويلة المدى. لذلك تعتمد تل أبيب سياسة “التحوّط المستقبلي”، أي افتراض الأسوأ حتى في ظل ظروف تبدو مواتية.
في المقابل، ترى دمشق أنّ إسرائيل تستخدم هذا الشك لتبرير فرض واقع جديد على الأرض وتجاوز اتفاق 1974، وأنّ استحضار ماضي السلطة بات وسيلة سياسية لإضفاء شرعية على التوسع. ويتعمق هذا الانطباع السوري بسبب الدور الأمريكي المحدود؛ فواشنطن تبدو راضية عن أداء السلطة السورية الجديدة وتشجّع على التفاهم، لكنّها لا تمارس الضغط الكافي على إسرائيل للدخول في مفاوضات جدّية أو مراجعة إجراءاتها الميدانية.
وبذلك يتحوّل انعدام الثقة من عامل معيق إلى محدد رئيسي لمسار التفاهمات، إذ لا يمكن لأيّ اتفاق أن يصمد ما دام الضامن التقليدي غير قادر على تحويل التشجيع السياسي إلى خطوات ملزمة تعيد ضبط المشهد وما دامت الحسابات مبنية على نوايا مستقبلية غير قابلة للقياس.
تغيّر حسابات الأمن الميداني.
يمثّل التغيير الميداني الذي قامت به إسرائيل في الجنوب السوري أحد أكثر العوامل تأثيراً في تعثر أيّ تفاهم محتمل. فبعد سقوط النظام السابق وما رافقه من فراغ في السيطرة وتراجع حاد في القدرة العسكرية السورية، تحركت تل أبيب بسرعة لفرض واقع جديد يتجاوز حدود اتفاق فصل القوات لعام 1974، الذي حدد مناطق محددة للانتشار ومنطقة فصل تشرف عليها قوات الأمم المتحدة.
من منظورٍ إسرائيلي، لم يكن ذلك مجرّد توسع عسكري، بل خطوة لإعادة ضبط الجغرافيا الأمنية على نحو يمنع أيّ تهديد مستقبلي قادم من الجنوب مهما تغيّرت السلطة في دمشق. ومع غياب طرف سوري قادر على الردع، وجدت إسرائيل أنّ اللحظة السياسية مناسبة لتوسيع نطاق انتشارها وإقامة نقاط مراقبة وطرق عسكرية داخل مناطق لم تكن فيها.
هذه الوقائع الجديدة تُدخل أيّ تفاهمات محتملة في مسار شديد التعقيد؛ إذ إنّ العودة إلى خطوط 1974 لم تعد تعني فقط الالتزام باتفاقٍ قديم، بل تتطلّب تفكيك منظومة ميدانية باتت جزءاً من استراتيجية الأمن الإسرائيلية.
أمّا من الجانب السوري، فإنّ هذه التغييرات لا تُعد مجرّد خرق للاتفاق، بل مسّاً مباشراً بالسيادة وتأسيساً لواقع حدودي قد يتحوّل مع الوقت إلى أمر واقع دائم. وترى دمشق الجديدة أنّ أيّ تفاوض لا ينطلق من نقطة “إعادة الوضع إلى ما كان عليه” هو عملياً قبول بفقدان الدولة السورية القدرة على تثبيت حدودها التاريخية. وبهذا تختلف قراءة الطرفين جذرياً لما حصل:
– إسرائيل تعتبر الخطوات احترازاً أمنياً مشروعاً.
– وسوريا تراها تجاوزاً لخطوط حمراء تُفقد الاتفاق الدولي قيمته القانونية.
ويؤدي هذا التباين إلى نتيجة حتمية: كلما طال بقاء الوقائع الميدانية الجديدة، ازدادت كلفة التراجع عنها، ليس على إسرائيل فقط، بل على الاستقرار الحدودي برمته. وهذا ما يجعل السبب الثاني من أكثر العوامل صعوبة، لأنّه يلامس بنية القوة على الأرض وليس مجرّد خلاف في الخطاب السياسي.
الحسابات الداخلية الإسرائيلية.
يمثّل الوضع الداخلي الإسرائيلي عاملاً رئيسياً في إبقاء ملف التفاهمات مع دمشق في حالة جمود؛ فالمشهد السياسي يعيش انقساماً حاداً يجعل أيّ حكومة أكثر ميلاً لاعتماد التشدد الأمني خشية استغلال خصومها لأيّ خطوة تُفهم تراجعاً على الجبهة الشمالية. وبهذا يتحوّل الجنوب السوري إلى ورقةٍ تستخدمها القيادات لتعزيز صورتها أمام الجمهور، لا إلى ملفٍ قابل للتسوية.
كما تضغط المؤسسة العسكرية باتجاه عدم تقديم أيّ تنازلٍ قد يُضعف مكانتها أو يُظهر الحكومة بمظهر المتساهل، فيما يضيف الرأي العام القَلِق من تداعيات ما بعد السابع من أكتوبر مزيداً من التحفّز. هذه البيئة المعقّدة تقلّص هامش المناورة السياسي، وتجعل التراجع عن الواقع الميداني الجديد مكلفاً انتخابياً قبل أن يكون أمنياً.
وهكذا يصبح التشدد الإسرائيلي تعبيراً عن حساباتٍ داخلية سياسية وأمنية وشعبية ترهن مسار التفاهمات بسياقٍ داخلي مضطرب لا يقل صعوبة عن التحديات الإقليمية.
تُظهر العوامل السابقة أنّ الهوّة بين دمشق وتل أبيب ليست نتاج ظرف سياسي آني، بل نتيجة تراكمات معقّدة تتداخل فيها حسابات الأمن الميداني مع محددات الداخل الإسرائيلي، إضافة إلى بيئة إقليمية تشهد تحولات متسارعة ودور أميركي غير فعّال. وفي ظل هذه المعطيات، يبدو أنّ فرص التفاهم تظل رهينة ميزان القوة على الأرض أكثر ممّا هي نتاج إرادة تفاوضية صافية، لأنّ أيّ مقاربة تتجاهل طبيعة التحولات الأمنية والجيوسياسية ستجد نفسها عاجزة عن إنتاج تسوية قابلة للحياة.
ومع ذلك، فإنّ استمرار الوضع الراهن يحمل كلفة متزايدة على المنطقة، قد يؤدي إلى انزلاقات غير محسوبة في منطقة لطالما ارتبط استقرارها بقدرة الأطراف على إدارة التوتر ضمن حدود مضبوطة. وعلى هذا الأساس، تبدو الحاجة ملحّة لعودة إطار تفاوضي مباشر أو عبر وساطة فعّالة يعيد تعريف قواعد الاشتباك ويضع آليات واضحة للحد من التصعيد، بما يفتح المجال أمام مقاربة جديدة أكثر واقعية وتوازناً.